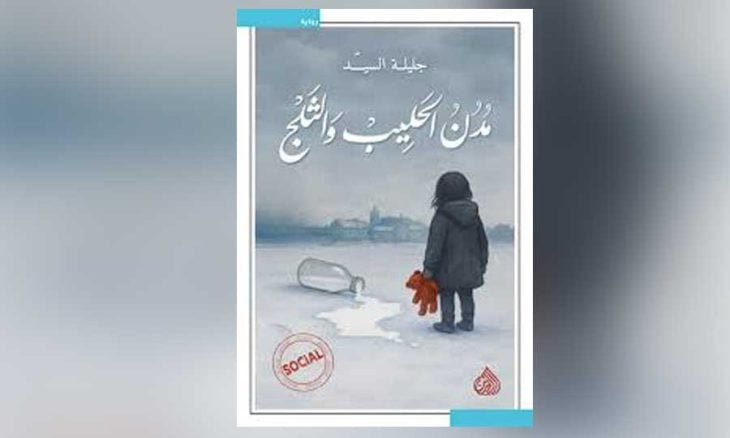مستشفى المعمداني.. جدران تروي حكاياتها للعابرين بقلم يسري الغول -غزة
بقلم يسري الغول -غزة

مستشفى المعمداني.. جدران تروي حكاياتها للعابرين
بقلم يسري الغول – روائي فلسطيني يعيش في غزة.
وأنت تدفع نفسك إلى الولوج من بوابة المستشفى الأهلي العربي المعمداني، لا يمكنك أن تغفل عن مشهد المقابر التي زُرعت في المربعات التي أنبتت زهوراً فيما قبل، والخيام التي أُقيمت رَغِمَ أنف المساحات الضيقة في الواجهة، وذلك لمتابعة الحالات الطارئة نتيجة القصف المستمر، فضلاً عن الصحافيين الذين ينتظرون القصص كي تَحْضُر في سيارات إسعاف شبه متهالكة، والجدران الغارقة في دمها، وبعضها مدمر والبعض الآخر أثري.
ما إن تقف أمام مبنى الجراحات العامة، حتى تسمع الصراخ والأنّات التي تزلزلك، وتتمنى لو في استطاعتك الهروب من المكان، لكنك تصمد لأنك مضطر، وتجلس في جوار سرير أبيك، وتتأمل الأسِرّة القديمة، التي لا أغطية لها ولا فراش، والمطلوب منك أن تُحضِر كل شيء معك، وكذلك الطعام والدواء أحياناً. والممرات ضيقة والناس سكارى، والجميع يهرول نحو هدف محدد غير متوفر، وكلهم يصرخون، وصوت الأقدام يطن في أذنيك، وأبوك مبتور القدم اليُسرى يستمع معك إلى إيقاع حزين، ويتمتم لك أن الشبان فقدوا حيواتهم، وهُم مبتورو الأقدام والأيدي، ويتألمون، والضجيج يزلزل المكان.
الإيقاع مستمر، ولا شيء رتيب في ذلك المكان، وكلّه قابل للتشظي، وسيمفونية الوجع هي السمة الوحيدة الثابتة في هذا السوق/المستشفى، إذ تبصر كل لحظة خروج صِبية ونساء وشيوخ، كلّهم بلا أقدام، وكأنها حانة للرهان على الأجساد، والمشتري في الأعلى يضرب بقوة، ويبطش بمن هم دونه، ويطلق صواريخه وهو يضحك بفجاجة، ولا يأبه للقصص والحكايات والمشاعر والأوجاع. ويبلغ الأمر منك إلى درجة أن تحاول الخروج من المكان إلى صوت جديد يملأ الدنيا نواحاً، فأمامك مشاهد لن تُمحى من الذاكرة أبداً؛ فالجثث تصل على عربات تجرها حيوانات هزيلة، وبعضها فوق بعضها الآخر، ويقول الرجل العادي: “نزلوهم يا شباب”، وآخر يطلب الانتظار لعل أحدهم فيه روح، “أي ما زال يتنفس”، فيذهبون إلى الاستقبال ثم يعودون بخفَّي مقاوِم، ويضعونهم على بلاط مشبع بالدم، ثم يحملونهم واحداً تلو الآخر على خشبة لتكفين الموتى. رأيت مرة ثلاثة شبان كانوا يشترون الفلافل عند مفترق الشجاعية لعائلات عديدة، وربما كانوا يضحكون وربما كانوا جائعين جداً، وربما سئموا الحياة، فقرروا الوقوف عند المفترق ليعيدوا إكسير الحياة بضحكة عابرة.
فتتساءل بينك وبين نفسك: “لو كان هؤلاء في بلد لا مجانية فيها للموت، هل كانوا سيتركونهم بلا فحص؟ وهل سيعجزون عن إنعاشهم بمحاولات لإحياء ما تبقّى منهم كما تشاهد في الأفلام والمسلسلات؟ هل سيدفنونهم بهذه الصورة الغريبة العاجلة؟ في خمس دقائق تختفي وكأنك لم تكن، وتُنسى وكأنك حلم عابر. يذهبون بهم ليَحْضُرَ آخرون؛ شهداء للبيع، وقطع غيار لأجساد تَصْلُحُ للحياة، فتعاود السؤال: ما حاجة تجار البشر إلى خطف الأطفال الأبرياء والشبان البسطاء أو النساء في بلاد العالم الفقير؟ يمكنهم المجيء إلى غزة واختيار ما يشاؤون في مقابل منح عوائل الشهداء/الجرحى فرصة الهروب إلى أي مكان لا حرب فيه، لترميم الحياة، إذا رُممت.
ويمر أمام ذلك كلّه فتى لا يحمل في قلبه سوى الحب، ومتلازمة داون تعفيه من فهم دروس الحياة الصعبة، فيمسك بقبضة يده اليمنى بربيشاً بلاستيكياً وكأنه مايكروفون، ويتحدث وكأنه صحافي بهمهمات لا نفهمها، ويحاول التفاعل مع المشهد، والجميع في حالة ذهول وتناقض؛ “أيبكون أم يضحكون؟”، ثم يغادر المكان.
وتمضي ساعات ثم يأتي الفتى نفسه وهو يلبس ملابس أطباء، وينظر في وجوه المرضى، ويحاول سحب الأغطية عنهم، ويهز برأسه وكأنه يقول إن الحالة الصحية جيدة، ويقلد كل ما حوله، ويتقمص المشاهد التي يبصرها فيما عدا الموت. ربما استطاع في لحظة أن يصير أخاً أو ابناً لشهيد، فتراه يبكي ويبكي بحزن، فيأتي أحدهم ليضمه، ليعود هذا الفتى إلى الضحك.
والقصص لا تتوقف، وتعلن أنها ستستمر طالما تحلّق الطائرات في الأعلى، والعجوز الطاعن في الحزن يقص القماش الأبيض جيداً، ويتفنن في صناعة الأكفان، فلا شيء يشغل باله إلاّ ربط الميت بقِطَع بيضاء بعد وضع النايلون، ثم القماش الأبيض بالكامل على الجسد، إلى درجة أنه ينسى جلالة اللحظة، ويشرع في تعليم شاب آخر كيف يصبح خبيراً في تكفين الموتى، والناس تحدق في الجثث الجاثمة على الأرض، مسلّمين بالكامل للواقع السوداوي اللعين.
ثم تأتي القطة السوداء بأطفالها، وتسير بين الأسِرّة باحثة عن وليمة لمصابين جائعين لا يملكون ثمن علبة حمص أو تونة، ثم تجلس تحت سرير ضخم كصاحبه، وتنام رغم أنف الصراخ، وينام معها أطفالها، ولا يأبهون للرجل المحترق الوجه، أو الطفل الذي فقد طفولته باكراً، أو للأسرة التي ترزح تحت صهْد الشمس، أو الأطفال الممددين على الأرض بلا ممرضين لكثرة الإصابات والشهداء. والقطة لا تفهم أن هذا مستشفى، لا يجوز لها الحضور إليه، وأن عليها احترام صراخ المبتورين.
الجدار مليء بالأوراق والملصقات المتنوعة؛ ملصق لمكتب بصريات أبو يوسف، وورقة أدعية لمسلمين على الرغم من أن المكان مسيحي، وملصق للحلاق أبو محمود. وترى الجدار متهالكاً، ويوشك أن يتداعى بعد تصدُّعه وتمزُّق أوصاله. والناس عند مدخل القسم ينامون بصورة مثيرة للحزن؛ فعند أسفل الدرج، وفي مساحة صغيرة، يتمدد آخرون، وترى الشهداء عن اليمين والشمال، أطفالاً، ونساءً، وبأعمار وأحجام متعددة. وتجد امرأة تغطي بكفيها عينَي ابنتها لتمنع عنها رؤية تلك المشاهد الدامية، وقد جاءت تلك المرأة لزيارة أخيها الوحيد المتبقي من سلالة عائلة عريقة فقدت الحرث والنسل بصاروخ بليد لا يفهم، فأحرق الأخضر واليابس، فظل الرجل المبتور تحت الأنقاض حتى جاء رجال ببزة برتقالية وانتشلوا ما تبقّى من روحه، ليظل شاهداً على المجزرة.
وما يلفت انتباهك خلال ذلك هو تداخُل الأصوات، وانسجامها الغريب على الرغم من اختلاف اللهجات، فتشعر تجاه الجميع بألفة غريبة، في ظل اختلاف طباعهم وأشكالهم وألوانهم ولهجاتهم وربما دينهم.
تحاول أن تهرب من الجثث بتمييز اللهجات؛ فهذا من جباليا البلد، وهذه غزّيّة، وتلك شخرة حانوني، وربما هذا من مخيم الشاطئ، وخلال ذلك، تقرر الهروب إلى الحمام لإفراغ ما في جعبتك من طعام، فتطالعك الرائحة النتنة، والحمام الملوث، والأدوات الصحية التالفة والمعطلة، وتدهشك الحياة بكمّ التناقضات الهائل الذي يمكن أن يتمثل في هذا المكان الذي يصارع للبقاء، ويحاول أصحابه احتواء هذا الكمّ الكبير من المرضى والجرحى بعد تدمير البنية الصحية في القطاع، واستهداف الطواقم الطبية، وتدمير المشافي وعيادات الرعاية الأولية والعيادات الخاصة.
وبينما أنت جالس في جوار سرير أبيك، تطالع الأخبار السوداء على هاتفك المحمول، أملاً بخبر يبلّ الريق، ويتحدث عن هدنة أو وقف لإطلاق النار، وإذ بهم يُحضرون طفلة تشبه الملائكة، ويضعونها على الدكة الخشبية، ويكفنها العجوز وهو يتفنن في ربط الكفن وترتيبه، بينما يبكي الأب، ويصرخ بعلو الصوت، ويسأل الله في عليائه: “ليش يا الله؟ طيب لو خليت لي وحدة.. بس وحدة منهم يا الله.. بحبها يا رب بحبها، ليش أخذتها مني؟ ليششش”، ويجلس وهو يندب حظه، وحوله مجموعة من الشبان يواسونه، فيعيد سرد القصة مما أدركه العابرون عن تلك الحورية الصغيرة؛ أن الأب خرج ككثير من الرجال ليحضر الطعام، فقام الاحتلال بقصف المنزل على مَن فيه بتلذذ كامل باستهداف الملائكة والأنبياء والأطفال، فاستشهدت الأم وبناتها الثلاثة. كانت تلك جثة لارا مقاط، وعمرها عشرة أشهر كما قال الأب وهو يحضن آخر ويبكي طالباً من الله أن يمنحه الصبر على تحمُّل ألم الفراق الذي هز أعماق الفؤاد.
هذه المشاهد الدائمة جعلتك تعتاد المشهد وكأنه حدث عابر، وفي مكان بعيد لا ينتمي إليك تاريخاً ولا لغةً ولا ديناً. وعلى الرغم من أن رائحة الموت تنتشر حولك، وصوت المجنزرات والدبابات ليس ببعيد عنك، ربما ثلاثة كيلومترات فقط، فإنك مع كل ذلك تعيش كغيرك حالة استسلام رهيب للقادم. ويقصّ عليك صديقك الصحافي بشير أبو شعر قصة سارة مصعب البرش، الفتاة ذات الـ 12 عاماً، وقد جللت يدها بسوار متواضع لفّ معصمها بتلك الخرزات المصنوعة محلّيّاً، لكنها لم تستطع الاحتفاظ به لأن القصف الذي استهدف الشقة التي تقطن فيها العائلة، وقتل معظم السكان، بتر يدَيها الاثنتَين، ولم يبقَ مكان للسوار، وفي أثناء زيارة أخيها الكبير، قالت بحسب ما يروي بشير: “مش مهم إيدَيّ، المهم أبوي ما يموت، إيدَيّ بيطلع غيرهم.” إذ اعتقدت هذه الطفلة أن اليد تنبت مجدداً كما الأزهار والبساتين والفراديس السامقة، لكن الأذرع لن تنبت والأب لن يعود إلى الحياة مجدداً.
وتقرر الهرب بعد استلام أخيك الأصغر مهمة الرباط في جوار الأب، فتهرب من المكان وأنت تسأل نفسك عن الأطباء والممرضين والصحافيين ورجال الدفاع المدني والعامة: ما هو مصيرهم بعد انتهاء الحرب؟ وأي حالة نفسية سيعيشون؟ وهل سيقبلون التعايش مع الواقع الجديد إذا جاء قبل أن يموتوا جميعاً؟ هل ستقبل الزوجة رَجُلاً بلا قدم؟ وهل سيقبل الرَجُل زوجة بلا ذراع؟ وكيف للطفل أن يتعلم بعد فَقْدِ ذراعيه؟ وهل سيتم بناء المدارس؟ وكيف سينسى كل هؤلاء الكارثة؟ كيف يمكن لأحد أن ينسى الأهل والأصحاب؟ كيف يمكن تجاهُل الإبادة التي قضت على أحلام الفلسطيني في غزة وآدميته؟ كيف؟
ولن ننسى…