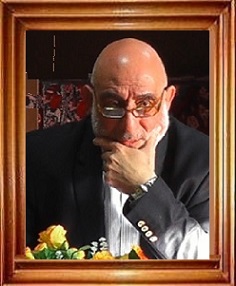الله لا يوَفِّئْكُن…

الله لا يوَفِّئْكُن…
سهيل كيوان
مشاهد الفرح شحيحة، وخصوصاً منذ انطلاق الرّبيع العربي الذي اغتالوه وأغرقوه بالدّم، حتى شكّك الناس في جدوى كلّ محاولة تغيير، وانكفأ كثيرون بعد أن رأوا نماذج سيِّئة من استبدال سيّئ إلى حالة أسوأ، وذلك على قاعدة “خلّيلك على منحوسك أحسن ما يجيك أنحس منه”.
نحن نخشى الفرح، وإذا ضحكنا كثيراً في لحظة صفاء نسرع لنقول “الله يكفينا شرّ هذا الضحك” كأننا نعتذر، وحينئذ يصمت الجميع، وكأنَّ الضّحك تحذيرٌ وتجاوزٌ للخطوط الحمراء.
كلُّ الأفراح صغيرة وعابرة، إلا الفرح الذي تغسله الدموع، فهو فرحٌ كبير وعميق، إنّه الفرح الذي يأتي بعد آلام عظيمة.
ذُرفت دموعٌ كثيرةٌ بعد سقوط نظام الطاغية، توازي حجم الفرح وتزيد، ولم تنته بعد.
لا يمكن حصر الأسباب، فهنالك دموع الفرح بخبر هروب الديكتاتور أوّلاً، ثم دموع العودة إلى الوطن بعد سنين من الغربة القِسرية في بلاد الله الواسعة، التي لم يكن الوصول إليها رحلة سهلة، دموع الشّوق إلى الأهل والبيت والحارة والجيران والأصدقاء.
دموع فرحٍ بحرّية الدخول إلى الوطن من غير خشية اعتقال أو تحقيق وإخفاء قسري، هكذا بكل بساطة تقود سيارتك وتتوجّه إلى الوطن من غير تعقيدات. ومن غير رشوة من مالٍ جمعته بتعبك وتعب أبنائك لموظّفٍ أو عسكريٍ طفيليٍّ.
هنالك ملايين شعروا بفرحة الثّأر وهم يرون التماثيل تتحطّم، والجماهير التي كانت تخاف من مجرّد الالتفات إلى ناحية القصر، تدخله وتجوب في غرفه ومطبخه وأسطول سيّاراته.
هناك دموع الفرح لرؤية شاشة التلفزيون العربي السّوري لأول مرّة منذ عقود، تفتتح ببيان سقوط النّظام.
هنالك فرحة عند مشاهدة أحد مقاتلي المعارضة في مطار دمشق الدولي، يفتح شاشة حاسوب القادمين إلى المطار ويُعلن بسخرية، السّماح بإدخال السُّكَر.
فرحة أخرى لرؤية لافتة على واجهة محل بوظة بكداش في سوق الحميدية، وقد كُتب على واجهتها “بوظة 3500 ليرة السورية 25 ليرة تركية، دولار 1”.
دموع الفرح لرؤية المتطوّعين ينظّفون المدارس استعداداً للعودة المنتظمة إليها.
دموع لمشاهدة استسلام جنود النّظام وحقن الدماء، في مواقف شهامة ورجولة وأخلاق “اذهبوا فأنتم الطُّلقاء”. فرحة جنود النظام بنجاتهم ومعاملتهم كإخوة في الوطن.
أما أكثر الدّموع سخونة، فهي دموع الفرح بإطلاق سراح وتحرير آلاف سجناء الحرّية، التحرّر من باستيلات الأسد.
ما رآه العالم يشبه قصص الخيال، وكأنّنا نعيش في عصر آخر عن ما دار في سجون الطاغية، بل الطغاة، لأنّ شركاء الطاغية في التنفيذ طغاة، خصوصاً ذوي المواقع المتقدّمة في فروع الأمن، الذين قادوا علميات التعذيب والقتل.
أحد النماذج الغريبة هو السّجين الأردني أسامة البطاينة، الذي اختفت آثاره منذ عام 1986 أي عندما كان عدد سكان الكرة الأرضية خمسة مليارات إنسان، بينما يبلغ عددهم الآن حوالي ثمانية مليارات، بزيادة ثلاثة مليارات إنسان منذ دخل أسامة البطاينة الطالب الثانوي، سجن النظام المُجرم.
أسامة فقد ذاكرته، وقال “إربد، عبد الناصر”. المسكين نسي التفاصيل، فهو مولود عام 1968 وناصر مات عام 1970، نسي اسم الطاغية الأسد. والده الذي رأى صورته لم يعرفه، وقال إنه سيجري فحص” دي إن إيه” للتأكّد من أن هذا ابنه. قال والده إنّه دفع الكثير من المال وباع أملاكه رشوة للمسؤولين في سوريا، وفي كلّ مرّة كانوا يعدونه كذباً. إضافة إلى السّجن ظلماً، فهنالك استغلال لمشاعر الأهالي وابتزازهم. بعد أن جاء أسامة إلى الأردن وبعد الفحص يوم أمس، تبين أن أسامة ليس ابن العائلة. الله لا يوّفّئهن.
لقد مرّ العالم منذ خمسة عقود بتغييرات هائلة أهمها تفكك المعسكر الاشتراكي، وتوحيد ألمانيا، واحتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين، وسقوط عدد من الرؤساء العرب، ومعاهدات سلام وتطبيع، وأُعلن العفو العام مرّات في دول عربية والعالم عن معتقلين سياسيين، وأسامة في زنزانته. كيف لإنسان أن يبقى في السّجن لمدى الحياة من غير محاكمة، وما هو الجُرم الذي ارتكبه! بكلِّ بساطة لأنّ أحداً من المسؤولين لم يجرؤ على التساؤل عن حقيقة سجن هذا الرجل! ما الذي فعله وما هي جريمته كي يبقى كل هذه السنين! المسؤولون في سجون الطغاة لا يصلون وظائفهم إلا لكونهم أشدّ قمعاً ووحشية ونفاقاً للنّظام من سابقيهم.
البطاينة لم يكن قائداً أو مسؤولاً في تنظيم أو حزب، وإلا كان ذُكر اسمه مثل مناضلين آخرين، الذين عادة ما يكون هناك من يطالب بإطلاق سراحهم، وتُدرج أسماؤهم على لوائح منظمات العفو الدولية وغيرها.
ممكن لمن قرأ رواية “القوقعة” لمصطفى خليفة، أن يشكّ للحظات بأنّ الكاتب أضاف من إبداعه شيئاً من فنون التعذيب والبطش والإذلال، ولكن بعد المشاهد التي رآها العالم، فإنه يمكن كتابة آلاف الرّوايات والأفلام وستظل ناقصة ولن تستطيع أن تحيط بجرائم هذا النظام.
هنالك عشرات آلاف وربما مئات آلاف في السّجون العربية يتوقون إلى الحرية، وكثيرون قضوا نحبهم إعداماً لمجرّد دمغهم بالإرهاب، إضافة إلى سجون الاحتلال المكتظّة بأسرى الحرّية، وآخرها سجن “سديه تيمان” الذي أقيم مع بداية حرب الإبادة غي قطاع غزة، وشهد عشرات من حالات الموت تحت التعذيب.
لا يمكن نسيان الصدمة على وجه صبيّة شاهدت صورة شقيقها عبر الهاتف الذي كانت تظنّه قد مات منذ أحد عشر عاماً.
لا تفسير لكل هذا البطش، إلا بأنّه نظام رعديد وجبان، كان يخشى من أيِّ بادرة معارضة بأن تكون شرارة تشعل حطب حُكمه البائس.
في فرع فلسطين سجّلوا سيدة اسمها بشرى، تهمتها أنّها زوجة إرهابي، ومعها طفلان. هناك آلاف العائلات التي تنشر أسماء أبنائها وصورهم وتسأل عنهم طالبة المساعدة للعثور عليهم ومعرفة مصائرهم.
رجل يبكي في الشارع ويقول “أذلّوني، ضربوني، وعندما سال الدم قالوا له “عادي”. ثم قال “الله لا يوَفِّئكُن”.
آلاف ينشرون صور أبناء وآباء وأخوات يبحثون عنهم، إذ إنّهم لم يظهروا مع من تحرّروا من السّجون. هناك شبان متطوعون ينشرون صور بعض المحريين عسى أن يتعرّف ذووهم عليهم ويأتوا لإعادتهم إلى بيوتهم.
هناك من عاد إلى قريته ووجد بيته خاوياً تصفر فيه الرياح، وهناك من ينشر بأنّه رأى شقيقه على الشّاشة خارجاً من السّجن ويناشد من رآه أن يخبر عن مكان وجوده.
“الله لا يوَفِّئكُن”، هذا هو ردّ فعل أكثر السّوريين على ما يرون ويسمعون.
الحرّية أمُّ الإبداع، وفور إعلان التّحرير واستنشاق رائحة الحرّية، انتشرت وروح النكتة بسرعة وعفوية، مثل طرح سؤال ماذا سنسمي “جسر الرئيس” في دمشق، والنكات حول العملة التي تحمل صورة الأب والابن.
سيّدة تنظف الشّارع “ضروري توسّخوا الشارع؟ لسّا مبارح اشترينا سوريا جديدة”.
عائلة دراغمة من قرية اللبن الشرقية، في الضفة الغربية، تبين أن ابنها حي وسجين منذ اثنين وأربعين عاماً بتهمة محاولة تنفيذ عملية ضد الاحتلال على جبهة الجولان. شقيقته عالية تقول إنها رأته في حلم يقظة قبل الخبر، يدخل غرفتها ويبرز لها علامة على ذراعه كي تتعرّف عليه”، كل هذا مع دموع الفرح.
مآس كبيرة، ولكنها في الوقت ذاته مساحات كبيرة للفرح على قدر المعاناة. والجميع يتمنى أن تتّسع وتتعمّق في الصّورة التي ترضي كلَّ ذي ضمير إنساني وأخلاقي ووطني وقومي وديني لسوريا وشعبها كما تستحق أعرق وأقدم وأجمل الحضارات على وجه الأرض.
كاتب فلسطيني