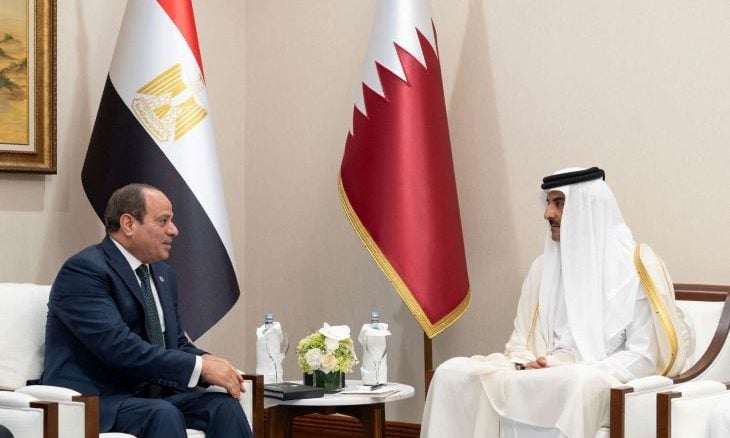لماذا يخفق الوسط العربي في تحويل تعليمه الأكاديمي إلى فرص عمل في إسرائيل؟

لماذا يخفق الوسط العربي في تحويل تعليمه الأكاديمي إلى فرص عمل في إسرائيل؟
هل درست البرمجة في المدرسة؟ كيف مستواك في الإنكليزية؟ أين عملت سابقاً؟ أين خدمت في الجيش؟ هل تعرف أمير كوهين؟ كل هذه الأسئلة، التي تبدو عادية للغاية للعاملين في قطاع “الهاي تك” الذين يديرون شبكة علاقات مهنية أساسية، قد تثير الكثير من عدم الراحة لدى مرشحين آخرين: العرب والعربيات الذين أنهوا درجة البكالوريوس في مجالات “الهاي تك” (البرمجة أو الهندسة) ويخطون خطواتهم الأولى في هذا القطاع.
العوائق التي تمنع العرب والعربيات من الاندماج في هذا القطاع معروفة، ونوقشت لسنوات في منتديات حكومية وجمعيات متخصصة. تبدأ الفجوات من المدرسة، ومن الثقافة داخل المنزل، وتستمر لاحقاً إلى الجامعة وسوق العمل. ولكن فريقاً من الباحثين من جامعة حيفا قرر الغوص من المستوى الكلي إلى المستوى الجزئي لفهم كيف تؤثر المعايير السائدة في قطاع الهايتك على دمج العرب الذين من المفترض أن يكونوا مرشحين مناسبين له.
بين جميع الفئات السكانية في إسرائيل، ثمة فجوة كبيرة بين التعليم والتدريب، وسوق العمل. من جهة، نسبة الأكاديميين الإسرائيليين عالية جداً مقارنة بالدول الأخرى، لكن من جهة أخرى، مهاراتهم المطلوبة لسوق العمل المستقبلي تُصنَّف بمستوى منخفض جداً. هذه الفجوة لا تستثني المجتمع العربي: على مدار سنوات، كان هناك ارتفاع كبير في عدد العرب والعربيات الذين يدرسون علوم الحاسوب والهندسة في الجامعات، لكن نسبة اندماجهم في قطاع الهايتك لا تزال منخفضة، حيث تبلغ حوالي 2% فقط (معظمهم من الرجال). ولم ينجحوا في تحويل التعليم الأكاديمي الذي حصلوا عليه إلى وظائف ذات جودة عالية.
لقد أجرى البحث الدكتورة عينات لافي من قسم الخدمات الإنسانية، والبروفيسور أساف ليفنون من قسم علم الاجتماع، وداريا غوملسكي-حيفي، طالبة الدكتوراه في قسم علم الاجتماع، وروان كعبية طالبة بحث في درجة الماجستير بجامعة حيفا والتي تعمل أيضاً في وحدة تعزيز الحياة المهنية بالجامعة.
تحدثت روان عن سبب إجراء هذا البحث قائلة: “من خلال البيانات ومن الواقع، رأينا ارتفاعًا ملحوظًا في توجه الشباب نحو دراسة المهن التكنولوجية. ولكن، رغم ذلك، وبالرغم من وجود برامج حكومية وجمعيات تدفعهم للقيام بذلك، فإن نسبة العرب في قطاع الهايتك (التكنولوجيا المتقدمة) لا تزال منخفضة. الاستنتاج الرئيسي لبحثنا هو أن التعليم العالي وحده لا يكفي للاندماج في سوق العمل، وخصوصًا في قطاع الهايتك.
“كيف تسير الأمور”
لم يتجاهل البحث وجود أسباب هيكلية وراء غياب العرب عن قطاع الهايتك، لكنه أشار إلى أن العديد من العوائق تأتي من نقص المعرفة لدى الشباب والشابات العرب بشأن “كيفية سير الأمور فعليًا” في قطاع الهايتك الإسرائيلي. فالعديد منهم يجهلون الأعراف السائدة في القطاع، والتي تبدو واضحة تمامًا لكل موظف يعمل فيه بالفعل. أجرى الباحثون مقابلات مع 30 مشاركًا عربيًا، جميعهم حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى في علوم الحاسوب والهندسة.
أحد الأمور الأساسية التي أشار إليها المشاركون في المقابلات، أنهم لم يكونوا على علم بوجود علاقة بين مكانة المؤسسة التعليمية التي درسوا فيها وفرصهم المستقبلية في العمل. لم يعرفوا أن شركات التوظيف في قطاع الهايتك تفضل خريجي الجامعات. قال أحدهم: “عندما أنهيت دراستي فهمت أن هناك العديد من الشركات التي لا توظف سوى خريجي الجامعات ولا تقبل خريجي الكليات. لم يخبرني أحد بذلك مسبقًا”. وقال مشارك آخر إنه أدرك ذلك متأخرًا: “أرسل سيرتي الذاتية باستمرار، لكنهم لا يردون عليّ. آخر مرة دعيت فيها إلى مقابلة عمل كانت قبل سنة ونصف. عندما يرون أن شهادتي من كلية، يرفضونني مباشرة”.
غالبًا ما يدرس الطلاب العرب في كليات أقل شهرة مقارنة بالجامعات، وغالبًا ما تكون هذه الكليات في المناطق النائية – أي في أماكن سكنهم – مما يؤثر بشكل مباشر على قيمتهم في سوق العمل في المستقبل. عادةً ما يكون من الأسهل الالتحاق بها، وتتطلب مهارات أقل في اللغة العبرية والإنجليزية. وأضاف أحد المشاركين في الدراسة: “عندما بدأت دراستي، لم أكن أعرف الفرق بين المؤسسات الأكاديمية. علاماتي في اختبار القبول الجامعي أدت إلى قبولي في كلية معينة (س) والواقعة [في منطقة نائية].
لم أكن مدركًا أن فرصي في الحصول على مقابلات عمل ستكون منخفضة جدًا. كنت أعتقد أن شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية ستفتح لي جميع الأبواب، ولكن هذا لم يحدث. لم أدع إلى أي مقابلة، في حين أن خريجي الجامعات مطلوبون جدًا”.
وتقول لافي: “الملف الشخصي لهؤلاء الأشخاص يشير إلى أنهم يحملون شهادات جامعية، مع درجات عالية في المدرسة، الذين يدخلون سوق العمل ويبدأون من الصفر. يرسلون سيرهم الذاتية إلى وظائف كما كان يتم إرسال السير الذاتية سابقًا، ويحصدون العديد من الإخفاقات بعد إرسال سيرهم الذاتية”. هناك العديد من الجمعيات في هذه المجالات، وهي مصدرهم الوحيد للمعرفة عن القطاع، لكنهم في كثير من الأحيان يصلون إليها بعد أن يتعرضوا للعديد من الإخفاقات”.
“غير متمرسين في لينكدإن”
ثمة حاجز آخر، وهو غياب التوصيات، أو بمعنى آخر الشبكات الاجتماعية. العديد من فرص العمل في شركات التكنولوجيا العالية لا تُنشر علنًا، وتعمل بنظام “الواسطة”. أشار المشاركون في الدراسة إلى أنهم كانوا يفتقدون إلى شبكة اجتماعية قوية يمكن أن تزيد من فرصهم في الحصول على هذه الوظائف المخفية. فضلاً عن ذلك، كان غياب الأشخاص في شبكاتهم الاجتماعية الذين يمكنهم الشهادة على مهاراتهم وأخلاقيات عملهم وشخصيتهم، يعيق مصداقيتهم عند التقديم للوظائف.
ووفقًا لأحد المشاركين في الدراسة: “أداة البحث عن العمل الأكثر فاعلية هي التوصيات، وبسبب العدد القليل نسبيًا من العرب في مجال التكنولوجيا العالية، لدينا فرص أقل للتعيين داخل مجتمعنا. نطاق الشبكات الاجتماعية يؤثر بشكل مباشر على احتمالية تأمين وظيفة، ويبدو أن اليهود لديهم الكثير من العلاقات في هذا الصدد
كعبية تشرح أن طرق البحث عن العمل التي تعتمد على الشبكات الاجتماعية لم يستغلها العرب على النحو الأفضل. “معظم الأشخاص الذين قابلتهم قالوا إنهم يعرفون “لينكدإن”، لكنهم أقل خبرة في استخدامه، لا يحدّثون ملفاتهم الشخصية ولا يستخدمونه بطريقة قد توفر لهم عملاً”، كما تقول.
وكما تقول: “العرب والعربيات يتخرجون من الجامعات في سن مبكرة جداً، دون خبرة عملية، دون خدمة عسكرية أو مدنية، ولم يمروا قط بشيء مثل الفحوصات أو الاختبارات النفسية، وهي أمور يمر بها اليهود في الجيش في سن مبكرة. كثيراً ما يبحث أصحاب العمل عن الخبرة التي يكتسبها الشخص في الجيش، وهي شيء غير موجود لديهم. في الأساس، العرب لا يحصلون على أولوية في مجال التكنولوجيا. لكن اتضح أنهم لا يعرفون فعلاً ماذا يفعلون عندما يبدأون في البحث عن عمل – يرسلون سيرهم الذاتية بالطرق الرسمية، ولا يفهمون لماذا لا يتواصلون معهم. برأيي، الأمر المهم هو ألا يذهبوا للدراسة مباشرة في سن 18 – التطوع، والقيام بالخدمة الوطنية أو العسكرية، محاولة العمل قليلاً، والتعرف على الناس، وفهم كيف يعمل العالم، ثم الغوص في الأكاديمية. هناك ضغط كبير من الآباء للدراسة، وغالباً ما يذهبون لدراسة تخصص دون أن يعرفوا عنه شيئاً، ولا يبحثون بما فيه الكفاية..”
العزلة عن الشبكات المهنية مرتبطة أيضاً بعدم وجود شخصية مرشدة تساعدهم في خطواتهم الأولى. ظهرت الحجة التالية في أشكال مختلفة في معظم المقابلات: “أنا خائف من التقدم [لوظيفة في مجال التكنولوجيا]، ليس لدي خبرة في العمل، ولا أعرف كيف أفعل ذلك. ليس لدي شخص أستشيره.” وقال خريج آخر: “أحد الأشياء التي منعتني، على سبيل المثال، هو أن سيرتي الذاتية لم تُكتب بشكل صحيح، لم تكن مناسبة لوظائف التكنولوجيا. لم يكن لدي من يساعدني، لم يكن هناك من يراجع سيرتي الذاتية”.
يردين بن غال هرشهورن
هآرتس 13/1/2025