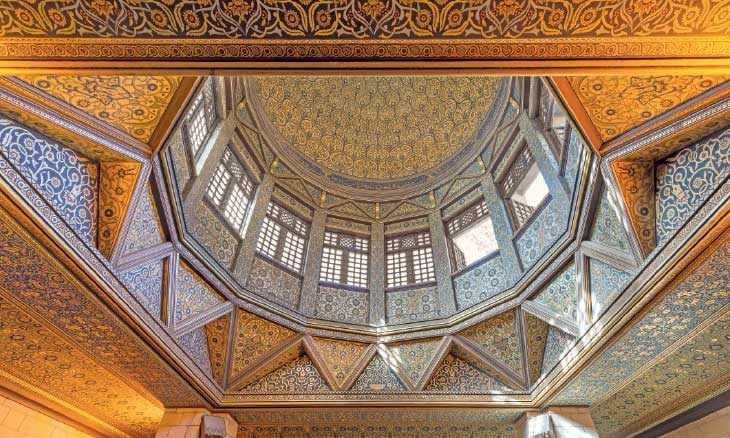
معاوية بن أبي سفيان: ما له… لا ما عليه

حيان الغربي
يشير المؤرخ السوري الراحل عبد الله حنا، في كتابه: «حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر- نموذجٌ لحياة المدن في ظل الإقطاعية الشرقية» إلى أن الدولة العباسية قد تعمدت إهمال المدن السورية، إذ لم تكن تأمن جانب السوريين وكانت ترى فيهم موالين مخلصين لأعدائهم الأمويين. بيد أن التاريخ عموماً يذكر أنه تمت إبادة بني أميةَ من خلال القتل والتهجير، فقُتِل من قُتِل، وفر من بقي منهم حياً إلى الأندلس. إذن، ما الذي كان العباسيون يخافونه؟ وهل يعني خوفهم ذاك أن الأمويين في سوريا لم يكونوا مجرد عائلةٍ حكمت بلاداً واسعةً، وتحكمت فيها برقاب الناس وأرزاقهم وفقاً لأهواء غلمان بني أمية (كما يطيب لمؤرخي بني العباس تصويرهم)؟
خلافاً للخطأ الذي يقع فيه الكثيرون من الكتاب الصحافيين وأصحاب الرأي، ليس النزاع التاريخي، الذي لا يبدو أنه سيعرف طريقه إلى الحسم يوماً، بين الإمام علي بن أبي طالب والخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، هو الحدث الوحيد الذي يمكننا من خلاله مقاربة شخصيةٍ تاريخيةٍ استثنائيةٍ، كان لها أعمق الأثر في الهوية الحضارية السورية، شخصية من طراز معاوية بن أبي سفيان. وهو أيضا خطأٌ تقع فيه الكثرة الكاثرة من الأعمال الفنية والأدبية (بل حتى الدراسات) المعاصرة، التي غالباً ما تقارب هذا الموضوع الشائك من وجهة نظرٍ مركزيةٍ، تتمحور أساساً حول إلباس الماضي قميصاً ضيقاً جرى تصميمه وتفصيله وحياكته في مصانع الحاضر الطائفية والمذهبية والمناطقية، علماً بأن أحداً من المذاهب الحالية (الإسلامية والمسيحية)، لما يكن آنذاك قد بدأ بالتشكل بعد حتى ينخرط في ذلك الصراع المشؤوم، بل إنه يسقط عليه موقفه الراهن بأثرٍ رجعي كما أسلفنا. وتقع الكارثة حين يصدق المرء الحكاية التي لفقها بنفسه، ليبرر الإمعان في الترويج للاستقطاب الحاد بين من رأى ويرى في معاوية شيطاناً أكبر يحل قتل كل من شايعه ومن يريد باسم الأمويين أن يطعم الأسماك لحم شركائه في الوطن.
ولعل المرء يستغرب الإصرار على عدم الاستئناس بالمصادر السريانية الخاصة بتلك الفترة، طالما أن الأمر يتعلق ببلادهم هم أيضاً، وطالما أن التأريخ السرياني لها سبق نظيره العربي بزهاء قرنٍ ونيف، وقد جاء الأخير مشوباً بالتدخلات العباسية، التي سعت دائما إلى تشويه التصور الشعبي عن دولة الأمويين، وتقديمها بوصفها فترةً مظلمةً من اغتصاب السلطة والانحرافات والابتعاد عن الدين الحنيف، يدفعهم إلى ذلك الخوف من تمسك السوريين بالهوية الإسلامية الحضارية (على حد تعبير الباحث السوري نجيب جورج عوض) والمكانة المرموقة والازدهار الذي نعمت به مدنهم إبان الحقبة الأموية، في حين أن الأدبيات السريانية كانت أكثر إنصافاً بما لا يقاس، لدى تطرقها إلى خلفاء بني أميةَ وإلى حال السوريين تحت حكمهم، ولا بد لنا في هذا المقام من الإشارة إلى أن أواصر القربى بين القبائل العربية والسريانية في تلك الآونة كانت كفيلةً بتجاوز أي اختلافاتٍ عقديةٍ بينيةٍ، كما أن معظم أبناء القبائل كانوا يتحدثون اللغتين العربية والسريانية في آنٍ واحد، الأمر الذي يؤكد قوة التماسك والانسجام داخل المجتمع السوري الأموي.
إذن، هذا ما كان العباسيون يخشونه، ناهيك من أن التنافس بقي قائماً والخطر ظل محدقاً، نتيجةً لاستمرار الدولة الأموية في نسختها الأندلسية، تلك النسخة التي بلغت من الرفعة الحضارية شأواً عز نظيره بين الدول على مر التاريخ، ولاسيما في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (أو عبد الرحمن الثالث، وهو حفيد الخليفة الأموي الأندلسي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، أو صقر قريش، وهو بدوره حفيد الخليفة الأموي السوري عبد الملك بن مروان) الذي كتب معاصروه من المؤرخين الأوروبيين الكثير في تقريظ أفعاله ومنجزاته، وذهب العديد من اللاحقين منهم إلى أن تأثيره على الملوك والأرستقراطيين الأوروبيين (معطوفاً على حركة الترجمة عن العربية التي شهدت نشاطاً كبيراً في عهده وعهود غيره من خلفاء بني أمية في الأندلس) أسهم في نشوء الدول- المدن (ولاسيما الإيطالية منها) التي شكلت منصةً انطلقت منها أوروبا في طريقها نحو التنوير والحداثة، فضلاً عن أن قرطبة، عاصمة دولته آنذاك، كانت حاضرةً كوزموبوليتانيةً بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
بطبيعة الحال، ما كان لتلك الدولة أن تبقى في إسبانيا ثمانية قرونٍ بقدها وقديدها، لولا كونها الوريثة حضارية الشرعية لدولة الأجداد التي ازدهرت بالأمس القريب في دمشق، وهي دولةٌ كان مسلموها ومسيحيوها يتقاسمون دور العبادة عن طيب خاطرٍ، كما يشير الباحث نجيب عوض أيضاً. وحري بنا التأكيد ثانيةً في هذا السياق على أن الطائفية بمعناها المعاصر لما تكن قد تبلورت في تلك الآونة بعد، بل كانت المفاهيم الدينية السائدة لدى أتباع الديانتين متقاربةً إلى حد كبير، وإن شابتها بعض الاختلافات الثانوية، فلا ضير في ذلك طالما أن اختلافاتٍ مماثلةً تبقى قائمةً بين أتباع كل ديانة على حدة. فعلى سبيل المثال، جرت عملية نقلٍ حرفي- Transliteration لجميع أسماء العلم الواردة في الكتاب المقدس إلى مختلف اللغات الأوروبية، فلم يُستثنَ إلا اسمٌ واحدٌ منها، وهو أهم اسمٍ بينها دون أدنى شك، أي اسم «الله» إله المسلمين والمسيحيين الشرقيين (بمن فيهم السوريون) والمحور الرئيس لإيمان أتباع الديانتين، في ما تبدو أنها مساعٍ مبكرةٌ لترحيل مركز القوة والتأثير الحضاري بعيداً نحو الغرب، الأمر الذي كانت له تمظهراتٌ أكثر دمويةً غداة بعثات التبشير، التي كانت تندرج في سياق عملية إخضاع مجتمعات الشرق للهيمنة الثقافية الغربية تمهيداً للسيطرة عليها سياسياً.
كما تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هدم الكنائس المسيحية، أو دور العبادة اليهودية، لم يبدأ في عهد الخلفاء الراشدين أو الأمويين (الذين سمحوا ببناء كنائسَ جديدةٍ أيضاً)، وإنما في عهد الفاطميين ومن قبلهم العباسيين، ولاسيما في عهد الخليفة المتوكل، الذي أسهم بسلوكه الإلغائي في ترسيخ الصراع المذهبي ضمن الإسلام نفسه ووضع البذرة الأولى للطائفية، ليتكفل الاستشراق الغربي بسقايتها ورعايتها، بعد نحو ألف عام. وينبغي هنا التنويه إلى أن المتوكل، الذي كان يسعى إلى الاستئثار بمركز القوة أيضاً، والذي اتخذ ما اتخذه من إجراءاتٍ صارمةٍ على خلفية الصراع البيني على السلطة ضمن البيت الهاشمي نفسه هذه المرة، قد قُتِلَ لاحقاً لا على أيدي مناوئيه، بل بأيدي مشايعيه أنفسهم، ما يشي بأن الفكر الإلغائي لا يلبث أن ينقلب على صاحبه، وهو فكرٌ لم يعرفه الخلفاء الأمويون في إدارتهم للبلاد، فكانوا وحدهم القادرين على توحيد السوريين حقيقةً دون حاجةٍ للإفراط في استخدام القوة، مسترشدين في ممارسة سلطتهم بالقول المأثور عن مؤسس دولتهم: «لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرةً ما انقطعت، كنت إذا مدوها خليتها وإذا خلوها مددتها».
ويذكر أن السوريين كانوا ما قبل الأمويين هدفا للاستقطاب الخارجي الحاد ما بين الشرق والغرب، وهم عادوا كذلك بعدهم.
كاتب سوري







