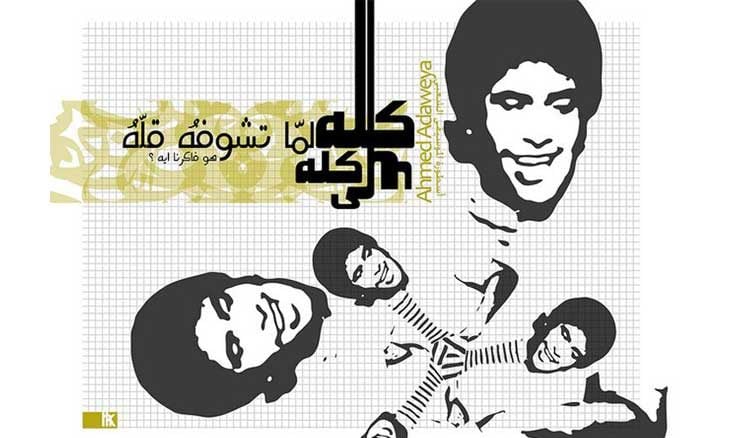الصفقة… خريف الأفكار!

رامي أبو شهاب
على ما يبدو فإنّ العالم يعيد تعريف ذاته، أو يغادر على الأقل صورته التي تشكّلت بعيد الثورة الصناعية، التي على الرغم من تبنيها منظوراً مادياً خالصاً، غير أن إنسان ذلك الزمن أدرك خطورة هذا التكوين على وجوده، فنشطت المشاريع الفكرية من أجل الحد من التكوين الوحشي للرأسمالية، ولكن الإنسان في الزمن الحاضر، بات أقرب إلى التخلي عن اجتراح مشاريع فكرية نقدية كبرى، وبهذا فإننا نقترب من مقولة تصفية الفكر بعيداً عن أي قيم إنسانية بفعل عوامل عدة.
يمكن الاستدلال على ذلك بتراجع منظومة القيم لا على المستويات الفردية أو الاجتماعية الضيقة، ولكن على مستوى الكيانات الكبرى، التي فقدت ما يمكن أن ننعته بالتنظير المتعالي للفكر، لاسيما أنّ معظم الأمم والمجتمعات المعاصرة باتت محكومة بنتاج واقع لغة جديدة تشكلت ملامحها بصورة خجولة في الفترة الأولى من حكم ترامب، غير أنها عادت إلى الظهور في الخطاب العالمي، لتكشف عن نفسها في الفترة الثانية بجلاء، ذلك أن معظم حكومات العالم، والمحطات والمواقع الإخبارية، أمست تتداولها بوصفها واقعاً لغوياً، وممارسة مقبولة.
ولنتأمل بداية نموذجاً بسيطاً، ونعني مفردة «الصفقة»، التي لم يكن لها وجود قبل ترامب في نشرات الأخبار، أو اللغة السياسية، إنما كانت محصورة في المجال التجاري، وربما في مجالات تجارية خالصة، لا على مستوى الدول، وإنما على مستوى الشركات، أو السماسرة، في حين أن الدول كانت تعتمد كلمات مثل اتفاقية، أو اتفاق، أو معاهدة، ناهيك عن سلسلة من المنظومات القانونية التي تشكلت في القرن العشرين، نتيجة الوعي بالإنسان والبيئة والحيوان، وحقوق الأقليات، وصون الثقافة، وتجريم الإبادة، وغير ذلك، ورغم أن هذه النماذج لم تكن فاعلة بصورة واقعية، أو لنقل مثالية، بيد أنها كانت تشكّل شيئاً من الضغط على الأمم، أو الدول بداعي احترام مقولة القانون الدولي، الذي بات الآن أقرب إلى شيء تنبغي تصفيته.
في عالم يتجه أكثر إلى ثقافة (الصفقات) أضحى كل شيء معروضاً للبيع والشراء، ما يعني أن مفهومنا القيمي الذي صاغه الإنسان من أجل تقنين الوحشية لا ينسحب على حرب غزة، ربما لأن سفك الدماء الحاصل نتج بفعل البربرية الصهيونية، بالتوازي مع ظهور النسق الترامبي، الذي يقدم صيغة جديدة للعالم تنهض على التهديد، ومن أبرز ملامحه الجلية اشتداد الصراع الاقتصادي بين الإمبراطوريات عالمياً، أما عربياً فيمكن القول إننا نواجه سقوط الفكرة العربية، ومشتقاتها من أيديولوجيات، أو مشاريع قومية وإسلامية ويسارية، بمعنى إفراغ المعنى العربي من ماهيته أو بوصفها أمة، فغدت عبارة عن كيانات بلا رؤية، أو فكر، وبذلك فنحن إزاء واقع جديد لا معنى فيه للفكر، أو القيم، وخير شاهد على ذلك صمت العالم: بعربه وعجمه على مقتلة ذهب ضحيتها أكثر من خمسين ألف شهيد.
إن تأملنا وقائع هذا المشهد يُعزز بعدم القدرة على توليد مشاريع فكرية جديدة ذات طبيعة نقدية، تطال كل متعالية الثورة الصناعية الخامسة ومشتقاتها، بالإضافة إلى أنماط السيولة التي طالت كل شيء، بحيث لم يعد لشيء معنى، ومن هنا فإننا بتنا ننظر إلى كل ما حولنا على أنه زائل، وقابل للتحول، وبتنا أكثر أنانية، بداعي التنصل من المسؤولية، والانشغال بالذات، فبات الإنسان لا مجرد مستهلك فحسب، إنما بات هو السلعة، في حين بات نمط التدين أكثر شكلانية، وانعزالاً عن قيم السلوك، واعتمدت ثقافة النأي بالنفس بوصفها سياسة تعتمدها الدول والأفراد، فباتت مقولة «أضعف الإيمان» أكثر من كافية كي نتخلى عن الضمير والأخلاق وتقديم ادعاءات أن الواقع صعب، ولا أمل للتغيير.
بدأ الوعي بأهمية المشاريع الفكرية – منهجياً- مع ظهور عصر النهضة، الذي انطلق مع غاليلي ومفهوم النزعة العلمية، ومن ثم الإنسانية برائدها فرانشيسكو بيتــراكّا، لنصل إلى عصر تنوير روسو وفولتير، ولوك، ليعقب ذلك الليبرالية الكلاسيكية والعقلانية، ممثلة بديكارت وكانط وسبينوزا، وفي القرن التاسع عشر الماركسية والوجودية عند كل من ماركس وكيركغارد، وليس انتهاء بنقد مدرسة فرانكفورت، وما بعد الحداثة عند فوكو وليوتار، وبودريار، بالإضافة إلى ما بعد كولونيالية إدوارد سعيد، وغيرها من الأفكار أو المشاريع الدينية التصحيحية، التي سعت إلى الحد من انحرافات العالم، ونزعته التدميرية، غير أن السؤال الأهم يتحدد، هل ثمة مشاريع فكرية مقبلة، أم أن الأمر سيخضع لسياقات أخرى؟
لقد كان سعي الإنسان منذ الأزل يهدف إلى تقنين مسالكه التي تتنافى مع طابعه الإنساني، على الرغم من أن حوادث التاريخ، ومساراته كانت في معظم الأحيان تشير تقريباً إلى فشل ذلك، غير أن إنسان القرن العشرين، وما بعده، ادّعى إنه وصل إلى ما يمكن نعته بالنموذج الحضاري المطلق، بالتوازي مع اتساع البعد القانوني والإنساني، كي لا يواجه العالم تكرار التاريخ ودمويته مرة أخرى، ولكن الأمر بدأ بالتحول، خاصة مع بدء الربع الأول من القرن، حيث لم يعد الإنسان معنياً بذلك، ما يدفعنا إلى التفكير بالعوامل، أو المسوغات، وبالتحديد من حيث غياب المشاريع الفكرية الكبرى، أو لنقل مع شيء من الحذر- أو عدم الجزم- باختفاء المفكرين، أو المشاريع الفكرية النقدية الكبرى، بل إننا نرى ما هو أسوأ من ذلك، غياب التأثير الحقيقي للمثقفين والأكاديميين، وأدوار الجامعات، بوصفها مصدراً لإنتاج الأفكار، وليس أدل على ذلك من الحملات التي تواجهها الجامعات الأمريكية خاصة، والغربية عامة من حيث قمع التعبير، ومصادرة الأفكار، ما يدفعنا إلى القول، إننا أمام انعطافة تاريخية من ناحية وجود أزمة فكرية.
ونقصد بأزمة الأفكار، أو الأزمة الفكرية العجز عن توليد مشاريع فكرية عميقة تنقد النماذج المسرفة بالمادية والدموية، من ناحية تهديدها للقيم الإنسانية، فلا جرم أن جعلت النهضة أو حركة التنوير من الإنسان محور اهتمامها، ولكنه وجوده بدأ يتراجع، حيث أضحى مختزلاً في اسم مستعار، وكومة من البيانات الشخصية، والميول والاتجاهات القابلة للبيع للشركات الكبرى، وباختصار بات الإنسان منتجاً بيانياً لا غير، ومع تسارع الإيقاع خلف مقولة «الترند»، لم يعد أحد يحفل بالخبر الذي غدا عابراً ينطوي أثره بمجرد تحريك الشاشة، أو سرعان ما نتناساه في غمرة توالي الأخبار، وتعدد مصادرها، وانشغال ذهن الفرد بسيولة مواقع التواصل الاجتماعي، ومبادئ التصفح التي لا تتيح التفكير أو التفكّر بما يحصل أو تحليل الموضوع، وعلى الرغم من وجود دراسات أو كتب تتصل بنقد هذه الظواهر الجديدة في عالم بات يتغير بصورة متسارعة، ولكننا لا نقع على أي اتجاهات، أو فلسفات، أو حتى أيديولوجيات جديدة، تعيد هندسة فكر العالم، وتقدم رؤى جديدة، وبهذا فقد بتنا أقرب إلى مقولة انقراض العقل، أو الفكر، حيث لا يوجد سوى مقولات (الصفقة) التي باتت فلسفة العالم الجديد، وربما هذا يحملنا إلى التساؤل.. هل أصبحت البشرية تعيش في عصر خريف الأفكار؟ كاتب أردني فلسطيني