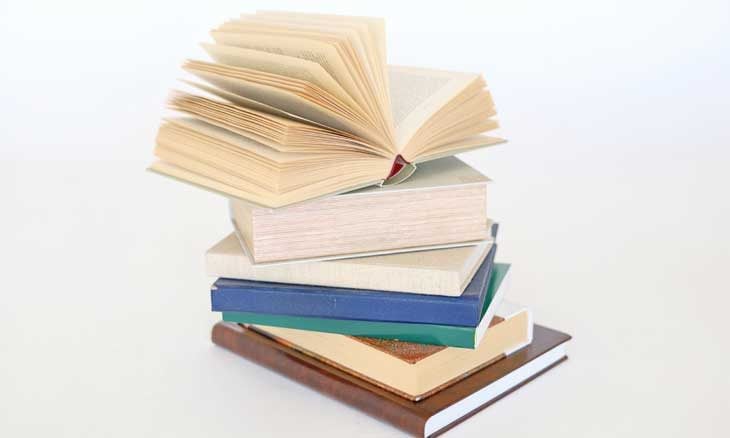
نحن المدجّنين لا نكتب إلا نصّا مدجّنا

ناتالي الخوري غريب
نحن المدجّنين، نكتب نصّا مدجّنا، نصّا مشوّها، نسميه لائقا كي يُتلى على صوت عال، أي نصّا مهذّبا. يفوتنا أنّ هذا التهذيب تشذيبٌ يقترب من البتر، أو فلنقل يسحب الضوء من عباراته، فتنطفئ فيها لمعتها. نصّ يغرق في العتمة ونظنّ أنّه النور.
نحن المدجّنين، يريحنا أنّ ثمّة محوا عند تفلّت العبارة وهروبها من معتقلنا، فالرقيب حارس أمين على السرديات الكبرى والصغرى، أمين على عدم إزعاج المنظومة السياسية والاجتماعية والعائلية والفكرية والدينية. أمين على خنق نباتات الجرأة وإمكانات نموّها.
رويدا رويدا نبتعد عن أصالتنا معتقدين أنّنا نقترب منها أكثر، نبتعد عن هويّتنا، معتقدين أنّنا نخلص لها. نطفئ اشتعالنا باللفظ البارد والمعنى الموارب، ونلقي حمولاتنا على التأويل، والتأويلُ يحتاج قارئا تجذبه شفافية اللغة واحتجاب رسالتها في سياق لامرئيّ! هذا القارئ تحديدا لا يقرب من النصّ المدجّن.
يصير النص شاحبا كوجوهنا، أطفأه العيب وما لا يرضي القبيلة، ما يجوز قوله وما لا يجوز. أطفأه الخوف من الأحكام الجاهزة المترصّدة عندما تلمس الكلمات الهواء. نحن المدجّنين، نمضي على طريقتين: مدجّن لا يعرف أنّه مدجن، فيظنّ نفسه حافظ القيم، سليل الأصالة وناقلها، ذكيّ التكيّف والمرونة، تتطلّب قضيّته سموّا ونضالا وعيشا في مصطلحات عرّتها العصور، وثمّة مدجّن يعرف أنّه مدجّن ونصّه صورة عنه، ومع ذلك يحاول أن يسكن الموج، فيختبئ في المجاز، والمجاز لغة الخائفين الذين لا يجرؤون على المواجهة، لديهم رسالة يكتبونها ثم يبتلعونها، كي لا يحاكمهم أحد، حتى على نواياهم، لكنّهم يعترفون لأنفسهم على الأقل بماذا يفكرون.
أشير إلى نموذجين عن حياتنا في تعرّضها الدائم للمحاكمة. في رواية «المحاكمة» لكافكا، استُدعي بطل الرواية، لم يعرف ما تهمته، فتمّ اعتقاله، وبقي عاجزا عن فهم سبب ذلك. يدرك أنّه إنسان والإنسان عرضة لقوى لا يفهمها ولا يمكن له تغييرها تحاكمه دائما، وربّما في ذلك إحالة إلى سياق ميتافيزيقي.
وفي رواية «اللجنة» لصنع الله ابراهيم، طُلب بطله إلى المحاكمة، وأيضا لم يعرف تهمته، فجاءت الرقابة لتعيش معه في منزله، وتنام في سريره، وتتناول الطعام معه في صحنه، حتى انّ هذه الرقابة دخلت معه إلى حمّامه. حوكم بناء على شكوى ضدّه، ومن ثم طلب إليه أن يكتب تقريره، فقتل مرافقه وحكم عليه بأن يأكل نفسه. لا نظام يحبّ معارضيه، لكنّه يسمح لهم بقليل من جرأة معلّبة، ليقول إنّه ديمقراطي، حتى البرامج الساخرة التي تتناول السياسيين، هي أيضا سخرية مدجّنة أو انتقاد مدجّن. من ثمارها التنفيس وإنكار الاستبداد والتباهي بالقدرة على الانتقاد. من يتجرّأ من رجال الدين أن ينتقد المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها؟
النقد الأدبي أيضا، رُوّض بمناهج كثيرة، وخنق بمصطلحات لها حدودها التي لا تتجاوزها، فخنق معه النص وجرأة كاتبه. غدا التعامل مع كلّ عاداتنا وتقاليدنا كنصّ مقدّس لا نحيد عن حروفه، وإلا غدونا بحكم المقرّبين من المفسدين.
نحن المدجنين، لا يمكن أن تكون لنا رسالة أصيلة بمعنى أصالة الجوهر الذي يعترف بالصيرروة، نحن المدجنين مجرّد ثرثارين، نعيد ما تعلمناه، أصبنا بداء السرد، وهي علّة النظام المصرفي في التعليم، كما يشير إليها الفيلسوف البرازيلي والعالم التربوي فريري، إذ يؤدّي هذا النظام إلى تعليم الطلاب كيف يمتثلون للمجتمع لا كيف ينتقدونه. نظام تعليمي قمعي يعلّم المقهورين كيف يرضون بقهرهم، ويجعلون الخاضع فخورا بطاعته، والمنتقد والمشكّك مذنبا.
نحن المدجّنين نقرأ نصوصنا بعيون الآخرين وأحكامهم، وصورتنا عن أنفسنا صورتهم عنّا، لكنّنا نسمي ذلك رقابة ذاتية. نكتب ذواتنا عبارة نصف محذوفة ونسميها تنقيحا، نتبنّى أحلام الآخرين، ونسميها قضيّتنا.
تحضرني الآن لوحة ديفيد فيلا، يجمع فيها سلفادور دالي وبيكاسو وأمامهما بيضة عادية لرسمها، الأوّل نقلها تكعيبيّا، والآخر سرياليا، مقلية بامتداد حجمها، ممدّدة على غصن. كلاهما عبقريّان، مدمّران لقيم زمنهما، لأنّهما لم يقبلا أن يكونا امتدادا للفن السائد وأنماطه، فاتُّهما بالجنون والفوضى والتخريب.
لم يتمرّد دالي بسرياليته الفنية، بل بحياته أيضا، فرفع شاربيه تمرّدا على كلّ من أجبرهما على الاتجاه نحو الأرض، لأنّها العادة. العادة اسم آخر للخضوع ومنها العادات التي تصبح عرفا فعملا مقدّسا، والتدجين أن نحترمها ونمضي بها باعتبار تراث الأجداد.
ما زلنا نعتقد أنّنا أحرار، لكنّنا مدجّنون باسم العادات والتقاليد والتراث وسلطة المجتمع، لا قدرة له على أيّ تجديد وإبداع وتغيير.
أكاديميّة لبنانيّة






