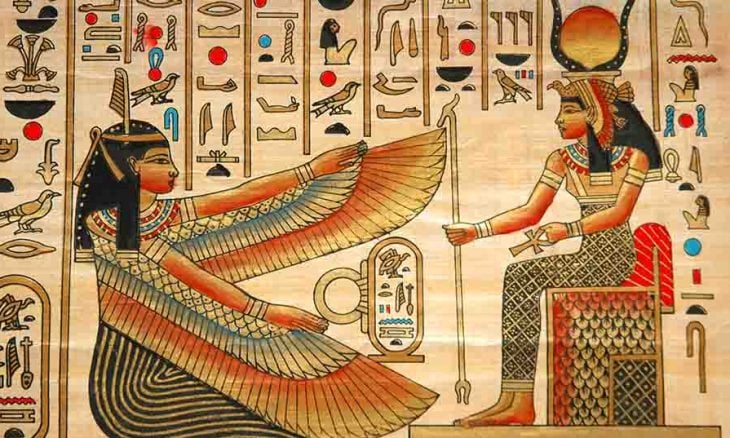
مولد سيدي «تارتارين التراسكوني» و«ألفونس دوديه»

نعيمة عبد الجواد
من أمتع التجارب التي قد يشعر بها أي شخص هي المشاركة في أحد الموالد الشعبية؛ أو بمعنى آخر الاحتفالات الدينية أو الشعبية أو الفلكلورية التابعة لدولة أو مدينة ما، أو حتى حضورها. فحضور تلك المناسبات يعد تفريغًا عقليًا وعاطفيًا على جميع الصعد؛ حيث إنه طوال فترة الاعداد للاحتفال، أو المولد، أو حضوره، لا ينفك المرء عن الانغماس روحيًا وجسديًا في تلك المناسبة، ما يمنحه تعزيزًا نفسيًا وعاطفيًا داخليًا يفوق أياً من جلسات الطب النفسي؛ لأنه يغسل الهموم من نفس الإنسان لفترات طويلة. فإقامة الموالد وحضورها هي جرعات مكثَّفة من «الدوبامين»، وهو الهرمون الذي يفرزه المخ البشري للإحساس بالسعادة، والذي أيضًا يتواجد في ألوان من العقاقير الدوائية التي تساعد مرضى الاكتئاب من الخروج من حالة الحزن.
و»المولد» كلفظ يصف لونًا من ألوان الاحتفالات، ويجد نظيرًا له في الثقافات الغربية تحت مسمى «عيد» أو «مهرجان» وذلك ترجمة حرفية لكلمتي «Feast» و«Festival». أمَّا الطريف في ذلك الموضوع فأن هذا اللون من الاحتفالات قد ظهر في مصر منذ عصر المصريين القُدماء، وتم تصديره للعالم أجمع لنفس الأسباب وبنفس الطريقة التي كان يحتفل بها المصريون القدماء، بل إنه أيضًا يوجد بعض الأعياد عينها التي تم تصدير الاحتفال بها وبوقتها خلال العام للعالم أجمع، على غرار المصريين القدماء، مثل «عيد شم النسيم»، الذي هو بالأساس «عيد الحصاد» عند المصريين القدماء.
والموالد هي احتفالات شعبية لمناسبات دينية أو ثقافية، الغرض منها ليس فقط نشر البهجة، بل أيضًا تقديم الشكر أو إحياء ذكرى الشخص أو الشيء محل الاحتفال. وجذب المزيد للمشاركة ولنشر هذا الاحتفال، استوجب توافر مسيرات لتمجيد ما يتم الاحتفال به إلى جانب الموسيقى والطرب، ويزين كل هذا تقديم مأكولات شهية تُسعد كل الحاضرين.
ولقد نقل المصريون القدماء هذا التقليد للحضارات الإغريقية والرومانية، ومنها انتقلت إلى الغرب بأكمله، الذي كان يحتفل أيضًا بمناسبات، وإن كان دون بهرجة أو تبذير؛ نظرًا لطبيعة دولهم الفقيرة نسبيًا وآليات الحكم آنذاك.
أمَّا الأطرف من كل هذا، أنه في حقبة الفاطميين في مصر، كانوا يجتذبون المصريين للمشاركة في الاحتفالات الدينية الإسلامية من خلال الاحتفال بها على غرار التقليد المصري القديم. ولقد انتشرت تلك العادات للدول الإسلامية الأخرى سريعًا، لمَّا وجدوا فيها متنفسًا راقيًا لإحياء شعائر المناسبات الدينية.
والأغرب من كل هذا، أن الغرب في وقت ازدهار الحضارة الإسلامية، كان يعيش فيما يسمى «عصور الظلام» Dark Ages، حينما كانت أيضًا تنتشر المجاعات والأوبئة والجهل، ما جعل مظاهر الاحتفال بالأعياد تتآكل إلى حد بعيد. لكن بعد الحملات الصليبية، التي داهمت المشرق الإسلامي الحضارة حينها، عرف الغرب أساليب الاحتفال المبهرجة والضخمة التي تقام على أساسها الموالد، والتي كانت في السابق يُطلق عليها لفظ «جالا» Gala، وهو لفظ تناقله الغرب مع بداية الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، وهو تحريف لكلمة «خيلاء» ويقصد بها، حينها من قبل الغرب، ارتداء الملابس الرائعة التي تجعل الفرد يشعر بـ «الخيلاء»، أي «الزهو».
ولقد تم تغيير الكلمة إلى «فيستفال» Festival، بعد استخدامها في اللغة الفرنسية القديمة، والتي نقلتها إلى اللاتينية. والكلمة مشتقَّة من الكلمة الفارسية «مهركان»، والكلمة تصف أحد الشهور الفارسية في شهر الخريف، والذي كان يقام فيه احتفال ديني كبير، بنفس طريقة المولد المصري القديم، ومع تواتر اللفظ على ألسنة العامة بعد انتشار اللغة العربية، والتي تأثَّرت بكثير من الألفاظ الفارسية، تم تحريفه لكلمة «مهرجان» الذي كان أيضًا في بعض الأحيان يُطلق عليه «بهرجان»، نسبة إلى ما يموج به من مظاهر «بهرجة» كثيرة. ويعتقد البعض أن الفرنسيين قد نقلوه إلى لغتهم، اللغة الفرنسية القديمة، مع تحريف النطق وتكييفه ليعبر عن كلمتي «عيد» و«مهرجان» في آن واحد. وبداية من القرن الثامن عشر، تم اعتماد الكلمة لتعني كلمة «جالا»، وتصبح مرادفًا لها. ومنذ ذاك الحين، طغى استخدام كلمة «فيستفال»؛ لأنها تعبر عن كلمة العيد Feast أكثر.
وقد يصاب البعض بالدهشة عند الاحتفال بالقديسين في العالم الغربي، تقريبًا بنفس الطريقة التي يتم بها الاحتفال بمولد «الحسين» أو «السيد البدوي» في مصر. وبما أن بدايات التقليد والاحتفال في العالم الغربي القديم بدأت من فرنسا، استحدثت فرنسا مولدًا شعبيًا في مقاطعة «بروفانس» Provence في جنوب فرنسا، وهي تلك المنطقة التي تمتد من الضفة اليسرى لنهر الرون السفلي في الغرب وصولًا إلى الحدود الإيطالية في الشرق، ويحدها البحر الأبيض المتوسط في الجنوب. وهي نفس المنطقة التي نشأت فيها كلمة «جالا»، وقد يكون لوقوع المنطقة على البحر المتوسط وطريق التجارة أثر كبير لاكتساب الكلمة وتعميق مفهومها. وفي تلك المنطقة، يعد تقليد إقامة «الموالد» شهيرًا ومتواترًا، وخاصة في مدينة «تاراسك» Tarasque. ولقد أدخل القائمون على «مولد» (احتفال) «تاراسك» الشهير إدخال شخصية «تارتارين التراسكوني»، المذكورة في رواية «تارتارين التراسكوني» Tartarin de Tarasque (1872)، التي ألَّفها الكاتب الفرنسي «ألفونس دوديه» Alphonse Deudet (1840-1897). وفي عام 2005، أعلنت اليونسكو مهرجان «تاراسكون» جزءًا من التراث الشفاهي وغير المادي للبشرية.
والسبب الرئيسي لاعتبار مهرجان «تاراسكون» ينتمي للتراث الشفاهي، أن كلمة «تاراسك» Trasque التي اشتق منها اسم المدينة، تشير إلى حكاية شعبية قديمة تنتمي للأساطير الفرنسية، وبالتحديد هي جزء من كتاب «الأسطورة الذهبية» Golden Legend للراهب «جاكوبس دي فوراجيني» Jacobus de Voragine . والمؤلَّف يحتوي على 153 سيرة ذاتية، انتشرت على نطاق واسع في أوروبا خلال أواخر العصور الوسطى، ويُرجَّح أنها جُمعت بين عامي 1259 و1266.
وأمَّا الـ «تاراسك» فهو مخلوق خرافي ورد وصفه في مؤلَّف «الأسطورة الذهبية»، وتم وصفه بأنه وحش له رأس أسد، وجسمه يحميه درع يشابه صدفة السلحفاة، ولديه ست أقدام ذات مخالب تضاهي مخالب الدب. وأمَّا ذيله فهو على شكل ثعبان، وله القدرة على نفث السم، تمامًا مثل أي ثعبان. ووفقًا للأسطورة، التي من المرجَّح أنها نشأت في مقاطعة «بروفانس»، يُروى أن الوحش كان يسكن ضفاف نهر الرون المُغطاة بالأشجار بين آرل وأفينيون، حول ما يُعرف الآن بمدينة «تاراسكون» (التي كانت تُسمى آنذاك نيرلوك أو «المكان الأسود»)، وكان يختبئ في النهر، ويدأب على مهاجمة كل من يحاول عبوره. لكن السبيل الوحيد للنجاة هو طلب المساعدة من القديسة «مارثا»، التي كانت تخمد الوحش عندما تنثر المياه المقدَّسة في البحيرة.
وكما هو جلي، تعد المقدَّسات والخرافات من شيمة مدينة «تاراسكون». والمثير للعجب أن «الفونس دوديه» في رواية «تارتارين التراسكوني» يقدِّم صورة ساخرة للتقاليد الفرنسية، وخاصة عادات البرجوازيين، تلك الطبقة التي كان ينتمي لها ويشعر بالضيق من زيفها وتكريس جهودها للتباهي والتبجُّح. وتدور القصة حول مغامرة البرجوازي الثري السخيف «تارتارين» الشهير بتفوُّقه في التصويب والصيد في تلك المدينة الشهيرة باحتوائها على أمهر وأشهر الصيادين. ولإثبات تفوُّقه، قام «تارتارين» برحلة إلى الجزائر في أفريقيا لصيد أسد عتيد؛ ليتباهى به عند رجوعه ولتأطير مدى تفوُّقه في الصيد. لكن ما يحدث أنه يتم الإيقاع به من قبل نصَّاب مرتين، لدرجة أنه يؤوب إلى فرنسا مفلسًا تمامًا، لكنه أيضًا ينجز مهمته ظاهريًا. فالصياد الماهر «تارتارين» بالفعل يرجع بجثَّة أسد، لكن في حقيقة الأمر هذا الأسد كان عجوزًا أعور ومروَّضًا، أي أنه منحه رصاصة الرحمة، ليس إلَّا. وهذا الأسد المذكور في الرواية، يشير أيضًا إلى «التراسك» الذي نسجت حوله الأساطير، وهو لا يعلم لماذا اخترعوا تلك الأقاويل حوله.
ومن الأقوال الشهيرة لـ «ألفونس دويه»: «أفضل وسيلة لزرع فكرة في رؤوس الآخرين هي إيهامهم أنهم أصحاب تلك الفكرة». وهذا بالفعل ما فعله عند سبكه لشخصية «تارتارين التراسكوني» الذي جعل من الأسد أضحوكة، لكن على النقيض الآخر، أصبح «تارتارين» شخصية رئيسية في مهرجان «تراسكون». ولهذا، ابتهج وأنت تردد «بركاتك يا سيدي التراسكوني».






