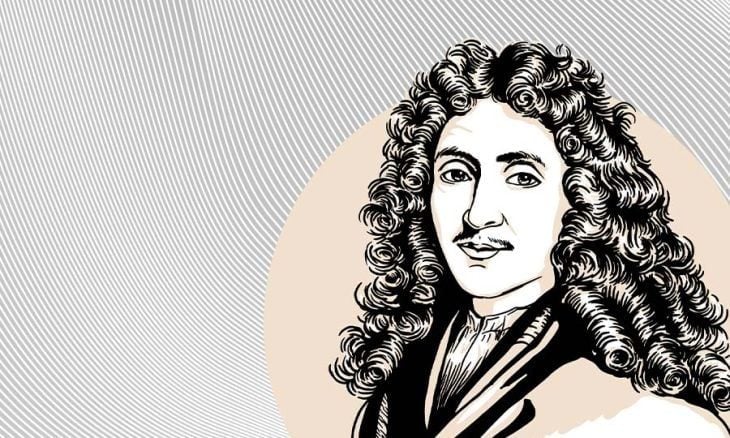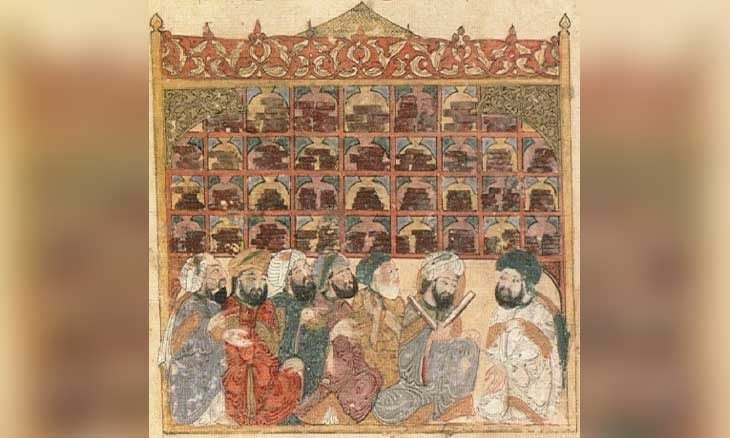الواقع والأمل في الدراما المصرية
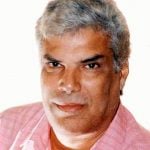
إبراهيم عبد المجيد
جاءتني دعوة لحضور مؤتمر عن تطوير الدراما المصرية، من أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. صحبني إلى المؤتمر المخرج حسن عيسى، الذي سبق له من قبل أن أخرج روايتي «لا أحد ينام في الإسكندرية» مسلسلا تلفزيونيا منذ حوالي عشرين سنة، والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس القنوات المتخصصة والمشرف على القناة الثقافية. أعرف أحمد المسلماني منذ أكثر من ربع قرن، حين كنت أعمل في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكان صحافيا مرموقا في جريدة «الأهرام» يحرص على حضور أنشطتنا ويتابعها. تابعت كل نشاطه السياسي والإعلامي في برامج قدمها وذاع صيتها مثل برنامج «الطبعة الأولى» قبل ثورة يناير/كانون الثاني، أو مناصب تولاها مثل المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور، أو كتبا أنتجها مثل «المؤسسة العسكرية في إسرائيل» و»الحداثة والسياسة» أو كتبا قام بتحريرها مثل كتاب «عصر العلم لأحمد زويل» ومذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ومن ثم أعرف رغباته الحقيقية في التجديد وتطوير كل ما يتولاه. كان المؤتمر ليوم واحد، شهد لقائين متتابعين حضرهما عدد من الشخصيات المهمة، مخرجين وكتاب وفنانين من كل الأجيال.
سبق اللقائين، تكريم عدد من الرواد الأفاضل هم، الفنانة سميرة أحمد والفنان رشوان توفيق والمخرج محمد فاضل والكاتب محمد جلال عبد القوي.
جاء اللقاء الأول حول مشكلات وحلول الدراما. كنت متحدثا فيه مع الكتاب والفنانين مدحت العدل ومحمد صبحي ومحمد فاضل ومحمود حميدة وعلا الشفعي وأشرف عبد الباقي ومحمد جلال عبد القوي.
كانت هذه هي المرة الثالثة تقريبا، التي أذهب فيها إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون عبر أكثر من خمس سنوات ويؤلمني الإهمال الذي لحق بالمبنى الذي فقد كثيرا من جماله، فصارت الطرق الداخلية إليه مليئة بالتراب، وفي داخله ترى أكثر المكاتب في حالة فوضى. وإذا فكرت في ذلك فلا بد أنه سيكون لأحمد المسلماني دور في تطوير المكان، وإبعاد ما لحق به من إهمال. طبعا لن أحدثك عن تاريخ المكان. ولا عن حالة ما يسمي بتطوير العمران حوله، التي تسببت في هدم كل المنازل القديمة، التي كانت صغيرة تتسق مع عرض الشوارع وفقا لقانون البناء القديم، الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، والذي يحدد ارتفاع المباني بمقدار مرة ونصف المرة لعرض الشارع، والذي ضُرب الحائط به في مصر كلها، فصارت الأبراج والعمارات حول مبنى الإذاعة والتلفزيون عالية على نظام البناء في دبي، كما يقولون، وتسبب ذلك في زحام شديد للسيارات وغير ذلك.
المهم أعود إلى اللقاء التي كان ذهابي إليه بحثا عن بصيص من الأمل، لن أستطيع أن الخص كل ما قيل، لكن على الإجمال كان هناك اتفاق على أن مسلسلات رمضان هذا العام، رغم الانتقاد، شهدت ستة أو سبعة أعمال مهمة مثل، «لام شمسية» الذي كتبته مريم نعوم وأخرجه كريم الشناوي، أو «ظلم المصطبة» الذي كتبه أحمد فوزي صالح وأخرجه محمد علي، أو «قهوة المحطة» الذي كتبه عبد الرحيم كمال وأخرجه إسلام خيري، أو مسلسل» النُص» الذي كتبه شريف عبد الفتاح وأخرجه حسام علي وغيرها. لكن أيضا ذهب البعض وكنت منهم على أن الاحتكار هو أحد أسباب تأخر الدراما، فهي تخرج تقريبا من منبع واحد هو الشركة المتحدة. طبعا هناك أعمال لا تخرج منها مثل مسلسل «معاوية» الذي أنتجته السعودية، وأعمال لا تنتجها الشركة المتحدة، لكن يتم الأمر بدعم منها. من الكلمات المهمة ما قاله الفنان محمد صبحي عن دور الرقابة في المنع، ولم يكن هذا بعيدا عن قناعتي. فأكثر ما واجهته الدراما من انتقاد هذا العام كان من السوشيال ميديا، حيث رأى المتحدثون فيه، أن أهل الحارة ليست هذه لغتهم ولا هذه حياتهم، ومن ثم توسعتُ في الأمر، حين جاء دوري في الحديث، بعد أن وجه لي من يدير الجلسة سؤالا عن الدراما والرواية. تحدثت حديثا يعرفه كل متابع لأحوال الدراما منذ ما يقرب من ثلاثين عاما. كيف في سنوات الأربعينيات والخمسينيات كان يُشار إلى مصر في الصحافة العالمية باعتبارها هوليوود الشرق. كيف كانت الأفلام قبل ظهور المسلسلات تؤخذ في كثير منها عن أعمال روائية. فأول فيلم صامت كان فيلم «زينب» عن رواية الكاتب محمد حسين هيكل عام 1930 الذي أخرجه الرائد محمد كريم، وهو الفيلم نفسه الذي أعيد إنتاجه عام 1952 بصورة ناطقة للمخرج نفسه.
لم تكن الرواية كفن أدبي قد انتشرت بعد في مصر، فكانت ألف ليلة وليلة مصدرا لأفلام، وكانت حياة البادية العربية قبل وبعد الإسلام مصدرا أيضا، وكان كثير من الأفلام يؤخذ عن أفلام أجنبية، لكن كان منتجوها حريصين على وضع المصدر في الأفيش، أو على شريط الفيلم، رغم أن مصر وقتها لم تكن عضوا في جمعية حقوق المؤلف العالمية، التي حين صارت عضوا فيها بعد ذلك، ازداد عدد الأفلام المأخوذة عن أفلام عالمية لدرجة كبيرة دون إشارة لذلك! شهدت الخمسينيات أكبر عدد من الأفلام عن روايات ليوسف السباعي وإحسان عبد القدوس. اتسع الأمر شيئا فشيئا فعرفت السينما روايات محمد عبد الحليم عبد الله وفتحي غانم وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، الذي التفتت إليه السينما بكثافة تزيد عن أي كاتب آخر. ربما جاء هذا من تعاون سابق لنجيب محفوظ في كتابة سيناريو أفلام ليست من رواياته، وربما لاتساع مساحة التناول النقدي لأعماله وتصدره المشهد الأدبي، وهو في كل الأحوال يستحق. قلت إذا أردنا أن نعرف عدد الروايات لكتاب ما بعد محفوظ، من جيل الستينيات أو بعدهم، فلن تزيد عن خمسة عشر عملا، أي تقريبا نصف ما عرفته السينما من قبل من أعمال السباعي أو عبد القدوس أو محفوظ. يحدث هذا في الوقت الذي يدرك فيه من يدرس تاريخ السينما في العالم، أن الرواية كانت الرافد الأعظم والأكبر لها في كل الدنيا. انتقلتُ بعدها إلى مسألة الرقابة والاحتكار. كيف من المغالطات التي مشت معنا أن الفن أو الأدب، إذا ابتعدا عن الأخلاق الحميدة يدمرا شخصية المشاهد. تحدثت عن كيف مشت هذه الكذبة فتوسع تدخل الرقابة، بينما يصنع الفن إنسانا سويا بالمتعة في ما يشاهده، والإجرام يأتي من المجتمع وحالته حول الناس. أين هي المدارس التي كانت يوما مراكز ثقافية، فيها أنشطة للفن والقراءة والسينما والرحلات وغير ذلك كثير، بل أين هي المدارس أصلا. الرقابة ازدادت في وقت صار فيه العالم هاتفا نقالا أو «موبايل» يستطيع من يحمله أن يرى ويعرف كل شيء محظور، وهنا يأتي دور الأسرة في حماية أطفالها، الذين لا ينقطعون عن النظر في الموبايل مثلا. الرقابة في السنوات الأخيرة حظرت ظهور أي شخص من فئات يسمونها سيادية، مثل القضاء أو الشرطة أو غيرها بشكل سيئ باعتبار كذبة أن هذا يرمز للجميع من أهل المهنة، بينما السيئ هو من تراه أمامك على الشاشة، ولا يرمز لغيره. قلت بالنص ليس معنى خيانة زوج لزوجته في فيلم أن كل الأزواج خونة، والأمر كذلك في الزوجات. الخائن هو من تراه أمامك فقط لا غير. وباعتبار الرقابة أوقفت تصوير أي شخص من الفئات السابقة بصورة سيئة، لم يبقَ إلا أهل الحارة الذين لا تدافع عنهم الدولة ولا نقابات مثلا، فصارت الحارة مثل أوكار العصابات وكلما زاد فيها الإجرام زاد الإقبال عليها. هكذا ابتعدت الأعمال الدرامية عن كثير من القضايا الإنسانية.
وفي النهاية هل هناك بالفعل أمل في تطوير الدراما؟ أتمنى أن ينجح أحمد المسلماني. واكتفي بسعادتي بلقاء عدد كبير جدا ممكن أحببتهم من الفنانين والكتاب الذين جاءوا يسبقهم الأمل، والحوارات الرائعة بيننا في فترة الاستراحة بين لقائي المؤتمر، والأسماء كثيرة يضيق عنها المقال.
كاتب مصري