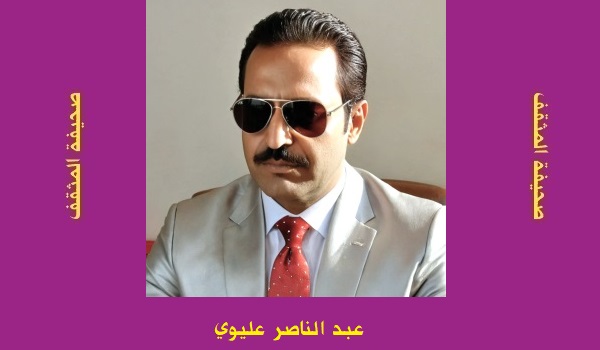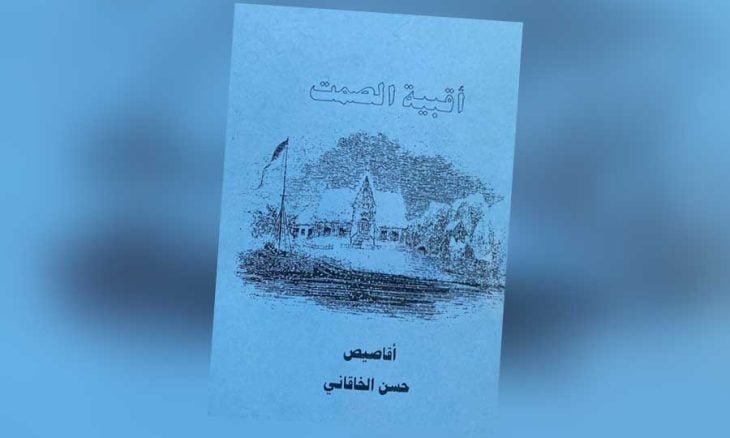
النزف الوجداني في قصص «أقبية الصمت»

ملاك أشرف
نقل المعلومات لا يُعدّ من صميم دور القاص، فوظيفته الحقيقية ككاتب فردي وذاتي تتمثل في توثيق ردود أفعال شخصياته. ويجب ألّا تكون السيرة الذاتية عائقاً أمام العمل القصصي. فمثلاً، حين قال فلوبير: «مدام بوفاري، هي أنا»، لم يُنظر إليه كنرجسي، بينما قد يُتهم مؤلف آخر بذلك، لكن المسألة لا تكمن في مدى انعكاس حياة الكاتب في عمله، بل في ما إذا كان هذا الانعكاس يثير اهتمام الآخرين ويجذبهم.
العنصر الأكثر إثارةً للإعجاب في مجموعة «أقبية الصمت» للكاتب الأكاديمي حسن الخاقاني هو، كيفية نقلها للصدمات النفسيّة من خلال نثر مُحكم ودقيق. وكما قالت الروائية آنا كافان (Anna Kavan): «إن القصة القصيرة أشبه بغرفةٍ صغيرةٍ يرتكز فيها ضوءٌ ساطع»، وفي «أقبية الصمت» يتوهج هذا الضوء بوضوحٍ لا يُرحم، متحدياً محاولات العتمة والصمت للهيمنة على المشهد. تبقى القصص في حال من الغموض: هل تصف تجربة نفسية واحدة مستمرة، أم تجليات متكررة لحالة إنسانية متشابهة؟ وإنّ النصّ الذي يحمل جرحاً إنسانياً، يتغلغل في أعماق ذهن القارئ، كما تفعل كتل الجليد حين تتحطم وتتراكم فوق بعضها بعضا. طغت النزعة العبثية التي تروّج لفكرة عبثية الحياة وانعدام جدواها على هذه القصص، غير أنها لم تكن مشوبة بالثغرات والقصور كما يدّعي الكاتب. كُتبت هذه القصص في فترات متفرقة، تعود بداياتها إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تلك المرحلة التي أثقلت كاهل الإنسان بالهموم والموت واللا جدوى حقّاً.
افتتح المجموعة القصصية بقصة «أقبية الصمت»، التي غلب عليها الوصف الدقيق، كاشفاً عن عمق بصيرة الراوي ورهافة إحساسه وذائقته الأدبية، يقول فيها: «من عمق المسافات الداكنة تتصاعد النداءات الخفية لموجة الصمت الرهيبة، تغطي القعر المنكفئ حتى تلامس الأشعة المُتكسرة لتلتف حول ذلك الخفقان اليائس في هوّة الظلمة السحيقة.. تتفيأ أسلحة النسيان أسلاك الحقيقة الشائكة، تتماوج في عبث الريح فتستطيل المسافة بين اللعنة واللعنة، تضيع بداية السلسلة المتصلة بلا نهاية.. في ظلام معدم البصيرة تترنح الخطى بغير اتجاه ويوسع الصمت جدرانه الهرمة، تتهاوى في الرماد ظلال الأوراق القديمة، التي تبعثر الريح خضرتها وتسحق الأقدام العنيفة آخر خيوط الأحلام».
النص يُجسّد رؤية عميقة وسوداوية للوجود، مشبعة بلغة عالية الكثافة وصور بلاغية مشحونة بالتوتر؛ ما يضفي عليه طابعاً وجودياً وعبثياً واضحاً. تنغمس اللغة في الشعرية والتكثيف، وتحمل في طياتها صوراً معقدة تُجسّد مشاعر متضاربة من الألم، والتشتّت، واليأس. استحضر ثنائية «الظلام/الضوء»، «الحقيقة/النسيان»، و»الأحلام/الرماد»، وهي ثنائيات تعزز الصراع الداخلي في النص، وتُبرز الصراع بين الواقع المظلم والطموح الإنساني إلى الانعتاق والمعرفة. تعكس التراكيب الطويلة والمتداخلة حالة من الارتباك الذهني والتيه الذاتي، وهذا البناء اللغوي يتناغم مع الأجواء الكئيبة للنص ويعزز فكرته المحورية حول الفقدان وانعدام الاتجاه. تكشف هذه الصياغة عن رؤية عبثية للكون، حيث «تترنح الخطى بغير اتجاه»، والصمت «يوسع جدرانه الهرمة»؛ ما يؤدي إلى الإحساس بعبثية الفعل والقول في واقع فقد معاييره وقيمه.
ظلّ النص يطرح تساؤلاته الموجعة: من يوصد أبواب الضجيج المتصاعد من أقبية الصمت الكئيبة؟ من يفتح للريح شراع السفن الغريقة؟ ومن يوقظ جرس النسيان في الأزمنة السحيقة؟ تحمل هذه الأسئلة مفارقة مثيرة، فكيف يمكن أن ينبعث «ضجيج» من «الصمت»؟ المقصود ليس الضجيج الحسي، بل ذلك الضجيج الداخلي، صوت المعاناة والكبت والتوترات النفسية، التي تتراكم في أعماق الإنسان. ترمز «أقبية الصمت» إلى تلك الزوايا الخفية من الذات، حيث تتكدّس الانفعالات المكبوتة. والسؤال هنا يُجسّد رغبة دفينة في كبح هذا النزف الوجداني، في إسكات عواصف الألم التي تتفاقم، على الرغم من المظاهر الهادئة.
أما تصوير «السفن الغارقة» فيتضمن دلالة على الأرواح المنطفئة، أو الأحلام التي انكسرت، بينما ترمز «الريح» إلى القوة المحركة، ربما الأمل أو نبض الحياة المتجدد. والسؤال يعكس بحثاً عن قوة قادرة على إحياء ما بدا ميتاً، أو استنهاض ما اندثر واندفع نحو العدم. إنه نداء عميق لإيقاظ الحياة من سباتها، وإعادة النبض لما حسبناه انتهى. في حين أن «النسيان» أشبه بالنعاس الثقيل الذي غطّى حقباً مليئة بالمعاناة والذكريات المنفية. «جرس النسيان» قد يرمز إلى الطفولة، الحنين، أو حتى الرغبة في استعادة ما نُسيَّ عمداً. والتساؤل يُعبر عن شوق دفين لاستدعاء الماضي، أو لحظة كشف الحقيقة التي طُمرت طويلًا. هذه الأسئلة لا تهدف إلى إجابات محددة، بل تسعى لتعميق الإحساس بالضياع والفراغ، مجسّدة رؤية عبثية تُسائل المعنى في عالم تآكلت فيه القيم وتزعزعت فيه المعايير. لم يقتصر الألم في هذه القصة على ما ذكر فحسب، بل نلحظ في قصة «الضرب على أوتار مقطوعة» تجسيد السيدة للدخان الذي تأمل أن يطفئ القلوب المشتعلة بلا دخان، فحرائق البشر تحترق من دون أن تترك أثراً مادياً. ويضيف مَن يخاطبها إلى كلامها بأن المشاعر لا تتشابه ولا تتكرر، فهي جديدة في كل مرة؛ وذلك لأن الإنسان يخسر في كل مرة يشعر فيها بشيء، فالشعور ذاته هو نوع من الاستهلاك المستمر. وبقيّت هذه الشخصية تسير وحيدة، خطواتها تتنقل ببطء على طريق طويل، تمضي في صمت، ويختلط شبحها الأسود مع ظلام الليل، حتى الشخصية الرئيسية في قصة «الحجرة» التي طرقت الباب من دون أن يُجاب، ومع مرور الوقت اختلط عليها الظلام شيئاً فشيئاً، ترتبط برمزية الأقبية الملعونة. نحنُ أسرى هذه الغرف الملعونة، بينما العالم يواصل حركته في الخارج.
القصص – في هذا الكتاب – تشبه أنيناً مرتفعاً يشقّ سكون الوجود، وشخصياتها تبدو وكأنها تقف عند حواف التلال، تفتّش عن لحظة راحة تروي بها ظمأها الداخلي، في صمت يغلفه الحزن. ومن هنا تبرز رمزية الطائر في قصة «طائر في فضاء»، إذ يجسّد الكائن الذي لا يكفّ عن الصراخ في العلاء، بينما لا أحد يفكّر بإعادته إلى موطنه الذي تركه خلفه. أما الأيدي التي التقطته، فقد ظنّت أن صراخه الصاخب ليس سوى تعبير عن الفرح والسرور، لا استغاثة مُفجعة. ويؤكد الخاقاني هذه الفكرة في قصته «بقايا رماد» إذ يقول فيها: «هي قبالي إذن.. تلك الشعلة المتوجهة تتلألأ في جوف الليل البهيم، على الرغم من بعد المسافة التي أجهل مقدارها، ليس عليَّ إلا أن أجد في السير باتجاهها فهي منقذي الوحيد من هذا التيه، الذي لا حدود له». يُساوره الشكّ في أن كل هذا الجهد الذي يبذله في حياته لا يختلف عن ليلٍ طويل، مهما انقضى منه، يبقى أطول مما يتخيل. ومع ذلك، لا يملك سوى الظن، لا برهان لديه سوى الإحساس الغامض، بل ربما كانت حياته بأكملها مجرد وهم، سراب من رجاءٍ خادع بدأ يخبو نوره. فبعد كل ما مرّ به من خوف وأشباح، من شقاء وبردٍ ورياح، لم يبقَ له سوى ما بلغه في نهاية المطاف: نار انطفأت، ورمادٌ نثرته الريح. المكان دائماً هو نفسه، رماد مبلل بالندى، بعضه كانت تذروه الرياح على حدِّ قوله. وهكذا تتبدّد أمواج الكتاب فوق ذرّات رمل الحياة، تذوب رويداً، على الرغم ممّا تحمله من عنفوان واندفاع وضجيج؛ لأنها بلا انتماء واضح، وتستند إلى فلسفة بودلير في «أزهار الشر» حينما كتب: «ستحبّ البحر دائماً أيها الإنسان الحر!/البحر مرآتك، أنك تتأمل ذاتك/في جريان أمواج أعماقه اللامتناهي/وليست لجة روحك بأقل مرارة/ إنك تتلذذ بالغوص إلى أعماق صورتك،/تحضنها بعينيك وذراعيك، ويتسلى/قلبك أحياناً عن صخبه الداخلي/ بصوت هذا الأنين الوحشي الذي لا يروض». باختصار، تتلاقى هذه الأشطر مع قصص «أقبية الصمت» في رؤيتهما الوجودية والعبثية، حيث يصبح البحر كما الأقبية، مكاناً رمزياً للتأمل في الذات المُنهكة، والإنصات لصوت الألم الوجداني الذي لا يهدأ. تنعكس في هذه الصورة الكثيفة مرارة شخصيات الكاتب، التي تُعاني من اغتراب وصدمات نفسية عميقة. أرواحهم مثل البحر، عميقة ومضطربة.
إذ يصف إحدى شخصيات قصة «القرار» قائلاً: «كانت جالسة أمام نافذة كبيرة من الشقة التي كانت تسكنها، ليس بعيداً عنها يغفو الطفل الذي طرأ على اختيار حياة الحرية التي قررت أن تحياها، لم تحاول أن تفكر بالطريقة التي جاء بها، فهي مهتمة فقط بالطريقة التي ينبغي أن يرحل عنها.. نسمات الليل الهادئة تداعب صفحة خديها ببرود ناعم وهي تمرّ على ذلك البحر المتسع، لتملأ أجواء الغرفة بتلك الأنسام الندية التي تملأ رئتي الطفل وهو يسبح في عالم نوم عميق». قدّم هذا المقطع الشاعري مشهداً تأمّلياً يُسلّط الضوء على توترات شخصية نسائية تعيش صراعاً بين حرية اختارتها ومسؤولية أمومة فرضتها الحياة. بحيث تجلس الشخصية أمام نافذة تطل على البحر، وهو رمز تقليدي للحرية واللانهاية. هذا المشهد يُبرز رغبتها في التحرر والتخلّص من قيود الحياة، بينما وجود الطفل النائم يُمثّل التزاماً ومسؤولية تُقيّد هذه الحرية. استعمل لغة شاعرية تُضفي على النصّ طابعاً حالماً، فضلًا عن الرموز المكانية والزمانية التي تعمّق النزاع الوجودي.
قليلٌ من الكُتّاب صوّروا الحياة «العادية» بمثل هذا القدر من الرقي والتعاطف، مقروناً بمهارة تقنية باهرة، تتميز هذه القصص بالثقة والجرأة والأصالة، وتنطلق من رغبة الكاتب في قول ما يريد هو أن يقوله، لا ما يتوقّع أن يُقال أو يُنتظر منه. فالكتابة بهذا المعنى، ليست تملّقاً لذائقة الجمهور، بل وفاء لحقيقة النص. عندما نكتب ما نظن أن الآخرين يريدون سماعه، نقع في فخّ أنصاف الحقائق، وننتج نصوصاً مصطنعة، متكلّفة، تقترب من الخطاب السياسي أكثر مما تقترب من الأدب الحقيقي. والعالم كما يُقال، ليس بحاجة إلى مزيد من السياسيين.
ترى الروائية أوكونور (Mary Flannery O’Connor) أن كل قصةٍ قصيرةٍ ممتازةٍ، في رأيها، تتمحور حول لحظةٍ يصبح فيها التغييرُ الكبيرُ ممكناً، أو على الأقل مُتخيَّلًا للشخصية. ليس بالضرورة أن تكون اللحظة في النهاية، وليس بالضرورة أن تكون نهاية القصة مُلهمة أو كاشفة، أو أن تحتوي على مفاجأة غير متوقعة! وهذا بالضبط ما تحققه هذه المجموعة القصصية، كل قصةٍ فيها سريعة وسهلة القراءة، لكنها تترك في الذاكرة جوهراً، وبقايا من التأمل.