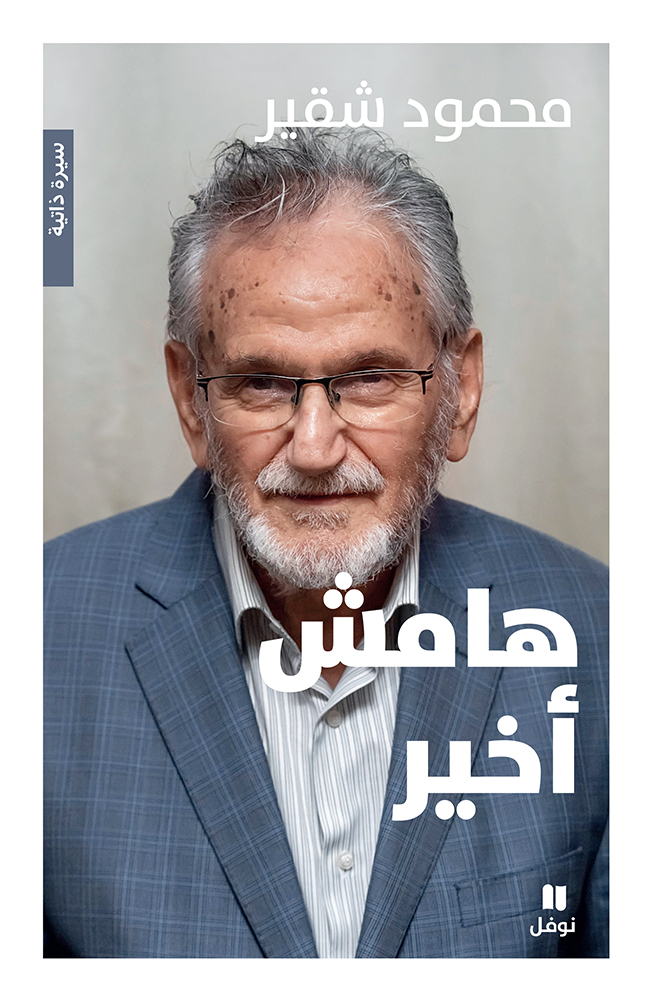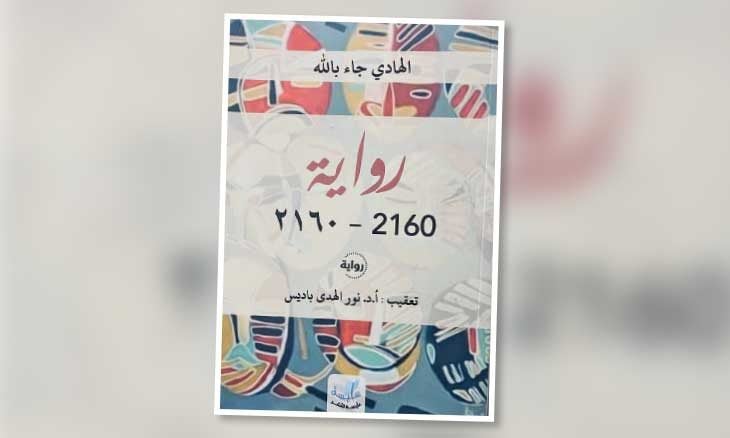
« 2160» رواية البحث عن عالم جديد بين ضيق اللفظ واتساع المعنى

مهدي غلاّب
ما يطرحه الصحافي والكاتب التونسي الهادي جاب الله في روايته «2160»، الصادرة عام 2023، عن دار عليسة للنشر، يعد بمثابة مغامرة أدى فيها التجريب الدور الرئيس في إيصال عمق معاني السرد إلى أبعد حدودها، حتى تجاوزت الرحلة حدود العالم المحيط، وخلخلت الأفكار المعهودة، في السابق والراهن، لتظل العبارة شاردة متنازلة عن سلطانها أمام عنفوان المتاهة السردية، فهي بمثابة مسبار صاعد متمرد على محيطه، يبحث عن مساحة جديدة لاحتضان المعنى والفعل والحركة، ألم يقل جاك لوران المتوج بجائزة كونكور في 1971 معرفا الرواية، في مؤلفه رواية الرواية «إنها جنس مختلف عن كل الأجناس، يقتات من عثرته ويعيش من ارتباكه». من هنا تطرح رواية «2160» إشكالية الواقع والحقيقة، بين حدود دنيا تمثلها اللغة، وحدود قصوى يمثلها الإيهام والإبهام.
وهذا ما ذكره الكاتب في مقدمة عمله قائلا: «إن المكان والزمان والأفعال لا تستجيب للفضاء الروائي، إذ جاءت اللغة بسيطة وسلسة وحمالة للمعنى بأقصر السبل». ذلك أن الأثر يعد بمثابة مشروع بحث مضنٍ مسكون بتأسيس عالم جديد، يكون فيه الفرد كائنا خارقا، والعالم مخبر تجارب والأدب علما واللسان محكوما بمتطلبات البناء اللغوي الذي يجره إلى لحظة فارقة، يحكمها التلاشي والاندثار المتزامن مع كارثة العصر، كما صممها وصقلها الراوي. وهي الحالة الرمزية ذاتها التي تمثل نهاية خالد بطل الرواية، بعد مأساة فقدانه لعدد من أعضائه، ثم بعد ذلك تلاشي عضوه التناسلي. يقول: «هذا الزمن نصبح فيه غرباء عن أنفسنا وعن كل ما لنا به علاقة». فهي إرادة لا شك فاعلة ومتحركة، ثائرة عن الزمان والمكان، تطمح للتحليق في عوالم الغريب وقد غاصت فيها معانيها وتشابكت شخصياتها، وتداخلت مراميها حتى صار الموت مشروع حياة، كما هو شائع في تقنيات الدستوبيا. ذلك أن من يعتقد أن هذه الرواية توقفت عند مفهوم الميميسيس أو المحاكاة الأرسطية المضمنة في كتاب الشاعر (الذي وصلنا مبعثرا) هو مخطئ، وأن من يعتقد أن الرواية تتوقف عند التضمين (l’intertextualité) الذي تتحدث عنه جوليا كريستيفا هو مخطئ، وأن من يعتقد أن الرواية تتوقف عند تعددية باختين الصوتية (La polyphonie) فهو مخطئ، وأنّ من يعتقد أن الرواية تتوقف عند القطع مع الواقعية والإنسانية التي تناولها جان ريكاردو، فهو مخطئ، وأن من يعتقد أن الرواية تتوقف عند تجربة التفاصيل في لعبة السرد عند بارت فهو مخطئ، وأن من يعتقد أن الرواية تتوقف عند تكثيف تودوروف فهو مخطئ.
أمام هذا السفر نحو سحر المعنى ونشوة الانحدار وأزمة الضمير وعدمية المسارات التي مهدت للسخرية والرمزية والسريالية نجد أن المعادلة تتغير تبعا لما يسوقه الكاتب من مجاهرة محمومة ومعان متداخلة، وقاموس علماني ومراوحات فنتازية وشخصيات معقدة وأصوات متقاطعة، وحركات متشابكة، ونفسيات متضاربة ومضطربة. وأمام هذا التقابل الذي يولد تجاذبا خفيا بين الواقع من جهة (فعل الكتابة النقدية) عبر المتن الروائي والشخصيات الجوهرية والثانوية. واللاواقع من جهة أخرى (فعل الكتابة الأسطورية) عبر الإثارة والعجيب. لذا يمكننا أن نتساءل عن مقدرات الواقع من الحقيقة، أو اليقظة من الحلم في رواية «2160» أمام جنوح المقاصد ومجازفة المضمون وجموح اللغة؟ ثم ننتقل إلى تناول مآلات العجيب والغريب في رحلة غيرت العلم بالأدب، والطبيعة والبيئة والفضاء المفتوح بالكبسولة، والشخوص بالخوارق.
يذهب الناقد الفرنسي ايف ستالوني في كتابه «الأجناس الأدبية» ( Les genres littéraires) الصادر عام 1997 عن دار دينو، إلى حد اعتبار الجنس الأدبي بمثابة وضع نظام في نظام الوضع، يتوقف على إعادة توزيع العناصر النصية، فهو بمثابة تجسيم لفهم جديد ومتغير داخل سياقات الكتابة، يقوده السارد حسب رغبة بنظرة خلفية مسيرة وغير مسايرة، عبر استعمال الغائب المفرد. وهو طرح متحرك يتموقع بين حقيقة الخيال العلمي وزيف الواقع كبديل يحيلنا لا محالة إلى جدلية جديدة خلناها اختفت مع هيغل وماركس، ولكنها عادت كصراع إبداعي خلاق بين السماء والأرض، والحياة والموت. والوجود والعدم، والصدق والكذب، والجسد والنفس، والشخوص والخوارق/ (الكائنات المعمرة).
وجدير بالاهتمام أن نضع النقاط على مفاهيم يربطها الشد والجذب، والعلم والجهل، والصمت والكلام لنفك ألغاز الحيرة، لذلك وجدت أنه من الجدير التركيز على ثلاثة عناصر صناعة روائية بارزة للهادي جاب الله، لا تثمن المنجز الإبداعي فقط، بل تجعل منطق التجريب عنده ذا منحى ساحر وساخر، وفي الوقت ذاته، تجعله ساحرا وزاخرا بمتعة السفر في عوالم مستقبلية حاملة لمعطيات جديدة خارج مقاييس الزمن، وخارج مقاييس المكان المعتاد، جاذبة للخطاب السقيم ليسافر في رحلته، لنجد عناصر الاهتمام متتابعة بتواتر مدلولاتها في الأثر على التوالي:
تقديم المصطلح العلمي كبديل عن المصطلح الأدبي:
وهو مبدأ لتناول جديد يسلب منا نشوة المعنى ومتعة القراءة والسفر في الأثر، وبين السطور دون استحضار أي سفر آخر عدا البحث والضياء والتعلم والقياس بالممارسة، واستدعاء المغامرة (التجريب)؛ من ذلك نسجل بمرارة خسارة غياب التشويق والإنكار، والنفي والتمني، والتقرير والتهكم والسخرية، والمدح والتعظيم والاستبعاد، والأسى والحسرة، التي عادة ما تشدنا إلى البنية النصية وتجذبنا إلى أسرار اللغة والمنطق. وما استبدال الكاتب لكل ذلك بمصطلحات طبية تارة وفيزيائية طورا وجيولوجية أخرى، إلاّ دليل على ذلك، فورد الأثر بمقاربة بحثية دراسية وتصدرت المصطلحات العلمية خبايا السطور، من ذلك الحديث عما يسمى بـالكارثة الكبرى في أغلب الصفحات، نجدها كالآتي:»مقبرة مجهزة بآلات لاقطة عبر لوحات سرية». «تناول جرعة من الماء الفيزيوكيميائي». «تغيير الجينات وانهيار الهرمون المحفز على العدوان». «جهاز عوّض في جزء منه الطبيب وإضاعة الوقت للانتظار والتحاليل».
ولعل الكاتب بهذا الاختيارالمعجمي، يطرح بديلا جديدا لإقناع القارئ بمدى أهمية الطرح الذي يقدمه، لاسيما وأنه يتناول قضايا مصيرية منها ما يتعلق بالإنسان (المصير) ومنها ما يتعلق بالكون (المستقبل)، وهو بذلك يعبّد طريقا يسلكه في تمارين رحلته الحالية المتخيلة المطابقة لعام 2160، ليكون متسعا ومسارا لمن بعده، بالتطوير والتأسيس، مجددا غايته الأولى والأخيرة في ذلك وهي تخليص الذات العربية عموما، والقلم العربي خصوصا، من أحلام يقظة وثرثرة أدبية في عدد من النصوص لا تسمن من جوع، أمام ترهل وتشنّع الوضع العربي بسيطرة الخرافة والوهم، لكن تبقى الرسالة الكونية الأولى مرتبطة بالضمير والوعي بالبيئة والخلق والصراع بين الخير والشر. ولربما أمكننا التطرق إلى مفهوم الكارثة في بيئتنا العربية، من خلال الخراب الأسطوري للمقدرات الطبيعية وتحول البراري إلى مصبات. وفي باب آخر أمكننا ربط كارثة زمن الكاتب بكارثة زمننا الحالي، عبر التطرق ولو بانحناءة واحدة غير مباشرة إلى احتدام الوضع في الشرق الأوسط وقوة الصدامات المخربة لكل أمل في البناء والبقاء. ولعل مشاهد تفحم الأجساد مئات المرات وتحول الآلاف إلى مخلفات تحت الأنقاض ودمار الفرد والمتاع في المنطقة الفلسطينية والعربية، خلال الحرب الحالية والحروب السابقة، خير دليل معبر أمكننا أن نستلهمه من الرواية إن كان ذلك من قريب أو من بعيد.
2- طرح المعطى البيئي البيولوجي كعنصر ثقافي جديد يفرض نفسه:
وهو مفهوم قديم جديد ورد تداوله في ضوء تصاعد الضغوط الاجتماعية، والنفسية والصحية والإيكولوجية، حضرمنذ القديم في أدب الإنسان والطبيعة الصامتة عند ابن خفاجة، الذي ألقى فيه ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ، ﻭﺃﺻﻭﻟﻪ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻭﻣﻣﻳﺯﺍﺗﻪ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ، ﻭﻛﺎﺗﺑﻪ ﻭﻧﺎﻗﺩﻩ، ﺛﻡ ﺗﻧﺎﻭلاته المتعددة. ورد ذلك في ﻗﺻﻳﺩﺓ «ﺍﻟﺟﺑﻝ»، ﺛﻡ في ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺳﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺭ ﺍﺑﻥ خفاجة. ففي قصيدة القمر يعود بنا الشاعر إلى محاسن ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ: ﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺹ، ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻝ والتأمل ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ الدقيق. فتبني الأثر للمفاهيم البيئية الإنسانية، يتماهى مع نظريات العولمة والاستهلاك والخوف من النفس، وهو تماهٍ تجريبي جريء يدفعنا لمزيد التفكير في المحطات المقبلة والتحديات المحتدمة في عدة محاور، وحول عدة نقاط ضوء.. غير أن استبدال الطبيعة الأصل بالإيكولوجيا كبديل قد يحملنا للحديث عما يسمى بأدب المدونة الفاسدة والواقع المريض (دستوبيا) على غرار روايات الأوبئة: من ذلك، نجد الجمل التالية في الكتاب:
– إحدى المراكز الدولية تدرس ميدانيا إحدى الظواهر الخاصة بالبيئة الخارجية للمدن.
– ما زالوا رابضين على أديم هذه الأرض الناقصة.
– الأفق الخاص بحياة الإنسان المعاصر.
– الرياح التي تؤدي إلى نتائج عكسية.
– عبّارات صغيرة الحجم وسريعة التنقل تعمل بالطاقة.
3- لغة الواقع التي تحيلنا لا محالة إلى وضع العملية اللسانية في الرواية:
وهي معطيات بنيوية تبلورت في العديد من العناصر، جعلتنا من جهة نستكشف تمرد وتحرر اللفظ في جانب، ومحدوديته في جانب آخر من ذلك:
* في باب تحرر المعطى اللغوي نجد:
– حضور النص الشعري في قصيدة «ماض لو»
– اعتماد نقاط الاستتباع لترك المجال لحضور القارئ في النص.
– استعمال الجمل الطويلة التي غالبا ما تؤول المعنى وترهق القارئ في البحث عن مقاصد السارد.
– اعتماد بعض المصطلحات التقنية الخارجة عن الأدب. الكارثة الكبرى، المستجدات، المصطلحات، الفضاءات، المواد، المستخلصات الرسمية. وهو ما يحيلنا إلى تأثره بالتجربة الصحافية التي ما زال يمارسها في مهنته.
*في باب ارتباط المعطى اللغوي نجد:
– الجمل التوكيدية التقريرية، مثل لقد ذهب الرجل ذاك الرجل الذي تزعم الحكم.
– أخذ الجد خالد مكانه بقاعة الجلوس في وقت الظهيرة.
– استعمال العطف والاستتباع والاستطراد.
– بداية الجمل بحرف الواو، وقد زارت وقد أدخلت
وفي رواية مشابهة بعنوان «2034»، تنبأ جنديان سابقان بمستقبل تحدث عن صدام تكنولوجي مسلح بين الولايات المتحدة والصين. ويبدو أن الواقع ليس بعيدا عن هذا التصور الخيالي الكارثي، الذي يُعتقد أن الظروف السياسية والتكنولوجية وسباق التسلح ستقود إليه لا محالة.
كاتب تونسي