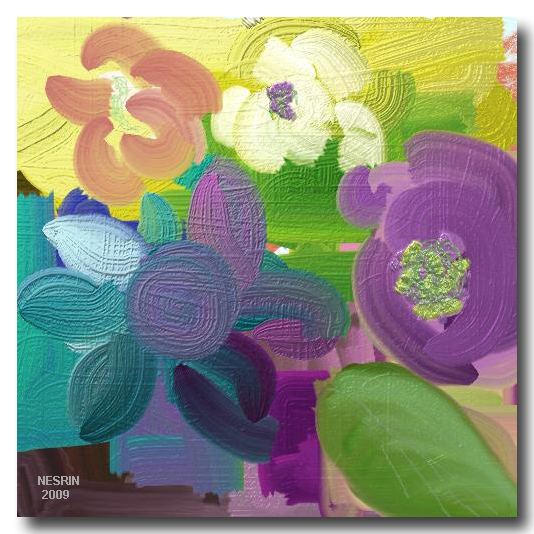الفيلم الألماني «حياة الآخرين..»… حدود الوعي بالذات والآخر

رامي أبو شهاب
غالباً ما يُنظر إلى الوعي على أنه أهمّ ما يُمثّل الإنسان عن سائر الكائنات، ويأتي الوعي بتدرّجات مختلفة بدءاً من الوعي بالذات بوصفها متمايزة عن الآخر، ومن ثم الوعي بالمحيط عينه، غير أن الأهم الوعي بمفهوم الحقيقة، كما جملة القيم التي تجعل الإنسان في وعيه يتطابق مع تعريفه لذاته، وعلى الرغم من ذلك فإنّ تعريف الذات الثقافية يبقى جزءاً من سؤال السياقات، ومن ذلك التأويلات في تحديد أين يكمن الخير أو الحق؟ ومن يمثّله؟
من الأفلام التي حظيت بتقدير النقاد، كما المهرجانات السينمائية الفيلم الألماني «حياة الآخرين» الذي صدر عام 2006 من تأليف وإخراج « فلوريان هنكل فون دونرسمارك ». وقد نال الفيلم جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي عام 2007 ربما لحساسية أسلوبه، وطرحه الذي يتصل بفترة الحرب الباردة في ألمانيا الشرقية، وبوجه خاص سطوة النموذج البوليسي القمعي في الدول الشمولية، أو الكتلة الشرقية.
مراقبة الثقافة
يعمد الفيلم إلى صيغة تتصل بتموضع الثقافة في هذا الجزء، ومفردات السيطرة والهيمنة والمراقبة في ألمانيا الشرقية إبّان التبعية للمعسكر الاشتراكي، ويتّخذ الفيلم من مفردة «حياة الآخرين» جزءاً من الصيغة التي يرغب في معالجتها سينمائياً، حيث يقوم البوليس السرّي بمراقبة، أو التجسس على كاتب مسرحي اسمه «جورج درايمان»، وعلى الرغم من أن العامل الأساسي، أو المسوغ لمراقبة الكاتب ينهض على شبهة ارتباطه بمثقفين في ألمانيا الغربية، غير أن الرؤية التي تحكم ذلك تتعلّق حقيقة بممارسته الثقافية الليبرالية، ونقده المبطن للنموذج القمعي، ومعنى استلاب الحرية، والأهم دور الثقافة في عملية الوعي بالحرية، ومن هنا، تُخضع الثقافة في النموذج الشمولي لحساسية عالية من حيث أثرها على تشكيل الوعي، وما يكمن فيها من خطر، وبعيداً عن هذه الجزئية إلى حين، فإن من يُكلّف بمهمة المراقبة ضابط اسمه «غيرد فيسلر» لديه خبرة كبيرة في التجسّس، إذ يُستدعى من مهنته في تدريس آليات المراقبة مدفوعاً بولاء للمؤسسة، وقد قام بأداء الدور باقتدار الممثل «أولريش موه».
تكمن حساسية الفيلم في بيان تموضع الرقابة الثقافية على المبدعين، وتعقيدات ذلك، بالتضافر مع بيان قيم الاستغلال، والابتزاز التي تقوم بها المؤسسة، أو رموزها من المسؤولين، بحيث تتشكل مشهديّة ذلك عبر وزير الثقافة، ودوره في توجيه المراقبة التي تضطلع بمهمة رسم المشهد كاملاً، حيث يطلب وزير الثقافة من قائد البوليس السرّي مراقبة الكاتب المسرحي، ومن ناحية أخرى فإن الوزير على علاقة بزوجة الكاتب، وهي ممثلة مسرحية، يقوم بابتزازها جنسياً مقابل غضّ النظر عن أنشطة زوجها الثقافية المناهضة للدولة، ومن هنا تتداخل مسارات الصراع في تكوينين: الداخلي ممثلاً بوعي الزوجة، أو الممثلة من ناحية الامتهان الإنساني الذي تشعر به والخوف، وفي مرتبة ثانية موقف زوجها بعد أن يعلم عن هذه العلاقة، والخارجي عبر أنماط من المثقفين، أو الشخصيات الذين ينتقدون أجواء القمع بما في ذلك الكاتب المسرحي، ومجموعة من الأصدقاء، ومنهم صديق ينتهي به المطاف منتحراً في مسلك يبدو أقرب إلى الاحتجاج، مع شيء من اليأس.

ينجح الضابط والبوليس السرّي في زراعة أجهزة تنصّت داخل شقة الكاتب، وعبر نوبات من المراقبة، يمكث المراقب في الطابق العلوي من البناية للتنصّت على أنشطة الكاتب المسرحي، وما يدور في شقته من نقاشات، ناهيك عن الاستماع للأحاديث التي يتبادلها مع زوجته الممثّلة، كما أصوات ممارسة الحب، وكل هذا يؤدّي إلى تكشّف أو تشكل النموذج الإنساني، الذي يكمن في هذه الحيوات، والوعي من لدن المراقب بغياب هذا الإحساس عن حياته الخاصة، ومع الوقت يتحوّل الوعي لدى هذا المراقب، ولكن بصورة تدريجية، ولاسيما بعد أن يتمكّن من تكوين صورة مغايرة لحياة الكاتب المسرحي عما كان يكمن في متخيله، كما يتأثر من مسلك الزوجة التي تضطر للتغطية على زوجها، أو المحافظة على حياته، وحريته مقابل علاقتها مع وزير الثقافة، في حين يسهم المراقب ـ في وقت لاحق – في كشف تلك العلاقة للكاتب الذي يدرك ما تقوم به زوجته من تضحية، وما ينتج عن ذلك من إحساس بالقهر والغضب وتداخل المشاعر، ومن هنا فإن متعالّية الحب تدفعه إلى أن يطلب الكاتب من زوجته الكفّ عن ذلك، وحين تستجيب لطلبه تتعرّض للاعتقال وتُخضع للتحقيق بغية تقديم معلومات عن نشاط زوجها الثقافي، وبالتحديد المقال الذي نُشر في مجلة في ألمانيا الغربية بالتعاون مع بعض الكتّاب هناك.
تحول الوعي
إن عملية نشر المقال تطلب عملية معقدة، ومن ذلك من تهريب نوع معين من الآلات الكاتبة، ما يضطرهم إلى إخفائها بالشقة، غير أن الزوجة تحت الضغط تنهار لتكشف عن ذلك، غير أن ما يُفاجئ المشاهد هو ما بدأ من تحوّل في وعي المراقب الذي يقوم بالتخلص من الدليل، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الأداء المذهل للممثل الذي استطاع من خلاله، أن يجمع بين شعورين: الصرامة البوليسية والهشاشة الإنسانية في آنٍ واحد، فهو بطريقة أو بأخرى يتأثّر بحياة الكاتب المسرحي، وعلاقته مع زوجته التي تعمل بوصفها عامل تأثير على هذا المراقب، في تحريك الروح الداخلية، فهو يبدو معجباً أو عاشقاً لها، أو أنه يتعلم من ضحيته أن يكون إنساناً.
وهنا أستحضر ما عبر عنه الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدة «حالة حصار» حين اختزل هذا المعنى قائلاً: «سيمتدُّ هذا الحصارُ إلى أن نعلِّم أَعداءنا نماذجَ من شِعْرنا الجاهليّ»، وبهذا يمكن بيان ذلك حين يستغلّ الفيلم نموذجاً ثنائياً لرسم حياة الخواء التي يعيشها هذا المراقب، الذي يعيش في شقة صغيرة، حيث لا أسرة، ولا امرأة، يتناول طعامه وحده ببرود، وخواء، بلا دفء، ولا روح، يمارس الحب بصورة آلية مع مومس تؤجَّر لمدّة ساعة، وحين يطلب منها البقاء تقول له إنها محجوزة، وعليه أن يدفع ثمن ساعة إضافية، أو يقوم بالحجز مسبقاً.
هكذا تتأطر حياة المراقب الذي يكتشف خواء عالمه على المستوى القيمي والإنساني والفكري، إذ يبدأ تدريجياً بالتأثّر بعوالم الكاتب المسرحي، ومن هنا تنشأ المفارقة، فعوضاً عن محاولة السيطرة على حياة المراقب تتبدل الأدوار، وتصبح عملية المراقبة درساً في معنى الإنسانية، ويمكن ملاحظة ذلك عبر تغيير تقارير التنصّت، إذ يُخفي بعض الأجزاء، فبعد أن قام بإخفاء الآلة الكاتبة في لحظة مواجهة في الشقة، التي تشكل مركزاً لبيان تقاطع حيوات الآخرين، تهرب الزوجة من الشقة عند محاولة كشف البوليس السرّي عن الآلة من تحت عتبة البيت، لحظة الهروب لا تعني سوى ذلك الانكسار، مع الوعي بالعار تجاه لا خيانة الزوج من الوزير، وقبول فعل الابتزاز فحسب، بل إنها تتجاوز ذلك لهروبها من عار خيانة من تحب عندما قامت بالإخبار عنه، فتخرج إلى الشارع، فتواجه سيارة شحن تدهسها مباشرة، ومن ثم يخرج المراقب فيشاهد موت الممثلة بين يدي زوجها، وهي تحاول الاعتذار له، في حين أن البوليس السري لا يجد الآلة الكاتبة، وبذلك تنتهي جميع الأدلة التي تدين الكاتب، ولا يبقى سوى اعتذار بارد من رجال البوليس السري.
نتيجة لما حصل يُبرأ الكاتب من التهمة أو الخيانة، لنرى بعد سنوات قليلة، وتحديداً سنة 1990 سقوط جدار برلين، وتوحد ألمانيا، ومن ثم يسعى الكاتب لمعرفة حيثيات الموضوع، من خلال مراجعة أرشيف البوليس السرّي الذي يُجمع في ملفات كبيرة باسم عملية «لازلو»، ومن خلال هذه الملفات يكتشف أن المراقب الذي قد كُلّف بمهمته قد أسهم في إخفاء الأدلة، وقد نتج عن تأديب عقابي بأن يقبع لسنوات في القبو يقوم بمهمة فتح الرسائل بالبخار للمراقبة، وتقديراً لهذا الدور يقوم الكاتب المسرحي بكتابة نص، أو كتاب عن هذه التجربة، وحين يعثر المراقب السرّي بالصدفة على الكتاب في إعلان إحدى واجهات المكتبة يجد على الصفحة الأولى كلاما موجها له، أو بالتحديد لاسمه المستعار الذي يكون : ( )
إنّ قيمة الفيلم تكمن لا في عمق رسالته، وحساسيتها، إنما بجماليات متقنة على صعيد تكوين الحبكة السردية، بالتوازي مع القدرة على الإيفاء بواقعية الحقبة الباردة بتفاصيلها كافة، ولكن يأتي هذا أيضاً بالتجاور مع القدرة على خلق أجواء أو مناخات النموذج الشرقي الاشتراكي في ألمانيا الشرقية، وسطوة مفهوم المراقبة الذي شكّل جزءاً من منظومة هذه الفترة، وقدرة النظام على تشكيل حيوات الآخرين، والتلاعب بها على مستوى الوعي، وتقديم الولاء للدولة، مع الإحالة على دور الثقافة، وحساسية ما يكمن فيها من أثر على تشكيل الوعي بالذات، التي ينبغي أن تتلاشى مقابل المفهوم الأيديولوجي، ودينامية القمع البوليسي، ومع ذلك فلا بد من نقد يقين ينهض على توجيهات أيديولوجية تنهض بمنظور الغرب، الذي يبقى عالقاً في ذاكرة التمركز على مفهومه الخاص بمعنى الحرية، وأنه يشكل ملاذاً للأحرار، ومعنى الديمقراطية، ولكن هذا يبقى جزءاً من صورة مبتورة للغرب، الذي يبدو انتقائياً على مستوى القيم، ومتناقضا تجاه ممارساته الأخرى مع شعوب العالم، ما يعني نمطاً من ازدواجية المعايير، ناهيك من تكوين سردية سلبية تجاه النمط المخالف، وتجاهل أي قيم أخرى.
أحادية المنظور
لا شك أن المنظور الذي يعيد إنتاجه الغرب، على أنه يمثّل نموذجاً للحرية، ولكن ذلك يبقى رهيناً بالجغرافيا الغربية على مستوى الفرد، ناهيك من أنه من أكبر منتجي، أو داعمي الديكتاتوريات في العالم، وعليه فإن الغرب يصوغ حيوات الآخرين، ولكن الآخرين هنا من يكمنون خارج حدود الوعي الغربي، وثقافة الجغرافيا.
على الرغم من كل ذلك، فإن الفيلم يحيلنا إلى جزئية جمالية تُعنى بالتلقي، لا بمفهومه التقني النظري، والمعني بالثقافة النقدية، ولكن نعني تلقي حيوات الآخرين في سياقات شديدة التعقيد، فالمراقب الذي شكّل نموذجاً للتحوّل والانقلاب العميق على المستوى الأيديولوجي، لم يكن سوى إجراء خارجي، غير أن الأهم التحول الإنساني، ولاسيما حين اختبر عُمق ما يكمن في حيوات الكاتب المسرحي وزوجته وأصدقائه نتيجة المراقبة المستمرة، أو على مدار الساعة، فمن خلال ذلك أدرك فراغ عالمه، والحقيقة الكامنة من الوجود التي تتأطر بالحب الذي فقده، وهو يعاني من عمى الوفاء المطلق للمؤسسة الأمنية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الفيلم يعتني بتقديم لوحات لحيوات الشخصيات، بدءاً من حياة الكاتب المسرحي، ووفاة زوجته، وصديق الكاتب الذي انتحر، ووزير الثقافة، وأخيراً حياة المخبر أو المراقب، لنتحصل من خلال ذلك على سياق هجائي واضح للنموذج الشمولي الذي حاربه الغرب أثناء الحرب الباردة، وما يكمن فيه من مآلات عنيفة، ومؤلمة.
كاتب أردني فلسطيني