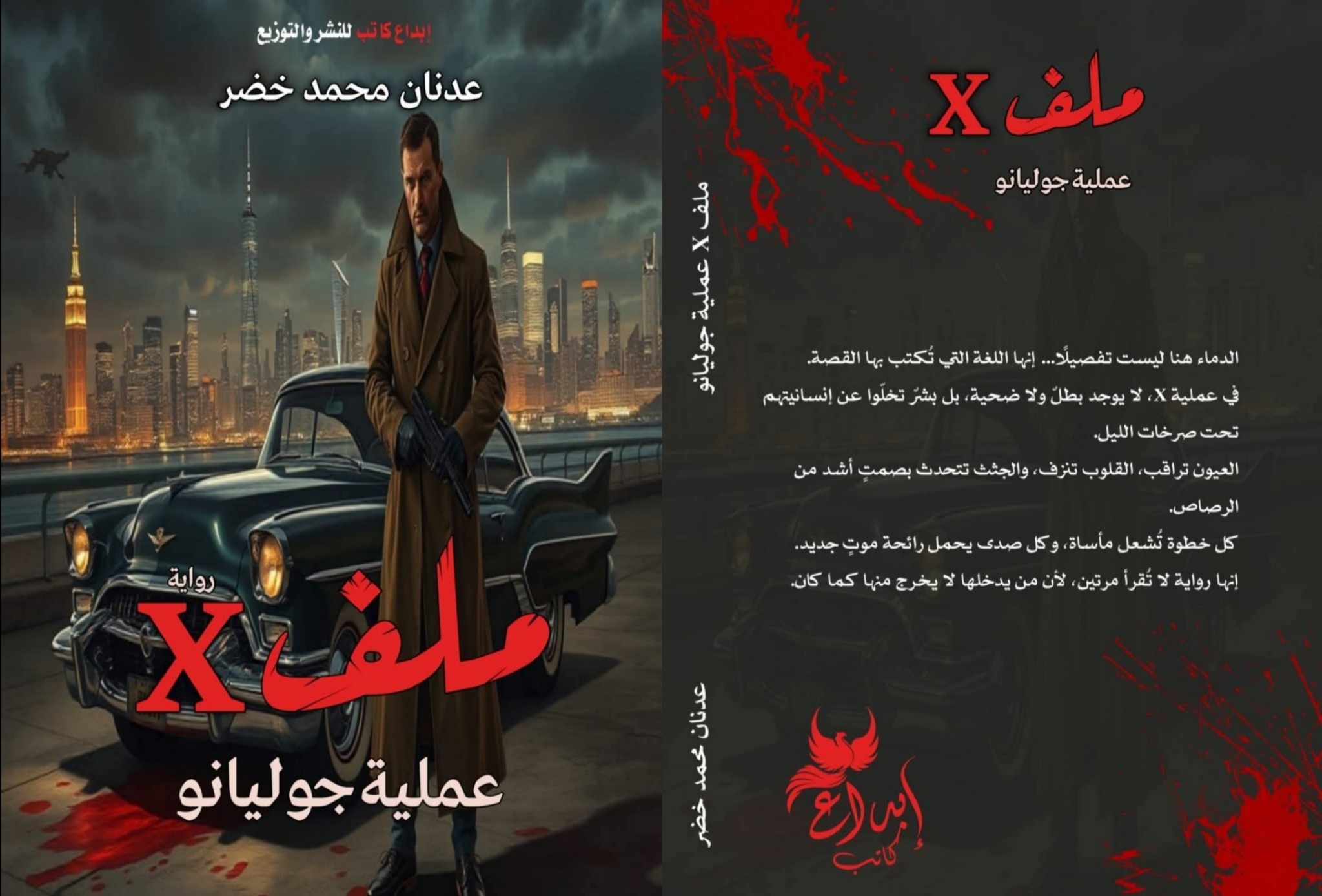الحقيقة والرواية: تأملات في خيانة اللغة وتواطؤ التكنولوجيا

عبير النجار
في قلب العاصفة الإعلامية التي تحيط بغزة، تبرز معضلة العصر: تحويل الوقائع الدامية إلى مجرد «روايات» قابلة للنقاش. فالحقيقة الصحافية تقتضي التحقق أولاً من التجويع الممنهج، والتهجير القسري – تلك الوقائع التي لا تحتمل التأويل. لكننا نعيش زمناً صارت فيه آلة التضليل الإسرائيلية (الهاسبارا)، المدعومة بتقنيات حديثة، تجيد تحويل الجرائم إلى «وجهات نظر».
الحقيقةُ تُبنى على الوقائع القابلة للإثبات، لا على التأويلات أو السرديات. ففي الصحافة الجادة تبدأ العملية بالتحقق من الوقائع أولاً، ثم يأتي دور النقاش حول تفسيرها أو تأطيرها عبر تحليل اللغة والخطاب حول التأويل والتفسير والتأطير، الذي يتم إنتاجه ضمن المادة الإخبارية، ويمكن تحليله بدراسة اللغة المستخدمة وبنية الخطاب اللغوي، أو متعدد الوسائط وقيمته بشكل عام. لكننا اليوم وفي إطار ما يسمى بعصر وسياسات ما بعد الحقيقة، نواجه تشويهاً وطمساً ممنهجين للحقيقة، لقد سبق الفلسطينيون العالم في اختبار عصر «ما بعد الحقيقة»، فالإبادة حقيقة كما أن النكبة حقيقة والاحتلال حقيقة وسياسات الفصل العنصري حقيقة، وليست رواية سياسية تقابلها روايات أخرى. هذا الانزياح اللغوي ليس بريئاً، بل هو بوابة لتقليل فظاعة الإبادة الجارية، وتمهيد الطريق لقبول الرواية الإسرائيلية كبديل «شرعي» للحقيقة.
من الروايات إلى الحقائق: في اختزال الإبادة إلى سرديات سياسية

من هنا يجدر بنا التوقف عن استخدام تعبيرات «الرواية الفلسطينية» و«السردية» في أحاديثنا ومنشوراتنا، وبالذات في نقاشاتنا عن الفلسطينيين في زمن الإبادة، فالإبادة حقيقة قائمة على الوقائع الموضوعية والقابلة للتثبت منها، كما هو استخدام إسرائيل لسلاح التجويع وإرهاب الدولة في التهجير القسري في غزة، إن استخدام مصطلحات مثل «السردية»، أو «الصوت» بدلا من «الحقائق» في نقاشتنا وتحليلاتنا الإعلامية والمعرفية، ليس مجرد سوء تعبير عن الواقع، وإنما قصور في فهمه والتعاطي الفاعل معه. من المفهوم أن يتجه بعض منا لتجنب استخدام تعبير الإبادة، أو تقديم نفسه على أنه يمثل وجهة النظر، أو الرواية الفلسطينية لكي يتمكن من الحديث، أو النشر وبالذات أننا نعي مقدار التضييق علي نقد إسرائيل وسياستها ليس فقط في الاعلام والمؤسسات الفكرية، وانما في النشر الأكاديمي ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن ذلك – التنازل الذي قد يبدو بسيطا مقابل وصول الحقيقة- يساهم في تغذية وتعزيز فهم سائد وفحواه أن ما يحصل مع الفلسطينيين هو حلقة جديدة في رواية سياسية لها رواية مقابلة وليس حقائق مثبتة.
حراس البوابة الجدد: تحولات الرقابة من البشر إلى الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي
إن سقوط النظام الدولي الليبرالي، والنظام الأخلاقي والحقوقي العالمي، على أعتاب غزة هو حقيقة قابلة للتثبت، والمضحك المبكي هنا هو أن يواجه منتقدو السقوط الأخلاقي والسياسي والقانوني والإعلامي المدوي جيوشاً من الرقباء، هؤلاء الرقباء لم يعودوا بشراً فقط، بل أصبحوا خليطاً من البشر والروبوتات والبرمجيات الذكية، في دراسات الإعلام، كان يطلق عليهم سابقاً «حراس البوابة» – وهم محررو الصحف والمنصات، الذين يتحكمون بالمحتوى، لكنهم اليوم لم يعودوا مجرد أفراد، بل تحولوا إلى منظومة معقدة يصعب تتبع قراراتها وآليات عملها، هذا الواقع يناقض تماماً توقعات مبشري التكنولوجيا من الباحثين والخبراء، فقد بالغ هؤلاء في تقدير الآثار الإيجابية للبيئة التكنولوجية المعقدة، توقعوا أنها ستعزز جودة المعرفة وتدعم حركات التحرر وتقوي الديمقراطية والعدالة الإعلامية، لكن المفارقة أن قوة الرقباء تضاعفت مئات المرات، بينما تضاءلت الحريات. فمن كان يواجه حراس بوابة الصحيفة أو بوابة الدوريات الأكاديمية من مجالس تحرير، أصبح الآن يواجه بوابات وأنظمة أقل ما يقال فيها أنها أكثر تركيبا، وأعلى فاعلية وأقل شفافية. فالمحرر الصحافي أو مجلس التحرير، انضم اليه عدد كبير من الجيوش الإلكترونية من الروبوتات وبرامج الحجب الآلي التي تحجب باستخدام منع النشر عن طريق الخوارزميات، أو بتشتيت الانتباه أو بالإغراق بالمعلومات المتناقضة التي تضعف من ظهور ومكانة أي نص بغض النظر عن حقيقية طروحاته، أو معقوليتها، أو واقعيتها، أو قوتها الدليلية أو البراهين التي تساق في إطار إثباتها.
هذه الإيكولوجية الإخبارية والمعرفية، ليست مؤامرة كبرى ضد الحقيقة، أو جودة المعرفة المتاحة، ومقدار حقيقية الحوارات التي تجري، وإنما نتاج لآلة تكنولوجية واستراتيجية ضخمة ومكلفة، يتكاتف فيها أباطرة التكنولوجيا مع ديكتاتوريات المال والأعمال الممولة لآلات التضليل وشعبويات مجدية ماليا، فالحقيقة وإنتاجها غير مربحة وغير محبذة في عصر ما بعد الحقيقة، كما يقال أو عصر طوفانات المشاعر والآراء وتراجع الوقائع والمعرفة الجيدة.
إن استخدام تعبيرات الرواية في نقاشاتنا عن الإبادة تخفّف من فظاعة الجريمة، وتحوّلها إلى مجرد خلاف في الروايات السياسية، التي تعزز تعميم فهم للإبادة يضعها ضمن سلسلة من دوائر العنف بين طرفين في نزاع، هذا الفهم يحجب الحقيقة الساطعة عن التطهير العرقي والوحشية الماثلة أمام أعيننا ويشعرنا باعتيادية المشهد ويضعف من حافزيتنا وقدرتنا على التعبئة والاستنفار لوقفها، ويمرر تبرير الرقابة المفروضة على النشر تحت مسميات الحياد الصحافي وضرورة إبراز وجهتي النظر. إن مجرد استخدام تعبيرات مثل «حرب غزة»، أو الحرب على غزة، هي تعبيرات مضللة، كما هي تعبيرات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يتم صبغ الموقف بوجود طرفين في صراع مغفلا حقائق بديهية وهي، الاحتلال والإبادة والنكبة، إن أحد هذين الطرفين هو أقوى بمئات المرات من الطرف الآخر الذي يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية عن المعاناة التي خاضها الطرفان، لأنها نتيجة لاعتداءاته وجرائمه، فالقاعدة الأخلاقية أنه لا مسؤولية دون قوة. علينا رفض لغة التضليل والإصرار على تحري الدقة في المفردات المفصلية، أن نتمسك بتسمية الجرائم بأسمائها: احتلال، إبادة، فصل عنصري.
لغة التضليل: تموت الحقيقة عندما تصبح الجرائم «وجهات نظر» في هذا المشهد الكابوسي، تبرز مهمة الصحافي والناشط والأكاديمي في الإصرار على تسمية الأشياء بأسمائها. فـ»الصراع» هو احتلال، و»الحرب» هي إبادة، و»الخِلاف» هو فصل عنصري. اللغة هنا ليست محايدة، والحياد في وجه الجريمة هو تواطؤ. فكما أن الجماجم في غزة لا تحتمل التأويل، كذلك يجب أن تكون الكلمات التي تصفها: واضحة، صادمة، وغير قابلة للمساومة.
كاتبة أردنية