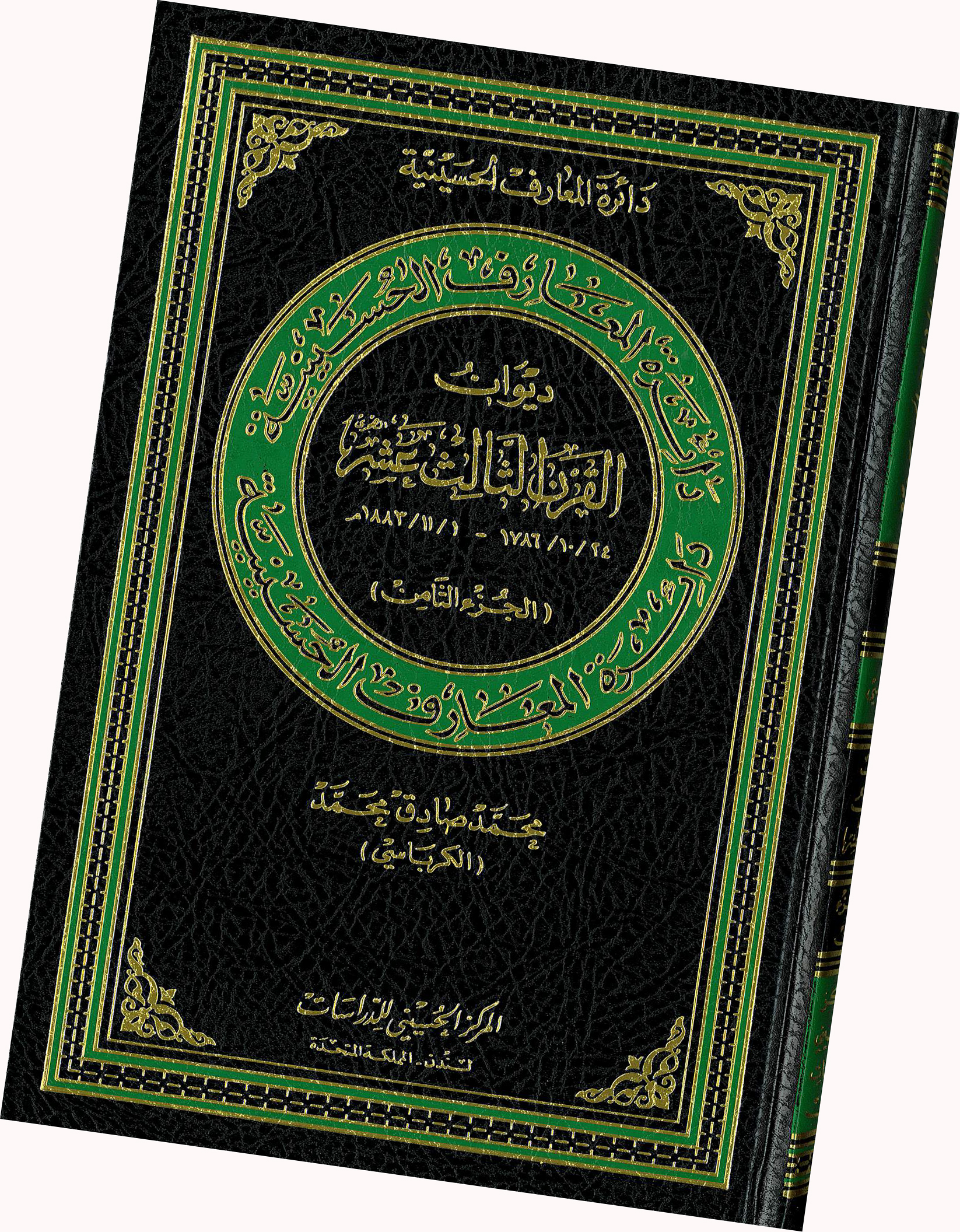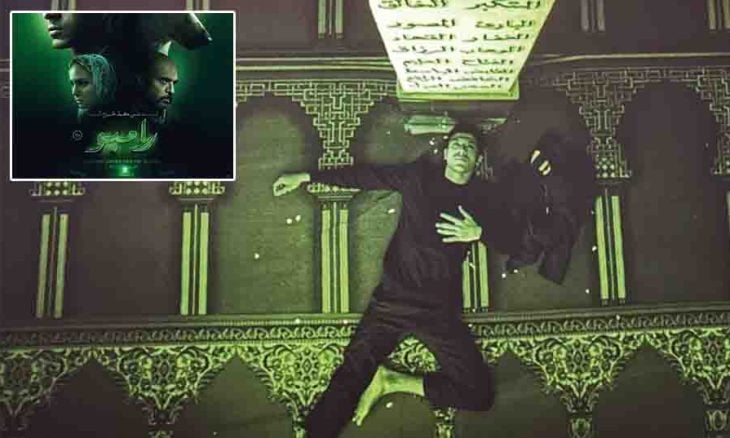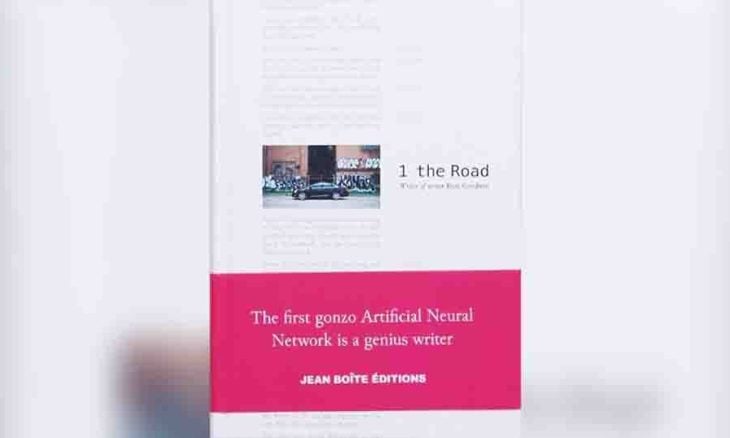سوريا الجديدة: ذكورة ومدن غريبة ومراكز محلية خجولة

سوريا الجديدة: ذكورة ومدن غريبة ومراكز محلية خجولة

محمد تركي الربيعو
باحث سوري متخصص بالدراسات الأنثربولوجية
عرفت سنوات الثورة السورية (2011ـ 2024) نشوء عدد من المراكز البحثية السورية، التي تأسست في الغالب في تركيا. وعلى الرغم من محاولات هذه المراكز سد الفراغ الحاصل في الحديث وتحليل ما يجري في سوريا، إلا أن ما يُسجل عليها هو بقاؤها بعيدة عن دراسة مجتمع ما بعد الثورة. فقد انشغلت هذه المراكز غالباً بتقديم «تقديرات الموقف» والدراسات الأمنية (حول إيران، داعش، النظام السوري)، فيما كانت تتقدم ببطء وبشكل خجول نحو دراسة ما حدث في المدن السورية والمجتمع.
يُعَدّ موضوع اللاجئين السوريين مثالاً واضحاً على هذا القصور. فعلى الرغم من وجود ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا، لم يخصص أي مركز دراسات سوري، قسماً منه لدراسة عالم اللاجئين، سواء في تركيا أو الأردن أو مصر أو أوروبا. وما يلفت الانتباه أنه، حتى بعد سقوط النظام، ودخول معظم هذه المراكز إلى الداخل، لا نرى الاجتماعي واليومي حاضراً على أجنداتها. وإن وُجد، فإنه غالباً ما يكون نتاجاً محدوداً، يفتقر إلى البحث الميداني. ولا يعني هذا تعميما بالضرورة، لكن من اللافت، أنه مقابل هذا القصور، كانت بعض المراكز الأوروبية تحاول سد فراغ فهم ما جرى في حياة السوريين خلال الحرب.
من بين هذه المؤسسات، يبرز المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، الذي تحوّل في سنوات ما قبل الحرب إلى ورشة بحثية مهمة عن تاريخ سوريا ومجتمعها. لكن مع اندلاع الأحداث، اضطر معظم الباحثين العاملين فيه لمغادرة البلاد، ما أفقدنا مجموعة من الأسماء المهمة، التي ساهمت في بناء تراكم معرفي وميداني كبير حول سوريا، مثل تييري بواسيه، الذي درس حلب وحماة. ميريام عبابسة (الرقة)، جان كلود دافيد (حلب) وسراب الأتاسي محررة كتاب حي الشعلان، إلى جانب عشرات الباحثين الآخرين.

ميريام عبابسة . مشاركة في تحرير الكتاب
رغم هذه الخسارة، حاول باحثو المعهد البقاء على تماس مع الشأن السوري، وغالباً ما ركزوا على عالم اللاجئين ودراسته. وقد ظهر هذا التوجه من خلال عدة مشاريع أُطلقت في بيروت مع بواسيه، أو في إسطنبول مع فرانك ميرميه، وصدر في هذا السياق عدد من الكتب والدراسات، إلا أنها، في الغالب، لم تُترجم إلى العربية، رغم وجود عشرات دور النشر السورية أيضا في تركيا مثلا.
مؤخراً، وفي إطار هذا الاهتمام، أصدر المعهد الفرنسي كتابا بعنوان «المجتمع السوري في الثورة والحرب (2011ـ2024)»، من تحرير ميريام عبابسة، وفالنتينا نابوليتانو. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات لباحثين غربيين وسوريين منهم ياسين الحاج صالح وسلام كواكبي، ويناقش قضايا تتعلق بعالم اللجوء، والمجتمع الطائفي في سوريا بعد الحرب، حالة الدروز والجغرافيا وإعادة الإعمار ماثيو ري. في هذا السياق، سأحرص في ما تبقى من المقال على الإشارة إلى ثلاث دراسات ميدانية من هذا الكتاب.
الدراسة الأولى للأنثروبولوجية شارلوت الخليلي، حول زواج اللاجئين في مدينة غازي عنتاب التركية. تلاحظ الخليلي أن مفهوم الزواج وأنماطه، تغيرا خلال الحرب. فخلافا لما كان عليه الأمر سابقا، حيث كان قسم كبير من الفتيات القادمات من الريف يتزوجن من الأقارب، أدّى النزوح إلى تغيّر في أنماط الزواج، بحيث حلّ الزواج الخارجي محلّ الداخلي. وهذه الظاهرة لا تقتصر على تركيا فقط، بل ظهرت في عدة مدن أخرى استقر فيها اللاجئون.
ففي جبل لبنان مثلا، ومن خلال تتبعنا لقصص الزواج خلال السنوات العشر الماضية، ظهر لنا أن كثيرا من الفتيات القادمات من بيئات قبلية في شمال شرق سوريا، وبسبب الاستقرار في الخارج وتأخر سن الزواج، تزوجن من شبّان من ريف طرطوس أو اللاذقية، أو حتى من عمّال مهاجرين مصريين. وهذا أمر لم يكن مألوفا خلال المئة عام الماضية من تاريخ الزواج، حيث كان الزواج يتركز داخل العشيرة، أو بين عشائر المنطقة. وترى الخليلي أن هذه التغيرات في أنماط الزواج، التي نتجت عن النزوح، شكّلت قطيعة اجتماعية ثورية. فقد أُعيد رسم التحالفات على أساس الانتماءات والأخلاقيات، لا على أساس الزواج الداخلي. كما لعب انخراط النساء في السياسة والحياة العامة، دوراً في بناء شبكات اجتماعية جديدة، أتاحت لهن لقاء الرجال الذين تزوجنهم عبر هذه المشاركات، لا من خلال العائلة.
وفي دراسة ثانية، ركزت الأنثروبولوجية فالنتينا نابوليتانو على تحوّل مفاهيم الذكورة والأنوثة داخل العائلات السورية اللاجئة في الأردن. لاحظت الباحثة أن الحرب أعادت تشكيل الذكورة نتيجة الصراع والنزوح، ما خلق فجوة واضحة بين الرؤية التقليدية للذكورة كمصدر حماية ودخل، والواقع الذي يعيشه الرجال في المنفى، خاصة في ظل البطالة والتهميش. ومن خلال مقابلاتها، لاحظت نابوليتانو أن السرديات التي قدمها الرجال السوريون غلب عليها شعور بالعجز والانحدار الاجتماعي، ما أدى إلى تغييرات كبيرة داخل الأسرة. فقد اضطر كثير من النساء إلى لعب دور الرجل في توفير الدخل، ما أدى أحيانا إلى قلب المعادلة داخل المنزل، وظهور ما تدعوه بـ»الأنوثة الجديدة». ومع انخراط النساء في المجال العام، نشأت لديهن تصورات وآراء جديدة، ليس فقط في ما يتعلق بالأسرة، بل أيضًا حول قضايا الشأن العام.
أما الدراسة الثالثة، فهي لميريام عبابسة، وتتناول الرقة الجديدة، كمدينة بسكان جدد. وعبابسة باحثة في الدراسات الحضرية، وسبق لها أن أصدرت عام 2009 كتاباً عن الرقة والحياة الاجتماعية فيها، ما يجعل دراستها الحالية امتداداً لتاريخ المدينة وتحولاتها بعد الحرب. تسجل عبابسة ملاحظتين أساسيتين في هذا السياق. الأولى، أن المدينة شهدت واحدة من أكبر عمليات النزوح، حيث فرّ قرابة ثلثي سكانها السابقين البالغ عددهم 370.000 إلى تركيا ولبنان والأردن ومناطق أخرى، ولم يعد سوى ثلثهم، وبعد خروج داعش، شهدت المدينة تحولات ديموغرافية كبيرة، حيث استقر فيها نازحون من الجزيرة، يشكلون اليوم قرابة نصف السكان. هؤلاء القادمون الجدد، الأكثر فقراً، لجأوا إلى المدينة بحثاً عن سكن رخيص، في حين عاد بعض السكان الأصليين إلى الأحياء الأقل دماراً.
وفي ظل هذه التغيرات، اضطر العديد من الملاك لبيع شققهم بأسعار زهيدة، في ما يشبه البيع القسري. ووفقاً لبعض سكان الرقة، فضّل مجلس الرقة المدني، التابع للقوات الكردية، توطين نازحين من محافظات أخرى، بهدف الاعتماد على سكان مطيعين يصبحون مدينين له فعليا.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بإدارة المدينة، حيث تم توكيل شيوخ العشائر بحل الخلافات بدلاً من المحاكم ومخافر الشرطة. كما تبنّت الإدارة سياسة خلق خلافات دائمة بين العشائر، لمنع تشكل قوة محلية بديلة.
ما نخلص إليه من دراسة عبابسة، أن الرقة اليوم مدينة تغير جزء كبير من سكانها وذاكرتها، تُدار من قبل مجلس عسكري/مدني، وتُحل الخلافات فيها عبر سلطات تقليدية، بالتزامن مع جماعات أهلية متحاربة. هذه التركيبة توحي بصراعات لا تنتهي حول من يملك ذاكرة المدينة، ومن يديرها، وصراعات أخرى بين الريف والمدينة. كل ذلك يجعل من المدينة السورية مكاناً قلقاً، مرشحاً للبقاء في حالة من اللااستقرار لعقود طويلة.
كاتب سوري