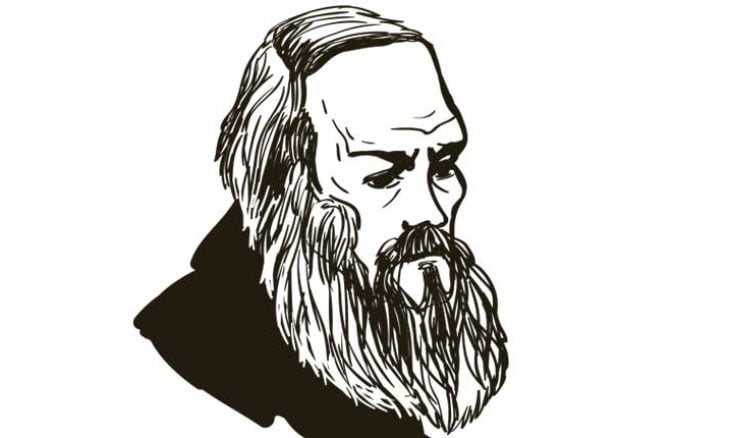مشايخ وأفندية

ثائر دوري
يقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته: «كان في مصر أيام سفري إليها مشايخ وأفندية، أزهر وجامعة، محاكم شرعية ومحاكم مدنية، يختلفان في الزي وفي التفكير وفي تقويم (لا تقييم) الحياة، يمشيان كالخطين المتوازيين، يتجاوران ولا يتلاقيان، يتكلمان بلسانين ويفكران بعقلين، فلا يكاد الشاب يفهم ما يقوله الشيخ، ولا يرتضي تفكيره، ولا كان الشيخ يعرف الطريق إلى إفهام الشاب وإثارة اهتمامه بما يفكر هو فيه.
وكانت هذه هي العلة الكبرى، وقد ظهر أفراد جمعوا طرفي الخيط ولكنهم كانوا قلائل، حاولوا أن يقربوا العلوم الجديدة، أو الفكر المعاصر من الإسلام، ومنهم من صنع ذلك باعتدال كالشيخ محمد عبده في مصر، وصاحبه السيد رشيد رضا، ومنهم من أوغل فيه حتى جانب الحق، وأفراد بلغوا الغاية في تحصيل العلوم (الجديدة) والأستاذية فيها، وكانوا على إلمام تام، أو اطلاع كاف على العلوم الإسلامية، من أظهرهم محمد أحمد الغمراوي في مصر، وأحمد حمدي الخياط في دمشق، وكلاهما من أساتذة الجامعات».
ما تحدث عنه الشيخ الطنطاوي عن الانفصال بين المشايخ والأفندية كان معضلة عثمانية، أشار لها المفكر ألبير أورتايلي: «كانت الإدارة والتربية تتغربان في تركيا بصورة لا مفر منها. ومع انعكاس التحديث على التربية، بقيت أوساط المدارس الدينية وطبقة العلماء خارج هذه العملية، وبدأت بفقدان دورها القديم المسيطر في حياة الدولة والمجتمع. وكان هذا هو الفرق المهم بين التحديث الإيراني والتحديث العثماني، فقد استطاع رجال الدين في إيران، الذين يمكن لنا أن نشبههم بطبقة الرهبان، المحافظة على مواقعهم بتلقيهم التعليم الحديث»، وهذا يشكل مفتاحاً لفهم كثير من الأمور التي جرت في بلاد الشام، خلال القرن العشرين وما زالت مفاعيلها مستمرة حتى اليوم. كانت عملية «التحديث» في الدولة العثمانية تغريبية بحتة، وتمت على طريقة «مفتاح في اليد»، حيث تتولى الشركة المتعهدة إنشاء المصنع من البناء إلى التجهيز، ثم تسلم مفتاح المصنع ليد الحكومة المعنية، وهذه الطريقة لا تؤدي إلى تراكم أي خبرة فنية في البلد الذي أُنشئ فيه المصنع، بل يظهر وكأنه زرع زرعاً في أرض غريبة. أما المجتمع التقليدي، فقد بقي على حاله دون أن يتأثر بالحداثة، ومن هذه اللحظة بدأ ينشأ داخل الدولة العثمانية مجتمعان متوازيان.
كان المجتمع التقليدي ينتج نخبه (رجال دين وفقه ولغة) بواسطة التعليم في الكتاتيب والمدارس الملحقة بالمساجد، أو عبر التعليم العائلي، أو بواسطة المؤسسات الأرقى مثل الأزهر، دون إدخال العلوم الحديثة مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، لكن بعد منتصف القرن التاسع عشر دخلت المدارس التبشيرية (الأمريكية في البداية، ثم لحقتها باقي الطوائف) إلى عملية التعليم العثمانية، فأنشأت مدارس ومعاهد حديثة على الطريقة الغربية، في البداية بيد غربية، كما في الإرسالية الأمريكية، التي افتتحت عدداً كبيراً من المدارس في بلاد الشام بشكل خاص، وكذلك الطوائف الكاثوليكية، أو بيد أبناء البلد بعد أن انخرطت الطائفة الأرثوذكسية بالعملية التعليمية، خشية على رعيتها من التبشير البروتستانتي. وهذا أدى إلى نظامين لتخريج النخب في الدولة العثمانية، النظام التقليدي الذي يعتمد على دراسة الفقه واللغة وعلومها وآدابها في الكتاتيب، أو في الحلقات الملحقة بالمساجد، أو داخل العائلة، ثم في المدرسة الرسمية التركية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وهذا النظام التعليمي يُخّرج مثقفاً تقليدياً، بمرجعية عربية إسلامية.
أما النوع الثاني فهو النظام «الحديث»، الذي يماثل المدرسة الأوروبية في مناهجه العلمية من الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء، وتعليم اللغات الأوروبية، خاصة الفرنسية والإنكليزية، ويقدم للطلاب رؤية استشراقية للكون إما بشكل مباشر، أو موارب، رؤية تقوم على احتقار الإسلام، واعتباره مصدر التخلف، واعتبار الإسلام عاصفة هوجاء هبت من جزيرة العرب وأدت إلى إطفاء نار الحضارة في كل من بلاد الشام والرافدين. كما تركز مناهج التاريخ على الحضارات السابقة للإسلام محاولة تحويلها إلى هوية حضارية، ففي لبنان هناك الفينيقية وفي مصر الفرعونية، إلخ.
أدت هذه العملية إلى نشوء نوعين من المثقفين في الدولة العثمانية هما: المثقف التقليدي المتعلم بالطريقة التقليدية، ويختص باللغة والدين والفقه (الشيخ)، ومرجعيته الحضارية عربية ـ إسلامية، والمثقف «الحديث» (الأفندي) الذي تعلم في المدارس الحديثة التابعة للإرساليات التبشيرية، ويختص بالعلوم الحديثة كالطب والهندسة والحقوق، وهو على اطلاع على الثقافة الغربية واللغات الأجنبية، ومرجعيته الحضارية غربية. وبالتالي نشأ شرخ في المجتمع العثماني، وتكونت منذ اللحظة الأولى لهذا الانقسام بوادر انشقاق خطيرة بين مجتمع تقليدي مرجعيته الحضارية عربية ـ إسلامية، ومجتمع «حديث» مرجعيته الحضارية غربية. وكان هذا الانقسام يحمل خطورة مرفوعة إلى أس كبير في بلاد الشام، بسبب التنوع الديني والطائفي، فقد تراكب فوق الشرخ الثقافي ـ الحضاري، بين مثقف تقليدي ومثقف «حديث»، بين مجتمع تقليدي ومجتمع «حديث».
تراكبت خطوط الانقسام الديني والطائفي، ومن ثم تحولت خطوط الانقسام الثقافية إلى خطوط انقسام طائفية، لأن «الحداثة» في بلاد الشام دخلت عبر مدارس الإرساليات التبشيرية والدينية، التي حددت كل منها الفئة المستهدفة لها، فالمدارس الأرثوذكسية اختصت بالأرثوذكس، والكاثوليكية بالكاثوليك، أما البروتستانتية الأمريكية فاتجهت نحو التبشير في أوساط الطوائف الإسلامية غير السنية (العلويين، الدروز)، وفي أوساط الطوائف المسيحية الأخرى (الأرثوذكس، الكاثوليك)، لعدم وجود طائفة بروتستانتية أصلاً. وبالتالي فإن الحداثة الغربية اختصت في البداية بالمسيحيين، ثم بأبناء الأٌقليات الإسلامية. وترافق ذلك مع ما سمي بالمسألة الشرقية وحماية الأقليات، حيث بسطت كل دولة غربية حمايتها على أقلية دينية أو طائفية كما هو معروف. أما المسلمون السنة الذين يشكلون أغلبية السكان فقد استمروا بتلقي التعليم بطريقة تقليدية في الكتاتيب، أو في المدارس الملحقة بالمساجد، ثم لاحقاً في المدارس الرسمية العثمانية، فبقيت مرجعيتهم الحضارية عربية ـ إسلامية، وبقوا سياسياً مواطنين عثمانيين قبل أن تلتحق نخبهم بالمدارس التبشيرية أيضاً، ونادراً ما كنت تجد طالباً مسيحياً خارج مدرسة طائفته، ويذكر يوسف الحكيم في مذكراته أن والده أصر على إلحاقه وأخيه بالمدرسة الرسمية العثمانية، لضمان مستقبلهم في الوظيفة الحكومية، لكن ذلك كان موضع استغراب القائمين على الطائفة الأرثوذكسية في اللاذقية، وجرت محاولات كثيرة لتغيير موقف الأب وإقناعه بوجوب التحاق أبنائه بمدرسة الطائفة!
أما ما يتحدث عنه الشيخ الطنطاوي عن الالتقاء بين المشايخ والأفندية، فقد تم بواسطة أفراد محدودين وبجهود فردية، وحتى اليوم لم يتحول إلى مؤسسة قادرة على إنتاج نخب بأعداد كبيرة تمزج بين التراث والحضارة المعاصرة.
كاتب سوري