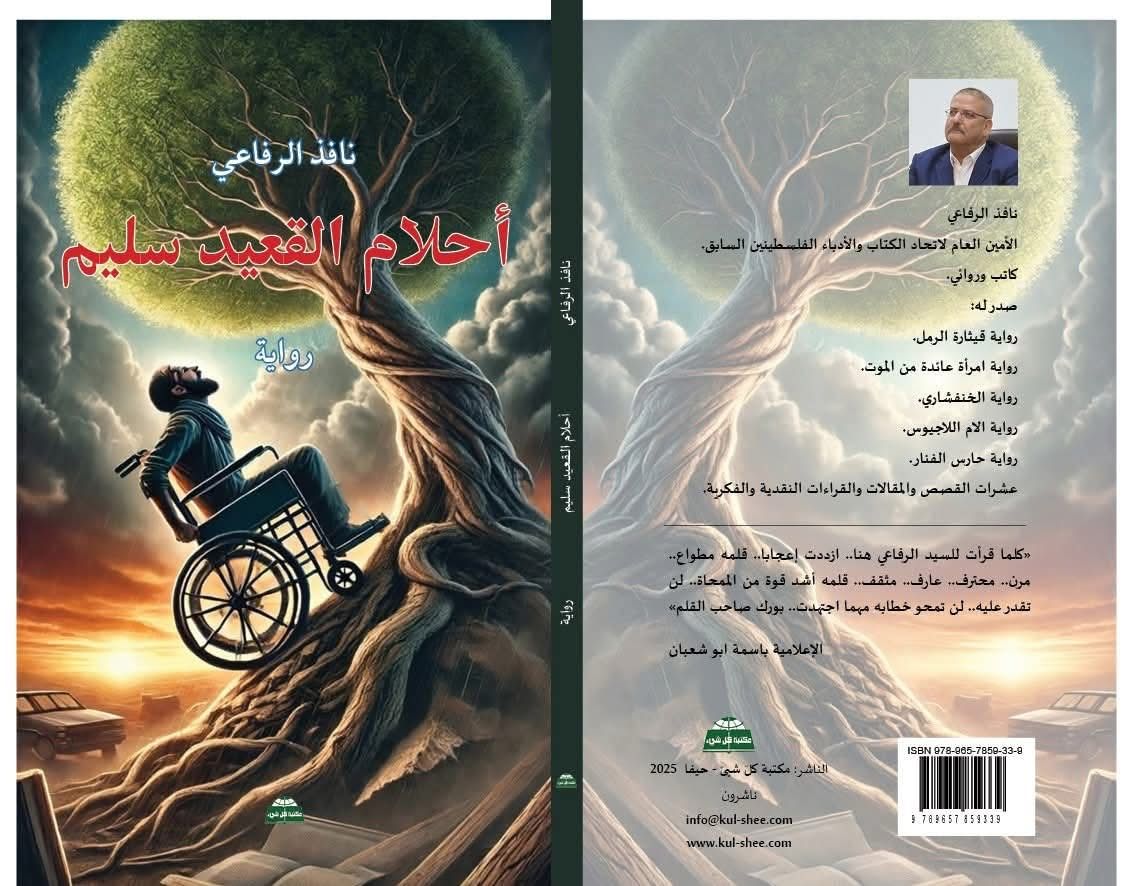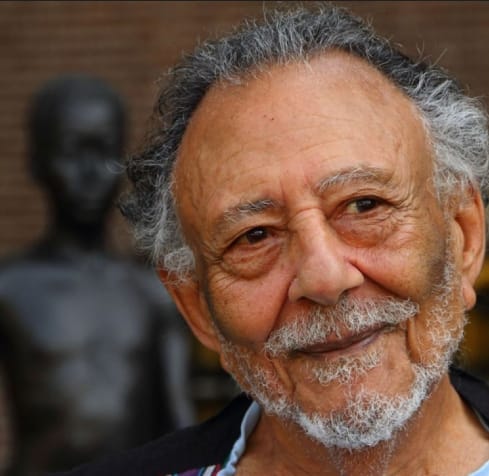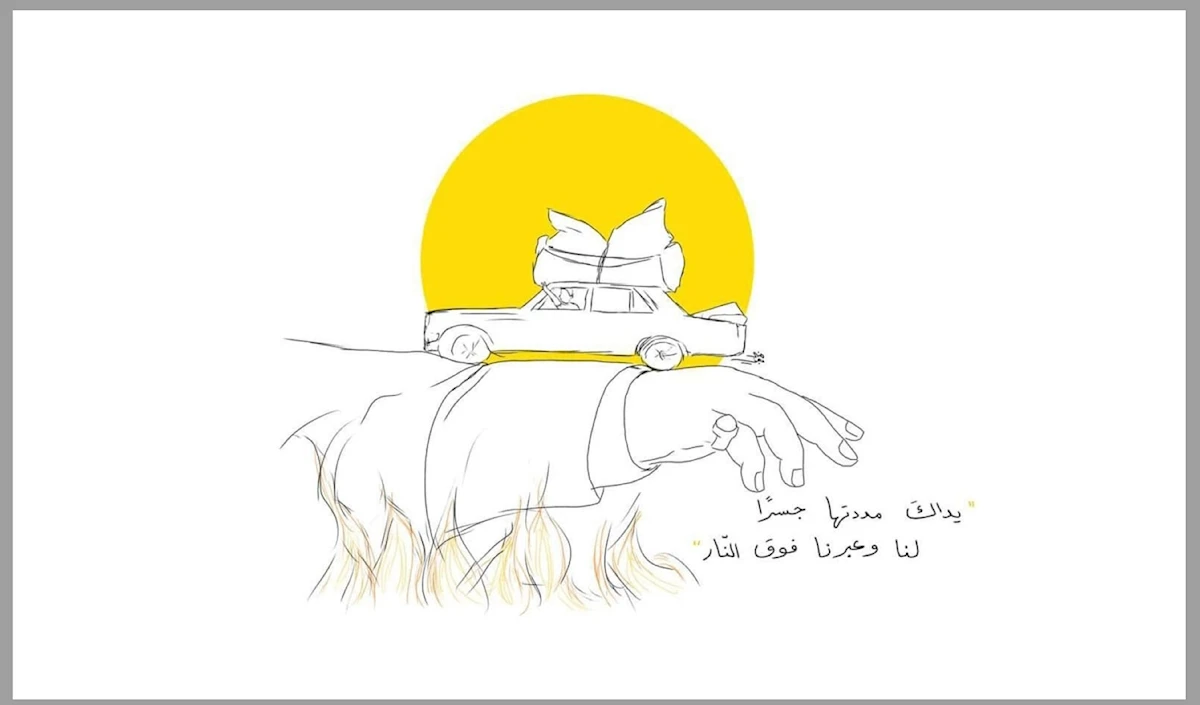اليوم أكملت لكم دينكم: بنية السردية الخاتمية في الخطاب القرآني

اليوم أكملت لكم دينكم: بنية السردية الخاتمية في الخطاب القرآني
محمد سعيد احجيوج
تشكل الآية الثالثة من سورة المائدة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينا) نقطة التتويج في مشروع سردي استثنائي يتجاوز حدود الخطاب الديني التقليدي، ليؤسس لنظام دلالي شامل يعيد تشكيل الذاكرة الدينية للإنسانية. إذ يمثل هذا الإعلان الذروة الدرامية لما يمكن وصفه بالملحمة الكونية للوحي، حيث تتضافر آليات السرد المتنوعة مع استراتيجيات الهيمنة الثقافية لتنتج خطابا يحتكر تفسير التاريخ الروحي للبشرية، ويغلق أفق التطور الديني إلى الأبد.
يتأسس الخطاب القرآني على نظام سردي يتبنى استراتيجية الاحتواء التصحيحي. فالنص يتحرك عبر محاور زمنية متعددة، يستوعب التراث الديني السابق، ويعيد صياغته ضمن إطار أوسع، مقدما نفسه كخاتمة حتمية لسلسلة متصلة من رسالات الوحي الإلهي، محققا بذلك مكاسب هائلة من خلال تحويل الأديان السابقة إلى مجرد مقدمات ناقصة للحقيقة الكاملة التي يحملها الإسلام، مما يجعل كل تراث ديني سابق جزءا من سرديته الخاصة.
تتركز البنية السردية للخطاب القرآني على فكرة جوهرية هي العودة إلى الأصل الصحيح. يتجاوز هذا المبدأ الدلالة الدينية المباشرة ليصير آلية سردية تعيد تنظيم التاريخ الروحي للبشرية. يظهر الخطاب القرآن كمصحح كوني يحمل مهمة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد انحرافات تاريخية متراكمة، وهو في هذا السياق لا يكتفي بالتعامل مع اليهودية والمسيحية فحسب، بل يمتد ليشمل تراثا دينيا أوسع يلّمح إلى بعضه ذكرا عابرا (مثل الصابئة) ويأخذ من الآخر دون ذكره (مثل الزرادشتية) يستوعب منها جميعها في إطار ما جاءت به الآية 164 من سورة النساء (ورُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾، يتم استيعابها ضمن تصنيف الرسالات السماوية، وفي الآن نفسه يتم نفيها من جهة أنها نسيت أو حرّفت.
تتجلى هذه الآلية في معالجة القرآن لقصص الأنبياء السابقين، حيث تُعاد صياغة شخصياتهم ورسائلهم ضمن إطار التوحيد المحمدي. موسى وعيسى وإبراهيم، وغيرهم من الأنبياء والرسل، يُقدمون كمسلمين، مما يجعلهم أسلافا روحيين لأمة القرآن. ﴿ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيّا وَلا نَصْرَانِيّا وَلَـٰكِن كانَ حَنِيفا مُّسْلِما ۗ وَما كانَ مِنَ المُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران، الآية 67]، ﴿وَوَصّىٰ بِها إِبْرٰهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البقرة، الآية 132]. يحقق هذا التحول السردي عملية تأميم شاملة للتاريخ الديني، حيث تصبح جميع التقاليد الروحية إرهاصات أولية لظهور الإسلام، الذي يمثل الصورة الكاملة والنهائية والنقية للدين الإلهي.
نقطة قوة الخطاب القرآني بهذا الخصوص هي اعتماد الفصل الرمزي بين الأصل الإلهي والتحريف البشري. يسمح هذا الأسلوب بالحفاظ على قدسية مصدر الوحي مع رفض التجليات التاريخية المعاصرة له. فالتوراة والإنجيل والصحف والمزامير، وغيرها مما نعلم ومما لا نعلم، يُعترف بها كوحي إلهي أصيل، لكن النسخ المتداولة تُعتبر محرفة. هذا الفصل يحقق توازنا دقيقا بين الاستيعاب والتمايز، ويمنح الخطاب القرآني سلطة تأويلية استثنائية كونه المرجع الوحيد القادر على التمييز بين الأصل والتحريف، وهو النص الوحيد غير قابل للتحريف؛ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر، الآية 9].
إن هذه السلطة التأويلية تتجاوز حدود النقد التاريخي لتصبح هيمنة معرفية شاملة. فالقرآن يقدم نفسه نصا يحتوي جميع النصوص السابقة ويتجاوزها، مما يجعله المرجع الأعلى لتفسير أي تراث ديني. هذا المنطق السردي يؤدي إلى نتيجة حتمية: أي محاولة لفهم التاريخ الديني خارج الإطار القرآني تصبح ناقصة أو منحرفة، وأي اجتهاد يتجاوز حدود النص القرآني، بصفته النص الخاتم، يصبح بدعة وضلالة.
وهنا يبرز مفهوم «ختم النبوة» بصفته آلية للإغلاق السردي الكوني. فباستثناء المانوية، التي يربطها فقهاء الإسلام ربطا محكما بالزندقة، والتي ادّعت هي الأخرى أنها التكميل النهائي والتصحيح الأخير لجميع الأديان، فإن الأديان السابقة تركت أفقها مفتوحا على احتمالات مستقبلية (اليهودية تترقب المسيح المخلص وكذلك الزرادشتية من قبلها، والمسيحية تنتظر نزول ابن الله، إلخ.)، أما القرآن فينتهج عملية إغلاق جذرية لهذا الأفق، ويحول التاريخ الديني من مسار مفتوح قابل للتطور إلى خط وصل منتهاه واكتملت معالمه، مما يحقق احتكارا أبديا للحوار بين السماء والأرض.
يتجلى امتياز هذه الآلية في قدرتها على تحويل الخاتمية إلى ضمانة أبدية لاستمرارية النظام الدلالي القرآني. فكل وحي مستقبلي يصبح مستحيلا بحكم التعريف، وكل تطور ديني يتحول إلى انحراف عن الأصل الثابت؛ بدعة وضلالة. يؤسس هذا المنطق لنظام فكري مغلق يرفض التجديد الجذري ويحصر الاجتهاد، إن سمح به، في إطار ضيق يخدم استمرارية البنية الأساسية للخطاب.
تعبّر آية «اليوم أكملت لكم دينكم» عن لحظة فاصلة تمثل، سرديا، لحظة الاكتمال الدرامي. إنها نقطة التحول الأساسية في السرد، حيث تتضافر جميع العناصر السردية السابقة لتصل إلى ذروتها الطبيعية. يكتنز الاكتمال هنا دلالات متعددة: فهو اكتمال في المحتوى (هو المرجع الذي يصحح الفهم المنحرف) واكتمال في البنية (هو الذي يستعيد دين الفطرة الأصلي الذي بُعث به كل الأنبياء) واكتمال في الزمن (هو الكلمة الأخيرة التي تُغلق باب السرد). هذا التمام يتحقق من خلال منهج يعتمد الاستيعاب لكل التراث السابق والتجاوز لكل النقص السابق والختام لكل الاحتمالات المستقبلية.
يتبنى القرآن أولا مفهوما للزمن يمكن وصفه بالزمن الدوري، حيث يُقدم التاريخ الديني كسلسلة من الدورات المتكررة: إرسال نبي، تبليغ الرسالة، انحراف الأمة، إرسال نبي جديد. هذا النمط الدوري يخلق إيقاعا سرديا يربط بين الماضي والحاضر، ويجعل كل نبي امتدادا طبيعيا لسلسلة متصلة من الوحي. لكن هذا النمط يتحطم مع مجيء محمد كخاتم النبيين، فيتغير مفهوم الزمن وتتوقف الدورة وتصل إلى نهايتها الحتمية، مما يحول الزمن من دوري إلى خطي مُنجز وصل نهايته.
تتجلى قوة الخطاب القرآني في قدرته على إنتاج نوع متميز من الهيمنة الثقافية يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، وفق آليات تشمل إعادة تفسير التاريخ والسيطرة على المستقبل وإنتاج نظام دلالي شامل يفسر الوجود والكون والإنسان من منظور واحد متماسك. يظهر هذا بوضوح في معالجة القرآن للتراث الإبراهيمي، حيث يُقدم إبراهيم كمسلم وحنيف يمثل الأصل الصحيح للتوحيد، مما يجعل اليهودية والمسيحية تطورات لاحقة ومنحرفة لأصل إسلامي خالص.
من خلال ذلك يعتمد القرآن على الاستيعاب والتجاوز، معا. فهو يستوعب التراث الديني السابق من خلال الاعتراف بأصوله الإلهية، ويتجاوزه من خلال تقديم نسخة مصححة ومكتملة منه، فيكتسب الخطاب القرآني مرونة استثنائية في التعامل مع الأديان الأخرى، حيث يستطيع الاستفادة من رصيدها الروحي دون التقيد بحدودها أو تناقضاتها.
يتمحور الخطاب القرآني حول رمزية مركزية هي الكتاب، حيث تتجاوز هذه الرمزية الدلالة الحرفية لتصبح استعارة كونية للمعرفة والهداية. فالكون نفسه يُقدم ككتاب مفتوح يحمل آيات الله، والقرآن يُقدم ككتاب مبين يفسر هذه الآيات الكونية. تتطور هذه الرمزية عبر مراحل تاريخية متعددة: التوراة ككتاب أول، والإنجيل ككتاب ثان، والقرآن ككتاب خاتم، مما يخلق هرمية رمزية تضع القرآن في قمة الهرم كالكتاب الذي يحتوي جميع الكتب السابقة ويتجاوزها. يعترف بوجودها وبأصلها الإلهي لكنه يصر على زيف نسخها المتداولة، ووحده القرآن يبقى نقيا من التحريف، وممثلا مستوعبا شاملا لكل ما سبق.
يعتمد القرآن كذلك على فكرة الأمة الوسط، وهي تصور يضع الأمة الإسلامية في مركز الكون الروحي. هي فكرة تجمع بين الامتياز والمسؤولية، حيث تتمتع الأمة الإسلامية بامتياز كونها خير أمة أخرجت للناس، وتحمل مسؤولية كونها شاهدة على الناس. هذا التموضع المركزي يبرر الهيمنة الثقافية والسياسية للمسلمين، ويجعل من مقاومة هذه الهيمنة مقاومة للإرادة الإلهية ذاتها.
لكن هذا الخطاب، أو النظام السردي، يحمل في طياته بذور جموده. فالاكتمال الذي يعلنه القرآن يتحول في الممارسة التاريخية إلى إغلاق لأفق التفكير النقدي والاجتهاد الحر. مفهوم البدعة يصبح سيفا مسلطا على رقبة كل محاولة للتجديد أو إعادة النظر، حيث يُعتبر كل خروج عن النص الخاتم ضلالة وانحرافا، وخروجا عن الملة.
إن نجاح الخطاب القرآني في إنتاج هذا النوع من الهيمنة يمكن قياسه من خلال أثره العميق في الوعي الجمعي للمسلمين، حيث نجح في إنتاج نظام مرجعي شامل يحكم تصورات المسلمين للتاريخ والمستقبل، للذات والآخر، للحق والباطل. نظام ثابت لا يمكن اختراقه بأي شكل من الأشكال.
تأتي آية «اليوم أكملت لكم دينكم» لتكون لحظة فاصلة في تاريخ الخطاب الديني، حيث يعلن النص القرآني عن اكتمال مشروعه السردي، ومتجاوزا الدلالة الدينية المباشرة ليصبح إنجازا أدبيا وثقافيا استثنائيا يؤسس عالما دلاليا متكاملا يطبق على الماضي والحاضر والمستقبل، ويقدم تفسيرا شاملا للوجود والمعنى، ويصير هو التمظهر الأسمى للحقيقة.
لكن هذا الإنجاز الاستثنائي يحمل في طياته مأزقا جوهريا يتمثل في تحوله من نظام لإنتاج المعنى إلى نظام لاحتكار المعنى. فالكمال الذي يعلنه النص يتحول ضمنيا إلى جمود فكري يرفض التجديد ويعتبر كل خروج عن النصِ الخاتَمِ بدعة وضلالة. النتيجة الحتمية هي تجميد الفكر الديني والثقافي داخل إطار مغلق، واعتبار أي نقد أو محاولة تجديد تهديدا للنظام الدلالي القائم. مما يجعل من هذا المقال نفسه بدعة وضلالة تستحق الرفض والإدانة.
لكن، هل يمكن أصلا التجديد من داخل الدين؟