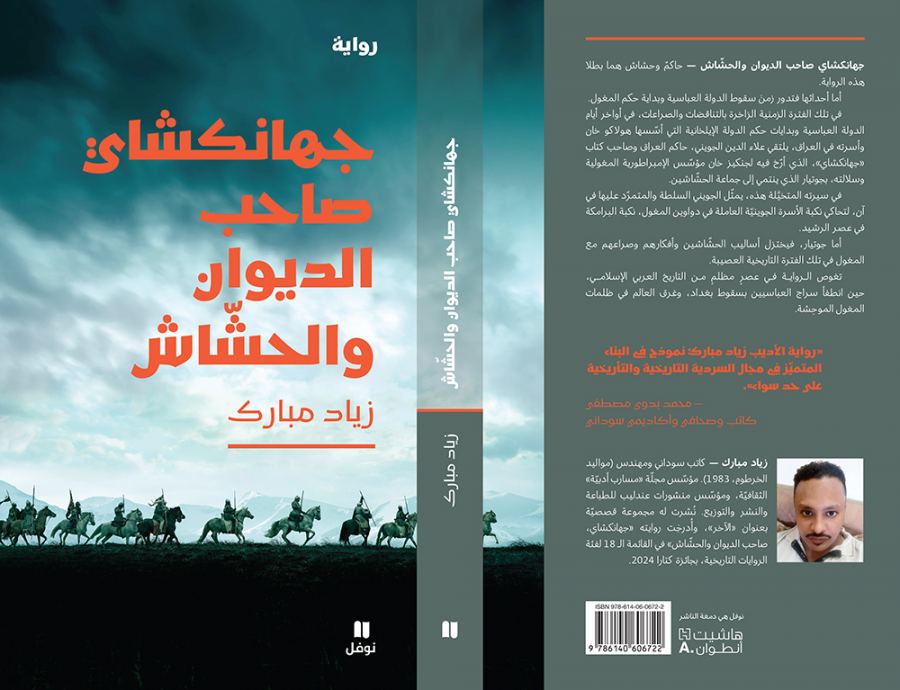الحكي ومركزية الأنثى الساردة

علي حسن الفواز
هل يمكن لـ«الكتابة النسوية» أن تراهن على صناعة مركزية سردية للأنوثة، مقابل ما هو تاريخي في المركزية الأنثروبولوجية للذكورة؟ وهل يمكن الادعاء بأن شطارة ومكر الراوية شهرزاد، كانت الخرق الإطاري المؤسِس في تقويض مركزية السرد؟
أحسب أن هذين السؤالين يمكن أن يكونا مدخلا للحديث عن سرديات الخرق، وعن التمثيل المفارق لهما في تقويض مركزية الراوي/ الراوية، وأن يقترحا للجدل حولهما سياقا ثقافيا، تعنى به الدراسات الثقافية، والدراسات السردية، وبكل ما يثار حولهما من الإشكالات النقدية التي علقت بالسرد العربي، وبميثولوجيا غياب «المؤلف» الأصلي عن كثير من هذه السرود، لاسيما حكايات الليالي، حتى بدت «البطلة الحكّاءة» وكأنها هي «المؤلف الرئيسي»، رغم أن وجودها ليس بعيدا عن السلطة، ولا عن الذاكرة والسير والأخبار، فهي ابنة الوزير، أي أنها داخل نسق السلطة، لكن ما قامت به من وظيفة فارقة تحوّلت الى اصطناع «سردية مضادة» للسلطة، حيث كان مركزها مهددا مع كل ليلة، ومع كل حكاية، لاسيما وأن كثيرا من أبطالها شخصيات غامضة، معارضة وثورية وصعاليك وهامشيون، وبعضهم يعيشون أزمة الخيانة الجنسية، وهذا ما أعطى للحكي نوعا من الخرق، والإيهام بالإشباع، فلا تاريخ محددا لأحداثها، ولا لعوالمها الغامرة بالميثولوجيا والأساطير والخرافات، إذ بدت وكأنها وحدات لا زمنية، سوى ما تعتاش عليه تلك الشخصيات، عبر وظائف السفر والبحث عن العفاريت، وعبر ما تؤديه من المكر والشطارة العيارة، وهي تمثلات، ليست بعيدة عن الحمولة السياسية، حدّ أن بعضها يوحي بما هو مسكوت عنه، في الإشارة إلى زمن سياسي معارض انخرطت فيه جماعات سياسية معروفة مثل، «الشطار والعيارين والحشاشين وغيرهم»، وحتى التوظيف الأنثروبولوجي للجنس والهوية والعادات والأفكار، ظل فاعلا برمزيته داخل السرد، وعبر الوظائف المولدة، التي يؤدي فيها وظائف السرد الموازي، أو المتقاطع مع الواقع، وأن ما يجمعهما هي لعبة الحكي، وطبيعة الوظائف التي تتغذى عبر فاعلية المتخيل السردي، وعبر ثيمة البحث عن الغائب السياسي والجنسي..
التخيّل السردي هو الوظيفة الجامعة التي تؤدي من خلاله الشخصيات أدوارها، عبر التمثيل وعبر خرق المألوف، وعبر أن تكون تلك الوظائف جاذبة ومثيرة ودافعة للفضول، على مستوى تمثيل الغائب، وتحريك سرديات «البحث عنه والتفكير فيه، وتحمّل المشاق للوصول إليه»، كما في الحكايات والقصص القديمة، وعلى مستوى تحويل السرد، مجالا للاختباء داخل السرد ذاته، وبقصد ممارسة الاحتيال على التاريخ والسلطة.
لقد اهتم السرد بهذا التخيل، فجعله مشغولا بتمثيل المتعدد والمختلف من مستويات الصراع، وتمثيل الشخصيات في حكاياته، عبر استدعاء سرديات الاعتراف والجنس والتلصص، وعلى نحوٍ اعطى للسرد وظيفة فائقة، جعلت منه وكأنه الترياق السيميائي والتمثيلي لفكرة الحرية، ولما يتصل بها من شيفرات الإفصاح عن الرغبات والإيحاءات، وعمّا يتبدّى منها عبر رهانات اللغة، في سياق تحويل التخيل إلى وظيفة فنية، أو في سياق اصطناع «هوية متخيلة» تحتفي بالذات الأنثوية، كنظير تعويضي للاحتفاء بـ»الجسد الأنثوي» الغامر بإكراهات التابو والممنوع والمحجوب..
الجسد وغواية السرد
الجسد الأنثوي ليس لغزا، بقدر ما هو كينونة مخفية، وهذا الإخفاء في بنيات الحكي، أو بيوت اللذة، أو أجنحة الحريم، كثيرا ما يتحول إلى «مجال أيديولوجي» يرتبط بالسلطة والمقدس والهيمنة والامتلاك، وباتجاه يعطى لخرقه قوة متعالية، لها بعدها الرمزي، من خلال توصيف تمثلها لسلطة المكان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أو من خلال خضوعها للعنف الرمزي، أو الجنسي، الذي تصنعه الحروب والغزوات والصراعات الأهلية، التي تجعل من فكرة خرق «بيت الحريم» وكأنه الخرق المتعالي لرمزية السلطة ولتابواتها وسريتها. ما قرأناه في كتب «الروض العاطر في نزهة الخاطر» للشيخ محمد النفزاوي، و»نزهة الألباب في ما لا يوجد في كتاب» لشهاب الدين أحمد التيفاشي، يضع الحديث عن أطروحات الجنس في «السرديات العربية» أمام مقاربة تربط بين السرد بوصفه الحكائي، وبين ما تواتر في الأخبار والنوادر والأشعار، وكل ما له توصيف أيروتيكي يدخل في سياق الحديث عن أنواع الجنس/ النكاح، وعن علاقة ذلك بمعاني المتعة والشهوة وما ورد منها في بعض أشعار العرب..
هذه الحكايات وغيرها ليست بعيدة عمّا ورد من حكايات في النسخ القديمة لـ»ألف ليلة وليلة»، التي أعطت للجنس مساحة كبيرة، تتماهى مع طبيعة الحكاية الإطارية القائمة على فكرة «الخطيئة الجنسية»، وعلى علاقتها بالمسكوت عنه، وهو ما جعل هذه الفكرة محورا مهما في تشكيل سمات «مجتمع السرد الجنسي» الذي تحوّل إلى خزّان سردي له «كنوزه» وحمولاته، الهمَ كثيرا من الروائيين العرب، واستثار مخيلتهم للتعاطي مع ثيمة الغائب، والمقموع، والسري، ومع موضوعات الجنس والجنوسة والأنوثة، حتى بدا شبح شهرزاد المخفي وكأنه يتسلل إلى «المتخيلات السردية» عبر أقنعة بطلات، أو حكاءات، يملكن من المراوغة والمكر، ما يملكنه من سرود تتشهى البحث عن الذات الأنثوية عبر الجسد، وعبر ما تصنعه اللغة من إحالات نفسية ورمزية وحتى سيميائية.
الجسد وتمثلات الكتابة
رغم أهمية اللغة في تشكيل العلاقة مع الهوية، إلا أن الجسد في «السردية العربية» يظل فكرة إشكالية، تثير حولها كثيرا من اللغط والجدل، بوصف الجسد يحتفظ برمزيته عبر المقدس والمُحرّم، وعبر علاقته بالسلطة، وبالسياق الذي يستدعي لها خطابا تتكرّس فيها متعاليات نصية، وقيم تاريخية، وذوات مقموعة، أو «مخصية» بدلالة تقويض مركزية الفحولة داخل منظومة السلطة، وفي بيوت حريمها، ليظل الجسد محتفظا بنقائضه، وبتمثلاته، فهذا «الجسد حين يدخل عالم الكتابة، ينفلت من معناه المعجمي المنغلق، إلى دلالات احتمالية مضاعفة، يفرضها السياق وتفرضها القرائن المصاحبة المنفتحة على قنوات محايثة للجسد، تحقّق الاستبطان والتمثّل من كون الأشياء، كما تتحوّل أعضاء الجسد إلى كائنات حبلى بالتحوّلات الدّلالية المتشعّبة الّتي تغني السّرد وتشحنه بالخصب والنّماء» (الأخضر بن السايح/ سرد الجسد وغواية اللغة- قراءة في حركية السرد الأنثوي وتجربة المعنى).
لقد أسهمت الرواية العربية في تقديم نماذج نمطية، وأخرى مفارقة لـ»الأنثى» بوصفها مفهوما، أو بوصفها رهانا لتمثيل فكرة البحث عن الهوية، أو لتمثيل وجودها في إطار الجنوسة والعلاقة مع الآخر، فتوزعت هذه التمثلات بين تقديم أضحويتها، والتعرّف على خذلانها الاجتماعي والطبقي ورمزيتها السياسية والنفسية، وبالاتجاه الذي جعل هذا التوزع كاشفا عن تعقيدات العلاقة السيميائية بين الجسد واللغة، أو بين النص المكتوب، وإحالاته النفسية، فكثير من الروايات كشفت عن تمثلات السرد للأنثروبولوجيا الاجتماعية، وللتحولات داخل الاجتماع السياسي والثقافي، وأحسب أن روايات نجيب محفوظ في توظيفها لموضوع الأنثى كشف عن الصراع الموازي لما هو اجتماعي وسياسي، فالسيد في الثلاثية لا يعيش عقدة «الشهريار»، لكنه يتمثل ما هو تعويضي عبر رمزية البطل/ الفحل، والأنموذج السيادي للطبقة الوسطى التي تفرض سلطتها على الزوجة والبنات، وعلى الأولاد عبر إخصائهم العاطفي، مقابل تغوله في الاستبداد الجنسي.
وفي روايات أحلام مستغانمي «نجد صور متعددة للأنثى، فالحضور الشهرزادي لها يكتسب بعدا وجوديا من خلال لعبة التمثيل السردي، حيث يكشف عمّا يشبه المفارقة، التي تصنعها الرواية، من خلال وظيفة الأنثى الحكاءة، التي تجد في الجسد فضاء رمزيا، ليس للإيحاء بالجنسي، بقدر ما هو تمثيل للوجودي، عبر البحث عن الذات والهوية، وعن أنموذج الرجل المهزوم من الحرب، والثورة والحلم إلى واقع مأزوم، تتحول فيه الخيبة الوجودية إلى خيبة جنسية، وإلى عجز في تمثيله الرمزي والإشباعي. في ثلاثية «ذاكرة الجسد»، و»فوضى الحواس»، و»عابر سرير» تحضر لعبة السرد بوصفها مجالا سيميائيا، يجد في شيفرات الجسد والحواس والسرير إحالات نفسية، وسياسية، لها نسقها المضمر في تمثيل أزمة الهوية، وسؤال الأنثى التي تبحث عن الغائب، مثلما تبحث عن الإشباع، وعن مواجهة الفقد بوصفه معادلا رمزيا للفقد التاريخي والسياسي.
وفي روايات حنان الشيخ، يبدو الجسد والاغتراب وتشوه الهوية من أكثر الموضوعات حساسية إزاء فكرة التمرد، بوصفه توقا لوعي بالذات، وشغفا بالبحث عن هويته، من خلال وعي عقدة الحرية، عبر الجنس، وعبر العلاقة مع الآخر، لكن هذا الوعي يبقى إشكاليا في سياق مقاربته لما تصنعه اللعبة السردية، فتتبدى عقدته الوجودية من خلال حساسيته إزاء الاغتراب والضياع، حتى تبدو الثيمة الجنسوية وكأنها الثيمة التعويضية التي تتغذّى عبر أوهام تلك الحرية، وعبر ما تمثله من إشباعات رمزية، يرتهن فيها الجسد إلى شراهة اللغة، وإلى البحث عن الحبيب، بوصفه القوة التي تواجه الفقد، فتجعل من نكوص الجسد رهينا بما يصنعه من تمرد، مثلما تجعل من تقويض الهوية رهينة بتقوّضات السلطة ومركزيات الأب والوصايا والسيرة. ففي روايتها «حكاية زهرة» و»حكايتي شرح يطول» و»إنها لندن يا عزيزي» و»عين الطاووس»، يتبدى الاغتراب عن المكان بوصفه عتبة تأسيسية للوعي القلق، ولمواجهة محنة الوجود، من خلال محنة الجسد والغياب والعاطفة الشوهاء، حدّ أن موضوعاتها تتشظى، بوصفها تمثيلا لحكايات ساردة عن محنة ذاتها الباحثة عن وعي لوجودها، وعن هوية أنوثتها الباحثة عن حكاية موازية..
الروائية علوية صبح من أكثر الروائيات اهتماما بموضوع الجسد، إذ تتجاوز وظيفته الاجتماعية لتجعله أكثر تمثيلا للتحول، في سياقه الجنسي والسياسي والقيمي، حد أن موضوع «الهوية» الإشكالي يتحول إلى رهان وجودي لتمثيل الذات القلقة، فتعيش عبر محنتها العاطفية والرمزية، بما يجعل هذا العيش الغرائبي، مقابلا لمحنة الواقع العربي، وصراعاته، وإكراهات تحولاته الكارثية في السياسة وفي الأيديولوجيا، وبما يجعل روايتها تبدو وكأنها رثاء للجسد والمكان والهوية، ففي روايتها «دنيا» و»مريم الحكايا» و»اسمه الغرام» و»ن تعشق الحياة» لا نجد سوى «ذوات أنثوية» مأزومة، تعيش انهياراتها النفسية والسياسة عبر انهيار وجودها في المكان، إذ تحضر «الحرب الأهلية اللبنانية»، كمدخل للحديث عن العنف المركب، الذي اقترن بالحروب الأهلية، وبمحنة الإرهاب السلفي، حيث تتحول في اللغة السردية وكأنها تكتب رثاءاتها الوجودية للذات الأنثوية الخارجة من التاريخ إلى داخل رهاب الأيديولوجيا والجماعة..
كاتب عراقي