
مدائنُ البَددِ
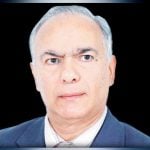
رشيد المومني
لقد أمست محارق الفتك، ومجازر الإبادة المعربدة في قطاع غزة، أداة محورية لفضح مدونات كاملة من الأكاذيب «الحضارية « و»الإنسانية» التي دأب المنتظم الدولي على تعميمها لعدة عقود خلت، إيهاما بجدواها بوصفها، درعنا الواقي لما يتهدد حياتنا البشرية من انتهاكات مادية ورمزية.
إذ بموجب هذا الفضح، ستكون المنتديات الفلسفية والقانونية، مدعوة أكثر من أي وقت مضى، لإعادة النظر في خطاباتها ومفاهيمها المرقطة كالعادة بأوهام التنوير ومشتقاته، عبر الاشتغال على تعرية ما يمور في باطنها من همجية القتل وعدوانيته. كما أنها ستكون فرصة سانحة ، لتسليط المزيد من الضوء، على بؤس جغرافيتنا البشرية السعيدة، بامتدادها العبثي من شرق المتوسط إلى غرب الشمال الافريقي، دون أن تستشعر أي عقدة ذنب أخلاقي، تجاه الإبادة الممارسة بآلية التجويع والتعطيش، من قبل الاحتلال الصهيوني، في حق فلسطينيي غزة، رغم أنهم على مرمى لقمة مغمسة بالدم، من موائدها المتخمة بما لذَّ وطاب من لذائذ النهم والشره.
وفي اعتقادنا أن الأحداث الجسام التي يحدث أن تعصف بمصائر الشعوب، هي المحك الفعلي الذي يمكن اعتماده في اختبار ذهنياتها وطبائعها، بما ظهر منها وما خفي. وليس ثمة في تصورنا من فاجعة أشد هولا مما هو دائر الآن في القطاع، الكفيلة برفع اللبس عن ظاهرة الصمت المريب، الذي ينهش ألسنة الحال، من مستهل شرق المتوسط إلى آخر نقطة في غرب الشمال الافريقي. وكما هو واضح وبالملموس، فإن استعانتنا بمرارة وجسامة الفجيعة، في محاولة فهم ما قل من طوية هذه الجغرافية البشرية، يعود إلى عجز أجيال متتالية من الباحثين والمفكرين، عن إدراك أسرار انطوائها المستفز على ذواتها، المصابة بكل ما يمكن أن يتبادر للذهن من أعطاب ثقافية وحضارية. وهي بالمناسبة ظاهرة على درجة هائلة من التعقيد والغرابة، التي يقف المرء حائرا أمام دلالة تمنعها على التحليل والتفسير، حيث لا يخرج منها عدا بالنزر القليل من الخلاصات المبتسرة، التي لا تغني ولا تسمن من جوع، في زمن يشكو من تفاقم القحط الفكري والمعرفي. وفي اعتقادي أننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتجريب طرائق جديدة للبحث والسؤال، علَّنا نتخلص ولو موقتا من سلطة المقاربات المتداولة، التي تجد في الفتور الغامض المستبد في ذات هذه الجغرافيا، مجالها النموذجي لتنشيط آلية اشتغالها، كما هو الشأن بالنسبة للمقاربات المؤدلجة، ذات المرجعية المادية، أو القومجية، أو تلك المعززة بمفاهيمها الفلسفية القائمة على التعدد والتعارض والاختلاف، بصرف النظر عن انتمائها للفكر التنويري بشقه التراثي الإسلامي، أو لإبدالاته المحيلة على مرجعيات الحداثة الغربية.
وفي تصورنا أن أفق هذه المقاربات، ينحصر أساسا في استثمار المعطيات الكفيلة بتسويق خطاباتها، دون أن تكون معنية باستجلاء الحقائق الموضوعية المتعلقة بهوية هذه الجغرافيا. بمعنى أن إنتاج الخطابات الفكرية المتمحورة حول واقع الشعوب الموجودة في فضاءات الخريطة الممتدة من شرق المتوسط إلى غربه، ليس سوى ذريعة لمراكمة المزيد من الأطاريح والمقولات، الكفيلة باستقطاب القراء المتطلعين إلى استكناه حقائق البؤس المهيمن على كيانهم. وبقدر ما تتنامى وتتناسل هذه الخطابات وهذه الأطاريح، بقدر ما يتضاعف غموض والتباس جوهر الموضوع المعنِيِّ بالمقارنة، ليحتفظ باحتجابه هناك، في تلك المنطقة المعتمة، والعصية على الفهم والتفسير.
فرض واقع التعايش بين الفرقاء على أرضية الحد الأدنى من التفاهم، هو الإطار المركزي، التي تضمن به الأجهزة الحاكمة إمكانية بقائها واستمراريتها، من خلال تحديدها المسبق والممنهج، للأسس التي ينبغي لهذا الشتات المجتمعي أن يمارس بها تعايشه القسري.
وسيكون من الضروري في هذا السياق، المغامرة بوضع الأصبع على الجرح، بدل الانتشاء بالتضخم المتسارع لرصيد الأرشيف الفلسفي، المتمحور حول الظاهرة، الذي لا يفضي بالضرورة إلى أي خلاصات شافية ومقنعة. وليس الجرح المكشوف هنا سوى تلك الحقيقة التي لن تفلح أزمنة طويلة من الحجب المبيتة، والمدبرة بعناية فائقة في إخفائها. ونعني بها الهيمنة المأساوية لواقع التشرذم الإثني، بملحقاته اللغوية والعقدية على جغرافيتنا المترهلة، الذي يأخذ شكل طوائف، عشائر، وشيع، وفرق، وأحزاب، ومذاهب، بمجموع ما يتفرع عنها من ملل ونِحَل، هي باستمرار عرضة للتنافر والتنابذ، أكثر من قابليتها للتكامل والتفاعل. والغريب في الأمر، أن سؤال التنوع الذي يعتبر في حد ذاته أحد أهم مقومات التلاقح الحضاري والثقافي، سيتحول داخل جغرافيتنا، إلى أحد أهم العوامل المؤثرة في إذكاء نار الكراهية المتبادلة وتصعيد أسباب الخلاف، بين مكونات النسيج المجتمعي، بما هي طوائف وقبائل وعشائر، وأحزاب وهويات محكومة بعلل وعاهات الخلاف والقطيعة المتأصلة في ذاكرتها وفي لا وعيها. حيث لا يمكن أن تتعايش في ما بينها، إلا ضمن الحد الأدنى من الشروط التي يقتضيها مقام النظام المنضوية تحت سلطته.
والجدير بالذكر، أن فرض واقع التعايش بين الفرقاء على أرضية الحد الأدنى من التفاهم، هو الإطار المركزي، التي تضمن به الأجهزة الحاكمة إمكانية بقائها واستمراريتها، من خلال تحديدها المسبق والممنهج، للأسس التي ينبغي لهذا الشتات المجتمعي أن يمارس بها تعايشه القسري. وغالبا ما يُستحضر في هذا السياق، مجموع تلك الشعارات السيادية، المفعمة بنكهة قداستها الدينية أو الترابية، التي لا مجال فيها لإبداء أي وجهة نظر نقدية أو تشكيكية، من شأنها المس بقدسيتها ومصداقيتها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشعارات السيادية المكرسة من قبل الأجهزة ذاتها، غالبا ما تكون مبطنة بشحنة ردعية وترهيبية، تلزم الانتماءات الموجودة تحت ظلها، بالتنازل مؤقتا عن خصوصيتها، من أجل الانصهار القسري في خانة المقدسات ذات المنحى الجماعي، والمؤطر بقانون الوحدة السيادية.
يتعلق الأمر إذن والحالة هذه بأزمة فصام قاسية ومستعصية تنخر نسيجا مجتمعيا يمتد من الماء إلى الماء، وقد أمسى موزعا بين قانون الوفاء اللامشروط لقداسة الانتماء الشخصي الخاص بالطائفة /العشيرة/ القبيلة /الحزب /العرق، وقانون الوفاء للقداسة العامة، المشَرْعنة من قبل الجهاز الحاكم، ما يفضي إلى إحداث شرخ عميق بين القداسة والقداسة، ثم بين التكتل والتكتل. كما يؤدي إلى إنتاج ذوات مصابة باختلالات سيكولوجية، يمتد تأثيرها القوي إلى مجمل الوظائف الحسية والفكرية والسلوكية المنوطة بالذات، ما يجعلنا بصدد بنيات مجتمعية ، منشغلة أساسا بتدبير أمر أعطابها الشخصية، حيث ليس للآخرين سوى أن يذهبوا للجحيم. وبالتالي، لن يكون ممكنا الجمع بين المقدس الخاص بالهوية الشخصية/ القبيلة /الطائفة /الحزب، ومقدس تمليه ضرورة الوجود تحت راية النظام، فضلا عن مقدس محايث، قد تمليه علاقة جوار ما.
هكذا ونتيجة ذلك، يستمر هذا الواقع المأساوي في الفتك بكل الأواصر المحتملة، التي يمكن أن يعززها التواصل الثقافي والإنساني، بغية توفير الحد الأعلى، وليس الأدنى من شروط الانتماء إلى جغرافية مشتركة، هي الآن ممتدة شرقا وغربا، دونما هدف واضح ومعلوم.
أيضا، هكذا سينحرف التعدد العرقي والثقافي والعقدي عن مساراته المستقبلية، كي يتألق في تفجير المزيد من الأحقاد الدفينة، حيث تلقي الأجهزة المتحكمة بثقل كلكلها الكريه، على نبض كل مبادرة، من شأنها إيقاظ العقول من سباتها الأبدي، ما يفسح المجال وبالمعروف، أمام كل بقعة جغرافية وهوياتية، كي تستقل بكامل حقها في اختيار صيغة قتلها المحتمل، بعيدا عن عيون الفضوليين، قصفا، تجويعا، أو تعطيشا.
شاعر من المغرب







