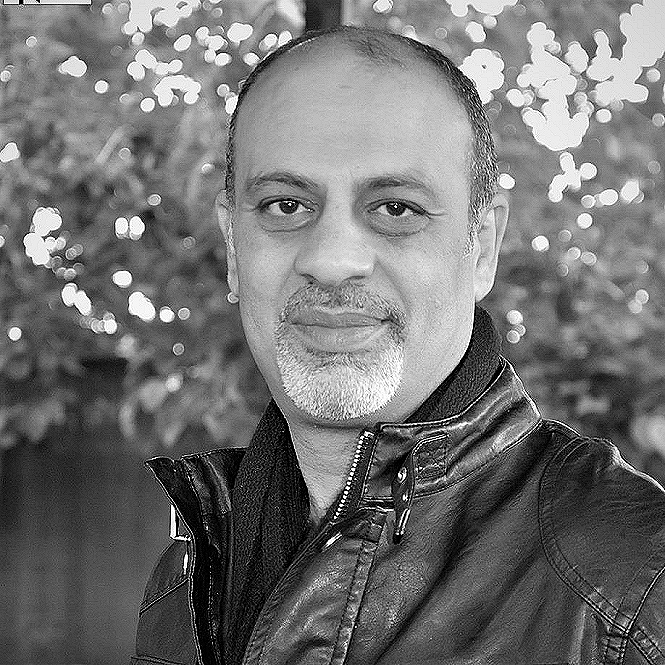خذلان الأمّة لأهل غزة: هل من سبيل للخروج؟!

خذلان الأمّة لأهل غزة: هل من سبيل للخروج؟!
معين الرفاعي
إن كان صحيحاً أن مستوى الإجرام الذي يستهدف قطاع غزة غير مسبوق، وهو صحيح بلا أدنى شك، فإنّ الصحيح أيضاً أن مستوى تخاذل الأمّة، أنظمة وشعوباً ومؤسسات ونخباً، عن نصر غزة وأهلها، أمر قد يكون غير مسبوق في تاريخ العرب والمسلمين كذلك؛ ما دفع الناطقين باسم المقاومة، وكذلك في بياناتها، إلى الحديث، وعلى غير العادة، عن «خذلان» الأمّة ووضعها في موضع الخصومة أمام الله يوم القيامة! وبهذا، يصبح البحث في أمر هذا التخاذل، والتعرّف إلى أسبابه، ومحاولة سبر سبل علاجه، أمراً ملحاً وضرورياً، ليس لأجل غزة فقط، بل أيضاً لما يشير إليه هذا الوضع لمستقبل الأمّة جمعاء.
لا شك في وجود جملة من الأسباب وراء وصول الأمّة العربية والإسلامية إلى هذا المستوى من الخذلان، أبرزها:
الأنظمة السياسية الاستبدادية، التي تخشى من تصاعد أي حراك شعبي، وموجة التطبيع، التي حصلت بموجبها بعض الدول القطرية على بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، وضعف الإعلام العربي، نتيجة التبعية أو الرقابة الصارمة والقمع، وشراء الذمم، وحملات الوصم بالإرهاب والتخويف من التصنيف الدولي والملاحقة القضائية، وغياب مشروع إسلامي أو قومي جامع، والانشغال بالأزمات الداخلية، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي. ولا يقل أهمية عن كل ما سبق، فقدان البوصلة الأخلاقية والإيمانية، والميل نحو الفردانية كثقافة عامة في المجتمعات العربية والإسلامية الحديثة.
أمّا بخصوص النخب الإسلامية، التي كان الرهان عليها كبيراً أكثر من غيرها من النخب الأخرى، فممّا لا شك فيه أنه يمكن الحديث عن عدد من عوامل تخاذلها، منها: الضغوط السياسية التي تتعرّض لها، والخوف من الأنظمة وقمعها، ولا سيما مع اعتبار عدد من الأنظمة الاستبدادية مجرد تأييد فلسطين معارضة وتحدٍّ يجب قمعهما، وكذلك ارتباط قسم لا بأس به من تلك النخب بالمؤسسات الرسمية وغالباً الخضوع لها، مع ميول عدد من العلماء والمشايخ إلى تبني النزعات المذهبية، أو مناهج لا تؤمن بالمقاومة، ربما تصل إلى حد تحريم العمل المقاوم وتجريمه ونزع الشرعية عنه. في حين يقبع عدد كبير من العلماء في أقبية السجون، أو تمّت تصفيتهم بطريقة أو بأخرى.
كما تعاني الحركات والأحزاب كافّة، ومنها الإسلامية، من الضغوط الدولية والإقليمية، أو الغرق في الحسابات السياسية المحلية، أو تعاني من الانقسامات الداخلية، أو الانشغال بأولويات قطرية ضيقة، أو الخشية من القمع والملاحقة، كما حدث لعدد منها في أكثر من بلد. وإضافة إلى ذلك، ونتيجة للملاحقة والاضطهاد، تنامى داخل الحركات الإسلامية اتجاهات تميل إلى البراغماتية المفرطة، مع ضعف الشعور بالمسؤولية الجماعية، وسط حالة من الاستنزاف المستمر واليأس المقيم، نتيجة التجارب التي لم تكلّل بالنجاح.
أمّا على المستوى الشعبي، ورغم الدفعة التي منحتها الثورات العربية في العقد الماضي للشعوب العربية وبدأت بإعادة بعض الثقة لديها بتحكمها بمصيرها، إلا أن إدخال تلك الثورات والشعوب العربية والمسلمة عامة في الصراعات والانقسامات الداخلية، وإرهاق عدد من شعوب المنطقة بمستنقعات من الدماء، وقمع الحريات من قبل أنظمة استبدادية تابعة للغرب ومصالحه، أدّى -كل ذلك- إلى نوع من الإرهاق الشعبي المزمن، مع ضعف في الوعي السياسي لدى عامّة الناس، نتيجة للضخ الإعلامي الممنهج الذي يحرف الحقائق ويصوب الشعوب باتجاه انقسامات داخلية وعلى رأسها الانقسامات المذهبية والعشائرية، مترافقاً مع خطاب تخويف وتوهين، عبر تضليل إعلامي ممنهج، وغياب التغطية الحقيقية والحرة والشفافة، معطوفاً على ضعف الخطاب الديني الذي يدعو إلى الوحدة، وطغيان الإعلام الذي يدعو إلى تأجيج الفتن والانقسامات، وتشويه صورة المقاومة، وأحياناً كثيرة باستخدام الدين نفسه لهذه الغاية، والتشكيك في منطلقات المقاومة ومهمتها وإنجازاتها، وسيادة ثقافة الخوف. وأضف إلى ذلك كله، غياب قيادة شعبية كاريزمية، ذات رؤية وحدوية تقدّم حلولاً للمشكلات وتستنهض روح الأمّة.
غير أنّ التدقيق والتدبّر في كل ما سبق، يوصل إلى استنتاج مهم: فالعوامل السالفة الذكر ليست هي الأسباب الحقيقية، بل هي عوارض المرض الذي اسمه الخذلان. فالعوامل الحقيقية تكمن في ثلاثية: التجزئة والتبعية والتغريب ــــــ باعتبارها نتائج الهجمة الحضارية الضارية التي شنّتها دول الاستعمار الغربي على أمّتنا، بوصفها أمّة، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. ويكفي إبراز بعض المؤشرات التي نعيشها اليوم للدلالة على هذه الأسباب.
فالكيان الإسرائيلي، الذي يشن عدوانه على أكثر من جبهة، من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، وإن كان يتعامل مع تلك الجبهات بالتقسيط العملياتي والتكتيكي، إلا أنه في صلب إستراتيجيته السياسية ودوافعه الأيديولوجية والبراغماتية يتعامل مع كل تلك الجبهات على أنها جبهة واحدة، هي جبهة الأعداء. والأعداء هنا ليست المقاومة وحدها، بل وجود شعوب وأنظمة غير خاضعة لهيمنته. لقد كان نتنياهو واضحاً جداً في حديثه عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، واعتبار نفسه أنه في مهمة دينية لإقامة «إسرائيل الكبرى».
وكان ترامب أوضح منه في حديثه عن توسيع مساحة الكيان «الصغيرة جداً» مقارنة بمحيطه. وعليه، فإن المرء لا يحتاج إلى كثير ذكاء للاستنتاج بأن مهمتَي الهيمنة والتوسع لا تصطدمان بالمقاومة وحدها، بل تقتضيان تفتيت المنطقة وإعادة تركيبها وهندستها بما يخدم هذه الأهداف.
حالة التخاذل التي وصلت إليها الأمّة تنبئ بوجود مرض مستشرٍ ينخر الأمّة جميعها. إنّ الخروج من حالة التخاذل ليس هدفه إنقاذ غزة فقط، بل إنقاذ الأمّة قبل فوات الأوان
وبهذا، فإن سعي الاحتلال إلى تقسيم سوريا، ومحاولات إجبار مصر على القبول بتهجير قطاع غزة إلى أراضيها، كممر أو كمستقر، تندرج كلها في إطار المخطط الأميركي والصهيوني لتحقيق هدفي الهيمنة والتوسع. ولن يكون الأردن وأقسام كبيرة من العراق وتركيا والسعودية، بمنأى عن هذه المطامع، ما لم يتم وضع حد لهذه الإستراتيجية وإلجامها.
تلعب التجزئة هنا لمصلحة الكيان والاستعمار الغربي في تفتيت جهود الأمة والسماح بالاستفراد بدولها وشعوبها واحداً تلو الآخر. وما لم تتكون في الأمّة قناعات وتوضع آليات لمواجهة إفرازات التجزئة، فإنّ الكيان ورعاته الغربيين، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية، سيواصلون مخططاتهم، وهم يعتقدون أن الزمن يسير لمصلحتهم.
وبالمثل، فإن حالة التبعية لصيقة بالتجزئة. فالكيانات التي نتجت من عملية التجزئة والتقسيم في منطقتنا هي كيانات هشة غير قابلة للصمود والتطور، إذ فرض التقسيم الجغرافي تقسيماً آخر باعد بين عدد السكان والمساحة والثروة، وهي عوامل ما لم تكن متوافرة في كيان ما فإن مستقبله كدولة يكون موضع شك.
ربما يكشف هذا جانباً من جوانب تدمير العراق، باعتباره الكيان العربي الوحيد الذي كان فيه عدد السكان والمساحة والثروة بنسب متوازنة تؤهله لإمكانية إقامة دولة حقيقية. وبالمثل، فإن هذا ما يفسر إصرار الغرب على فرض حصار على إيران، لما تمتلك من إمكانات تسمح لها بهامش أكبر من حرية القرار والتمرد على التبعية.
أمّا ما تبقى من كيانات، فهي إمّا متخمة بالثروات من دون قدرة على الإنتاج الحقيقي ومن دون طاقة سكانية تتيح لها نوعاً من الانعتاق أو حتى المناورة (تصريح ترامب أن السعودية لن تصمد أسبوعاً واحداً من دون دعم الجيش الأميركي، يؤكد ذلك)، أو أنها مرهقة بأعداد سكانية من دون قدرات اقتصادية (مثل مصر وباكستان وغيرهما)، أو أنها كيانات تستمر بالمعونات والمساعدات الخارجية وتتحول إلى كيانات وظيفية في إطار المخطط الغربي.
لا ينفي ما سبق حالة الارتباط العضوي بين النخب السياسية الحاكمة والمنظومة الغربية. فذلك أمر لا شك فيه. إلا أنّ تقسيم المنطقة على هذا النحو (مثال: تقسيم مصر التاريخية إلى مصر الحالية والسودان، ما أحدث فصلاً مكانياً تاماً بين السكان المكدسين في مصر والثروات المهملة في السودان)، أسّس لعوامل موضوعية لا يمكن تجاوزها إلا بالانعتاق الكامل من حالة التجزئة، ما يستوجب عقلية ونمط تفكير يقومان على ركيزة الأمّة، وليس على أساس القطريات القائمة.
أمّا التغريب، فقد شكّل الثقافة التي تحرس حالتي التجزئة والتبعية. يظنّ البعض أنّ التغريب يقتصر على وجود بعض النخب أو الأحزاب التي تتبنّى الفكر الغربي أو نمط الاستهلاك الغربي، أو يقتصر على بعض أدعياء العلمانية. غير أنّ التغريب في حقيقته يطال كل منحى من مناحي واقعنا. تكفي دراسة مقارنة بين أحوال مجتمعاتنا قبل الغزو الغربي لمنطقتنا وتقسيمها وواقعنا بعده، لتبيان مدى تغلغل التغريب في حياتنا اليومية. فقد طال التغريب جميع مناحي الحياة، من نمط الإنتاج والسوق، إلى التعليم، والقضاء، والثقافة، والعلاقات الأسرية، وحتى إلى الطموحات الفردية.
على سبيل المثال، فإنّ الإبقاء على بُعد ديني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق وغيرهما، لا يعني أنّ الشريعة هي التي تحكم، ما دام الزواج نفسه والطلاق، بل وآلية عمل المحاكم الشرعية ذاتها، تحتكم إلى أنظمة غربية في جوهرها وشكلها. وإنّ نظام التدريس في بلادنا بات مرتبطاً كلياً بالغرب، ولن تجمّله حصص مواد شرعية؛ وكذلك نمط السوق الذي أنهى آخر ما تبقى من قيم حضارية إسلامية، لن يصلحه تزيين يافطات إسلامية، أو مباحث في الحلال والحرام في المعاملات المالية.
ما لم تستعد الأمّة إدارتها لمنظومات التعليم والسوق والقضاء والأوقاف (بمعناها الإسلامي الأصيل الذي يتيح للمجتمعات إدارة شؤونها الداخلية وليس بالمعنى المتغرب الذي يجعل من الأوقاف مجرد دائرة تابعة لوزارات أخرى)، فإنها بذلك ستبقى أسيرة ومستتبعة وملحقة. وما لم تعبّر عن إرادتها وحضارتها وقيمها في إدارة أحوالها، فإنها أمّة على مشارف الانهيار، تنتظر النهاية، وفقاً لمنطق التاريخ الذي لا يرحم.
إنّ استرجاع هذه المنظومات لا يحتاج إلى أكثر من قرار جريء بإقامة منظومات شعبية خارج منظومات السلطات القمعية والمستتبعة بالغرب، ومن دون صدام معها. إنّ الجزء الأكبر من تاريخنا الإسلامي يشهد بأن المسلمين هم الذين كانوا يديرون شؤونهم الاجتماعية بعيداً من السلطات، التي كانوا يرون أنها سلطات تغلّب؛ ولهذا السبب دفع كبار أئمة أهل السنّة والجماعة حيواتهم في مواجهة تلك السلطات لكفّ أياديها عن إدارة شؤون الناس، كما حصل مع الإمام أبي حنيفة، في رفضه تولي القضاء لأبي جعفر المنصور العباسي، وحبس الإمام أحمد بن حنبل على أيدي المعتزلة، وسالت دماء الإمام مالك. ولهذا السبب ميّز الفقهاء بين مساجد عامّة المسلمين والمساجد السلطانية.
ومن أجل ذلك، تحتاج الأمّة إلى قيادة حقيقية تعيد تذكير الأمّة بماضيها، وتشخّص مكامن الخلل وتسلّط الأضواء على الحلول وتشير إلى طريق الخروج. قيادة غير فردانية، ولا تقوم على الكاريزما الشخصية، بل قيادة طليعية تخرج الأمّة من حالة التقاتل على السلطة إلى الاعتصام بالوحدة، واستحضار مكامن القوى المادية والنفسية والحضارية الكامنة لدى الأمّة، لكي تستعيد هويتها كأمّة قادرة على صنع تاريخها واسترداد حرّيتها.
بالطبع، لا يستطيع أهالي غزة انتظار تحقيق كل ذلك، أو بعضاً منه، وهم يعيشون مقتلة عظيمة اليوم. لكن، حالة التخاذل التي وصلت إليها الأمّة تنبئ بوجود مرض مستشرٍ ينخر الأمّة جميعها. إنّ الخروج من حالة التخاذل ليس هدفه إنقاذ غزة فقط، بل إنقاذ الأمّة قبل فوات الأوان.
إنّ أولئك الذي ينظرون إلى الصراعات الدائرة في منطقتنا وفقاً لمنظور جزئي ومجزوء، وكأنها قضايا خاصة بهذا الشعب أو ذلك، أولئك لم يفهموا ولم يستوعبوا ماهية المشروع الصهيوني وخطره على الأمّة. وإنّ فهم هذا المشروع وخطره يستدعي إعادة الشعور بالأمّة كأمّة، ونفض كل ركام التجزئة والتبعية والتغريب.
* باحث وسياسي فلسطيني