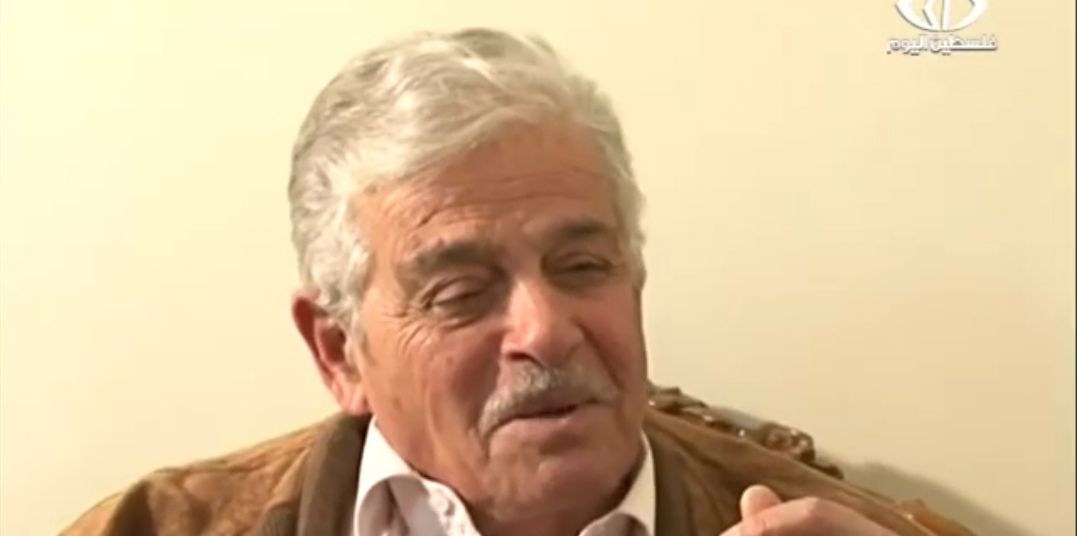مع عودة التشديد على “حلّ الدولتين”

مع عودة التشديد على “حلّ الدولتين”
قبل عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إبادة وتدمير على غزّة، كان الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين (ويمكن القول بين الإسرائيليين أنفسهم) هو بالأساس بشأن مستقبل القدس الشرقية ومنطقة ج في الضفة الغربية…
ما زالت التقديرات السائدة بإسرائيل أن تواتر الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية هو بمنزلة “تسونامي سياسي”، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية، غير أن التداعيات العملية له ستبقى محدودة، فضلاً عن أنه من المتوقّع أن تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم إسرائيل واستخدام “الفيتو” ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية إذا ما عُرض على مجلس الأمن. وبموازاة ذلك، هناك إقرار ضمني بأن ترامب قد يجد صعوبة في الاستمرار بالوقوف إلى جانب إسرائيل فترة طويلة أمام أغلبية الدول، خصوصاً إذا ما ردّت الحكومة الإسرائيلية بخطوات متطرّفة تشمل، من ضمن أمور أخرى، ضم أراض محتلة، ودفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار الاقتصاديّ والوظيفيّ.
ما هي أبرز عناصر الرؤية الإسرائيلية لهذا الحل؟ وهل كان يحظى بتأييد إسرائيلي يتماشى مع الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية المطروحة بشأنه؟… قبل عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إبادة وتدمير على غزّة، كان الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين (ويمكن القول بين الإسرائيليين أنفسهم) هو بالأساس بشأن مستقبل القدس الشرقية ومنطقة ج في الضفة الغربية، والتي تضم المستوطنات اليهودية، ومعسكرات الجيش الإسرائيلي، والطرق الرئيسية، ومناطق حيوية وحيّزا مفتوحا على مشارف غور الأردن، وحول مدى “الضرورة الأمنية” لمواصلة السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة.
وتلخّص موقف حكومات بنيامين نتنياهو إلى ما قبل حكومته الحالية التي بدأت تتحدّث أكثر فأكثر عن الضم، في أن “الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران (1967)، حتى لو كان مع بعض التعديلات في الكتل الاستيطانية الكبيرة، قد يُعرّض إسرائيل إلى خطر وجوديّ”، كما ورد مثلاً في كرّاسة صدرت في مطلع 2019 عن مركز بيغن ـ السادات للدراسات الإستراتيجية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية.
والزعم المركزي الذي تم تأكيده في تلك الكراسة أن انسحاب إسرائيل الشامل من مناطق الضفة الغربية لن يؤدّي إلى محاصرة إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها فقط، وإنما سيؤدّي أيضاً، “في حكم شبه الحتمي”، إلى نشوء “كيان إرهابي” كما حصل في قطاع غزّة على خلفية عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم مؤدّاه: أن قرب مناطق الضفة من الموارد والمنشآت الأساسية الحيوية الإسرائيلية، على طول سواحل البحر المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الانسحاب أضعافا مضاعفة.
كذلك تم التطرّق إلى مسألتين: الأولى، أن غياب الاحتلال الإسرائيلي في غور الأردن سيؤدّي إلى نشوء اتصال جغرافي على الأرض بين الدولة الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي، وهو الاحتمال الذي أثار قلق ديفيد بن غوريون منذ 1948.
والثانية، أن الإخلاء الواسع لمستوطنات يهودية في الضفة لن يؤدّي إلى تخفيف حدّة الصراع، وهذا ثبت في عرف الزاعمين بعد الانفصال عن قطاع غزّة. وفي النموذج الغزّيّ، الذي يمثل الانفصال التام، ظل تفعيل القوة العسكرية بحاجة إلى موارد هائلة: دبّابات، طائرات حربية، قوات برّية واسعة من حين إلى آخر، ناهيك عن جهود هائلة لمواجهة الأنفاق ولبلورة طرق قتالية ملائمة للوقوف أمام تحدّيات مستجدة، مثل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. في المقابل، يلغي التداخل العميق بين التجمعات السكانية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في مختلف البنى التحتية وعديد من مجالات الحياة المختلفة في الضفة الغربية، الحاجة إلى عملية عسكرية مكثفة وقوية، ولكن في وضع لا تكون فيه ثمّة مستوطنات يهودية متداخلة في الحيّز، سيكون من الضروري تنفيذ أي عملية عسكرية لإحباط عمليات مقاومة أو تنظيمات مسلحة من خلال التحرك في قلب التجمّعات السكانية الفلسطينية، ما قد يمهّد لمقاومة شديدة توجب إدخال قوات عسكرية كبيرة جدا.
وثمّة مسألة ثالثة ليست أقل أهمية، أنه حتى ضمن عملية أوسلو، ظل يتسحاق رابين يؤكّد حتى مقتله أن مسارها لن يؤدّي بالضرورة إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 ولا إلى إقامة دولة فلسطينية.