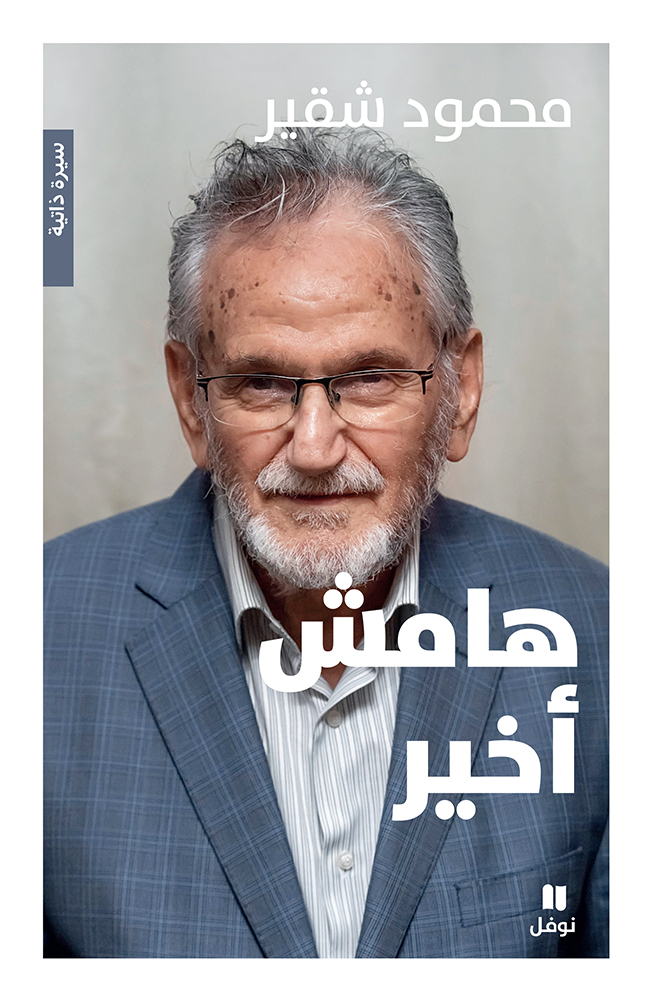لرواية الوطنية الكلاسيكية والرواية الاجتماعية والإنسانية والرواية النسوية في الأدب الفلسطيني: مقاربة مقارنة

الرواية الوطنية الكلاسيكية والرواية الاجتماعية والإنسانية والرواية النسوية في الأدب الفلسطيني: مقاربة مقارنة
اعداد وتقرير صحيفة صوت العروبه / قسم التحرير
منذ نشأة الرواية الفلسطينية ارتبطت بالهمّ الوطني والهوية الجمعية، وأصبحت وسيلة لإعادة إنتاج الذاكرة ومواجهة محاولات الطمس والتغييب. وقد تدرجت هذه الرواية عبر مراحل متعددة، بدءًا من الالتزام الصارم بالبعد الوطني الكلاسيكي، مرورًا بمحاولات تجاوز الطرح التقليدي بالانفتاح على البعد الاجتماعي والإنساني، وصولاً إلى إبراز دور المرأة كفاعل مركزي في معركة الصمود والوجود. تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين هذه الاتجاهات الثلاثة من حيث البنية السردية والرمزية والرسالة الفكرية، مع تحليل نصوص روائية فلسطينية محددة تسهم في توضيح الفروق الجوهرية.
أولاً: الرواية الوطنية الكلاسيكية
تمثل روايات غسان كنفاني (1936-1972) أبرز نموذج لهذا الاتجاه، وخاصة في عمله “رجال في الشمس” (دار الطليعة، بيروت، 1963) حيث تتحول مأساة اللجوء إلى مأساة وجودية جماعية. الشخصيات الثلاثة (أبو قيس، أسعد، مروان) تجسد أبعاد المعاناة الوطنية، لكن النهاية المأساوية داخل الصهريج توحي برمزية الهزيمة الجماعية. يقول النص: “لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟”، وهو سؤال تحوّل إلى صرخة أدبية وأخلاقية تختزل حالة شعب بأكمله. اعتمد كنفاني على الواقعية التسجيلية واللغة المباشرة لتشكيل نص أقرب إلى شهادة تاريخية، موظفًا الرموز الوطنية الكبرى كالخزان رمزًا للصمت العربي والموت الجماعي. وقد تناولت الناقدة سلمى الخضراء الجيوسي في كتابها “الاتجاهات والحركات في الأدب العربي الحديث” (دار الآداب، بيروت، 1997) البعد التوثيقي في روايات كنفاني باعتباره حجر أساس في بناء الرواية الفلسطينية.
ثانياً: الرواية المتقاطعة مع البعد الاجتماعي والإنساني

يمثل إبراهيم نصر الله نموذجًا بارزًا لهذا الاتجاه من خلال مشروعه “الملهاة الفلسطينية”، وخاصة روايته “زمن الخيول البيضاء” (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمّان، 2007) التي حازت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية عام 2009. في هذا العمل يمتزج السرد الوطني باليومي والمعيشي، حيث تتقاطع سيرة المكان (القرية الفلسطينية) مع التحولات الاجتماعية والإنسانية. يكتب نصر الله: “حين يرحل الخيل، ترحل البلاد معها…”، فيوظف الخيل كرمز لحيوية الأرض واستمرارية الذاكرة. الشخصيات هنا ليست مجرد رموز وطنية، بل كائنات متعددة الأبعاد تعيش صراعًا داخليًا بين التمسك بالأرض ومواجهة تحديات الفقر والقيود الاجتماعية. وقد أشار الناقد فيصل درّاج في دراسته “ذاكرة المغلوبين: نحو رواية فلسطينية جديدة” (المركز العربي للأبحاث، بيروت، 2010) إلى أن نصر الله أعاد تشكيل الرواية الفلسطينية بمقاربة أكثر حداثة تربط بين الخاص والعام، وتمنح التجربة الفلسطينية بعدًا إنسانيًا كونيًا.
ثالثاً: الرواية التي تبرز دور المرأة الفلسطينية
برز هذا الاتجاه بقوة مع سحر خليفة، التي تعد رائدة الرواية النسوية الفلسطينية، في روايتها “عباد الشمس” (دار الآداب، بيروت، 1980). تضع خليفة المرأة في قلب المعادلة الوطنية والاجتماعية، حيث تتحول البطلة إلى فاعلة تقود السرد وتكشف ازدواجية القمع الواقع عليها من الاحتلال ومن البنى التقليدية. تقول البطلة في إحدى المقاطع: “الوطن ليس خيمة ننتظر فيها عودة الرجال… الوطن أن نقف نحن، النساء، في وجه الريح”، وهو تعبير عن تحول الوعي النسوي إلى جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني. الناقدة رضوى عاشور في كتابها “المرأة والرواية” (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998) حللت هذا التحول باعتباره نقلة نوعية في بنية السرد الفلسطيني.
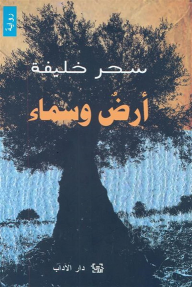
وفي السياق ذاته برزت روايات الكاتبة ليانة بدر مثل “نجوم أريحا” (دار الكرمل، عمّان، 1993) التي وثّقت تجربة المعتقلات الفلسطينيات، حيث تمتزج السيرة الذاتية بالبعد الوطني، وتتحول ذاكرة السجن إلى رمز للحرية المأمولة.
رابعاً: رولا غانم وتجربة التجديد النسوي

من الأسماء المعاصرة التي أسهمت في ترسيخ الرواية النسوية الفلسطينية الدكتورة رولا غانم، خاصة من خلال روايتها “تنهيدة حرية” (دار ببلومانيا، القاهرة، 2023) التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية. تعكس الرواية معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، لكنها تنفتح أيضًا على أبعاد وجودية وإنسانية أوسع، حيث تصبح الحرية نفسها موضوعًا روائيًا متعدد المستويات. وفي روايتها “لم يهزمني سواي” (دار الرعاة، رام الله، 2019) تقدم غانم نموذجًا مغايرًا لشخصية المرأة الفلسطينية، إذ تطرح صراعها الداخلي والنفسي بوصفه امتدادًا للصراع مع الاحتلال، مؤكدة أن الهزيمة الحقيقية ليست في مواجهة العدو، بل في الاستسلام للضعف الداخلي. في هذا السياق تقول إحدى شخصياتها: “كل الحواجز يمكن أن أعبرها، إلا الحاجز الذي بنيته داخلي”، ما يكشف عن وعي جديد بدور المرأة في صناعة المعنى الوطني والإنساني معًا. وقد تناول الناقد محمد صوالحة في دراسته المنشورة بمجلة “شرفات ثقافية” (عمان، 2021) خطاب رولا غانم باعتباره امتدادًا لتجربة سحر خليفة، لكنه أكثر التصاقًا بالتحولات النفسية والمعاناة الداخلية للشخصية النسوية الفلسطينية.
المقارنة بين الاتجاهات الثلاثة
من حيث البنية السردية: الرواية الكلاسيكية تتسم بالخط السردي المباشر القائم على البطولة الجمعية، في حين أن الرواية الاجتماعية والإنسانية تقدم تعددية الأصوات وتفاصيل الحياة اليومية، بينما الرواية النسوية تركز على السرد الداخلي ومركزية المرأة كبطلة رئيسية.
من حيث الرمزية: اعتمدت الرواية الكلاسيكية رموزًا وطنية كالأرض والشهيد والمخيم، فيما لجأت الرواية الإنسانية إلى الرموز الحياتية واليومية، بينما أعادت الرواية النسوية إنتاج الرموز من منظور جسدي ووجودي (الأمومة، الحرية، الجسد).
من حيث الرسالة الفكرية: الكلاسيكية أكدت قيمة الصمود والمقاومة، الاجتماعية والإنسانية أبرزت البعد الكوني للحرية والعدالة، أما النسوية فقدمت تحرر المرأة باعتباره جزءًا من التحرر الوطني.
الخاتمة
إن الرواية الفلسطينية لم تعد محصورة في نمط واحد، بل غدت فضاءً متعدد الأصوات والرؤى. وإذا كانت روايات غسان كنفاني قد أسست للبنية الوطنية الكلاسيكية، فإن إبراهيم نصر الله نقل الرواية إلى أفق إنساني كوني، بينما جاءت سحر خليفة ورولا غانم لتعيدان صياغة الوعي السردي من منظور نسوي يدمج بين الوطني والاجتماعي والإنساني. بهذا التنوع أثبتت الرواية الفلسطينية أنها ليست مجرد نص أدبي، بل مشروع هوية متجددة ومقاومة سردية ضد الطمس والنسيان.