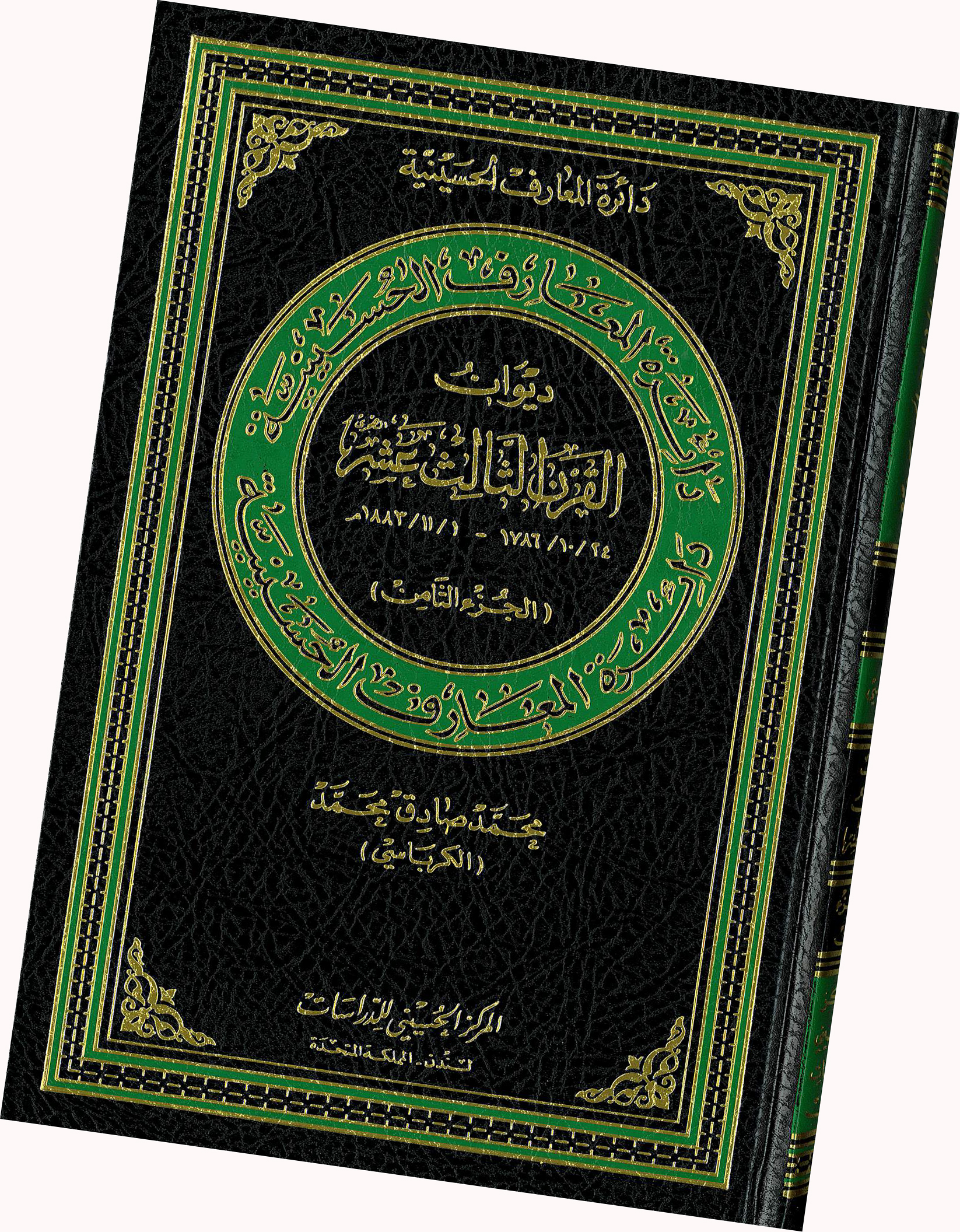لا تأتِ مبكّرًا، وإلا…

نعيمة عبد الجواد
هل تساءلت يومًا عن السبب وراء الاحتفاء بالجمال أو القوَّة أو الثراء على كل الأصعدة، في حين تحرص تقريبًا جميع ألوان الدراما والتعبير القصصي والروائي على تصوير العالم أو المفكِّر كشخص ناقص العقل ولا يبرع إلَّا في التفكير فقط، والذي غالبًا يكون مغلوطًا بسبب انعزاليته في قليل من الأحيان، أو سوء تقديره للأمور في أغلب الأحوال. بل وقد يتطرَّف التصوير الهزلي للعالم أو المفكِّر أو الشخص الذكي على أنه معتوه. وفي نهاية الأمر، يشطّ عقله ويكون مآله الحبس في إحدى دور الرعاية النفسية.
بالرغم من أن العلماء هم الذين بنوا أسس العالم الحديث ونقلوا الإنسان من ظلمات التخلُّف لذُرَى التقدُّم المتعاقب، لكن الشعور السائد والرَّاسخ هو وجوب تحقير تلك الفئة وعزلها عن المجتمع. ولو حاولت مخالفة ذاك الرأي أو حتى نعته بأنه منطق مغلوط، سيتم دحض هذا الزعم عند عمل تقييم بسيط لما تذوَّقه رموز العلم والمعرفة على مدار التَّاريخ، سواء أكان ذلك في الشرق أم في الغرب.
ففي الغرب، نجد سقراط يحاكم بتهمة إفساد الشباب وتشويه عقولهم بإدخال أفكار مغلوطة من شأنها إفساد المجتمع بأكمله. ولهذا السبب، تصير عقوبته الإعدام. وحتى في مشهد نهايته المأساوية التي يصرّ فيها على تنفيذ حكم الإعدام بشجاعة عند تجرّعه للسمّ، بالرغم من أنه أتيحت له الفرصة للهرب، يذكر التاريخ تلك اللحظة باستنكار، ويستهزئ بكلماته الشجاعة التي وجهها لزوجته التي تبكي لأنه يُقتل ظلمًا، حينما قال: «أوكنت تحبين أن أُقْتَل عدلًا؟»، فبدلًا من التصفيق له على مرّ العصور لشجاعته النَّادرة، يذكره التاريخ باستهزاء بأنه لا يكفّ عن التفلسف الذي أفقده حياته، حتى وهو على وشك الإعدام.
والظلم نفسه جابهه العلم الجليل غاليليو، الذي اكتشف كروية الأرض وكشف أنها تدور حول الشمس، فما كان من الكنيسة إلَّا أن حكمت عليه بالتعذيب والإعدام بتهمة الهرطقة؛ والسبب الحقيقي في ذاك الاضطهاد هو أنها أيقنت أن نظريته ستقوِّض ما كانت تنشره من آراء على مدار قرون، ما سيفقدها هيبتها. وتحت ضغط عارم والتلويح بما لا يطيقه من عذاب، تراجع غاليليو عن رأيه، وأصبح حبيس منزله، وقسريًا منبوذًا من المجتمع على مدار عقد كامل، والأدهى من ذلك أن العالم لم يعترف بصحة نظريته إلَّا بعد العديد من القرون. ونفس تلك التهم والعزلة القسرية واجهها العديد والعديد من المفكِّرين الذين تعج بهم صفحات التاريخ في الغرب، لكن العامة فهمت قيمة ما كانوا يتداولونه من آراء بعد عقود أو حتى قرون طويلة.
وإذا كان ذاك هو وضع العلماء والمفكِّرين في الغرب، فلم تكن الحال بأفضل لهم في الشرق؛ فكل عالم أو مفكِّر حينما كانت تثبت سطوته وصحة نظرياته، كان يتحوَّل طريدًا للعدالة التي كانت تلصق به تهمة الزندقة على الفور، تهمة راح ضحيتها العديد من المفكِّرين من أمثال ابن رشد. أمَّا العقوبة المُخففة فكانت الرمي بالزندقة دون إعدام فعلي، لكن الإعدام الفكري والمعنوي يتأتى بطمس الإنجاز الفكري الراقي المثير للجدل، أو تسفيه الشخص وإعلاء كلمة الجوانب الشخصية التي تؤكِّد ما يشوب شخصه من قصور وانعكس على ما تركه من أثر فكري وتقدُّمي. ولعل أفضل مثال على هذا هو العالم الشامل أعجوبي العبقرية ابن سينا، حينما طمست مخطوطاته وآراؤه الفلسفية والمنطقية، وما تبقَّى منها صار حبيس قاعات الدرس رفيعة المستوى. وأصبح العالم لا يعرف عنه سوى الإنجاز الطبي الذي كان يعتبره هو ذاته كتحصيل حاصل وسهلًا، لدرجة لا يجب الوقوف عندها طويلًا. أمَّا الظلم الأكبر فهو ذاك الذي تعرَّض له تاريخ العالم الرياضي الفذّ عمر الخيَّام، الذي لا تعلم عنه الغالبية سوى أنه شاعر برع في نظم قصائد فذَّة عن الحبّ والغزل، وأنه كان يكرِّس حياته للهو والمجون المعربد، في حين أن اكتشافاته الرياضية واختراعاته في مجال الفلك لا تزال يدين بفضلها العالم بأسره.
وحتى لو أقر العالم بأسره بهذا الخطأ الجسيم والظلم العظيم الذي يتعرَّض له الأذكياء والعباقرة، فلا يزال البشر في قرارة أنفسهم يعمدون إلى تحقيرهم كآلية فطرية للدفاع عن النفس. فالبشر ينظرون للقوي ومفتول العضلات على أنه مثال يحتذى به، بل ويتقرَّبون منه ويسعون لصحبته أينما حلّ. وكذلك هي الحال بالنسبة للمرأة الجميلة التي يسارع الآخرون لكسب ودّها والتباهي بالظهور معها، حتى ولو كانت ذات عقل فارغ. فلا يهم البشر إذا كان المحتوى العقلي لمن يرغب التقرُّب منه سليمًا، بل ما يهتم به البشر هو القوَّة والجمال والثراء والمكانة الاجتماعية. ولهذا السبب، إذا أراد أحدهم طرح حديث جاد في أحد التجمُّعات الاجتماعية، يُقابل بالصمت والامتعاض، بل وينقذ الموقف آخر يلتقط منه دفَّة الحديث ويوجهه لمحتوى تافه فارغ. وما يثير الحنق هو أنه كلَّما تصدَّر عالم المشهد، يحاربه من يمتلك المال والنفوذ بكل ما أوتي من قوَّة؛ لكيلا يخطف منه الأضواء. ثم دون تفكير، ينحاز المجتمع لمن لا يشكل تهديدًا لصورتهم الذَّاتية، ويساندونه لأنه استطاع أن ينقذهم من تأثير من لديه القدرة على أن يسيطر عليهم وعلى اختياراتهم، ولو حتى للحظات.
ولقد فسَّر هذا الموقف العجيب والملتبس الفيلسوف الألماني أرثر شوبنهاور Arthur Schopenhauer (1788-1860) الذي يتم نعته بأنه أصدق الفلاسفة على مرّ العصور، وكذلك بأنه أكثرهم ظلامية؛ والسبب أنه كان يعرض الحقائق بلا زيف أو تجميل. ولشرح السبب الحقيقي وراء التعمُّد الفطري للإهانة والتحقير من شأن الأذكياء، خصص فصلًا كاملًا في درَّة مؤلَّفاته «العالم إرادة وتمثُّلًا» The World as Will and Representation (1818) والذي خصص فيه فصلًا كاملًا لشرح سبب كره المجتمع للأذكياء من الجانب النفسي والاجتماعي والمنطقي. وأوضح شوبنهاور أن الآخرين يرون في صحبة العالم والمفكِّر إهانة لذواتهم؛ ففي صحبة الذكي تتم إثارة ما نطلق عليه حاليًا «نظرية المرآة»، والتي يشرع الشخص حينها في مقارنة ما لديه من قدرات مع تلك التي يتمتع بها الفرد الذكي. وحينها، يكتشف أن المعادلة غير متكافئة، وأن صحبة الذكي قد تكشف عورات ما يستره من تفكير ضحل ونواقص في شخصيته؛ أي أن المفكِّرين والأذكياء ينقلون من يظهرون معهم من منطقة الراحة التي ينعم فيها حدود التفكير بالرَّاحة ويشرع جاهدًا في مسايرة ذاك المفكِّر، وإلَّا وقع تحت سيطرته. وبما أنه يكتشف مبكِّرًا أنه من الصعب مجاراة الذكي، فالطريق الأسهل والأكثر ضماناً والذي يوافقه عليه الجميع هو إقصاؤه عن المشهد بعنف، وعزله في مكان لا يمكن أن يكتشفه فيه أحد. وحتى وإن تم اكتشافه، ستكون الصورة السائدة التي تصفه سلبية، ما يجعل الذكي يهرع هو نفسه لعزلته كمنطقة آمنة لما قد يتعرَّض له من تنكيل عند محاولة الانخراط في المجتمع.
فمنذ قديم الأزل، لم يكن الأذكى هو المحبوب، وكانت القبائل تقصيه، ليس لعدم قدرته على التعايش معهم، بل لأنه يكشف لهم ما قد تتوصَّل إليه عقولهم في وقت غير مستعدين فيه لتقبُّل ما يسرده من حقائق تنويرية؛ أي أنه أتى مبكِّرًا على زمان لا يستطيع فهم ما يطرحه من فكر متقدِّم. ويساعد القائمون على أي مجتمع في لفظ تلك الشخصيات الذكية المفكِّرة، سواء عن قصد أو من دون؛ فوجود من يشذّ بفكره لا يتسبب إلّا في خلل في توازن المجتمع، وأي خلل في النسيج المجتمعي يؤدي إلى عدم الاستقرار، والذي بدوره يحدث اضطرابًا وعدم تناغم قد يجعل من الصعب السيطرة على مسار الأمور الذي تم التخطيط لها مسبقًا.
عل سبيل المثال، العالم الفذّ نيكولا تسلا Nikola Tesla (1856-1943) قد لا يعرفه الكثيرون بالرغم من أن بفضله ننعم بالكهرباء في شكلها الحالي، والذي سطا توماس أديسون على ابتكاراته التي جعلت اكتشافه للكهرباء ذا قيمة، بل ونهل من اختراعاته وسرقها الكثيرون عبر الأزمنة ونسبوها لأنفسهم، والسبب أن تحالف ذوي النفوذ والمال مثل توماس أديسون وجي بي مورجان، تحالفوا ضده عندما صرَّح بأنه قادر على توليد الطاقة وجعلها متاحة ومجانية للجميع، ما يجعل مشروع أديسون ليس ذا قيمة، ومعه تخسر استثمارات جي بي مورجان، إذاً كان الأسهل عليهم إقصاءه عن المجال وطمس سيرته إلى أن مات مفلسًا معدمًا في غرفة دون المستوى في فندق صغير، بينما لا يزال الكبار ينعمون حتى الآن في اختراعاته وابتكاراته.
وقد يجادل البعض أن الأذكياء غير قادرين على تبسيط معلوماتهم حتى يفهما الآخرون بسهولة، لكن الحقيقة الصادمة التي لم يدركها حتى آينشتاين، الذي أطلق هذه العبارة، أنه من الصعب جدًا طرح معلومة في زمان لن يستوعبها. فبالرغم من الاحتفاء الظاهري بشخص آينشتاين وعلمه، فلا يزال العامة يصوِّرون شخصه بطريقة كاريكاتورية، ويجاهد البعض بكل الوسائل بالنبش في تاريخه لكشف أي نقيصة في تكوينه الشخصي أو النفسي. ومن ثمَّ، لا يجب على المفكِّر أن يداري نوره؛ لأنه في جمع الأحوال عرضة للتنكيل بشخصه وبأفكاره. أما الحل السليم للخروج من تلك الورطة فهي الإيمان بما لدى الفرد من قدرات، والسعي وراء تحقيق الأهداف، حتى ولو اقتضى ذلك العزلة.
لا ينبغي للفرد اعتبار الابتعاد التكتيكي عن الآخرين انكساراً، بل فرصة عظيمة لاكتمال ما لديه من أفكار وصقل مواهبه. ولقد استطاع شوبنهاور ذاته تحقيق تلك المعادلة عندما جعل من منزله ملاذاً يستضيف فيه من يطيب له من أصدقاء، ويتناقش معهم بحرِّية في اكتشافاته الفلسفية على مأدبة عشاء فخمة يستطيع فيها إخضاع الآخرين بألوان شتى من النفوذ. لقد فهم شوبنهاور مشكلة الذكاء والأذكياء، وأعطى الحلول العملية للاندماج مع المجتمع، حتى ولو كان ذلك يعني التشبُّث بالأطراف.