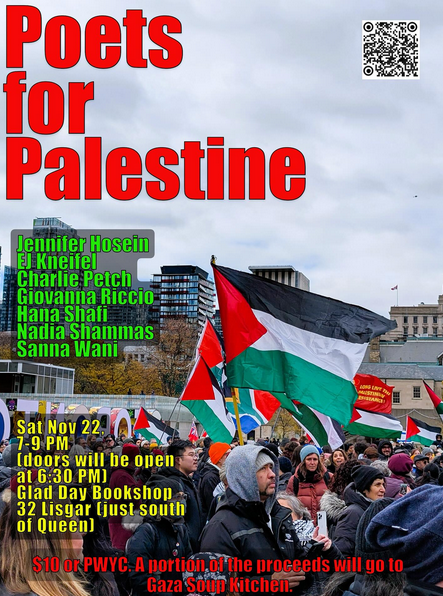«كان ياما كان في غزة» للأخوين ناصر… قصة في قديم الزمان

سليم البيك
هي فعلاً قصة «في قديم الزمان» لانفصالها عن الراهن. لكن الانشقاق السياقي في الفيلم كما أشرتُ له في المقالة السابقة، لم يكن الخللَ الأوحد فيه. فقد جانبه سيناريو منفصم، بقسمَين، غريب واحدهما عن الآخر، تقابل ذلك مع إخراج جيّد، أي إدارة جيّدة للتصوير وللممثلين، وإن كان لمسألتَي السياق والسيناريو أثرٌ بالغ أتى على الفيلم ونحّي الجيّدَ فيه.
في فيلم الأخوين عرب وطرزان ناصر، قصة محلية لا أثر للاحتلال فيها، وهو الأثر الحاصل بشدة في حياة الغزيّ ما قبل الحرب الإبادية، وهو أثرٌ بدرجة الكارثي منذ بدء الحرب. يكون بذلك تصوير فيلم عن حياة غزّية تغضّ النظر عن الاحتلال وأثره، قصة ناقصة. ولم ينقذ النقصَ المونتاجُ بالمشاهد الأرشيفية المتفرّقة والديكوريّة، غير المبرَّر لها درامياً، لقصف إسرائيلي، ولم تفعل الإضافةُ الصوتية لكلام ترامب عن الريفيرا في غزة ثم العودة إليها في إعلان تلفزيوني ضمن الفيلم، كانت واقعية جداً، فكانت خارج سياق فيلم كان خارج سياق الواقع.
إن كان من إمكانية لتغييرات من وحي حدث تاريخي يُقارن حقاً بنكبة لا نزال نحيي ذكراها حتى اليوم، وهذه إمكانية إن لم توجَد تستوجب الإيجاد، إن كان من إمكانية لتغييرات فلتكن في السيناريو، في حوارات وإن كانت جارية 16عاماً قبل الحرب هذه، فلتكن أمينةً لواقع غزّي اليوم هو امتداد لواقع كان قبل سنوات، فالسياق واحد ومخترَق بالحروب، وإن وصل مديات تراجيدية اليوم، في القطاع. المكان واحد، وكذلك الشعب، والاحتلال. بذلك، الفيلم بقصته الغزية، إن عُرض قبل الحرب لاتخذت قراءتُه منحى آخر، وإن كان بقصة غير غزّية معروضاً خلال الحرب، لاتخذت كذلك قراءتُه منحى آخر. ما يستصعب استساغتُه اليوم هو فيلم بقصّة غزّية، بعد عام ونصف العام من حرب لا تزال مستمرة على الواقع الغزّي، لم يرَ الحربَ ولم تُحدث هي أثراً فيه.
يحكي الفيلم عن صديقين، شريكين في مطعم فلافل، أسامة صاحب المطعم يتاجر بالمخدرات، يضعها في سندويشات الفلافل لتسليمها. يتعامل في ذلك مع ضابط من شرطة حماس، من قسم مكافحة المخدرات ويتاجر كذلك بها، يبتز الأخيرُ الأول، يتشاجران فيقتله في مرحلة مبكرة من الفيلم، وهذا نقصٌ في فيلم لم يطوّر أفضل ما فيه بل اقتطعه، شخصية ممتازة حواراتٍ وتأديةً. لاحقاً، الشريك، يحيى، سيمثّل دوراً لمناضل، أقرب في هيئته ليكون يحيى عياش، القيادي والشهيد من حركة حماس، في فيلم لوزارة الثقافة التابعة للحركة، سيلتقي لاحقاً يحيى بالضابط/التاجر/المجرم.
للفيلم، بمعزل عن كلامي أعلاه في قصور مصداقيته السياقية، حوارات متفرقة قوية، بسيناريو ضعيف إجمالاً، وتصوير هو من العلامات الفارقة للأخوين ناصر في عموم السينما الفلسطينية. لذلك يكون الفيلم، بالقطيعة التي فيه، سيناريوهاتياً، بين قصته وواقع أهالي تلك القصة اليوم، أي الغزيين، يكون بالقطيعة هذه خرجَ ناقصاً في مصداقيّته ومنفصلاً عن واقعه، بتغييبه التام لأثر الاحتلال على شخصياته وحصر الجانب الشرير بشرطة حركة حماس.
السياق الفلسطيني الكارثي اليوم كان من سوء حظ الفيلم، الذي لو خرج قبل الحرب لاستحقَّ تقييماً لا تُثقل عليه حرب كهذه. لكنها، القطيعة ذاتها، أي تجنُّب أيَّ ذكر للاحتلال مع إدانة أخلاقية وقانونية فيه لشرطة حماس، في السياق الفلسطيني اليوم، ستسمح للفيلم بتلقٍّ غير موضوعي، لصالحه، غربياً. مبرمجون ومحكمون وموزعون غربيون سيجدون في الفيلم ضالتهم الفلسطينية. سيكون ذلك على حساب حوارات جيّدة وتصوير وموسيقى بديعَين قد يخاطر التقييمُ الموضوعي للفيلم بتخطّيها. سينظرَ العربي والغربي كلٌّ من موقعه، بحرص، إلى موقع الحركة الإسلامية في الفيلم، وهو موقع المُدان. ستنبسط بذلك بعض الأسارير (الشقراء) وستنقبض أخرى (السمراء).
الفيلم، بذلك، عرضةٌ لقراءتين غير موضوعيّتين تماماً، تنظران إليه في سياقٍ انحصَر الفيلم بقصّته الغزّية، تلقائياً في أيٍّ منهما. بذلك يكون الفيلم خبرٌ جيّد في توقيت سيئ. بذلك يبقى الخبر الجيد جيداً، لكن مكانه وزمانه كانا أكثر طغياناً وجعلا الخبر مشوَّشاً. التوقيت السيئ من وجهة النظر الفلسطينية تجاه الفيلم، سيكون ذاته التوقيتَ الأفضل لوجهة النظر الغربية تجاهه. الخبر الجيّد جيّدٌ بالمعنى النسبي دائماً، بذلك يكون الخبر (الفيلم) الجيد ذاته، سيئاً إن انشق عن سياقه.
في «كان ياما كان في غزة» صورة أحادية عن حركة حماس، هي إما شرطة فاسدة ومجرمة، وإما مجموعة من المتخلفين يحاولون تصوير فيلم دعائي عن أحد القادة الشهداء. هذا الدمج من خلال الضابط ذاته، بين المخدرات والشهداء، أي المتاجرة بكل من المفردتَين، مادياً بالأولى ومعنوياً بالأخيرة، يُنزل من صورة الشهداء، يجعلها مزحة وسمجة. وهذا الدمج ملَحق بحادث أثناء تصوير فيلم عن الشهيد الحمساوي، يجعل من الشخصية التي مثّلته، يحيى، شهيداً بملصقات مطبوعة. الشهيد إذن عملية تمثيليّة، الشهيد أردَته رصاصاتٌ في مشهد تمثيلي. المشرفون على المشهد، على الفيلم، فوق ذلك، عناصر شرطة حمساوية يتاجر بعضهم بالمخدرات. هذه هي الصورة الأحادية لحركة حماس في الفيلم، ما يستدعي من المُشاهِد الإدانة الأخلاقية للحركة التي تجسّد الشرَّ، حسب الفيلم، الأوحدَ في حياة الغزيين، فلا احتلال إسرائيلياً يُشار مباشرةً إليه هنا. الفيلم يتيح لغربيين إجابةً بالإيجاب تجاه سؤال «هل تدين حركة حماس»؟ ولسبب فلسطيني تام.
«كان ياما كان في غزة» طموح، تحديداً في دخوله ضمن النوع السينمائي. فيلم تشويق وجريمة ناقصين لانقطاع السيناريو، يجهد لأن يكون فيلمَ حركة، وكل ذلك بكوميديا أفضل بشكل ملحوظ عمّا كان في الفيلمين السابقين للأخوين ناصر، لتواضع الفيلمَين. الجيّد في تجربة الأخوين – كما أشرت في المقالة السابقة – أنهما في مسار تصاعدي، بطيء، لكنه يتصاعد، وهذا بحد ذاته تحدٍّ يخفق فيه الكثير من السينمائيين العرب والفلسطينيين. بمعزل عن السياق السياسي الذي لم يكن من حسن حظ الفيلم، أمكن له أن يتيح للمشاهدين خفّة ظلّه، متحرراً من ثقل الواقع ووطأة المقتلة في القطاع، وأمكن لصورة حماس فيه أن تكون مقبولة، باعتبارها حزباً سياسياً حاكماً بالسيف، وذلك، وحسب، لو لم تكن الحركة اليوم تنظيماً مقاوماً، ومهدَّداً باستئصاله ضمن عملية استئصال أوسع تطالُ الغزيين كافة، وعموم الفلسطينيين في البلاد. ذلك ويستحسن أحدنُا إتاحة بعدٍ إنساني في كل الشخصيات الدرامية، فلا تكون جهة ما، «حماس» هنا (أو الرّوس في فيلم أمريكي) ممثلةً من خلال شخصيات هي إما قاتلة، أو حمقاء، وهي ربما حمقاء بما يكفي كي لا تكون قاتلة.
بمعزل عن الواقع الإبادي الذي تعيشه غزة اليوم، الفيلم جيد، نوعاً ما، وموقعه إزاء الفيلمين السابقين للأخوين، يمكن أن يبشّر بفيلم لاحق لهما يكون أفضل، فالأخوان يسيران بثبات ورويّة إلى الأمام، عنصران ضروريان في ذلك، أولاً إدراكهما لمحيط شخصياتهما السينمائية، وهو قطاع غزة، وثانياً إدراكهما لمقاربة هذا المحيط، الكوميديا. نقطتا قوّة تميّزا الأخوين ناصر عن غيرهما من السينمائيين الفلسطينيين.
تبقى نقطة ضعف تخللت الأفلام الثلاثة هي السيناريو، في آخرها بدا الفيلم أقرب إلى فيلمين منفصلين، تم لصقهما من المنتصف، تنقطع انسيابية كانت لطيفة في النصف الأول من الفيلم، سيناريوهاتياً، مع مقتل البائع المهرّب، لندخل في قصة منفصلة أُلصقت ميكانيكياً بقصة النصف الأول، وإن كانت في النصف الثاني كذلك انسيابية لطيفة، لكنها تبدأ من منتصف الفيلم تحديداً عندما يبدأ يحيى العمل في التمثيل، دون علاقة درامية تعقد ما بين النصفين. نحن هنا أمام نصفَي فيلمين أمكن لكل منهما أن يكون منتمياً لفيلم آخر يكون على الأرجح، في انسيابيته السردية العامة، أفضل من الفيلم الذي شاهدناه. لم تسعف الحواراتُ المتفرقة والمبنية على مواقف كوميدية بعضها تمثيلٌ لنكاتٍ فلسطينية مألوفة، لم تسعف هذه الحوارات التي ملأت السيناريو، الوحدةَ العضوية اللازمة لانسيابية سيناريوهاتية، والمفقودة هنا.
الظرف التاريخي المحيط بالفيلم، أيّ فيلم، ليس من مسؤوليات صانعيه، لكن وعياً ضرورياً يحتاجه الصنّاع، للّحظة الراهنة وأثرها في التاريخ المعاصر للفلسطينيين، لا يمكن صناعة الأفلام اليوم كأن شيئاً لم يكن، والدخول في جوقة عالمية، صارت نكتة سمجة، في إدانة «حماس». صور محاولة إبادة يعيشها فلسطينيون اليوم، ستكون حائمة، دائماً، في الفضاء بين المشاهد الفلسطيني والشاشة أمامه، مع أي عمل سينمائي فلسطيني جديد. الحديث عن فسادٍ حكوميٍّ وعنفٍ شرطيٍّ فلسطينيَّين، في ظرفٍ متطرّف لحرب إبادة طويلة يشنّها المستعمر على الغزيين بمن فيهم الفاسد والعنيف، هو حديث منشقّ عن سياقه ومنقطع عن زمانه.
يبقى للفيلم حقُّ القول فيه إنه، ومنذ عام 2000، أفضل من تناول قصّة غزّية، بحواراته ومَشاهده المتفرقة وليس بعموم السيناريو. وهو من بين القليل الجيد الذي شهدته السينما الفلسطينية في الأعوام الأخيرة، بشتى مواضيعها. يدرك الأخوان ناصر مساحة التميّز لديهما، وهي الكوميديا الاجتماعية السياسية، الغزية تحديداً، أما الخبر الجيّد في كل هذا فهو أنهما مركّزان في مساحتهما ويطوّران أفلامهما من خلالها، لذلك يمكن بسهولة الالتفات إلى خط سينمائي تصاعدي بدأ بأول أفلامهما «ديجراديه» 2015 واستمر مع ثانيها «غزة مونامور» 2020، وصل إلى ثالثها «كان ياما كان في غزة» (2025).

كاتب فلسطيني/ سوري