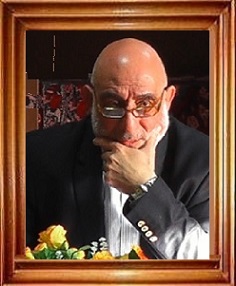معضلة الحكم في سوريا تاريخياً

معضلة الحكم في سوريا تاريخياً
نحن الآن في لحظة شبيهة بلحظة انهيار السلطنة العثمانية، ومجيء الملك فيصل ابن الشريف حسين، لتسلّم السلطة، عقب انتصار الثورة العربية الكبرى، وحصول التقسيم الإمبريالي بين فرنسا وبريطانيا للمشرق العربي. الفارق بين اللحظتين أنّ الأدوات التي كانت في متناول العائلة الهاشميّة، سواء في سوريا، أو في الأردن حيث لا تزال تحكم حالياً، أكبر بكثير مما هي عليه الحال الآن.
هذا إن لم نتحدّث عن الوزن السياسي والشرعية التاريخيّة لشخصيات مثل الأميرين فيصل وعبدالله، مقارنةً بالحالة الهَزَلية التي تمثّلها السلطة حالياً، حيث الافتقار ليس فحسب لحسّ القيادة، بل كذلك للدور المنوط بشخصيات جِيء بها، بعد ترتيبات إقليمية ودولية كبرى، لحُكم بلد مثل سوريا، في لحظة بالغة التعقيد على كلّ الصُّعُد.
الصيغة التي اختيرت حينها لحُكم سوريا بعد انهيار السلطنة هي المَلَكيّة. النظام السياسي الذي صُمّمَ لإدارة الجغرافيا السورية، بعد اقتطاعها لمصلحة فرنسا في مؤتمر «سان ريمو»، بدا قابلاً للحياة، ولكن من دون علم الأمير فيصل بأنّ الجغرافيا التي سيحكمها ستكون ذات طابع انتدابي وبنَسَق حُكم لن يستمرّ أكثر من سنة أو سنتين. هذا مع العلم أنّ الشرعية السياسية التي يحوزها الرجل، بفعل قيادته مع أبيه للثورة العربية الكبرى، كانت تؤهّله لحكم البلاد لسنواتٍ طويلة، لولا الموقع الجيوسياسي لسوريا، الذي جَعَلها، منذ لحظة ولادتها كدولة، مشروعَ حكمٍ ميّت وغير صالح للحياة، إلا كأداة لإدارة التناقضات بين القوى الدولية التي تدير المشرق العربي.
المَلَكية، كنظام حُكم للبلاد في ذلك الوقت، لم تكن لتحلَّ مشكلة الكيانية السياسيّة، تماماً كما هي الحال في الأردن الذي، بخلاف سوريا، بقي مَلَكياً، وفي إطار حكم العائلة الهاشمية التي انتقلت «الخلافة» فيها من عبدالله الجدّ إلى الابن طلال ثمّ الحفيد الحسين قبل أن تعود مجدّداً إلى عبدالله الثاني ابن الحفيد. لم تحل الملكية في الأردن إشكالية الكيانية السياسيّة التي ظلّت مصطَنعة، ولكنها على الأقلّ، وأيضاً بخلاف سوريا، أمّنت استقراراً سياسياً طويلاً للأردن، على الرغم من محدودية الموارد الطبيعيّة، وحتى البشرية، في هذا البلد، مقارنةً بسوريا الأكثر غنىً وتعدّديةً ونضجاً سياسياً وسوسيولوجياً.
لكن مشكلة سوريا كانت، منذ البداية، في المطامع الاستعماريّة، وعدم تناسُبها مع شكل الحكم الذي اختارته دولة الانتداب الفرنسي لإدارة البلاد ابتداءً من عام 1920 تاريخ احتلالها سوريا من بوابة العاصمة دمشق.
المَلَكية كنظام سياسي لإدارة سوريا لم تكن تتناسب مع المسعى الانتدابي الفرنسي الذي يفضّل أن تكون البلاد مجزّأةً، ولكن مع نظام حكم جمهوري، لتسهيل عمل القوى السياسيّة المتعامِلة مع الانتداب، كون التشريع في النُّظُم البرلمانية والجمهورية لا يكون عادةً متمركِزاً حول شخص الرئيس أو حتى رئيس البرلمان، كما هي الحال في النُّظُم الملكية التي تتمحور فيها كلّ السلطة حول الملك.
توزيع السلطة بهذه الطريقة بدا حينها متناسباً، أيضاً، مع مسعى الانتداب لتقسيم البلاد إلى أربع دول، بحيث تكون السيطرة على القوى السياسية أو الطائفية التي تدير هذه الكانتونات أسهَل مع النظام الجمهوري أو البرلماني، على اعتبار أنّ ذلك يعزّز اللامركزية ويسهّل عملية السيطرة على الموارد والتحكّم بها عبر ترك عملية إدارة هذه الموارد للقوى المحلّية التي تتبع مباشرةً للحُكم الانتدابي.
كان تصوُّر الانتداب الفرنسي قائماً ليس فحسب على إضعاف مركزيّة الدولة بعد تقسيمها إلى دويلاتٍ أربع، بل كذلك على تجريد الدويلات الصغيرة التي أقامها من عناصر القوّة، عبر عزلها في جغرافيا صغيرة، خصوصاً إذا لم تكن تمتلك حدوداً برّية أو بحرية مباشرة، كما هي حال السويداء. وهو ما يجعلها مفتقِرة إلى مواصفات الدولة أساساً، بما تعنيه من امتلاك جغرافيا متصلة وشعب وموارِد وحدود برّية أو بحريّة واضحة. هذا لا يُضعِفها كدويلات صغيرة ويجعلها بحاجة دائمة إلى الراعي أو الوصي الانتدابي، فحسب، بل يحرم أيضاً أي حركات تمرّد مستقبليّة داخلَها، من البيئة الحاضنة، على اعتبار أنّ أسباب التمرّد لن تكون قائمة أو موجودة، ما لم يكن ثمّة ما يغذّيها، سواء على شكل موارد بشريّة أو طبيعيّة.
بالنسبة إلى الدويلتين اللتين أُنشئتا عقب الانتداب، في الساحل والسويداء، كان من الأسهَل على أهل المنطقتين الاستمرار في خيار الانفصال عن «المملكة السورية»، كما كانت تسمّى إبّان حكم الأمير فيصل، فهذا يوفّر عليهما تبعات المسار الآخر النقيض المتمثّل في رفض الاستقلال والتمرّد ضدّ الانتداب. كان ثمّة انقسام أيضاً بين أطياف المجتمعين هنا وهناك، فدعاة الانفصال كانوا يفضّلون البقاء كدول مستقلّة في ظلّ الانتداب، على اعتبار أنّ ذلك لا يسمح بتفادي الكلفة المرتفعة للتمرّد فحسب، بل يساعِد أيضاً على تطوير المجتمعات المحلّية من خلال التعاون مع سلطات الانتداب وسهولة الحصول على الموارد والامتيازات عبرها.
في حين كان الشقّ الآخر الذي يفضّل البقاء ضمن سوريا موحّدة بعيداً عن الدويلات، والذي انتهى مع سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي إلى إعلان الثورة السورية الكبرى ضدّ الاحتلال الفرنسي، يرى أنّ ثمن التمرّد سيكون أقلَّ بكثير من ثمن الإذعان للانتداب عبر خيار التقسيم، حتى لو أفضى ذلك إلى حرمان المنطقتين من الموارد وحصول تمييز بينهما وبين باقي المناطق التي لم تُعلِن الثورة أو تؤيّدها.
لم يستطع حكم الوحدة معالجة هذه الانقسامات جذرياً، واكتفى بطَمْسها من فوق، ما أفضى ليس فحسب إلى حصول الانفصال بعد سنواتٍ ثلاث فقط، بل أيضاً إلى عودتها بشكلٍ أقوى، سواء في عهد الانفصال أو حتى في مراحل حكم «البعث» المختلفة
المفاضَلة بين الخيارين انتهت لمصلحة خيار التمرّد، ولكن وفق رؤية تضع المجابهة العسكرية مع الانتداب في إطار التنسيق مع مختلف بؤر التمرّد الأخرى على امتداد الجغرافيا السورية، من السويداء جنوباً إلى الساحل غرباً مروراً بالغوطتين ووصولاً إلى إدلب شمالاً، حيث العمل العسكري لا ينفصل عن المسار السياسي الذي يضع وحدة سوريا كأفُق ممكن لإنهاء التقسيم والحلول الانفصاليّة، وبالتالي فَرْض حلّ سياسي على الانتداب بموجب موازين القوى التي ستفضي إليها المواجهة معه.
قادَ ذلك، بعد سنواتٍ من المواجهة العسكرية مع الانتداب، على امتداد الجغرافيا السورية، وتحت وطأة نزف المجتمع على ضوء إعلان المناطق الثائرة بؤراً متمرِّدة ونفي معظم قادة الثورة السورية الكبرى إلى الخارج، إلى تآكلٍ متزايد في شرعية الاحتلال الفرنسي. وَصَلَ الأمر، مع احتدام المواجهة إلى درجة لم يعد ممكناً معها إدامة حكم الفرنسيين للبلاد من دون الاتفاق مع قادة الثورة، حتى وهم منفيّون، على صيغة محدَّدة لخفض التوتّر تبدأ بتوقيع «معاهدة صلح» (انتهت إلى صيغة معاهدة عام 1936) أو اتفاق وقف إطلاق نار، على أن تعقبها خطوات سياسية وعسكرية وأمنية لإنهاء الانتداب تدريجياً واستعادة سوريا الموحَّدة استقلالَها.
مع توقيع معاهدة عام 1936 التي مهّدت لاستقلال البلاد بعد عشر سنوات، انتفت أسباب بقاء الدويلتين في الساحل والسويداء، فضلاً عن دويلتي حلب ودمشق، على اعتبار أنّ الهواجس الأمنية لهذه الفئات التي تذرّع بها الانتداب لإقامة هذه الدويلات أو أشكال الحكم الذاتي ضمن الجغرافيا السورية، قد زالت تماماً. وهو ما انسحب على الترتيبات الانتدابية نفسِها، حيث بعد تحقُّق معظم المصالح الانتدابية، حتى أثناء المواجهات مع بؤر التمرّد على امتداد البلاد، زالت أيضاً الأسباب التي تدعو إلى التقسيم، بوصفه مصلحة استعمارية لتسهيل الاستيلاء على الموارد وضبط السكّان الواقعين تحت الاحتلال، بطريقة لا تقود إلى عنفٍ واسع النطاق.
السياق الذي أعقَبَ توقيع المعاهدة لم يشهد عودة الساحل والسويداء إلى الجغرافيا السورية الموحَّدة، فحسب، بل كان كذلك بمثابة استعادة الجماعات الأهلية في هاتين المنطقتين للروابط السوسيولوجية مع بقية أجزاء سوريا. وهو مُنجَز يعود للفاعلية التي لعبتها الثورة السورية الكبرى في تعزيز حسّ المواطنة والانتماء لدى أكثرية سوريّة كانت عُرضةً في سنوات الانتداب لمحاولات مستمرّة، من جانب الاحتلال ووكلائه، لتفكيك لُحمَتها وتثبيت واقع التقسيم بوصفه، كما حاول الانتداب إظهارَه، تعبيراً فعلياً عن إرادة قطاعات عريضة وواسعة من السكّان.
المرحلة التي أعقبت الاستقلال اتّسمت بمعاودة تهميش هاتين المنطقتين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على اعتبار أنّ خروج الانتداب أعاد إلى البلاد، ليس فحسب وحدتها الجغرافيّة، بل أيضاً شكل الحكم المُفرِط في مركزيّته. حيث جرى، سواء في السنوات الثلاث التي سبقت الانقلابات العسكرية في سوريا، أو خلال مرحلة الانقلابات نفسِها، استبعاد القيادات التاريخية لهاتين المنطقتين، مثل سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي، مع عدم وجود بدائل عنهما، كون حراك الأحزاب الصاعدة حينها، مثل «البعث» و«القومي السوري» و«الشيوعي»، لم يكن قد شَمَلَ هذه المناطق، أسوة بالمركز والمدن الكبرى التي تمحَورَ جلّ نشاطها فيها.
الأزمات التي عَصَفت بسوريا، عقب الانتهاء من آخر الانقلابات العسكرية في عام 1954، كانت تتجاوز مشكلات الأقاليم أو المناطق في الجنوب والغرب. ولكن حتى حين حُلَّت أزمة عدم الاستقرار المزمن في السلطة، عبر اللجوء إلى مصر وطَلَب الوحدة منها، بقيت مشكلات هذه المناطق قائمة، ولم يجرِ تجاوُزُها فعلياً إلا خلال سنوات الوحدة، بسبب عدم وجود انقسامات في نمط الحكم الذي أرساه عبد الناصر، ولأنّ البنية الخارجية للنظام الذي قامت عليه الوحدة مع مصر كان أكثر اتّساقاً بكثير من النَّسَق الذي قامت عليه سوريا، سواء كنظام جمهوري في زمن الانتداب، أو حتى كنظام مَلَكي قبلها.
صحيح أنّ حكم الوحدة استطاع، بفضل الآلية المتجاوزة للانقسامات الأهلية والسياسية التي ميّزت سوريا عن مصر، سلباً، تحقيق استقرار سياسي عجزت عنه حتى الحكومات التمثيلية هنا في المراحل التي عادت فيها الديمقراطية الليبرالية إلى البلاد. غير أنه، في المقابل، لم يستطع معالجة هذه الانقسامات جذرياً، واكتفى بطَمْسها من فوق، ما أفضى ليس فحسب إلى حصول الانفصال بعد سنواتٍ ثلاث فقط من حكم الوحدة، بل أيضاً إلى عودتها بشكلٍ أقوى، سواء في عهد الانفصال أو حتى في مراحل حكم «البعث» المختلفة.
المعضِلة التي أتى «البعث» لحلّها، بعد سنتي الانفصال، ليست فحسب استئنافَ ما انقطع من حكم الوحدة، لجهة تجذير إجراءات التأميم والإصلاح الزراعي وإلغاء المُلكيات الكبرى، بل أيضاً، وهذا أمر أساسي لفهم ما يحدث في البلاد حالياً، إعادة الاعتبار للمجموعات السكّانية المختلفة التي همّشتها صيغ الحكم المتعاقبة لسوريا بعد انقضاء المَلَكية المؤقّتة في عام 1920.
* كاتب سوري