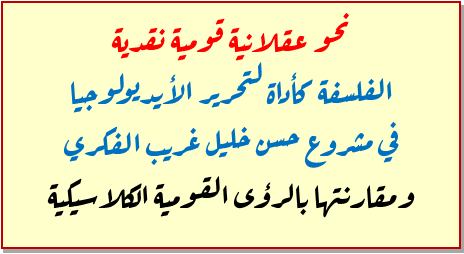التدويل مطلبًا والوصاية حكمًا..

التدويل مطلبًا والوصاية حكمًا…
أحمد زكارنة
طالبت وتطالب كل الأصوات الحرة حول العالم بإنهاء الحرب، ووقف التوحش، وقطع الطريق على مشروع التهجير، والانتصار للدم الفلسطيني الحرام، ولكن من دون وضع سؤال الوجود موضع التهديد..
ما زالت الشكوك تحوم حول خطة ترامب للسلام، هل ستصمد أم ستنهار؟ أهي خطة حقيقية لسلام فعلي وعادل؟ أم هي محاولة إضافية لتحويل الاحتلال إلى استعمار؟ وما بين هذا وذاك، يتجلّى أمامنا سؤال التدويل وسياقاته ما بين المواقف والأهداف. في هذا الصدد، جدير بنا التمييز بين مطلب التدويل الباحث عن العدالة، ومحاولة استدعاء شكل جديد من أشكال الوصاية كواقع لفرض السيطرة والتحكّم، لتتبدّل مقولة التدويل بهذا المعنى، من موقعها كفضاء لتحصيل الحقوق، إلى وسيلة لإعادة ترسيم شكل الهيمنة بأدوات مختلفة.
فبعيدًا عن تعريف التدويل كمصطلح ومفهوم، وهو تعريف مشروح على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني، لعلّ أخطر ما في الخطة “الترامبية” لا يكمن فيما تقترحه من حلول إجرائية آنية كوقف الحرب أو الإغاثة، بل فيما تُخفيه من نزعة لإعادة تعريف مفاهيم السيادة والحرية ذاتها؛ حيث يبني الرئيس الأميركي سياساته على أطروحات تجارية، تعمل بالضرورة على نقل الصراع من الحقل السياسي إلى السوق، ومن ميدان الحقوق إلى منطق الصفقات، ليبدو “السلام” نفسه سلعة قابلة للتسعير، لا قيمة حقوقية وإنسانية. ما يعني أننا إزاء إعادة إنتاج الاحتلال بآليات أكثر نعومة، ولكنها أشدّ فاعلية، قائمة على ضبط المجال القانوني بدلًا من إعادة النظر في الأصول القانونية لهذا الصراع.
بهذا المعنى، ربما يصبح التدويل مدخلًا لإعادة تعريف القضية الفلسطينية، عبر إعادة ترسيم الجغرافيا السياسة والديمغرافيا، ومن ثم إعادة هندسة الإقليم برمّته، لا لتعديل موازين القوى، بل لترسيخ واقع الهيمنة “الإسرائيلية” باسم الشرعية الدولية. فإنّ واشنطن، التي فشلت في إدارة الصراع الروسي/الأوروبي، تبحث اليوم عن استعادة دورها في الشرق الأوسط، مستندةً إلى “خطة سلام” يُمكنها أن تشكّل غطاء لإعادة تموضع مشاريعها التي تجمع بين الاقتصاد والأمن، وبين التطبيع والضبط، بوصفه الشكل الجديد للسيطرة الناعمة بعد تآكل أدوات الردع الصلبة.
وهنا، علينا أن نتذكّر السياسات الإسرائيلية التي أدمنت في الحالتين العربية والفلسطينية على تحويل المؤقت إلى دائم، ما يعني أنّها ستجد في المسار الترامبي المطروح فرصة ذهبية لتجديد مشروعها الوظيفي في المنطقة، عبر إعادة هندسة المعادلة الأمنية التي توفّر لها وضع الصراع تحت السيطرة، لا باتجاه الحل، ولكن باتجاه العودة إلى سياسات الإدارة التكتيكية والتصفية الاستراتيجية.
فهي تدرك أن أيّ تدويل مشروط وموجّه لا يفرض مفهوم سيادة القانون، يمكنه أن يتحوّل إلى غطاء للسيطرة بالقانون، تحت لافتة “المرحلة الانتقالية”.
هكذا، ومع اقتراح الإدارة الأميركية تحديد مركز ما يُعرف بـ”مجلس السلام” أو مركز التنسيق داخل الدولة الإسرائيلية، يُعاد تعريف الصراع على نحو يُبقي اليد العليا لإسرائيل بوصفها طرفًا في معادلة “الواقعية السياسية” كمتطلب أساسي لتحقيق الأمن الإقليمي، لا باعتبارها قوة احتلال، وإنّما بوصفها قوة شريكة.
أما على مستوى الإقليم، فيبدو واضحًا أن هناك بعض القوى المنخرطة، بوعي أو بدونه، في هذا التصور الأميركي عبر تسويغ بقاء الانقسام الفلسطيني وتغذيته، خصوصًا في ظل استمرار سيطرة حركة حماس على جزء من قطاع غزة، بما يجعلها ورقةً وظيفية في إعادة هندسة المشهد السياسي والأمني؛ إذ يعني وجود الحركة في غزة، بهذا الشكل المنضبط، منح طرفي المعادلة “الإسرائيلي والأميركي” الذريعة الجاهزة لتبرير استحالة الانتقال إلى الحل السياسي الشامل، كما ويتيح في الوقت نفسه للولايات المتحدة أن توازن بين “واقعية فرض الوصاية” و”رمزية التدويل المفترض”.
وهو ما يطرح سؤال المقاربة الأمنية مرة أخرى: هل تريد إسرائيل فعلًا نزع سلاح حماس؟ أم أنها تعمل على إعادة ضبطه بشكل ظرفي وانتقائي يصبّ في خدمة أهدافها؟ وفي المقابل، هل تعي حماس حينما تتحدث عن اعتزامها الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة، كما يؤكد محمد نزال، أنها تشارك بقصد أو دون قصد في المشروع الصهيوأميركي؟ هل تدرك أن خطاب نقل المواجهة إلى ساحة الضفة الغربية هو استكمال لدور وظيفي لا يمكن فهمه بوصفه خادمًا للمشروع الوطني، أو لفكرة التحرر من الأساس؟
من هذه الزاوية، إن دقّقنا النظر في التصريحات الأميركية والتحركات الإسرائيلية وسلوك حركة حماس، سنكتشف أن التدويل الذي بحث عنه الفلسطيني لردح من الزمن، سيقدَّم كعملية مزدوجة الوجه؛ وجهٌ يَعِدُ الفلسطينيين بالنظر في حقوقهم الوطنية وعدًا بلا سقوف زمنية معلومة، ووجهٌ آخر يُعيد دمج القضية قسرًا في منظومة مشاريع إقليمية تحكمها المعادلات الأميركية والإسرائيلية، وتعيد ترتيب الأدوار وفق ضرورات هذا الضبط الجديد؛ لنصبح بمعنى من المعاني أمام وصاية مقنّعة بلغة القانون الدولي، ومشروطة بلغة التوازنات التي تمنع الانفجار ولكنها لا ولن تصنع العدالة.
إنّ الخطر في خطة ترامب لا يكمن في تفاصيلها وحسب، ولكن في جوهر التحول الذي تكرّسه بالأساس، حيث تسعى هذه الخطة لما يسميه المؤرخ البريطاني إيريك هوبزباوم “اختراع التقاليد”، فالرجل البرتقالي يؤسس لمفاهيم لا تقيم وزنًا للقوانين الدولية الحاكمة، كما حديثه عن “السلام بالقوة” و”الاستثمار مقابل التطبيع”، والهدف الواضح، وضوح الشمس، يمكن تعريفه بـ”السلام كمقابل موضوعي للبقاء”.
هذه ليست دعوةً للتشاؤم، ولكنها محاولة للدفع بضرورة قراءة المشهد من كافة جوانبه الاستراتيجية، لا التكتيكية وحسب. نعم، طالبت وتطالب كل الأصوات الحرة حول العالم بإنهاء الحرب، ووقف التوحش، وقطع الطريق على مشروع التهجير، والانتصار للدم الفلسطيني الحرام، ولكن من دون وضع سؤال الوجود موضع التهديد، فإن تحولات خارطة المصالح الدولية والإقليمية، وعلى الرغم من تعثّر مسار التسوية السلمية، لم تزل تدفع المنظومة الدولية دفعًا لمقاربة الحق الفلسطيني. فإن لم يُصَغ معنى التدويل كمطلب حق، فلا يجب أن نمرّره بوصفه حكمًا بالوصاية.