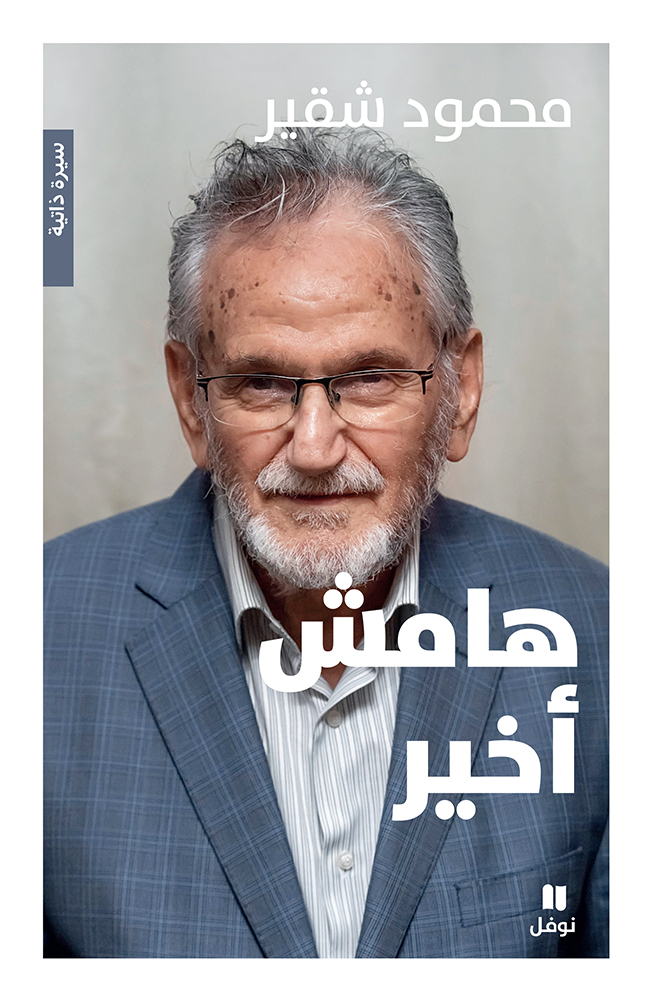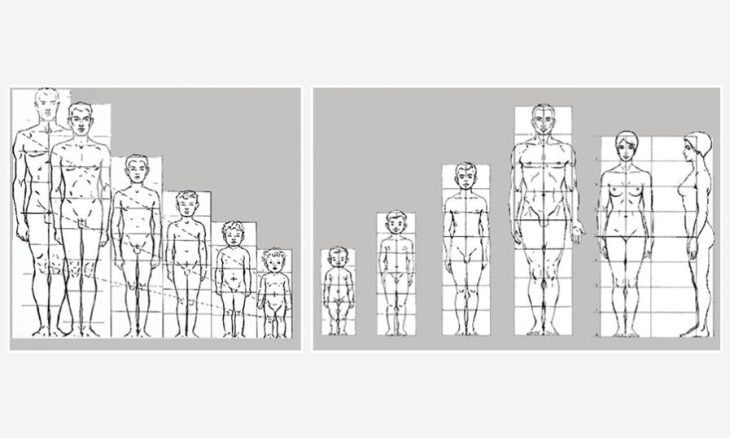تركيا الشاحبة: زلازل ويوميات لاجئين وزعيم صامت

تبدو أحيانا كتب ونصوص اليوميات مفيدة في أكثر من جانب. فهي، وإن كانت لا تعكس بالضرورة الحقيقة التاريخية، لكنها تمتاز بقدرتها على تقريبنا أكثر من رائحة الأجواء التي كانت تحيط ببعض الأحداث، وكيف صوّرها الناس العاديون، ولاسيما الأحداث الكبرى. وعلى هذا الصعيد، عادة ما تمتلئ كتب التاريخ الرسمية بالمداولات والنقاشات والمعارك، بينما لا نعثر في المقابل على فهم يوميات شخص عادي، وكيف انعكست الأحداث على حياته اليومية. وفي هذا السياق، ستحاول هذه المقالة تدوين تفاصيل بسيطة، لعلها غير مهمة كثيرا، عن يوميات كاتبها (لاجئ سوري في إسطنبول) خلال الأسبوع الأول من وقوع زلزالين ضربا عدة مدن في جنوب تركيا وشمال سوريا، وأوقعا آلاف القتلى والمفقودين إلى هذه اللحظة. وربما ما دعانا إلى كتابتها، الشعور بأنّ نصوص اليوميات توفر قدرة على جمع صور عديدة في متنها، وهو يتيح لكل الصور التعبير عن نفسها، ولأنّ تدوين بعض الملاحظات شكّل فرصة أو فسحة قصيرة للخروج، ومحاولة فهم أو ترتيب العالم اللاعقلاني الذي عاشه السوريون والأتراك إلى وقت نشرها وربما لأيام طويلة.
قبل الزلزال بيوم:
في اليوم السابق للزلزالين اللذين ضربا المنطقة في 6/2/2023، لم يكن أي شي غريب. كان الاستثناء الوحيد والمفرح بدء سقوط الثلوج في إسطنبول وباقي المدن التركية. في العادة، تعيش تركيا منذ رأس السنة في كل عام موجة من البرد والثلوج، لكن هذا العام تأخّر قدوم المطر والثلج. ما أثار قلقا لدى الحكومة التي لا تكّف عن نشر صور للسدود وهي جافة. وعلى الرغم من أنّ تقلبات الطقس في تركيا تبدو كما يرى بعض الخبراء مرتبطة بتغيرات مناخية عالمية، لكن بعض اللاجئين السوريين لم يكفوا في المقابل، في ظل شعورهم بالتهميش وأيضا بموجة العنصرية، والخشية من التكلم في المواصلات العامة باللغة العربية؛ من تفسير الجفاف في تركيا بـ«نوايا الأتراك غير البريئة» مع اللاجئين.
ومع قدوم موجة البرد، لم يكن كاتب هذا المقال، أو زملاؤه، يفكرون بشيء عدا عن كيفية عدم الذهاب للمكتب وإكمال العمل من المنزل. ومع قرب الليل، وصلت رسالة متأخرة من المؤسسة تفيد بأنّ الدوام سيكون من المنزل لليوم التالي، ولذلك نمت قرير العين كما تروي الحكايا. في صباح اليوم التالي، ومع سقوط الثلج بكميات كبيرة، الذي ترافق مع رياح شديدة وصلت لخمسين كيلومترا في الساعة، جاء الاستيقاظ متأخرا بعض الشي. وبمجرد أن فتحت شاشة الموبايل حتى بدا وكأنّ شيئا غريبا حدث. رسائل من العائلة والأصدقاء تسأل عني وعن أحوال أسرتي، وأخرى تتحدث عن وقوع زلزال في تركيا. في البداية بدا الأمر طبيعيا، فسكان إسطنبول اختبروا في السنوات الماضية عددا من الهزات الشديدة بعض الشي أو الضعيفة. لكن خبراً آخر سرعان ما كبح استنتاجاتي السريعة، عندما أشار إلى وجود مئات القتلى. مع ذلك، ظلّ الشك تجاه الأرقام وحجم الكارثة يحول دون فهم المشهد بشكل جيد.
بعد ساعات ومع الاستماع أكثر لنشرات الأخبار، كان المشهد ما يزال غير واضح. هناك حديث عن مئات القتلى، وفي المقابل أنباء أخرى تتحدث عن إنقاذ العشرات أيضا. في هذه الأثناء تواصلت مع بعض الأصدقاء في عنتاب وكلس للاطمئنان عليهم، بدا الجميع بخير. وربما هذا ما جعلني أعود للشك ببعض الأرقام، واعتبار ما يجري مبالغات من هول الحدث، وإن كان رقم 7.8 ريختر ظل ينغّص عليّ محاولة التصديق بأنه شبيه بكل الزلازل السابقة.
في نهاية اليوم الأول، عدت للسؤال على أحوال عائلة أحد الأصدقاء، الذي انقطع تواصله بهم، وكان الرد صوتيا «آخر نبأ وصلني أنّ الختيار والختيارة بخير.. لكن لا أعرف شيئا عن أختي وأخي وأولادهما». وهنا شعرت بنبرة توحي بشيء غريب، ولذلك رددت «خير إن شاء الله».
اليوم الثاني: اكتشاف الكارثة
في وقت مبكر من صباح اليوم الثاني، وصلني خبر وفاة قسم من عائلة صديقي (8 أشخاص بينهم اخته وأخاه) وأخذت الشاشات تعرض مشهدا آخر لمدن مثل إنطاكيا ومرعش (تركيا) وجنديريس (شمال سوريا) وهي على الأرض. وكأنّ حربا عالمية كبرى في هذه المناطق قد وقعت وانتهت في اليوم نفسه. لا وجود لعمارة أو حتى دكان صغير. كل شيء منهار، والآلاف تحتها دون من يساعدهم. في هذه الأثناء سيروي لي أحد الأصدقاء ما وصله من إنطاكيا عن وجود الآلاف في الشوارع دون خبز أو مأوى. وعن بدء صعوبة الوصول إلى المدن المنكوبة وغياب الدولة. بدت تركيا القوية، كما يقال عادة على صعيد الخدمات والبنية التحتية، غائبة تماما عن المشهد، ولذلك أخذ الحديث يدور عن فتح المحال التجارية في إنطاكيا وباقي المدن، بهدف الحصول على الطعام من ناحية، وللسرقة أيضا.
اليوم الثالث.. إبادة جماعية
في اليوم الثالث، كان عنوان المشهد يتغير مرة أخرى. فبدلا من قراءة وفاة العشرات هنا وهناك، كان الواقع يتحدث عن مقتل عائلات بأكملها، وعن مصير مجهول لمئات العوائل بعد انهيار مجمعات (وأشهرها مجمع الريزيندس) في مدينة إنطاكيا. لم يعد الأمر مجرد وفاة شخص أو اثنين من العائلة (وهو أمر في حد ذاته يعد فاجعة) بل غدونا نتحدث عن مشهد «إبادة جماعية» والجاني هي الطبيعة هذه المرة. أخذ هذا الواقع ينعكس على واقع مكتب العمل الذي أعمل فيه. كارثة كبيرة أو لنقل إنه شيء لا يمكن وصفه، وهذا ما أخذت التمسه من وجوه العاملين في المكتب، وبالأخص الزميل المشرف على مراقبة الدوام والأمور الإدارية. بدا لي يومها ساكنا على غير عادته. حتى أسلوبه الجاف في السلام، تحول إلى شيء من السكينة. لم يبدُ ممتعضا من التأخر في الوصول للعمل، وهو امتعاض عادة ما نتلمسه في ملامح وجهه التي تخونه في الغالب. الكل جالس خلف شاشات اللابتوب، ويراقب بصمت وخوف ودهشة ما يجري. هل نحن أمام فيلم، أو ضربة كيميائية؟ أم أمام شيء آخر ترك كورونا وكل مصائب العالم خلفه وسبقهم بوحشيته؟