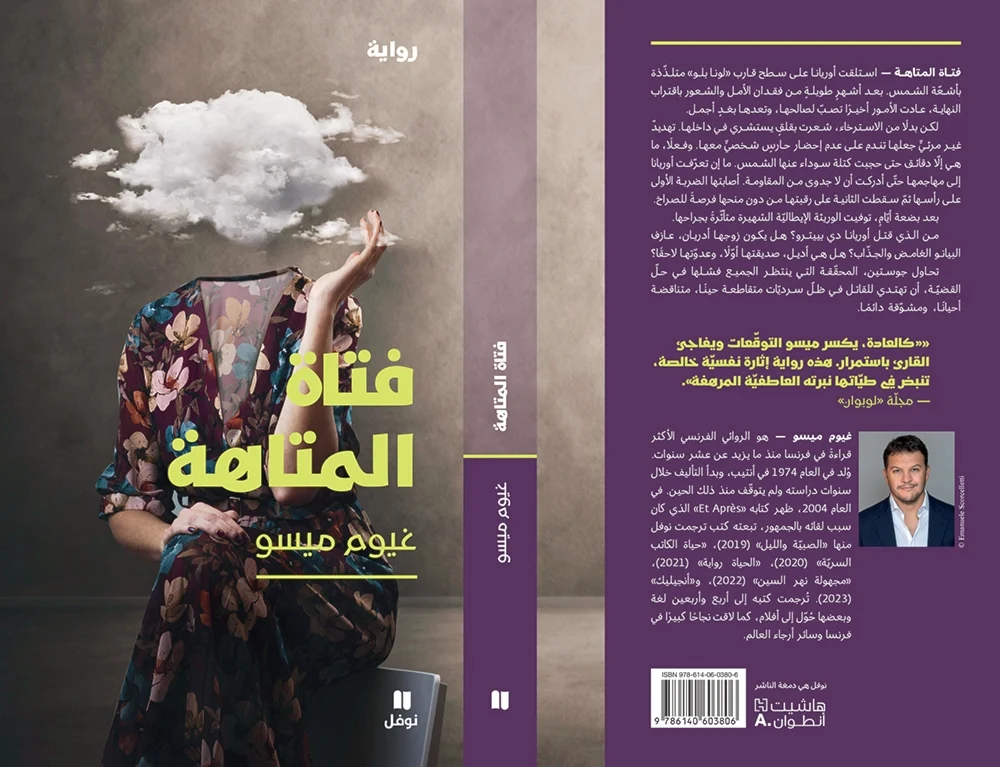كتابة الهامش في رواية «تفاحة في هودج» للكويتية ثريا البقصمي

كتابة الهامش في رواية «تفاحة في هودج» للكويتية ثريا البقصمي

سعاد العنزي
ناقدة كويتية
تكشف تجربة الفنانة التشكيلية الكويتية ثريا البقصمي، عطاء زخمٍ متعدد الاتجاهات والمجالات؛ فهي واحدة من رواد الفن التشكيلي في الكويت والخليج، وكاتبة موهوبة ومحترفة في ميادين الشعر والقصة والرواية. تتميز البقصمي بقدرتها العالية على تشويق القراء وجذبهم إلى دائرة حكاياتها بقوة، سواء كان ذلك من خلال طرافة أسلوبها السردي، أو من خلال لمحاتها السردية والتقاطاتها الذكية لقصص واقعية وحقيقية، تعيد نسجها بمخيلتها الخصبة التي تكسوها دائماً بطابع الجِدة والفرادة.
وكما نجد التشويق في أعمالها المكتوبة، نجده أيضاً في جانب آخر، إذْ إنها حكاءة بارعة، قادرة على جذب انتباه حضور فعالياتها ومقابلاتها المتنوعة. بالطرافة والصدق والبساطة، تستطيع أن تتحدث لساعات طوال دون أن يمل الحضور قصصها ونوادرها، وهذا أسلوب قلما أجده لدى الكتاب العرب، والكاتبات أيضاً. في أعمالها المكتوبة، أو في مشاركاتها في الفعاليات المتعددة تذكرني بأسلوب الكاتبة العراقية أنعام كجه جي ذات الأسلوب المرح والساخر، الذي يرصد المفارقات بلغة ساخرة ممزوجة بروح مرحة جداً.
كتبت ثريا رواية رائعة تحمل عنواناً لافتاً، وذات متنٍ حكائي مميز يدور حول انهيار الحلم الشيوعي في روسيا، وانكسار الخطاب القومي، إبان دراستها وزوجها في روسيا، بعنوان: «زمن المزمار الأحمر» ورغم أهمية هذا النص إلا أنه لم يحظَ بقراءة نقدية موسعة تفيه حقه من الدراسة والتحليل، باستثناء دراسة متواضعة أنجزتها بعد خمس سنوات من صدور العمل.
يثير هذا الأمر، حقيقةً، أزمة النقد الأدبي العربي اليوم في الصحافة والمجلات العربية، إذْ يتراجع عن دوره، ولا يجد الأدباء من يقدم أعمالهم تقديماً يضيء جمالياتها ويفسرها ويحللها تحليلاً نقدياً، ويعيرها اهتماماً وحضوراً بدلاً من الإهمال والنسيان. ثمة عامل آخر قد يقدم تفسيراً لهذه الظاهرة، وهو عدم حضور كثير من الكتاب المحترفين والمتقدمين في السن، وعدم تفاعلهم الحيوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن دائرة الاهتمام النقدي، ويجعل كتاباً آخرين، من الأجيال اللاحقة، قريبين من دائرة الضوء، حتى لو كانوا أقل إبداعية واحترافية.
حكايات الملونين: هامش يبحث عن التدوين
صدرت للأديبة البقصمي، العام الماضي، رواية بعنوان «تفاحة في هودج» وتعد روايتها الثانية بعد «زمن المزمار الأحمر» وإن كانت الرواية الأولى تعالج قضية المنفى والاغتراب، وتأثر المثقفين العرب بالمد الشيوعي في موسكو، فإن رواية «تفاحة في هودج» ترحل إلى مرحلة مهمة في تاريخ الكويت قبل الطفرة النفطية. لا تتحدث الرواية عن متن المجتمع الكويتي، بل عن هامشه. وتحديداً أكثر، تلتقط صورة من صور الهامش، وتلتقط تاريخ الملونين في الكويت، والجواري والسبايا في كويت ما قبل النفط.
اللافت أن الرواية ترتبط في موضوعها بكثير من الأعمال الغربية والعربية التي تناولت هذه الفكرة، مثل رواية جوزيف كونراد «قلب الظلام» ورواية الكاتبة الكويتية سعداء الدعاس «لأني أسود» ورواية العُمانية جوخة الحارثي «سيدات القمر». جميعها، روايات ترتكز وتؤكد أن المجتمعات عنصرية بطبيعتها، إلى أن يبدأ المستضعفون يقاومون الاستغلال والهيمنة.
تقدم رواية «فرج قصة الحب والعبودية» موضوعاً تقليدياً مفخخاً بأسئلة ما بعد حداثية، تتقاطع مع قصص الحب والعبودية في الماضي، حيث عنترة وعبلة، وكل السرديات ما بعد الحداثية، التي تُسائل فكر المركز باحثةً بعمق في هوامشه من النساء والملونين بلغة سردية عادية، وبكثير من التفاصيل السردية الممتعة بالتقاطع الكبير مع كثير من سرديات التراث، فهي إن لم تختلف كثيراً عن قصة البطل عنترة إلا أنها تقف بقوة مُسائلةً صور الظلم والقهر والاستبداد المعاصرة جداً. وإن حاول الكاتب عدم الإسقاط المباشر على المجتمعات الخليجية، إلا أنه يوضح على نحو بليغ فداحة الواقع الخليجي في ممارساته مع المهمشين، وتعامله مفرط الحساسية مع قضية الأنساب والأصول الخليجية، التي ما زالت تعاني في مسألة قبول الأنساب الأقل عراقةً، فكيف هي الحال مع العبيد الذين تحرروا في فترة متأخرة من التاريخ المعاصر للغرب والشرق. في عالم تختل فيه الموازين، ويصبح العبيد فيه مثل الحيوانات، يحركون ويُربطون مثل الدواب، متقاطعاً مع كثير من سرديات كافكا، الذي يقدم الإنسان عندما يتحول إلى حيوان في منظور وتعامل الآخرين، كل تلك التفاصيل، قدمها الكاتب ضمن دائرة سردية خارجية تقليدية عبر ضمير الغائب ولغة لا تتجاوز ضفاف المألوف.
تقدم رواية «فرج قصة الحب والعبودية» بنَفَس سردي طويل يمتد خلال 498 صفحة، حكايةَ البطل وهو يحاول ببطولة وشجاعة أن يتحرر من العبودية المفروضة عليه، عندما أسره مشايخُ مدينة ظويلم، التي تدور أحداث الرواية فيها. يصارع فرج عدداً من القوى التي تحاول أن تمارس قوتها عليه ظلماً وقهراً واستعباداً، من خلال علاقتها القوية مع المقهورين والمستضعفين من العبيد وأنصاف العبيد. تحاول الرواية أن تطرح معاناة مَن يقع على الهامش: فرج وعويشة، من خلال قضية العبودية التي ما زالت من القضايا الأكثر حساسية في الخليج العربي، أكثر دول الوطن العربي تمسكاً بالعادات والتقاليد. كما تطرح إشكالية محاولة العبيد التحرر من الأغلال الاجتماعية والنفسية والجسدية، التي يفرضها عليهم المشايخ بحيلٍ وألاعيبَ ودهاء كبير، مقابل القهر والإحساس بالظلم الذي يقابله كل مستضعف.
تثير نوره محمد فرج في كتابها الصادر هذا العام «العنصرية في الخليج: إشكالية السواد» حساسية هذا الموضوع الموجود منذ القدم والممارسات الاجتماعية في الوطن العربي، لكنه يبقى موضوعاً شائكاً لا يظهر إلى العلن، ولا يناقش على صعيد رسمي لأنه «يسبب حرجاً اجتماعياً. والسؤال: كيف يمكن لما عُد جزءاً من الحياة الممارسة طوال ما يزيد على 1400 سنة أن يغدو موضوعاً حرجاً؟».
«تفاحة في هودج» روايات الهامش
تدور أحداث رواية «تفاحة في هودج» حول عدد من الأبطال تركز عليهم فصول الرواية، ينتمون إلى قاع المجتمع الكويتي. تسرد الرواية حكاية كل واحد منهم بلسانه، متعقباً تاريخ قدومه إلى الكويت، ذلك القدوم الذي لم يكن أمراً اختيارياً، بل قسرياً بخلاف بقية بعض المكونات الاجتماعية. لقد عبرت الشخصيات عن كونها شخصيات مغلوبة على أمرها فقد سِيقت من بلدانها الأصلية، وسُلبت من بيئاتها الاجتماعية والثقافية والدينية الحاضنة لها إلى بلد امتهنوا فيه مِهناً دونية. يبين سلطان الحبشي، أحد أبطال الرواية، طبيعة عمله في مكان تعدى كونه مكان عمل إلى سجن كبير، موضحاً: «باحة عشوائية تتوسط تفرعات ضيقة تؤدي إلى الأسواق الداخلية، إنه (سوق العبيد) مسمى أطلقه الناس على مكان بضاعته، عيون مزروعة بالفزع، أفواه مكممة، أجساد مسروقة، وأرواح مبعثرة».
تعرض أحداث الرواية لقصة سلطان الحبشي الذي اجتهد واستطاع أن يحرر نفسه من أسر العبودية، بعد أن أُسِر من موطنه الأصلي واقتيد إلى الكويت ليكتسب ثقة سيده، الذي لا يلبث أن يعتقه أخيراً، فيتزوج الفتاة التي أحبها، ويدير شؤون العبيد الآخرين. لم يكن الوحيد، بل تتقاطع قصته مع قصة البطلة التي يركز عنوان الرواية على حكايتها «تفاحة في هودج» حيث تبدأ الرواية بسرد قصتها:
تفاحة حملتها ريح الأناضول
المشبعة برائحة البارود
إلى دوحة نخيل في البصرة
ثم دحرجها القدر
لتستقر في جوف هودج.
للتفاحة حكاية لا بد أن تُحكى
مهما طال زمن الصمت.
تعرض الرواية لحكاية الشخصية الرئيسية، واسمها سيتا، ابنة فلاح يمتلك بستانَ تفاح. تعيش البطلة قصة تحول كبير من الحضن الأُسري الدافئ والأمن والأمان الاجتماعي. تبدأ حكاية سيتا من الأناضول، وتتحول الحالُ بها وشقيقتها بعد هجوم بعضٍ من القوات على المنطقة، فتقرر الأم أن تفر ببنتَيها إلى البصرة، عند خالها التاجر الغني ميسور الحال. بعد ذلك، تعيش الفتاتان تفاصيل حياة رغد ووفرة لوهلة من الدهر لا تدوم بعد أن تأتي هجمة أخرى أوصلت الفتاتين إلى الكويت سبيتَين بعد خطفهما. تتطور الأحداث بعد أن تُختطف سيتا إلى أن تصل إلى مشروع جارية، أو فتاة من فتيات البغاء في ماخور حمود في حي الطرب، حيث تسلط الرواية الضوء على هذه الممارسات الاجتماعية في الكويت، حيث توجد بعض الشوارع التي تؤدي هذه الوظائف.
الجدير بالذكر، أن الأديبة ليلى العثمان سبق أن سلطت في روايتها «حكاية صفية» الضوءَ على هذا الحي، وتناولته على نحو موسع، في حين اختصرت رواية «تفاحة في هودج» تفاصيل هذا الحي حسب متطلبات الحكاية. مرت سيتا بسوق العبيد، واقتيدت إلى ماخور حمود الذي قرر أن يزجها في ماخوره كبائعة هوى، لكنها تُفلح متبعةً طرائق دفاعية، كانت قد تربت عليها في موطنها، في رد أي هجوم عليها، الأمر الذي ساعد في نجاتها من حمود وعودتها إلى المتجر لتجد مشترياً آخر، هو التاجر يوسف الذي يرتبط بها زوجة رابعة، لتبدأ معه فصلاً جديداً من حياتها، ولتشهد شخصيتها وهويتها تحولات عدة تبدأ بتغيير اسمها وديانتها ولباسها، لكن هذا التحول الظاهري لا يُنسيها هويتها الحقيقية، ولا يجعلها تستقر ضمن ظروفها الجديدة، التي شهدت فيها الراحة والدعة، لأنها تفتقد نصفها الآخر، توأمها، أختها التي فقدت التواصل معها ولا تعرف لها مكاناً. لذلك، تحاول سيتا جاهدة معرفة مكان أختها، وتخشى عليها الموت أو أن تكون قد اقتيدت إلى أحد المواخير، لكنها تعثر عليها في آخر الرواية بعد أن تلعب المصادفة دوراً مهماً في لقائها، حيث تعمل ممرضة في المستشفى الأمريكي.
محو الهُوية
تناقش الرواية مفهوم الاستلاب بقوة كاشفة عن سلب الهوية الأصلية وإحلال هوية أخرى محلها ما يبين عدم قدرة مجتمعات الماضي على التعايش مع هويات أُخَر مخالفة لها في الدين والعادات والتقاليد، وهذا ما رصدته الكاتبة في حكاية الفتاتين وسلطان الحبشي. إن هذا الحدث الصادم لكل الأبطال أدى إلى أن يُسلبوا من أوطانهم، ويُستعبدوا، وهو ما أدخلهم في عملية إعادة تشكيل الهوية، بدأ بتغيير أسمائهم ودياناتهم وأزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم، كي يتأقلموا مع المجتمع المضيف، وينسجموا مع بنيته بعيداً عن فكرة تقبل المجتمع المضيف لاختلافاتهم الإثنية والعقائدية. وبالطبع، القدرة على إدراك اختلاف الآخر والاعتراف به، لم يكن أمراً مطروحاً على نحو دائم في المجتمعات القديمة، ولم يكن ثمة استيعاب حقيقي لفكرة الاختلاف الثقافي وتقبله.
استدعاء ذاكرة غير محكية
قدمت الرواية قصص الأبطال، كل بصوته الشخصي عبر ضمير المتكلم، الذي منح السرد مصداقية وموثوقية أكثر، فقد كشفت كل شخصية قصتها بصوتها، والظلم الذي وقع عليها، ومحاولات طمس الهوية ومحوها، لتأتي الذات وتعلن عن نفسها بلغتها وأسلوبها وطريقة استدعاء حكايتها. هذه الأصوات السردية جاءت بمنزلة شهادات سِيَر ذاتية لكل بطل يسرد ما تعرض له من أحداث عنيفة، وكيف استطاع كل منهم الوصول إلى طوق النجاة والاستمرار في حياة كريمة، بعد أن انتُزعوا من أوطانهم عنوةً وظلماً. تبين ثريا البقصمي أنها استلهمت القصة المبتورة من حكاية والدتها التي أخبرتها أنها شهدت البطلة وتعرفت قصتها وقصة أختها، لكن حسب القصة لم تلتقيا. حاولت الكاتبة أن ترمم هذا الجرح، وتكتب الحكاية، وتسد هذه الفجوة العاطفية لديها كمتلقية متأثرة بالحكاية الشفوية، ولم تشفَ من فكرة عدم التقائهما وجعلهما تلتقيان في نهاية الرواية.
العنونة ودلالة التفاحة المعكوسة
تدور الحكاية حول المهمشين والسبايا، وترصد على نحو أكبر معاناة المرأة عندما تكون سبية مغلوبة على أمرها، لا كالرجل الذي يكون أجيراً مملوكاً فحسب، بل إن المرأة تكون مملوكة ومغتصبة، محاطة بعار العبودية وعار فقدان الشرف. من هنا، يتضح مغزى العنوان ودلالته «تفاحة في هودج».
تشتغل الروائية على دلالة التفاحة في الإرث الديني والمخيلة الشعبية والأدبية، حيث تبرز صورة المرأة الآثمة التي تقود الرجل إلى الخروج من الجنة. ومن ثم، تتضح تمثيلات المرأة في الأدب، الشهية كتفاحة، وتتحول سمعة المرأة إلى صورة التفاحة المكشوفة، لتفسد على نحو كامل، ثم تبور. في الرواية، نلاحظ أن الفتاة حينما تخرج من حضن أسرتها اختطافاً، تتحول إلى مشروع تفاحة فاسدة، حيث تغدو جاريةً في هودج، تُساق إما إلى دور النخاسة، وإما يكون قدرها أكثر كرماً معها فتحظى بزوج ميسور الحال. وبدلاً من حواء التي تقود إلى الخطيئة تصبح المرأة سلعة جاهزة لخطيئة الرجل: قاطع الطريق، التاجر، النخاس، الرجل المزواج.. إن لكلمة هودج دلالة تاريخية تربط الماضي بالحاضر، إذ تذكر بإن المرأة معرضة لأن تكون سبية في أي وقت.
تشتغل الكاتبة على دلالة العنوان كثيراً، فتتحول دلالة التفاحة في الرواية إلى معنى ثانٍ تشير فيه إلى التفاحة التي قُسمت إلى نصفين، سيتا وأختها، إذْ تكمل كل واحدة منهما الأخرى؛ سيتا بمرحها ومشاكستها وحبها للحياة، وأختها بعقلها وهدوئها واتزانها. تشتغل الرواية على فكرة البحث عن الآخر، الأخت، والحنين المتزايد إليها، ويبقى هذا الخيط العاطفي يمتد في الرواية، حيث تبين الساردة: «أختي سيتا جزء مني؛ لقد تقاسمنا الرحم نفسه. هي تشبهني حد الدهشة، كأننا تفاحة قسمت نصفين».
ختاماً، ترصد الرواية بفضاءاتها المتنوعة المفارقة الحادة بين البطل سلمان، الذي استطاع أن يختار مصيره ويتحرر من أسر العبودية، في حين تشكل صورة التفاحة رمز المرأة التي قد يحولها الخروج من أسرتها مسبية إلى تفاحة شهية في أعين قطاع الطرق وأصحاب المواخير، وفي أفضل حالاتها جارية لدى سيدها.
كاتبة كويتية