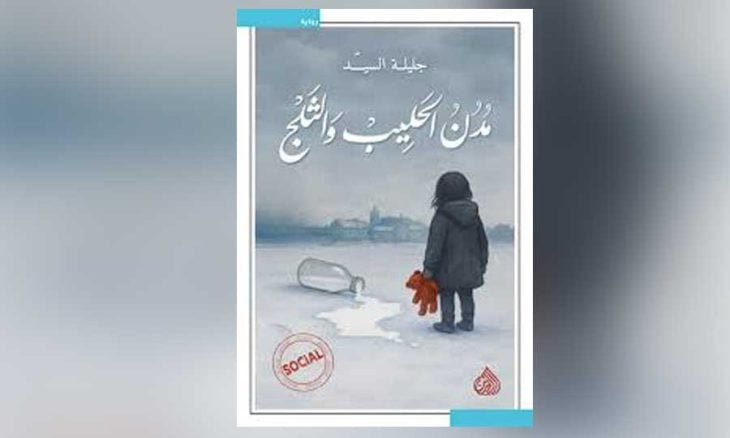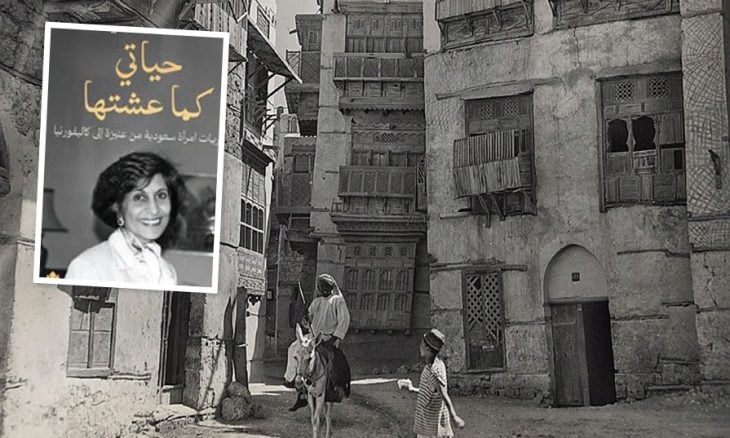«ضدّ الوحدة» مجموعة الشاعرة المغربية فدوى الزياني: حضور النسق وقمع الأبوة والأعراف
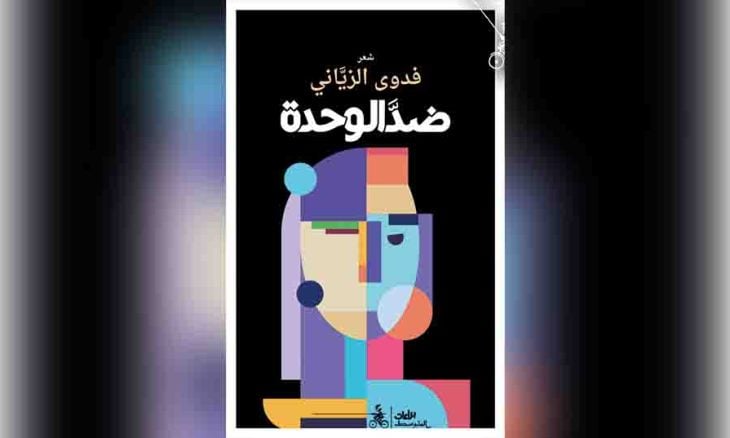
«ضدّ الوحدة» مجموعة الشاعرة المغربية فدوى الزياني: حضور النسق وقمع الأبوة والأعراف
عادل ضرغام
في ديوانها «ضدّ الوحدة» تنطلق الشاعرة المغربية فدوى الزيّاني وفق محددين كتابيين: الأول ذاتي، والآخر جمعي يرتبط بنسق أو بشريحة محددة، فنصها الشعري ينضوي – وإن كان ذاتيا في الأساس – داخل سياق جمعي مشدود ومؤسس داخل الشريحة النسوية التي يتأسس لها بفعل الزمن وطبقاته المتوالية نمط أو إطار خاص يكيّف وجودها وحركتها. فنصوصها تشكل انحيازا داخل انحيار، وتعاني قيدا داخل قيد عام، فتتوالد في إطار ذلك معضلة داخل معضلة كبيرة. وبوسع القارئ أن يلمّ شتات جزئيات وطريقة محددة في المقاربة والتناول، لكي تصبح واضحة الدلالة لتوليد فروق وسمات، تساعد لقبول مقترح يشير إلى أن هناك كتابة، يمكن أن نطلق عليها (كتابة نسوية) ربما تكون ماثلة في مساحة الاهتمام، وطبيعة التوجه، وآلية التناول والمقاربة.
يتجلى السياق العام الذي تنضوي في إطاره، بوصفه دائرة أكبر، وسياقا للاحتماء بفضاء تتسم مساحته بالضيق. فتعدد الوسائل التي تكتب عليها شريحة الرجال في نص (لمن تكتب الرسائل؟) بداية من الطاولات، ومرورا بالجدران الخلفية للأقسام، وأسوار المدافن، وحصى الطريق، وانتهاء بالكراسي الخشبية في الحدائق العامة، يمنح امتيازا لا يتاح لأصحاب الشريحة الأخرى التي تتجلى في اطر خيار واحد يتمثل في جدار المطبخ. فالنص هنا يشير إلى أفق مغلق شديد الذاتية والتعقيد، لأن حدود البوح الذاتي تظل داخل حدود راهنية مكانية وحيدة، مما يؤسس للكبت والقمع.
والكتابة الشعرية في نصوص الديوان انفتاح على الباطني المتواري الذي لا يفصح عن نفسه بشكل مباشر، بل يتجلى في جزئيات متفلتة، ومن خلال تكرار دوري في النصوص، دون كبير انتباه للحدود الفاصلة بينها، فكأن النصوص تفسر بعضها، وتتكامل فيما بينها، للكشف عن فضاءات مختزنة مقموعة داخل الخيار الوحيد، ومن ثمّ فهذه الجزئيات تشكل مساحة إضاءة وكشف وتفسير وتأويل بتوازيها البنائي، وبتكرارها.
رصد الذات وحضور النسق
القارئ للديوان يدرك أن إشكاليات الذات – بالرغم من خصوصيتها – لا تنفصل عن خصوصيات النوع البيولوجي أو النسق الأنثوي، فهناك رصد للذات في أزمتها، وهناك رصد للنسق في سياق وضعيته وتأطيره في إطارات خاصة، في ظل حضور النسق المهيمن المقابل. ففي نص (ثقب في الحائط) نجد أن هناك رصدا للنسق النسوي، من خلال الكشف عن المستور والمخبوء الذي لا يظهر بشكل مباشر، ولكنه يتجلى من خلال إشارات خافتة تحتاج إلى التجميع، ووضعها في بؤرة الاهتمام والتركيز، منها قمصان الأطفال الخالية من الضحكات، وهي إشارة أولى للتعبير عن الأزمة التي تتجلى في سياق بصري بعيدا عن الصوت والشكوى. وتكتمل حدود الصمت من خلال المراقبة والملاحظة لنسق عام لا ينفصل عن الذات (والثوب المجعّد لربة البيت- يكشف جراحا مبطّنة- وعلى يديها آثار حرب- بدأت ولم تنته بعد).
يؤسس النص مقاربته من فعل المراقبة الصامتة للشريحة بشكل عام، يعاين الموت البطيء داخلهن، نتيجة لغياب النسق المقابل في صناعته فخاخ الاصطياد. ولكنهن لا يأخذن اتجاها مشابها لاتجاه الرجل، فبابهن مغلق أمام القتلة، وأصحاب الدين، وبائعي الضرائب الذين لم يستطيعوا دخول البيت لعدم وجود ثقب في الجدار (وهي استعارة دائمة الحضور ومتعددة الدلالة في النصوص) لكنها تتمحوّر حول التباين مع سلوك النسق الذكوري المقبل، أو التباين مع حال الخراب والغرق الموجودين.
يوجّه الانضمام داخل هذا التوجه الصامت نحو الموت البطيء المشوب بالغفران، بوصفه استراتيجية ذاتية للتعامل مع سلوك النسق الذكوري. وهذا يفسّر حضور الالماح إلى خيارات أخرى لشاعرات سابقات، لم تتم الإشارة إليهن بشكل مباشر، وإنما من خلال إيماءات تجعلنا وجها لوجه أمام خيارات الانسحاب المتاحة (لم تملأ جيوبها بالحجارة بغية النجاة) أو (لم تضع رأسها في فرن- طائعة). فالذات المرتبطة بنسق أو مجموع تعاين خيارات أو توجهات سابقة.
يعاين القارئ الطبيعة الخاصة للشريحة المحددة، حيث تتشكل إطاراتها من الرماد والعجلة والخفة والصمت والتيبس داخل الوحدة، ويتجرعون اليأس بسبب البون الشاسع بين المتخيل الجزئي وما يجدونه واقعا فعليا، فنراهم على حدّ تعبير النص الشعري يمدّدون أية لحظة انتشاء إلى أقصاها، بوصفها حالة من حالات الأبدية الجزئية، فهم لإحساسهم بانعتاقهم الجزئي أو اللحظي (يخشون العودة إلى البيت). التعبير عن النسق أو الشريحة التي تنتمي إليها تتولّد في بعض الأحيان في النص الشعري من صياغة مغايرة من خلال ضمير الغياب، حيث تصبح الذات والنسق داخل حيز المراقبة والمقاربة. في نص (يحسبونها جسدا) هناك تقابلات وتوازيات بين الجسد والجثة بالرغم من وجود فروقات كثيرة وثيقة الصلة بالمنحى الذي يمرّره النص، فالجسد علامة صحة وحياة، والجثة إشارة للموت وبداية التحلل. وهناك تصوير للرغبة التي تتحوّل إلى تفاحة ثالثة بجوار تفاحتي الصدر، وفي ظل ذلك يمكن أن نعيد قراءة النص انطلاقا من العنوان والفروق بين الجسد والجثة، ومن ارتباط هذا النص بنصوص أخرى في الديوان، مثل نص (تعلّم كيف تموت)، ففي النصين إبدالات بين الحياة والقبر من جانب، والجسد والجثة من جانب آخر، فكأن الحياة وفق هذا التصوّر بالنسبة للذين يرهقهم الحب شبه قبر ممتد، يجهز للقبر القادم الذي يتنظرهن، يقول النص:
«هذه البيوت الضيقة
هذه العزلة الخانقة
هذا الحجر البطيء
كلها تجارب
تحت وطأة الإكراه
كي نتعلم أخيرا
كيف ننام في حفرة تحت الأرض»؟
تكشف نصوص أخرى في الديوان عن علاقة ملتبسة بالجسد، كما في نص (كلمات خضراء)، حيث يتحوّل إلى شيء تقوم باجتثاثه وتقطيعه، ورميه قطعة قطعة إلى قطط شاردة، وفي ذلك ارتباط وانشداد إلى الشبيه في الاغتراب والتشظي من جانب، ومن جانب آخر يتساوق مع التحلل التدريجي، والتسليم الهادئ، للوصول إلى النهاية والعدم أو الموت الصامت. ففي نص (أغنية للتعاسة) هناك جنوح لتأسيس خصوصية ذاتية، ترتبط بالسمات الظاهرة المسدلة عليها، بداية من العدمية، ومرورا بالهوس والاكتئاب، وانتهاء بالتمسك بالنشوة المختلسة، ومحاولة استبقائها، بوصفها ملامح لاستيلاد أبدية جزئية في مقابل الواقعي.
ويتجاوب مع حالة المواجهة العارية مع الوجود والألفاظ الدالة على الأشياء، توجه جديد يعود بالذات الشاعرة إلى الفطرة الأولى المأخوذة بحياة البداوة، فيعتمد النص على مقارنة لافتة بين حياتين، مع الانحياز للبداوة في مقابل المدن والحضر. فالنص الشعري (أوهام المدينة) يؤسس بنيته على نسق التقابل المستمر بين جزئيات مرتبطة بالبداوة مثل زهرة (الديس) وشجرة (الطلح)، و(النخيل)، و(ناي الراعي)، و(أثر النباح على الرمل)، و(خط المواويل على الرمل) في مقابل (زهرة الجرانيوم)، و(نباتات الزينة)، و(رسائل الواتساب).
الجسد وقمع الأبوة
في نصوص الديوان هناك انفتاح على جزئيات معرفية لافتة، تتجلى بمنطلقات خاصة، أهمها الجسد وإطاراته الخاصة، حيث تجلى في المعاينة المشوبة بالخوف والاستغراب. فقد كشفت النصوص عن هذه العلاقة الملتبسة بالجسد، فمع مرحلة النمو وظهور العلامات الدالة على النوع البيولوجي والشريحة يتولّد نوع من الخوف المرضي، يؤسس لنسق وطبيعة العلاقات مع الآخر على الطرف المقابل، ويظل ذلك مؤثرا.
إن أزمة الجسد تأتي في نصوص المجموعة مرتبطة بالعنف الأبوي، ليس العنف بمعناه البسيط المعهود، ولكن العنف الذي يحدد ويشكل النمط الذي يجب على الذات أو الذوات التي تنضوي في كنفه، أن تتشكل في إطاره، فهو عنف أقرب إلى الابتسار نحو الجاهز العرفي، أو عنف يفرض محددات السلوك والحركة.
في نص (استنكار أخطأ توقيته) نجد أول تجل واضحا للفاعلية الخاصة بالأبوة، من خلال صورة (الدمية) التي تشكلها وتحدد مسارب حركتها الأيدي الخشنة: (إنني كائن خفيف – وكل هذا الألم الذي تستلذونه – ليس سوى نشارة لدمية خشبية – تستنكر ماضيها في الوقت الخطأ). النص يمثل سيرة مرتبطة باللحظة الآنية، ومن ثم فهي تتشكل وفق ارتدادات كثيرة للماضي، ارتدادات مشفوعة بالقراءة والتفسير وفق لحظة مغايرة، حيث تشير إلى ندوب الذات التي لا تمحى، بل تترك أثرها في الحركة والتوجه، وفي الثبات بسبب ميراث قديم من الخوف.
وفي ظل الفهم السابق يمكن تفسير الصور التي تشكّل نتيجة طبيعية لهذا التكوين المبتسر الخارج عن سياقه الذي يكشف عن ملامح تشكيل تأسس بالقوة والعنف، في مقابل التجلي الطبيعي المختزن والمقموع. يتجلى ذلك في صور عديدة كاشفة عن الصراع أو العراك الداخلي.
الأبوة في تصورها الواسع، لا تقف عند حدود الشخص المعهود والمتجسد، كما تجلى في بعض النصوص بشكل لافت، فالأبوة في مجمل نصوص الديوان لا تقف عند عنف التشكيل الجاهز المنمط القائم على الأعراف، حيث يلحّ الأب حاضرا من خلال قيامه بدور خاص، بوصفه الشخص الذي تترك له حراسة النمط واستمراره فاعلا، بل تتوجّه الأبوة في بعض النصوص إلى أب غير حي، يتمثل في مجموعة الأعراف والآليات المرتبطة بثقافة محددة، وهي تمارس دورها وفق التحديدات الجاهزة المستقرة لكل نسق أو قسيم، وخاصة نسق المرأة، فتجد نفسها داخل هذا النمط متجذرة فيه بعيدا عن توقها الطبيعي.
وفي ظل ذلك الفهم يأتي اهتمام النص الأخير من الديوان مرتبطا بالصفر الذي يمثل عراء، ومساحة وقوف وبلبلة وانطواء، واختيارا للكمون، فالصفر في النص الشعري:
«بقعة عمياء يتخبّط فيها الأمل
لمعة الوعي في بطء البديهة
نية المسافر قبل بدء الطريق
الصفر بؤبؤا عينيك الضيقتين
حين غادرتا إلى البعيد
الصفر التواء ضلعين في صدري
يئنّان حين أضاعا
دورهما في العناق».
فالصفر فوق كل ذلك- ونتيجة له – يمثل غيابا للقدرة على الحركة أو الفعل، وغيابا لبراح الاختيار، وحضورا للتوزّع الذي يفضي إلى الثبات، والسبب يعود إلى وجود ذاتين: إحداهما مؤسسة ومسيّجة بالحركة داخل المجموع والسياق، والأخرى يتأسس وجودها في انفلاتات إبداعية داخل راهن خيالي، تسيطر فيه سيطرة جزئية، لكنها سريعا ما تعود مقهورة مقموعة داخل حدود النمط بصلابته، وداخل عنف الأعراف.
فدوى الزيّاني: «ضد الوحدة»
المتوسط، ميلانو 2023
102 صفحة.