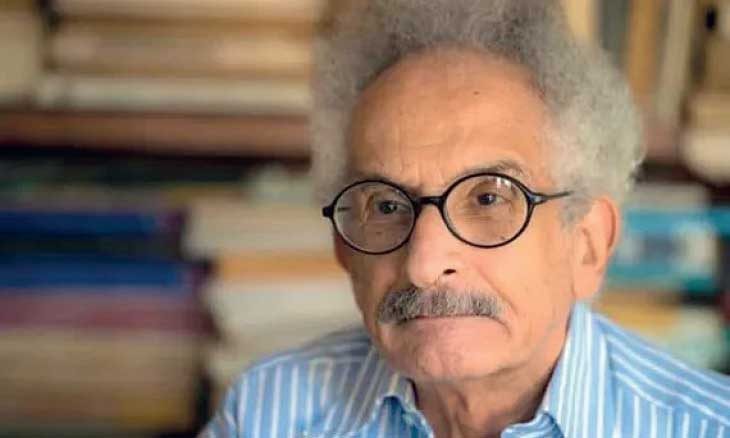فلسطين في وجدان المغاربة: تبدُّلات الوعي الشعري في علاقته بالقضية

عبداللطيف الوراري
وجدان مغربي
ظلّ وجدان المغاربة، لاعتبارات دينية وقومية وإنسانية، مُرْتبطا بأرض فلسطين وحاضرتها القدس. وتمثل حارة المغاربة على سور البراق عنوان هذا الارتباط وسنامه المعلى، إذ تحوّلت إلى ميدان صمود ومرابطة ومهوى روح يقصده الحُجّاج في رحلاتهم الحجّية إلى الحجاز. ولهذا، فالعلاقة بينهم وبين أرض المعراج تحوّلتْ إلى مسألة روحية ووجدانية في المقام الأول، واصطبغت بمعاني الألفة والإخاء وواجب الدفاع والنصرة في مراحل حاسمة من التاريخ القديم، أو الحديث الذي يرجع إلى عهد الحركة الوطنية المغربية، ولاسيما بعد اندلاع أحداث «حائط البراق» عام 1929، حيث لم يفتر رجالاتها (علال الفاسي، عبد الملك كنون، محمد حجي، المهدي بنونة، عبد الخالق الطريس) الذين تبلور وعيهم السياسي والقومي بالقضية، عن نصرة فلسطين في محافل الرأي العالمي والدفاع عن عروبتها، وجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين، مثلما عملت على تمتين أواصر شبيبة الجيل الجديد بها من خلال إرسال وفود طلابية إلى بعض حواضرها مثل القدس والخليل.
يمكن أن نقيس درجة هذا العلاقة وصورها وأبعادها المعبّرة والكثيفة في كتابات المغاربة وأفكارهم وفنونهم وتعبيراتهم الإبداعية المختلفة (الرحلة، الشعر، القصة، الرواية، المسرح، التشكيل، السينما، الأغنية الغيوانية)، بل كذلك من خلال مخيالهم الشعبي الذي كانت تغذيه جملةٌ من الصور والتمثلات عن القضية الفلسطينية وأطوار عذاباتها، وفصول المرويّات الفدائية والمشاهد المأساوية التي تنقلها إليه وسائط العصر الحديثة، منذ أن صدرت بعد النكبة جريدة اسمها «فلسطين» التي لم تكن تنشر إلا ما له صلة بقضية فلسطين، ثم جريدتا «المحرر» و»الاتحاد الاشتراكي» تاليا، حين كانتا تخصصان أسبوعيّا صفحة خاصة بفلسطين ويوميات الكفاح الذي يخوضه شعبها ضد الصهيونية والإمبريالية.
وقد واكبت نصوص الإبداع المغربي الحديث ومؤسساته الطليعية (هيئات، مهرجانات، مجلات)، ولاسيما بعد عام النكسة، أطوارَ القضية الفلسطينية، وتفاعلت مع ما كانت تشهده من بطولات الكفاح والمقاومة، أو من مشاهد دراماتيكية نتيجة ميزان القوى الراجح لصالح العدوّ الصهيوني، وسط تشرذم المحيط العربي واستخذاء نخبه السياسية والثقافية. فكان ما يجري في المشرق العربي عموما، وفي فلسطين على وجه خاص، من رغبة في التحديث والتحرر من الاستبداد السياسي وتجاوز آثار الهزيمة والتأخر التاريخي بعد الاستقلال الوطني، يجد صدى قويّا عند طلائع الأنتلجنسيا المغربية.
فمن جهة أولى، كانت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، التي تأسست عام 1968، وضمّت في نسيج أطيافها مفكرين، وأدباء، وساسة، ومحامين، وأطباء، وأساتذة، وطلبة وعمال، تحشد – على مدار عقود- مظاهرات مليونية للتعبير عن روح الإجماع الوطني مع فلسطين، وعن التضامن الشعبي مع شعبها من أجل قضيته الإنسانية العادلة. مثلما بادر اتحاد كتاب المغرب منذ مؤتمره الثاني الذي انعقد في يوليو/تموز 1968 في الرباط، إلى دعم الكفاح العادل والمشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، وإلى مقاومة الخطر الصهيوني وفضح أساليبه العنصرية. واختارت جمعية أصدقاء المعتمد أن تكون فلسطين موضوع مهرجان الشعر المغربي في دورته الثالثة، وهو اختيار يعكس إيمان الشعراء بالقضية وضرورة التزام القصيدة الحديثة بالدفاع عن الحرية ونصرة المظلومين والتطلع إلى تحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية. وكرست مجلة «أنفاس» (العدد 15 صيف 1969) عددا خاصّا من أجل فلسطين، تزينه ملصقات عن آلامها وتوقها إلى الحرية لفنّانين؛ من أمثال: محمد حميدي، وعبد الله الحريري ومحمد المليحي ونور الدين النوري وغيرهم. ودأبت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، بعد تأسيسها عام 1973، على إقامة أسابيع السينما الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض في عدة مدن مغربية، مثلما عملت مجلة «سينما 3» التي كان يديرها نور الدين الصايل على التعريف بالقضية ضمن احتفائها بسينما العالم الثالث ونزعاتها التحررية.
ومن جهة أخرى، كان الأديب المغربي على اختلاف توجهاته الفكرية وقيم إبداعه الجمالية، ما فتئ يُعبِّر عن روح ارتباطه بأرض فلسطين ويتغنى برموزها وتضحياتها الجسام من أجل الحرية، سواء في الشعر (إدريس الجاي، محمد الوديع الآسفي، عبد الرحمان الدكالي، عبد القادر المقدم، مصطفى المعداوي، محمد الحلوي، عبد الكريم الطبال، محمد أبو عسل، حسن الطريبق، مليكة العاصمي، محمد بن دفعة، محمد علي الهواري، علي الصقلي، أحمد بنميمون، حسن الأمراني، إدريس الملياني، جلول دكداك، محمد مستاوي)، أو في القصة والرواية (عبد المجيد بن جلون، عبد الكريم غلاب، مبارك ربيع، محمد الهرادي، أحمد المديني، خناثة بنونة صاحبة رواية «النار والاختيار» (1969) التي عالجت القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وجود، واستطاعت أن تؤثر في أجيال من المتعلمين بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية تدريسها في التعليم الثانوي سنين عددا، وغيرهم)، أو في المسرح (عبد القادر البدوي، عبد الكريم برشيد، مولاي أحمد العراقي، محمد مسكين، ثريا جبران، عبد الحق الزروالي).
الخيال السياسي
يستطيع قارئ ديوان الشعر العربي الحديث أن يتبين كيف أنّ جرح فلسطين ظل يجري نازفا بين صفحاته، فلم تقدح قضية قومية قرائح الشعراء المحدثين وتلهم ثمرات خيالهم وفنّهم، كما فعلت مأساة القضية الفلسطينية التي «منحت الأدب العربي ديوانا دمويّا ضخما»، إذ «هزّتْ أهوالها ضمائر الشعراء العرب وأوحت إليهم بصور شعرية لا نهاية لها» على حد تعبير صالح الأشتر؛ بعد أن حظيت أحداث فلسطين باهتمام متزايد على مرّ السنين من قبل العرب وشعرائهم، بلغ أوجه في العالم العربي إثر النكبة. وهكذا أخذت تحضر فلسطين بثقلها التاريخي والديني وأيقوناتها الرمزية في نصوصهم الشعرية، على تباعد أوطانهم واختلاف مرجعيّاتهم الفكرية والجمالية. بيد أنّها «تتجوهر» في القدس لما تُمثِّله من زخم تاريخي وحضاري عظيم؛ فلا ينطق أحدنا باسمها اليوم حتى تتداعى الأفكار، وتنهال الأشجان وتتوالى صور المأساة التي حلّتْ بها، وتتفجر قرائح الشعراء كحمم بركانية، تجسد الثورة العارمة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، لم تفارق فلسطين متخيل الشعر المغربي في كلّ تاريخه الحديث، بل إنّنا نجد الشعراء المغاربة يتغنّون بها وبحاضرتها القدس في قصائدهم منذ أواخر القرن التاسع عشر، ثم لازمت أصالة وعيهم الديني والقومي وموقفهم الصريح منها؛ حين جعلوا من المسألة الفلسطينية عبر أطوارها المفصليّة؛ بعد وعد بلفور المشؤوم وقرار التقسيم، ثم هزيمتي 1948 و1967 وما تلاهما من انتكاسات جذرية وآلام باهظة لم تنقطع إلى اليوم، في صميم اهتماماتهم الإبداعية التي اتخذتْ صِيَغا وأبعادا وحساسيّاتٍ متنوعة، وتطوّرتْ بِتطوُّر اتجاهاتهم وأساليبهم في الكتابة والوعي الحديث بشرائطها الفنّية. فالشاعر المغربي بقي محافظا على أصالته الفنية، وعلى صدق عاطفته يستوي في ذلك الشعراء المخلصون للعمود الشعري، وشعراء المدرسة الحديثة، وإذا كان هناك من اختلاف بينهما، فهو اختلافٌ اِستوجبه التكوين الثقافي، واستلزمته النظرة الخاصة لكل فريق إلى أسباب الهزيمة. ولهذا، ما كُتب عن فلسطين في ديوان الشعر المغربي، وعن حاضرتها القدس، على مدار قرن من الزمن، يستغرق صفحات طويلة منه، إلى درجة أن تصلح لقياس ما يمكن أن نصطلح عليه بـ»الخيال السياسي» لدى هؤلاء الشعراء، بالنظر إلى كون القضية الفلسطينية تمثل «ترمومتر» الوعي الذي لازمهم وعبّروا عنه موضوعاتيّا وجماليّا بطرائق متنوعة.
تجليات الخطاب
بوسعنا لتمثيل منحنيات هذا الوعي في علاقته بالقضية الفلسطينية، أن نميز بين ثلاثة تجليات من الخطاب الشعري، تحدد طبيعة اشتغال الموضوع الفلسطيني وأشكال استدعائه وتأديته فنّيا، إذا أخذنا في الاعتبار تمايز الشعراء من حيث مصادر نهلهم الفكري ومواقفهم وانتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، ثُمّ وَقْع المأساة ـ قبل هذا وذاك- على نفسياتهم قبل هزيمة 1967 وبعدها بشكل أثّر على الرؤيا الفكرية والمنظور الشعري.
يتمظهر الموضوع الفلسطيني عند شعراء النهضة، أو الإحياء من النيوكلاسيكيين، باعتبار ثيمة رئيسية، أو أحد الأغراض البارزة داخل الاتجاه القومي أو الالتزامي الذي كانت تغذيه البلاغة الكلاسيكية في ثوبها الإحيائي أو الإصلاحي ضمن «القراءة الوطنية»؛ حيث كان الشعر جزءا من المعركة ضد الاستعمار، وكانت بلاغته تقوم على استحضار الماضي المجيد لإدانة الحاضر. فازدياد الشعور القومي، والوعي بالمصير المشترك لمواجهة السياسة الاستعمارية الإمبريالية ونشدان السلام والحرية في أجلى معانيها، عدا الآصرة التليدة مع بيت المقدس، هو من جملة ما أملى على شعراء هذه المرحلة الاهتمامَ بما يجري في فلسطين، وفي القدس بخاصّةٍ، ممن كانوا يتابعون الأحداث التي بدأت تترى بعد وعد بلفور الذي كان يستهدف «تهويد فلسطين». ولم يكن هذا الاهتمام يخلو من عاطفة دينية أو اندفاع ثوري مشوب بنزوع غنائي أو خطابي عارم، يعكس المخاض النفسي الذي يموج بألوان الغضب والأسى والحيرة في وجدان الشاعر المغربي، وقد تواتر ذلك بشكلٍ جليٍّ بعد فاجعة النكبة التي دوّتْ أصداؤها فيه، إلا أنه لم يجد بُدّا من الدعوة إلى تجاوز الهزيمة واستنهاض الهمم وبعث الحميّة الدينية في النفوس، بل إلى الجهاد في سبيل نصرة فلسطين وتحريرها من الصهاينة الغاصبين، مُشيدا بنضالات الفدائيين من أبنائها.
ثم يأخذ هذا الموضوع مظهرا آخر مُغايِرا لما سبق في لهجته ورؤيته الفنية، بل يكتسي أبعادا ثورية في الغالب، وذلك بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967، وما أرخته تداعياتها المُدمِّرة من سحب الشكّ واللايقين على خطاب الأنتلجنسيا العربية، بموازاة مع بروز جيل شعري ذي كفاءة جماعية، غاضب وساخط من الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلده، ومتفاعل مع التغيير الاجتماعي المنشود، حسب الانتماء السياسي والتكوين الفكري لشعرائه، تحت تأثير الأيديولوجيا العلمانية من جهة، والانحياز إلى تعبير حداثي عن القضية الفلسطينية، بما هي قضية وجود، خارج ترسيمات البلاغة التقليدية. وقد انفتح هؤلاء الشعراء من جيلي الستينيات والسبعينيات على حركة الشعر الحر واستحقاقاتها التعبيرية والبلاغية في المشرق، وعلى شعراء الموقف السياسي الالتزامي من ذوي الاتجاه القومي أو اليساري التحرري العالمي (لوي أراغون، غارسيا لوركا، ناظم حكمت، بابلو نيرودا) وشعراء الأرض المحتلة (إبراهيم طوقان، علي هاشم رشيد، محمود درويش، توفيق زياد، معين بسيسو، فدوى طوقان، أحمد دحبور، سميح القاسم).
منذ التسعينيات إلى اليوم، أخذ الموضوع الفلسطيني يتوارى نصّيا على مستوى الخطاب، بعد أن خفت المدلول لصالح الدال، أو تراجع التوظيف الشعاري – الأيديولوجي للشعر وقضاياه المضمونية لصالح مطالب قصيدة النثر والشعر الصوفي والمبادرات التجريبية التي اهتمّت بصيغ الكتابة الشعرية وجماليات الشكل الفني بوجه خاص. لم يعد يهمُّ «ما يقول» هذا الشعر الجديد، بل «كيف يقوله»، مُتحرّرا من قيود الأيديولوجيا التي هيمنت في السابق، ومن لغة الهتاف والتبشير بالذي يأتي ولا يأتي. كان رهان الشعراء الجدد في ما يكتبونه هو الانفكاك من الأيديولوجيا التي أمست عبئا على الكتابة الشعرية، وتحرير الذات من مستتبعاتها الباهظة وإطلاق إمكاناتها الجماليّة المكبوتة.
وبهذا الوعي الجذري، دخل هذا الشعر في مرحلة صمت حينا، وتلميح وتجريد حينا آخر، في علاقته بالقضايا الوطنية والقومية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، التي لم يعد ينظر إليها باعتبارها قضية قومية وسياسية بحصر المعنى، بل هي قضية أخلاقية في المقام الأول، تستلزم أفقا للتفكير وإعادة النظر في محتواها وفي ما تقتضيه من ضرورة البحث عن سيرورة شكل جديد لا تكون القضية عبئا عليه.
كاتب مغربي