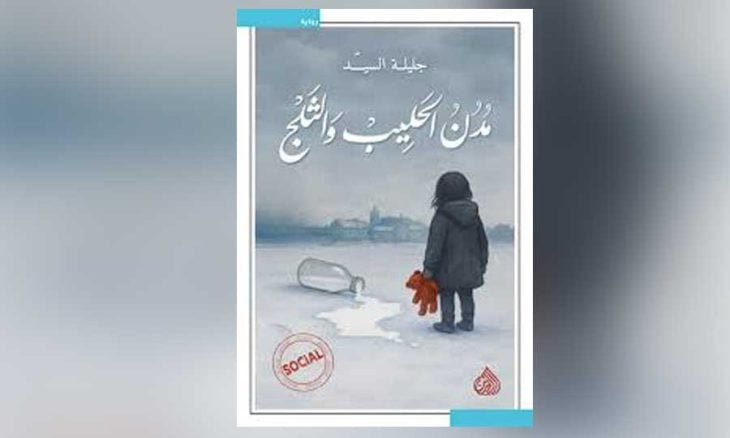السؤال الغائب رغم أنه معلَّق في الفضاء

إبراهيم عبد المجيد
رحلة الأديب والفنان يعرفها من كابدها. وأستخدم كلمة المكابدة هنا ليس إشارة إلى الإبداع نفسه، فهو على العكس من أجمل ما يعطيه الله لعبد من عباده. الإبداع يكلفك اختيارات جميلة منها العزلة أثناء الكتابة. لا يشعر بها الكاتب أو الفنان لأنه يكون في عوالم أخرى، مع شخصياته وطريقة كتابته أو رسمه أو نحته، إذا ابتدع تمثالا أو غيره من مظاهر الإبداع. لحظات قليلة يعرف فيها أن هناك عالما آخر حوله، فالعالم الحقيقي هو ما يبدعه. طبيعي ألا ينشغل اليوم كله وينتبه إلى ما حوله في ما بقي من وقت.
تبدو العودة طبيعية لكن يظل في الروح شجن ورغبة في العودة الأخرى إلى عالمه، فنادرا ما ينتهي العمل الأدبي في يوم واحد، حتى لو كان قصة قصيرة فقد تدعوه لينظر إليها من جديد بعد يوم أو يومين. الإحساس بامتلاك العالم ليس إرادة، لكنه الإبداع نفسه سبب في ذلك. من هنا تأتي الأزمات الروحية لكثير من المبدعين. كيف وقد امتلك العالم حين ينظر حوله، يجده قد صار أكثر رداءة. فلا الحروب تنقطع ولا مصادرة الرأي والاعتقالات، ولا مظاهر الفساد في كثير من جوانب الحياة. الكثيرون يستطيعون تجاوز ذلك والاستمرار. قليلون انتحروا. ليس لذلك فقط لكن لشعور بأنه يتم تجاهلهم عمدا من الآخرين أو من النقاد. قليلون استطاعوا أن يقسموا حياتهم بين الإبداع والفكر، فساهموا بكتاباتهم في كل القضايا الاجتماعية والسياسية بمقالاتهم، إلى جوار أعمالهم الإبداعية. كنت وما زلت واحدا منهم. استطعت أن أجعل الليل للإبداع والنهار للفكر والمقالات، لقد تم ذلك بشكل عفوي في بداية حياتي الأدبية. أدركت أن كتابة القصة والرواية لا تأتي بالإرادة، لكنها تنمو في مكان في الروح فلنسميه اللاشعور، حتى يأتي يوم ينكشف الغطاء عنها بحادثة أو موقف أو ذكرى، فتلح في الخروج.
لم تكن الحياة سهلة والآن طبعا ازدادت صعوبة، تكلفتها لم يكن يكفيها راتبي الذي أحصل عليه من عملي الحكومي. أشار عليّ البعض أن اكتب المقال، فهو عمل إرادي، ونشره سيعود بمكافأة لا تقل عن مكافأة القصة القصيرة وتمضي الحياة. كان يمكن للمقالات أن تسرقني من الإبداع، لكن اتساع وقتي، لأني لم أعمل عملا منتظما، أعطاني الفرصة أن يكون اليوم طويلا أكثر مما يبدو عليه. أضف إلى ذلك أن جيلي أدرك صعوبة ما حوله والكثير من قضاياه بعد هزيمة 1967. صار اليسار نافذتنا والعمل السياسي حتى جاء يوم أدركت الاثر السيئ للسياسة على الإبداع نفسه، فابتعدت عن كل عمل سياسي منظم، لكن ظللت أكتب المقالات إلى جوار القصة.
لم يقفز إلى روحي أبدا سؤال ما الفائدة مما تكتب. كنت على يقين أن هناك قارئا، حتى لو لم أكن أعرفه. كان النشر في السبعينيات، حتى السنوات العشر الأولى من هذا القرن، لا تقل فيه طبعة الرواية عن ثلاثة آلاف نسخة. ناهيك عن مكتبة الأسرة التي كان النشر فيها يصل أحيانا إلى ثلاثين ألف نسخة، فكان نفاد الطبعة الواحدة مصدر فرح كبير. الآن يقف الأمر في الطبعة الواحدة عند ألف نسخة، وبعض دور النشر تطبع خمسمئة نسخة، وأحيانا تطبع مئتي نسخة، وتُكرر الطبعات فتقرأ الطبعة العاشرة، وأنت تعرف أنها عشر طبعات في مئتي نسخة، ما يعني ألفي نسخة في كثير من الحالات. الحمد لله لم أنحدر إلى ذلك. تغير نمط الحياة وغلب عليه الطابع الاستهلاكي الذي جعل البعض يقيمون صفحات مدفوعة الأجر لجمع اللايكات وكلمات الإعجاب. لا يدهشني أن بعض الكتاب يساهمون في ذلك، فالأمر بين الكتاب نسبي. أنا من الذين يعتبرون المتعة كلها في الكتابة، وما بعدها ليس من عملي، لكنه من عمل دور النشر إذا أرادت. مشت معي مقولة قرأتها منذ سنوات بعيدة وأنا في بداياتي، لصنع الله إبراهيم حين سأله صحافي في حوار معه، كيف تفكر أن تبقى أعمالك بعد الموت، قال صنع الله إبراهيم «بعد الموت لا يهمني ماذا سيحدث» الحقيقة أن الأمر يمتد إلى الحياة نفسها، فصنع الله لم يهتم بما سيحدث لأعماله في الحياة نفسها، وترك الأمر للقراء والنقاد.
هو شعور الكاتب الحقيقي، الذي يأخذ متعته كلها في الكتابة. طبعا قد يسألني سائل هنا من محبي تفاهة السوشيال ميديا عن الجوائز وكيف حصلت عليها، متجاهلا الحقيقة التي أرددها دائما، أن كل الجوائز كانت بترشيح من دور النشر، أو جهات ثقافية، ولم أتقدم إليها مباشرة، وكما ينتهي كل شيء انتهت عوائد الجوائز المالية. لكن سؤال ما فائدة ما كتبت يقفز رغما عنك حين تتقدم في العمر، ويكون لديك الوقت أن تنظر حولك أكثر مما تبدع. فكرت كثيرا أن أفعل ما فعله يحيى حقي في سنواته الأخيرة وأتوقف عن الكتابة، لكن لا يزال الله رغم مِحَن الصحة يعطيني القدرة، فلماذا ابتعد عنها، رغم أن لافتة الموت في انتظار كل حي، صارت معلقة في فضاء الغرفة أكثر من الأزمان السابقة. هذه اللافتة التي غابت من قبل أيام الشباب تجعلني استمر في طريقي معلنا لنفسي، وماذا لو حدث هل سيتوقف العالم. ما أنت إلا كاتب أتيت وستمشي مثل آلاف الكتاب، بل إن الكثير من أعز أصدقائك رحلوا، وما زلت تحتفظ بأرقام تليفوناتهم وتشتاق لحديثهم. كانت وما زالت القضايا الحقيقية لي، هي قضايا الوطن حولي في مقالاتي، وقضايا الوجود نفسه في أعمالي. أتابع للتسلية أحيانا المعارك التافهة على صفحات السوشيال ميديا بين بعض الكتاب. هذه المعارك التي لا يمكن ربطها بالعمل الصحافي. في العمل الصحافي هناك مدير تحرير ورئيس تحرير قد يرفض المقال لأنه لا معنى له، أو لأنه ذم وقدح دون دليل، لكن السوشيال ميديا فتحت الطريق لهؤلاء، ولا أدري كيف يغيب عنهم السؤال المعلق في الفضاء، وهو الموت كنهاية لكل حي، فلتغتنم من متعة الإبداع ما يغنيك عن العالم، ولو شيئا من الوقت.
السؤال الذي صار معلقا في فضاء الغرفة أكثر من كل وقت أراحني على عكس ما يمكن أن يتصور أحد، فما أكثر الروايات التي لم يكتبها أصحابها، ولا أنسى مقولة غابرييل غارثيا ماركيز، أن الحياة أقل مما يريد الكاتب أن يكتبه. الموت المعلق عند الموهوبين والعقلاء، حتى إن كان كامنا في اللاشعور، له جانبه الإيجابي، وهو الابتعاد عن المساخر والمعارك الشخصية التي لن يبقى منها شيء.
ليست المعارك التافهة طبعا هي التي تذكرني بالموت المعلق، فلا فائدة لاصحابها من أي عظة تاريخية، لكنها الأحداث في غزة ولبنان والسودان، التي لا يعني بُعدنا عنها أنها ليست أمامنا، وتملأ فضاءنا ونعيشها في ألم. صحيح صارت رافدا لكثير من مقالاتي، لكن هذه المقالات لا تجعلني أنسى. وحتى بعيدا عما حولنا فليقل لي شخص واحد هل تحقق الخلود لأحد. هل عاش آدم أو أي من أبنائه حتى الآن. ترك لنا البحث عن الخلود أعظم الكتابات والملاحم والآثار لكن لم يخلد أحد. الذي عرف الخلود هو الفن والإبداع. وهكذا فالسؤال المعلق في فضاء الغرفة، ينجح من يستقبله من أجل الإبداع نفسه، لا شي شخصيا، كذلك من يكتب الفكر فيكون من أجل الوطن والأفكار، لا تسفيها للآخرين، وإلا سيقفز المعري هنا بقوله:
غير مجدٍ في ملِّتي واعتقادي
نوح باكٍ ولا ترنم شاديِ
وشبيه صوت النعي إذا قي
سَ بصوت البشير في كل نادِ.
حتى يقول:
خفف الوطء ما أظن أديم ال
أرض إلا من هذه الأجساد.
أو المتنبي قبله في قوله:
والموت آت والنفوس نفائسُ
والمستَغِرُّ بما لديه الأحمقُ.
روائي مصري