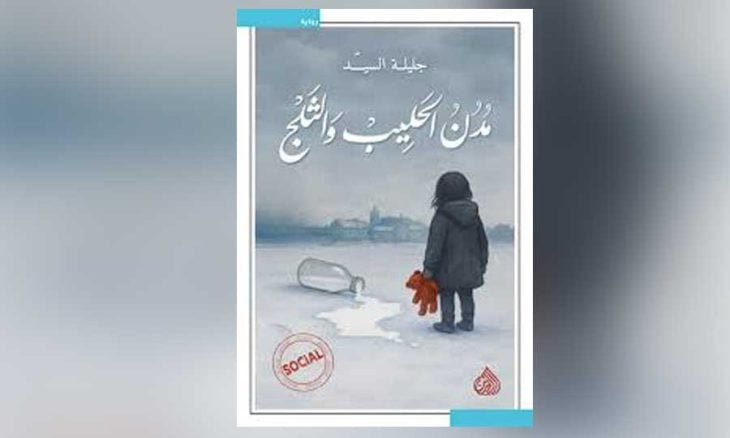بيروت: الذاكرة والعنف في مدينة عربية قلقة

محمد تركي الربيعو
بعد عقدين تقريبا من نهاية الحرب الأهلية في لبنان (1975ـ 1990) تظهر مدينة بيروت هذه الأيام وهي تقف أمام حرب إقليمية، وربما أهلية جديدة. وعلى الرغم من أن هناك من يربط هذا العنف الجديد الذي تشهده المدينة، بتداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة، وما خلقته من اصطفافات إقليمية، وأيديولوجية، لكن في المقابل هناك رأي آخر يرى أن العنف الذي تعيشه المدينة اليوم ناجم بالأساس عن تداعيات الحرب الأهلية السابقة، وأيضا عن المجال السياسي في البلاد، الذي أبقى على أبواب العنف مفتوحة. في كتابه المهم «الحرب القادمة: بين الماضي ومستقبل العنف في لبنان» لاحظ السوسيولوجي سامي هرمز عام 2017، أنه غالبا ما يكون هناك ميل إلى أن نكون أكثر انتباها لأشكال العنف المرئية، حيث يكون حاضرا علنيا.
وفي حالة لبنان، هناك من ظن أن انتهاء الحرب الأهلية كانت بمثابة إيذان بنهاية العنف، في حين يعتقد هرمز أن غياب العنف عن الحياة العامة لا يقضي عليه بالضرورة، وبالمثل، فإن ما يسمى بنهاية الحرب بتوقيع اتفاقيات السلام يقصد منها في العادة إرسال رسالة للسكان مفادها، أن العنف والشر قد مضى، بينما نرى في حالة اللبنانيين أن الشر ببعده المادي، مع بعض فترات العنف وأهمها اغتيال الحريري، اختفى إلا انه ظل يحوم حولهم من خلال حديثهم اليومي عن وقوع الحرب في المستقبل. وفي سياق تفسيره للخوف الدائم لدى اللبنانيين من وقوع الحرب، يعتقد هرمز أن هذا ناجم بالأساس عن سياسات التذكر والنسيان، التي حاولت السلطة اللبنانية فرضها بعد عام 1990. ففي عام 1958 أطلق رئيس الوزراء الأسبق صائب سلام عبارة ( لا غالب ولا مغلوب). ومنذ ذلك اليوم، ظل السياسيون اللبنانيون، وبالأخص بعد الحرب الأهلية، يرددونها كلما حدثت أزمة ما، للقول بأنه يمكن لأي حزب سياسي أو طائفة في لبنان القضاء على أي حزب أو طائفة أخرى، وأن جميع التجمعات السياسية يجب أن تكون ممثلة في النظام السياسي.
وقد اعتبر البعض هذه المعادلة على أنها تروج لسياسة النسيان التي ترعاها الدولة، لكن هرمز يعتقد أن هذه المعادلة خلقت نوعا من العنف الرمزي، كونها أخذت تطالب المسحوقين والمهمشين بضرورة التصالح مع واقعهم كبديل مقبول أخلاقيا في أعقاب العنف، وهو ما يراه بمثابة سياسة ليبرالية مدفوعة بمشروع هوبزي، لإبعاد العنف، حيث يبحث السياسيون عن طرق لمنع الحرب الحتمية، التي ستدمر البلاد، بدلا من ممارسة سياسة أخلاقية للبحث عن الخير للضحايا، وهو ما ينتج سياسة تعلن أنها لن تقبل بأي تغيير بدعوى أنها ستؤدي حتما إلى حرب، وهكذا يواجه المجتمع إنذاراً نهائيا/ إما أنه يقبل الحل الوسط حتى يتم منح الجناة السابقين العفو، أو يواجه الحرب والتهديد بالحرب.

ومع هذا التحليل نرى أن جزءا مما تعيشه بيروت اليوم، ناجم بالأساس عن محاولات بعض الأطراف (وبالأخص حزب الله اللبناني) فرض أفكاره، وسياساته بالقوة، في العقدين الماضيين على كامل المجتمع اللبناني، بدعوى المقاومة وتحرير فلسطين ومواجهة العدو، وإلا فإن الحرب الأهلية هي التي ستكون البديل، ولعل هذا ما يفسر وجود خلاف حاد بين اللبنانيين حول أسباب الحرب القائمة حالياً، إذ ترى أطراف واسعة أن المشكلة الأساسية في لبنان لا تتعلق بما جرى في 7 أكتوبر في غزة، بل تعود إلى كون وجود طرف يحاول فرض رؤيته عن الذاكرة والنسيان (حزب الله) وحلفائه، فهو بدلا من أن يعترف بمسؤوليته عن انهيار مؤسسات الدولة، أو يعود قليلا للوراء للاعتراف ببعض الأخطاء، نراه يفرض رؤية معينة للذاكرة عبر ربط مصير البلاد بتاريخ قدوم إسرائيل للمنطقة، أو أحقية الشيعة في السيطرة على البلاد، كونهم فئة عانت من التهميش لعقود طويلة، وهو خطاب بالمناسبة نراه على ألسنة مؤيده.
ولذلك فإن جزءا من العنف والصراع الذي نعيشه اليوم، يمكن القول إنه ناجم بالأساس عن سياسات الذاكرة التي عرفتها البلاد في العقدين الماضيين.
ويبدو أن هذا الصراع على الذاكرة، وتحوله لاحقا إلى عنف رمزي ومادي في أحيان عديدة، شغل باحثين آخرين عملوا على دراسة مدينة بيروت، ففي كتاب آخر بعنوان «إعادة إعمار بيروت: الذاكرة والفضاء في مدينة عربية ما بعد الحرب» وجدت الأنثروبولوجية أسيل صوالحة من جامعة فوردها، أن البيروتيين بقوا يعيشون كما لاحظ هرمز في حالة طوارئ مستمرة.
وأن هذه الحالة غير المستقرة، لم تعبر عن نفسها فقط من خلال فرض معادلة سياسية ونسيانية معينة، بل أيضا من خلال إعادة إعمار المدينة بعد الحرب الأهلية، التي في رأيها أدت إلى الإبقاء على حالة العنف الرمزي.
وقد حاولت المؤلفة دراسة هذا الجانب في حي عين المريسة، وهو أحد أحياء المطلة على شاطئ المدينة، إذ نرى من خلال قصص الناس التي جمعتها قبل وبعد الحرب، تحولات جذرية في عمران الحي وتصميمه، سواء من خلال هدم المباني القديمة، وطرد المستأجرين القدامى، ما أسفر عن تعطيل الشبكات والعلاقات التقليدية داخل الحي، مما شكل عنفا حضريا شعر به اللبنانيون، وظلوا ليومنا هذا يتحدثون عنه. لكن الملاحظ هنا أن هذا العنف غالبا ما حاول أهالي الحي القدامى مقاومته، من خلال لجوئهم للذاكرة أيضاً لتأكيد أحقيتهم، وبسبب هذه التغيرات غدا الصراع على الذاكرة جزءا من الحياة اليومية لهذا الحي، وظلت قصص الحرب الأهلية وتغيرات ما بعد الحرب العمرانية تحوم فوق المدينة.

نلاحظ أيضا أن الصراع على الذاكرة بقي يشغل حياة أهل المدينة، وبالأخص النساء، اللواتي تعرضن أيضا لعنف حضري، بسبب سياسات الإعمار، ففي فصل بعنوان (حياة النساء والمقاهي والجنازات في بيروت) نرى أن المقاهي اتخذت أشكالاً مختلفة قبل الحرب وأثناءها وبعدها، وهنا تقف صوالحة عند روايات الحنين إلى نساء الطبقة الوسطى اللواتي كن يتجمعن قبل الحرب لشرب القهوة في مقاهٍ على الطراز الفرنسي، لتقف لاحقا عند بعض روايات هؤلاء النسوة خلال الحرب، وكيف أنهن أخذن يلتقين في الجنازات خلال الحرب.
واللافت أنه بعد الحرب لم تتمكن هؤلاء النسوة من العودة للمقاهي، إذ أدت سياسات الإعمار إلى خلق أشكال جديدة من المقاهي، ولم يعد بوسع نساء الطبقة الوسطى زيارتها. وبالتالي نرى أن المدينة ظلت بحكاياها وذاكرتها تعيش حالة من القلق في العقدين الماضيين، وأن السياسات الحضرية والحزبية، لعبت دورا في عدم نضوج أي فكرة للنسيان، ما جعل اللبنانيين مستعدين ـ لا قدر الله ـ ( للقتال والعودة له في أي وقت، ونرجو أن لا يكون ذلك قريباً، أو حتى بعيداً.
كاتب سوري