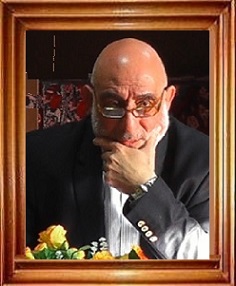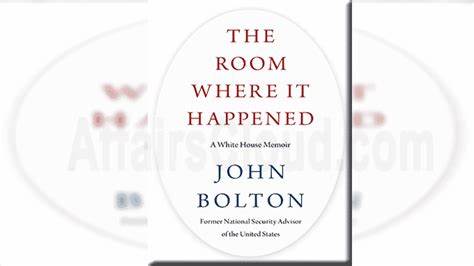من أجل فلسطين تُغيّر وتتغيّر

من أجل فلسطين تُغيّر وتتغيّر
منصف الوهايبي
مهما تكن فظاعة حرب الإبادة الجماعيّة وبشاعتها في فلسطين ولبنان، فإنّها لا ينبغي أن تنسينا أنّ الفنون: الأدب والمسرح والرسم والسينما والموسيقى والغناء… «خير» ما نحاور به العالم. وهذا يقتضي من جملة ما يقتضي اختراع سيميائيّة للصورة، وتحريرنا من سماتنا الذاتيّة «المنطوية» ليصبح أيّ منّا هو الفاعل في الجسم الاجتماعي؛ كما يبيّن الراحل الكبير جيل دولوز نصير فلسطين.
وليس هذا المقال بالمناسب من حيث الموضوع الذي أطرحه، لقراءة مجمل نصوصه عن فلسطين، أو تفكيك خطابه المساند، في عقلانيّة تامّة، ودون لفّ أو دوران؛ وكأنّه يكتب اليوم: «يزعمون أنّها ليست إبادة جماعيّة. ومع ذلك، فهي قصّة تنطوي على الكثير من «أورادور» [المجزرة التي ارتكبها النازيّون بدم بارد، في فرنسا في 10 حزيران/يونيو 1944 حيث قُتل المئات من النساء والأطفال والرجال من عدّة قرى في الريف الفرنسي رميا بالرصاص، وآخرون اقتيدوا إلى الكنيسة وأحرقوا أحياء]. لم يكن الإرهاب الصهيوني يمارس ضدّ الإنكليز فحسب، بل أيضا ضدّ القرى العربيّة التي كان ينبغي أن تختفي؛ وكانت منظمة الأرغون الإرهابيّة نشطة جداً في هذا الصدد (دير ياسين). ومن الأوّل إلى الآخر، سيتعلّق الأمر بالتصرّف كما لو أنّ الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يكون موجودًا بعد الآن فحسب، بل لم يكن كذلك قطّ».
يقول دولوز تعليقًا على عبارة بول كلي الشهيرة «الشعب هو ما ينقص [الفنّ]» إنّ كلّ عمل فنّيّ إنّما هو «من أجل شعب قادم» «يصنعه» الفنّ، شعب لم يوجد بعد، ولكنّه موجود بالقوّة. وفي عالم كعالمنا اليوم «يموت سريريّا»، فإنّ العودة إلى الفنّ إذ يضطلع في تقديره بدور «الطبّ التطبيقي» حيث الطبيب يبحث في الجسد عن العلامات الحسيّة والأعراض الخاصّة التي يستطيع أن يكتشفها بالحسّ وحده؛ من أجل أن يقوم بعمله، حاجة لا غنى عنها. فالفنّ ضروريّ للفلسفة إذ يتيح لها أن تتدبّر منزلتها وحالتها الخاصّة. من ذلك أنّ الأدب مثلا تمرين من تمارين الفكر، فضلا عن كونه رابطة العقد بين «السريريّ والنقديّ»، وفرصة لنقد ما يسمّيه دولوز «صورة الفكر» أي مجموع المسلّمات والافتراضات التي تصوغ رؤيتنا للعالم. أمّا الفيلسوف فيعيد تنظيم الفلسفة وفقا للصراعات السياسيّة، فيما الفنّان يغدو الطبيب الذي يعالج الأعراض الخاصّة، أو الجرّاح الذي يعرف كيف يبدّل الذائقة، ويعدّل أعراف المجتمع.
والأدب والفنّ عامّة، وهذا ما تخلّى عنه أكثرنا أو غفل عنه، شريك في الصراعات الاجتماعيّة، وليس مجرّد تجريب أو تمارين «شكلانيّة» أو «كيتش» وأزهار بلاستيكيّة؛ وإنما قدرة على تصريف اللغة بحيث يجعلها غريبة عن نفسها؛ في سياق ما ابتكره دولوز من مفاهيم مثل «اللاتوطينيّة» و«المخرج» [التخلّص] بحيث يصبح الأسلوب «حدوثا غريبا عن لغته نفسها». ولا يتّسع هذا المقال للخوض في «تخريجات» دولوز وطروحه الفلسفيّة والفنّيّة، وما يتعلّق منها بالفنون التشكيليّة وقدرتها على التقاط قوى الجسد، والتأثير فيها، أو بالسينما التي تشارك الفلسفة في صنع المفاهيم بنفسها، وبمكانة الصورة التي يبدعها الفنّ. وهي في تقديره ليست بأيّ حال استنساخا للواقع، أو تمثّلاً ساذَجا له. فالفنّ يخلق الواقع بطريقته الفريدة، ومثالها التي انتقلت من الحركة التي تجسّدها الشخصيّة، إلى الصورة ـ الحركة أو الصورة الزمنيّة؛ لتعرض صورًا غير مباشرة للزمن، فنتنقّل معها من السرد إلى الوصف.
ودولوز ينظر إلى النشاط الفنّي من حيث هو فعل صمود: «الفنّ هو ما يصمد» بعبارته، إذ به تنتشر المحاولة المتجدّدة باستمرار، من أجل ابتكار إمكَانَات وجود جديدة. وبهذا المعنى، فإنّ الحركة الفنّية هي في الأساس حركة سياسيّة، فهي تسبر أشكالا جديدة من العوالم. وها هنا يتلاقى الفنّ والسياسة، على اختلاف الأداة والمنهج.
هذا الفيلسوف كان مثل نيتشه «تسوؤه الحماقة» ويفضّل على غرار سبينوزا الحبّ والفرح على الحزن والكراهية. فلا غرابة أن وسّع من مجال الفلسفة وأشرعها على الآداب والفنون جميعها. ومن أطرف ما أحببت في أعماله، العلاقة التي يعقدها بين الشعر والسينما، بل هو يحاول تعريف الشعر الذي يخصّ السينما. وهي طموح منه شأنها شأن حدِّ الشعر نفسه أو كنْه هذا الفنّ الذي نردّد دائما أنّه «يعْرَف» و«لا يُعرَّف». أجل أحببت محاولته هذه، وأنا أستحضر شعراء فلسطين الراحلين منهم والأحياء، وأقول ماذا لو تُقدّم فلسطين إلى العالم من خلال أعمال هؤلاء وسيرهم: إبراهيم طوقان وفدوى طوقان وعبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ومعين بسيسو وأحمد دحبور وخالد أبو خالد وعز الدين المناصرة ومريد البرغوثي وزكريّا محمد…
وثمّة فضلا عن الشعراء الذين يستحضرون السينما في أعمالهم، صنّاع أفلام سعوا إلى خلق شعر «سينمائي» مثل كريستوف وول ـ رومانا الذي حاول من منظور أو «موشور» سينمائيّ أشبه ببلّورة موشوريّة ذات وجوه متوازية، إعادة النظر في الشعر الفرنسي في القرن العشرين. والمصطلح «سينما شعريّة» أو «سينما الشعر» ذاع قبله مع جول رومان وبريتون، وأراغون وفيكتورسيغالين. ناهيك عن منظّريها من أمثال شكلوفسكي وبازوليني وغيرهما من الذين جمعوا بين السينما والسياسة والشعر، من أجل إعادة صياغة الواقع، أو الذين حرّروا السينما من منطق السرد، وأحلّوا محلّه منطق القصيدة؛ وأحدثوا ما أحدثوا من تحوّلات، في فنّ المونتاج، أفاد منها ولا يزال كتّاب الرواية المتأثّرين بـ«السينما التجريبيّة» والأفلام الطليعيّة، وما يسّرته من تواصل أفضل بين المخرج والمتفرّج. بل جعلت المتفرّج يشارك في فكّ رموز الفيلم الذي يشاهده استئناسا بذخيرته المعرفيّة الشعريّة/الأسطوريّة التي هي أشبه بـ«قاموس» أو «جامع للمعارف» يمتلكه بصفته جزءا من المجتمع. وهو القاموس الذي تسترفده السينما الشعريّة المتنوّعة.
والحقّ أنا لست من أهل الاختصاص حتّى أخوض في المصطلحات السينمائيّة المثيرة، وخاصّة ما يتعلّق منها بالسينما «غير السرديّة» التي تشبه الشعر والرسم معا، أو ما يسمّى «سينما الصور» التي تجعل المتفرّج يشعر وكأنّه يشاهد «لوحة جميلة»؛ دون أن تكون محاكاة أو تقليدا لواقع مرئيّ، وإنّما مناسبة بين الأسلوب والموضوع من أجل إعادة امتلاك الواقع الحيّ، وإعادة إنتاج معناه، أو «معنى فلسطين» في السياق الذي أنا به، كما في شعر الفلسطينيّين الذين ذكرت وغيرهم من الموتى والأحياء. والخطاب أو «شعريّة السينما» المنشودة قياسا على «شعريّة اللغة» إنّما أساسه رفض الحكاية وسيولتها الوهميّة، وإحلال الإيقاعات البصريّة محلّها. وهي لغة عالميّة بامتياز تنفصل عن لغة المسرح، كما يبيّن أهل الاختصاص، لأنّ الفنّ لا يكون «شعريّا» إلاّ عندما يستخدم «أخصّ خصائصه» التي لا تشاركه فيها الفنون الأخرى. فلعلّ السينما الشعريّة هي تلك التي تتحرّر من الأدب والتي بإمكانها أن تجعلنا نفهم ما يفلت من أيدينا ومن عيوننا، فتقحمنا في سريرة الأفراد، وتأخذ بنا إلى ما وراء المرآة. ولعلّ في هذا يكمن سرّ التكامل بين «سينما الواقع» و«سينما الشعر» السينما التي تمنح الإنسان العادي العابر الذي يضطلع في المجتمع بدوره الخاصّ، فرصة الظهور في الفيلم بدون أن يكون ممثّلا. وليس المقصود التنصّل من التاريخ، وإنّما «رؤية العالم شعريًا» لأنّ هذا الشعر الفلسطيني الذي أشرت إليه، إنّما قوّته في جعل فلسطين واقعا ماثلا أبدا، حتى لا تكون «الفردوس المفقود».
قد يكون هذا شبيها بسينما بازوليني «الشعريّة» التي تقترح تفسيرا جدليّا للتاريخ يغدو فيه الماضي بعبارته استعارة للحاضر، والحاضر وهو الغنيّ بالصور دمج للماضي. وإذ يتساءل: «كيف نصوغ هذه الاستعارة؟» يجيب: «بالإبداع الشعريّ». وهذا وغيره يحتاج إلى تفصيل وتدقيق، إنّما أردتها إطلالة بـ«عين» فيلسوف ما أحوجنا اليوم إلى أمثاله قوّة حجّة ورباطة جأش، في هذا الغرب الذي «يَعمى» و«يتعامى» كلّما تعلّق الأمر بفلسطين. ونصوصه المناصرة للفلسطينييّن، تصلح أن تسترجع اليوم، فقد يفيد منها الذين على أعينهم غشاوة من جهل بحقائق التاريخ. وهو مقارنة بغيره من المثقّفين الفرنسيّين خاصّة، قد يكون الأشدّ معاداة للصهيونيّة إذ عرّى زيفها وبطلانها، وهو يتحدّث عن ضحاياها «هنود فلسطين»، ولا يتردّد في القول أنّ «بناة» إسرائيل مستوطنون أوروبيّون اغتصبوا الأرض بإبادة السكّان الأصليّين، واستولوا بالقوّة والإرهاب على ممتلكات ليست لهم.
ومن مفارقات التاريخ التي لا تنتهي، أنّهم يلحقون بالآخرين ما عانوه هم أنفسهم مع النازيّة من أشكال الإبادة الجماعيّة. وبدل أن تدفع أوروبا ثمن جريمتها في حقّهم، دفعها الفلسطينيّون ولا يزالون. يقول دولوز إنّ «حاخامات إسرائيل المجانين» لديهم الخديعة الفائقة التي تصوّر كلّ من يعارض وجود إسرائيل، ويتصدّى للإبادة الجماعيّة التي يرتكبها إرهاب الدولة المدعوم بالإرهاب الديني، على أنّه «معادٍ للساميّة»؛ فيما لا ينشد الشعب الفلسطيني سوى أن يكون «شعبًا مثل الآخرين»، وأن يعيش في سلام على أرضه.
*كاتب من تونس