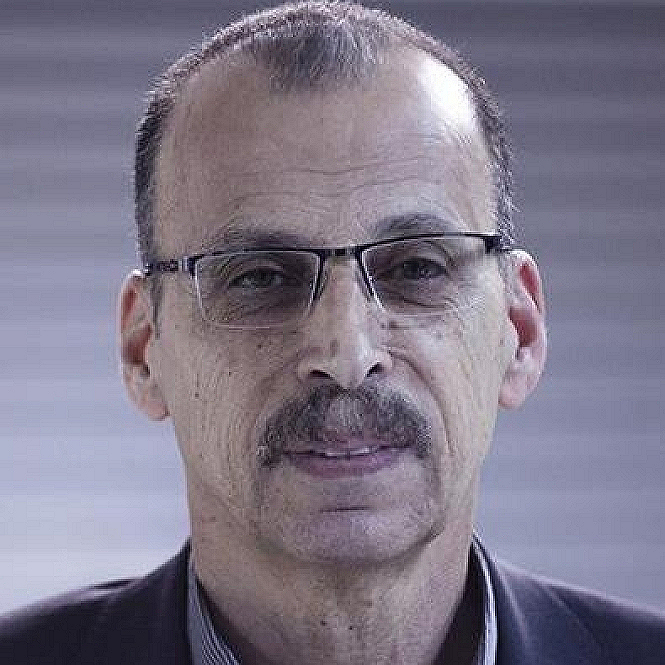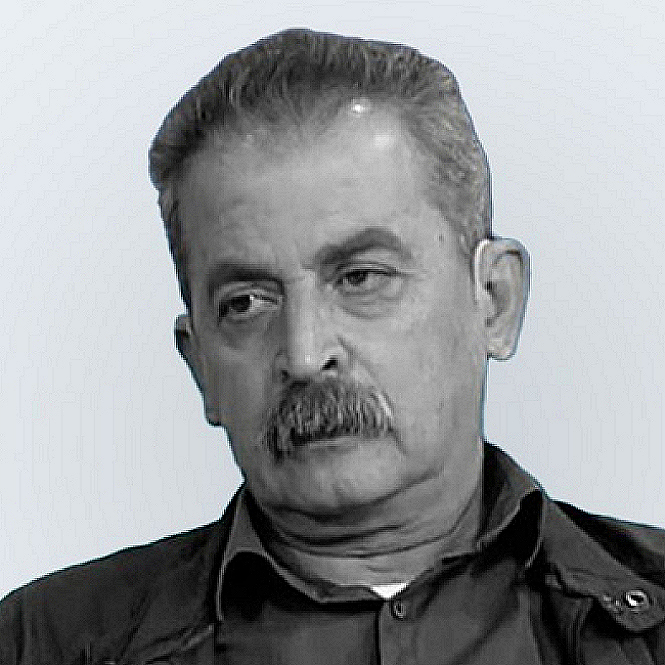رهاب الإفراط: عن موقع دونالد ترامب في التاريخ الإمبراطوري

رهاب الإفراط: عن موقع دونالد ترامب في التاريخ الإمبراطوري
جهدت الإمبراطوريات على مدار القرون على طلب أمر والتنبّه من مغبّة الأمر نفسه. طلب التوسّع المتواصل… والخوف من الإفراط فيه.
فالمنشود عند السلالات المتعاقبة والمتزاحمة أن تحقق كل واحدة منها «لحظتها القصوى». لحظة الاقتراب من صيرورتها «مملكة كونية» تحوز على متن المسكونة، وتنذهل بترامي أطرافها، وبما لا حصر له من أنام وأقوام يدينون بالولاء لصولجانها ويَمدّون بالجباية، على اختلاف أنماطها وأشكالها، خزانتها.
أما مصدر القلق الذي جرى تدبّره على مرّ التواريخ الإمبراطورية بأشكال من الوعي مختلفة فكان مردّه الأمر نفسه، منظوراً له بشكله المعكوس المتمثل بالوقوع فريسة لهذا التوسّع الزائد.
فالحذر من الإفراط من التوسع الاستنزافي للموارد والقدرات لم ينتظر نشر كتاب المؤرخ الأمريكي بول كنيدي «صعود وسقوط القوى العظمى» (1987) لتداركه. أول الأباطرة الرومان، أغسطس، توجه بما يشبه الوصية لمن بعده، بضرورة عدم المغامرة في ما يتجاوز مياه أنهر الدانوب والراين والفرات. هاجس التمييز بين التوسع الضروري وبين التوسع المفرط والضار انتاب أيضاً بناة الدولة الإمبراطورية الصينية منذ القدم. غلبت عليهم المعالجة التي تنظر إلى العالم كجملة دوائر، الصين فيها في الوسط، وحولها الممالك المنضوية تحت ظلها، ثم تلك المتاخمة المطيعة لها، ثم السهوب المفترض أن يؤمَن شرّها. أما التوسعية المفرطة في المرحلة الأموية فأدخلت أيضاً على الدولة نوعا من القلق بشأنها: فهذا الامتداد من الأندلس حتى تخوم الصين لم يحل دون استمرار تهديد الروم لمركز الخلافة الشامي نفسه طيلة هذه المدة. وجاءت الدولة العباسية من بعدها لتدرك سريعاً بأنّ الإفراط في التوسع يؤدي لا محالة إلى انفراط عقد الإمبراطورية نفسه، واستقلال الولاة بالأقاليم، ونشأة سلالات إقليمية مختلفة، وصولاً إلى وقوع الخلافة العباسية نفسها تحت وصاية بني بويه الديالمة. ومن الإسكندر المقدوني وهو يواجه برفض جنده تجاوز نهر السند، إلى الإمبراطورين الرومانيين تراجان وهدريان وهما يواجهان برفض جنودهم الاستمرار في غزو بلاد الرافدين، إلى الانكشاريين وقد رفضوا الامتثال لرغبة السلطان الشديد سليم الأول في التوسع في العمق الإيراني من بعد إلحاقه الهزيمة بإسماعيل الصفوي في جالديران ودخول عاصمته تبريز، محطات تظهر لنا أنه حين تملكت الإمبراطور الرغبة بالجموح التوسعي اللامحدود جاءه الصدّ من قبل جيشه.
اكتفى بول كنيدي في كتابه المشهور والمذكور آنفاً بتتبع كيفية وقوع كل من الامبراطوريات الهابسبورغية والعثمانية والبريطانية في شرك «الإفراط في التوسع» هذا، وكان الهاجس عنده كيف تنظر الولايات المتحدة إلى دورها الهيمني في العالم في ضوء هذه التجارب. بيد أن الولايات المتحدة اكتشفت لنفسها باكراً «لعبة أخرى» تقيها من مفارقة التوسع المظفّر، فالمرهق، فالمبدّد للموارد ولعناصر القوة. هي لعبة «الانعزال عن العالم» تارة، والعودة إليه» تارة أخرى. بخلاف بريطانيا، الجزيرة الطرفية بالنسبة للقارة الأوروبية، والتي هيمنت على البحار وما ورائها في القرن التاسع عشر، في مقابل دور أكثر تواضعاً من ذلك في ميزان القوى بين الدول الأوروبية نفسها، فقد وجدت أمريكا نفسها محمية بمحيطين، أطلسي وهادئ عن «الجزيرة – العالم» أو العالم القديم. حيناً تقول لنفسها إنّها تدير الظهر لهذا العالم القديم، وحيناً تعاود اكتشافه. لم يسبق لعناصر هكذا لعبة، وهكذا سردية، أن امتلكتها أي قوة إمبراطورية سابقة في التاريخ.
عودة ترامب تنبني اليوم على رغبة في إعادة تنشيط التقليد الانعزالي، في الوقت نفسه، ترامب اليوم يأتي بحلة مختلفة عن ترامب الأول
أسّس ذلك لتاريخ كامل من المفارقات تدرج عادة تحت عنوان «الانعزالية» وهو تقليد مديد في السياسة الخارجية الأمريكية، كما في نظرة أمريكا إلى دورها «الديني» أو الخلاصي في التاريخ. وهذه الانعزالية، المدشنة بعقيدة الرئيس مونرو عام 1823 أي قبل قرنين ونيف من يومنا، ترسم خيطاً ممتداً من مونرو حتى دونالد ترامب، رغم اختلافات مدهشة يعبرها هذا المسار. عام 1823، ومع تدخل الرجعية الفرنسية لضرب الدستوريين في إسبانيا وإعادة تحكيم الملكية المطلقة بها، وجدت أمريكا الشمالية أن الوقت قد حان للقطيعة مع القارة العجوز مجلبة الهم والكرب. فأوروبا هذه لا تعرف كيف توازن بين نوباتها. مرة تطرف في الثورة، ومرة في الرجعية. هي إذاً كحال مصر، أرض العبودية في التوراة، في حين أن سفر الخروج الجديد يُكتب في الأمريكيتين. الشمالية بأن تدير ظهرها لأوروبا، والجنوبية بأن تقتبس من إعلان استقلال الولايات المتحدة استقلالاتها هي عن إسبانيا والبرتغال. عنت الانعزالية وقت «عقيدة مونرو» الشيء ونقيضه. الدفع ببلدان الأمريكيتين نحو التحرر من ربقة الإمبراطوريات الأوروبية، وتعريضها في المقابل لهيمنة واشنطن. إنهاء الاستعمار، إنما على يد المستوطنين الأوروبيي الأصل، من جورج واشنطن وتوماس جفرسون حتى سيمون بوليفار، وليس الشعوب «الأصلية» أو الخلاسيين، بل وفي ظل استمرار أنظمة الرق لردح من الزمن.
بعد ذلك أخذت أمريكا تعدل عن انعزاليتها المونروية هذه ثم لا تلبث أن تشتاق إليها. عدلت عنها مع الرئيس ويلسن حين قررت المشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا وفرنسا، ثم آثرت عدم الانخراط في عصبة الأمم، التي اقترحت تأسيسها هي، وعادت للانعزالية الى أن عادت النغمة التدخلية مع فرانكلين روزفلت قبل قليل من الهجوم الياباني على بيرل هاربر. ولئن كانت التدخلية قد تحولت إلى تقليد أكثر هيمنة على السياسة الأمريكية في سني العالمية الثانية والحرب الباردة، فإن الحنين إلى الانعزالية لم ينقطع، لكنه عبّر عن نفسه أساساً من بوابة هاجس عدم الإفراط واستنزاف الذات بالتدخل.
يختلف باراك أوباما ودونالد ترامب في كل شيء تقريباً. مع هذا ثمة مشترك خفي بينهما. قوامه أن الولايات المتحدة أُجهِدَت بالتدخلات، منها الضروري والنافع، ومنها غير المجدي والذي لا طائلة منه. التدخلية تصاعدت في ظل ريغان وبوش الأب وكلينتون وبوش الابن. في المقابل، اثنا عشر عاماً قضاها كل من أوباما وترامب على رأس أمريكا والعالم، اتسمت بشكل عام بانخراط أقل في العمليات الحربية في العالم القديم، مع اختلاف بين اهتمام أوباما بالتشبيك بين قوة أمريكا وبين إعادة الدفع في اتجاه موجات توسع ديمقراطي جديدة في العالم، وبين عدم استيعاب ترامب لأي حديث عن الديمقراطية خارج حدود بلاده. ثم جاءت سنوات جو بايدن الأربع: أرادت إدارته الاستمرار ضمن هذه الاستراحة «الانعزالية» الجديدة، بدءاً من الانسحاب من أفغانستان وتسليمها لحركة طالبان، لكنها وجدت نفسها في تدخلية مدفوعة إلى أقصاها: الانخراط في حرب «شبه غير مباشرة» ضد روسيا، بدءاً من الدونباس وخرسون وصولا إلى أرض كورسك الروسية نفسها. وجدت نفسها أيضاً في موقع رعاية حرب إبادية إسرائيلية ضد قطاع غزة. عودة ترامب تنبني اليوم على رغبة في إعادة تنشيط التقليد الانعزالي، في الوقت نفسه، ترامب اليوم يأتي بحلة مختلفة عن ترامب الأول. في الولاية الأولى، أجاد ترامب تطبيق «نظرية المتظاهر بالجنون». العاقل الذي يخيف سواه عندما يظهر لهم استعداداً للتهور والطيش بما يجعله يحقق مراده ويظهر وجهه المتعقل حالما ينال ما يريد. المشكلة اليوم أن ترامب يحاول تطبيق أمر مختلف، وهو التظاهر بالتعقل والاتزان والروية. اتخذ الأمر في حملته الانتخابية شكل الخلط بين ما اعتاد الأمريكيون على التفريق فيه بين سياسة داخلية وأخرى خارجية، إذ اعتبر أن الداخل والخارج معاً ضحيتان لسوء الإدارة من طرف بايدن وفريقه. بالتالي، للداخل والخارج مصلحة مشتركة في التحاكم اليه، لإنقاذ العالم من «فتنة جو بايدن». هذا الشكل من التعقل، إذ يصيغ تصوره على هذا النحو، يفترض واقعاً آخر، يقبل فيه كل الناس في الكوكب للرجوع إلى ترامب لتقسيم الأحوال بينهم. هذا الإفراط في التعقل في الطبعة الحالية من دونالد ترامب هو مصدر مشروع للقلق. يريد أن يحيي النزعة الانعزالية في السياسة الأمريكية، وأن يدمجها بهالة تحكيمية لواشنطن في نزاعات هي حتى الآن، بل هي بشكل بنيوي كامل، راعية لها ومنخرطة فيها. الأباطرة السابقون في التاريخ انقسموا على أنفسهم بين طلب التوسع المتواصل وبين الخوف من الإفراط المرهق من جرائه. ترامب اليوم، يوجد صيغة جديدة من هذا الانقسام. تجديد الرغبة بالانعزال الأمريكي عن العالم، وافتراض أن العالم كله لن ينتظر إلا إشارة من الرئيس الأمريكي لتسليطه على شعوب الأرض قاضياً وحكماً.
كاتب من لبنان