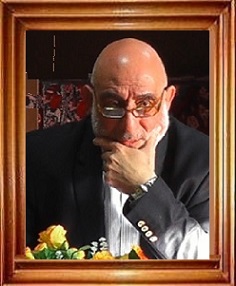سوريا وأولويات إعادة التأهيل: الهوية السورية

سوريا وأولويات إعادة التأهيل: الهوية السورية
د. محمد عثمان الخليل
يُروى أن أديب الشيشكلي، بعد انقلابه وإمساكه زمام الأمور في دمشق، دعا ضباطه للعشاء في بيته، وبعد العشاء سأله أحدهم ما خطته للعمل بعد أن تولى السلطة فأجابه الشيشكلي: «أوف.. والله هاي ما فكرت فيها». ربما كانت هذه مزحة من الجنرال، لكنها في الحقيقة تلخص إلى حد كبير واقع الحال إبان الانقلابات والثورات والتي يكون تركيز قادتها منصبا على عملية الوصول للسلطة دون سواها. نحن في سوريا اليوم نواجه وضعا شبيها، ولكن أكثر تعقيدا بسبب الإرث الكبير الذي تركه لنا نظام البعث ولتداعي حكم الرئيس بشار الأسد، المباغت والمفاجئ، خلال أسبوعين من بدء هجوم قوات المعارضة السورية.
في خضم ما يصاحب هكذا تغييرات جيوسياسية من فوضى وأعمال عنف، يعمل قادة سوريا الجدد على إحكام السيطرة على البلاد والحفاظ على وحدتها وسلمها الأهلي، وهي مهمة ليست بالسهلة وستمتد لمدة غير قصيرة. طوال هذه الفترة سيكون اهتمام هؤلاء القادة منصبا على تثبيت الأمن والأمان الداخلي، ومنع أي أعمال عنف أهلية، وتأمين حاجات الناس من ماء وكهرباء ومواد غذائية أساسية. ومع تشكيل حكومة انتقالية والبدء بتشغيل أجهزة الدولة سيستمر التركيز على إعادة الحياة لوضعها الطبيعي.
هنا يبرز سؤال مهم، ما هو الوضع الطبيعي الذي نريد أن نعيد الحياة إليه في سوريا؟ ومتى كان آخر وضع طبيعي للحياة في بلادنا؟ منذ وصول البعث للسلطة بانقلاب الثامن من آذار عام 1963 وبدء قادته بأدلجة المجتمع السوري وتغيير قوانين دولته بما يخدم تلك الأدلجة على كافة الصعد ـ لم تعد الحياة طبيعية في سوريا. فعلى مدى ستة عقود طوّر البعثيون سياسة واقتصادا وإعلاما وأنظمة أمن وتعليم وصحة وفق منطلقاتهم النظرية الخاصة. كان نظام البعث، كما الشيوعية السوفيتية، نظاما شموليا دخل في كل مناحي الحياة صغيرها وكبيرها بدءا من لباسِ وأغاني الأطفال في المدارس إلى المحاصيل التي يجب زرعها وأسعار بيعها. ستون عاما من الأدلجة التطبيقية قد خلقت لدى معظم السوريين الذين عاشوا في كنف البعث، أدركوا أم لم يدركوا، واقعا صار بالنسبة لهم طبيعة ثانية، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو الإثنية. هناك منا، من جميع أطيافنا، من ثار على هذا الواقع مدركا مدى مرضيته وفساده، لكن استطالة أمد الثورة إلى ثلاثة عشر عاما ما هو إلا دليل آخر على قوة وتغلغل هذا الواقع في حياتنا. إذ يجب أن نعترف أن قطاعا كبيرا من الشعب السوري لم يثر، فإما أيد نظام الأسد صراحة أو تبنى الرمادية السياسية. حتى أني أزعم أننا لن نعدم بعد طيّ هذه الصفحة من تاريخنا مَن سيحن لشخوص أو رموز أو ذكريات من ذلك الواقع المرير. بل إن هناك خطرا، إن لم يكن في العودة رجعيا له، ففي بقائنا نعاني من آثاره في أنماط تفكيرنا وسلوكنا وتعاملنا مع بعضنا البعض.
على مدى ستة عقود طوّر البعثيون سياسة واقتصادا وإعلاما وأنظمة أمن وتعليم وصحة وفق منطلقاتهم النظرية الخاصة. كان نظام البعث، كما الشيوعية السوفيتية، نظاما شموليا دخل في كل مناحي الحياة
من ذلك نذهب إلى أن هناك حاجة حقيقية لإعادة تأهيل سوريا لإنجاز قطيعة حياتية مع هذا الواقع المتغلغل فينا، ولتطوير نموذج تعاقدي جديد لمجتمعنا نخرج من خلاله مما نحن فيه. إذ نحن اليوم أمام أولويات لإعادة تأهيل وطننا ليعود طبيعيا جاذبا للحياة وليس طاردا لها. سأركز في باقي هذا المقال على أولوية استعادة الهوية السورية، وأفرد مقالات خاصة للأولويات الأخرى لاحقا.
ليس جديدا القول بأن نظام البعث قد عمل على إضعاف الهوية السورية على مدى عقود حكمه. وقد فعل البعثيون ذلك بدافعين: الأول أيديولوجي ناجم عن معتقد قومي طوباوي يؤمن بهوية عربية عابرة للحدود القطرية في المنطقة العربية، ويسعى لإقامة دولة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج. وقد لخّص شعار الحزب الشهير «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» هذا المعتقد الذي فشل فشلا ذريعا في إنجازه ولو بأدنى الحدود وذلك لإصرار الحزب والنظام الذي أقامه على تسيّد هذه الوحدة ما وضعه دائما في تضاد مع التيارات والأنظمة السياسية الأخرى في البلاد العربية.
أما الدافع الثاني لإضعاف الهوية السورية فقد كان ينطلق من أسباب أكثر عملية وإن جرت توريته خلف شعارات الدافع الأول: فقد كان يصدر عن خوف طائفي. فرغم أن حزب البعث في بداياته اعتمد في صعوده على دعم الشرائح الفقيرة في المجتمع السوري من «العمال والفلاحين وصغار الكسبة» من كل الطوائف والإثنيات السورية، والذين اعتبرهم قاعدته الشعبية، إلا أن أتباعه وصلوا إلى السلطة من خلال الجيش. وقد أخذ الصراع داخل المؤسسة العسكرية السورية في حقبة الستينيات طابعا طائفيا بسببٍ من البنية الأقلوية الأصلية لجيش الشرق، نواة الجيش السوري، الذي أسسته سلطات الانتداب الفرنسي وفق منظورها وسياساتها. أدى هذا الصراع في النهاية، كما يبيّن الدكتور حنا بطاطا في كتابه القيّم «فلاحو سوريا: أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم» إلى إقصاء ضباط الأغلبية السنية من مراكز التحكم العسكري واحتكار ضباط الأقلية العلوية لتلك المراكز، وهو ما أدى بدوره لصعود حافظ الأسد واستئثاره، وابنه من بعده، بالقرار السياسي في البلاد لعقود. إن أي تناول جاد للهوية السورية كان سريعا ما يُظهر هذه المفارقات بين توزيع التركيبة السكانية وبين الطبيعة الأقلوية للنظام الحاكم. وهكذا كان هذا النظام يفضل دائما الحديث عن هوية عربية واسعة وبعيدة تضيع فيها المفارقات الأقلوية للنظام السوري. وهو أمر لم يتأخر القوميون العرب المنافسون للبعث خارج سوريا للإشارة إليه، وكان الرئيس المصري جمال عبد الناصر ربما أول من فعل ذلك.
لقد ظل نظام الأسد، الابن من بعد أبيه، مصراً حتى نهايته على خطابه البعثي الخشبي والذي أفرغه واقع البلاد المزري والمتشظي من أية معنى. وقد بدا أن الانقسام السياسي والديمغرافي الذي تلى انطلاقة الثورة السورية عام 2011 قد يمتد ليطال وحدة سوريا خصوصا في ظل التجاذبات والتحالفات الإقليمية والدولية. لكن انتصار الثورة وما جرى على مدى الأسبوعين الماضيين من تعاضد بين السوريين ووعي واضح بضرورة تجاوز الماضي وعدم تحميل أي طائفة أو أقلية مسؤولية جرائم أركان النظام السابق قد أعطى أملا في استعادة مركزية الهوية السورية في الدولة الجديدة. وقد فوجئ كثير من السوريين بوحدتهم وهم يتنادون أسماء المدن السورية لتنضم لسلسلة المدن المحررة من النظام المتهالك في إعادة جميلة لمشهد من الأشهر الأولى للثورة عام 2011.
سيكون من الطبيعي في الأسابيع والأشهر القادمة انطلاق نقاش فكري سياسي بين كافة التيارات السياسية على الساحة السورية لتحديد معالم وأبعاد هذه الهوية بما يتجاوز التعريف الجغرافي والعاطفية الرومانسية التي تصاحب لحظة الانتصار الثوري. ما السمات التي تجمعنا كسوريين؟ ما خصائص المجتمع السوري؟ ما علاقة السوري بالعربي، خصوصا بالنظر لوجود إثنيات أخرى في الوطن السوري؟ هل هناك خصوصية إسلامية في الهوية السورية؟ ما طبيعتها وعلاقتها بباقي المكونات؟
هذا النقاش وما سيترتب عليه سيسهم بشكل كبير ليس فقط في إعادة إحياء الهوية السورية، بل بإعادة تأهيل سوريا كوطن وكدولة.
أستاذ الدراسات العربية في جامعة نيويورك