«ما ظلَّ منّي» مجموعة الشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري: كائنات وموجودات فردوسية تعزّز مقاومة الزوال
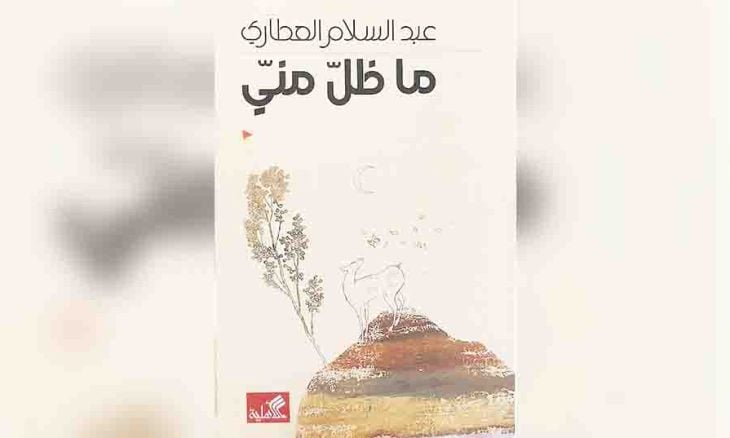
«ما ظلَّ منّي» مجموعة الشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري: كائنات وموجودات فردوسية تعزّز مقاومة الزوال
المثنى الشيخ عطية
من يشهد إبادةً جماعيّة بأعتى أسلحة القتل، وأطفالاً لم يعدْ نبش الأنقاض بأيدي الأمل مجدياً لمنحهم نفساً تحتها بعد شلل الآلات، ومقاومةً تصل إلى رمي طيارةٍ مسيَّرةٍ بعصا أخيرةٍ، وفناً يجسّد المقاومة بذراعٍ لا مفرّ من ضرب العدو بها بعد أن سقطتْ، لكسر الحصار بالحصار وفق شاعر المقاومة محمود درويش/ دون حصره بذلك؛ ثم يشهد عودةً يرتجف لها قلب العالم، حبّاً أو خوفاً، لأهالي شمال غزة إلى بيوتهم المدمّرةِ، يقيمون فوق أنقاضها خيم البقاء والتمسك بالأرض…
من يشهد ويشهد ويشهد ما لا يمكن مشاهدتُه إلا بالأساطير؛ لن يكون بوسعه سوى أن يفهم سرّ تمسّك الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده وأسلافه، وسوى أن يبحث في هذا السرِّ إن لم يسعفْه الفهم. وسوى أن يقف ربّما مكان ذلك «اليوتيوبر» الأمريكي الذي شكر إسرائيل، ليس على ارتكابها المجازر الجماعية، وإنما على تعريف العالم بجمال الفلسطينيين، فيما يسلكون ويقاومون ويحبّون الحياة ولا يستسلمون للموت.
وفي النهاية لا يسع من يشهد سيرة ومسيرة الفلسطينيين منذ «البقجة» الأولى في آدابهم، إلا أن يُعجَب ويشكرَ هذا الأدب على منح الإنسان ميّزة التماهي بالأرض، والتشابكَ بتفاصيل طبيعتها التي تجسّدُ تكوين الإنسان به، وتفتحُ هذا التكوين على التواضع وإشاعة السلام في الأرض. إن لم تفتحْه أكثر إلى تفكير الإنسان بوجوده، ومن أين أتى، وإن لم يكن سوى ذرّةٍ من غبار النجوم الذي يردّد بصمتِ خلاياه صوت الانفجار الكبير.
في تاريخ آداب الفلسطينيين، التي تجاوزت تصوير فعل المقاومة بمباشرة الحديث عنها دافعةً الآخرين إلى اختزال صورة الفلسطيني بالمقاوم والشهيد والإرهابي، انتبَه الفلسطينيون وعلى رأسهم شاعرهم محمود درويش إلى خطورة اختزال الصورة وحصرها، ففتحوا أسوارها مثلما فعل في مجموعته الشعرية «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق». وأعادوا ابتكار ما وجدوا أنفسهم عليه، وما يكمل صورة الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من أرضٍ تُفلَح وتنبِت الأشجار وتُفتِّح الأزهار وتخلُق بيئةً متوائمةَ الكائنات والموجودات. بقيم عاليةٍ في احترام قيم العائلة وإكثار ما يُنتج الحياة، وبإنسانٍ يتألّم لما يفقد من بيتٍ أو شجرةٍ أو حتى صوتِ هديل حمامةٍ كانت تخلُق ألفة الكائنات في بيته. مقابل صورة مغتصب الأرض التي يعيث فيها خراباً لأنها ليست أرضه وليست جسده الذي تكوّن منها.
وفي إعادة الابتكار هذه خفَتَ إيقاع شعر التفعيلة العالي النفير إلى همس قصيدة النثر في الغالب، إلى جانب ابتكار التفعيلات الهادئة المعبّرة عن الصورة الشاملة للفلسطيني في قصيدة التفعيلة، ولم يكن عصر تكنولوجيا الاتصالات بعيداً عن هذا التحوّل الذي فتّت الشاعر النجم إلى نجوم صغيرة لكنها بالغة التأثير في تجسيد الصورة الجديدة، من جميع الزوايا التي يجد كل شاعر نفسه فيها. ومن ذلك مجموعة الشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري التي وضع لها عنواناً يكاد يشمل جميع قصائد المجموعة في ظلّه: «ما ظلّ منّي»، التي يجسّد فيها صورته ممثِّلة لصورة الفلسطيني، «الذاتية» بخاصية وجوده طفلاً تتجذّر حياته ممتدةً في أرض وطبيعة وسماء قرية «عرّابة» الفلسطينية قرب جنين. و«الجمعية» التي تشمل الآخرين من جيرانٍ وحبيبات وأصدقاء ومكافحين من أجل الحرية ومعتقلين وشهداء، في تمازج الذاتين ببعضهما وبالذات الكونية الممثِّلة للمكان كطبيعة وموجودات تتخلّل روح الكائن لتخلقَ ما يمكن تسميته بروحية المكان.
وتتجلّى هذه الروح في القيم لتبقى عصيّة على الزوال، وإن غامت صورتها بفعل أفعال المحو العنصري، وتأثيرات الزمن. ويمكن للقارئ اقتطاف الكثير الذي يمثل تشابك الروح في المجموعة ومن ذلك صورة استيقاظ الموجودات برسم الصورة الأيقونية للأب في هذا الجزء من قصيدة «ترتيل»، حيث:
«عندما يبدأ أبي صلاة الفجر
تصحو البيادر
والطيور الدافئة
وصليبة القمح
من تحت شادر الخيش
تصحو شتول الزعتر
وهمهمات الرعاة
وتهليلةٌ تتهدّج بالصوت الناعس
تستقدم الملامح
من بين الشقوق الطالعة
من صوته؛ زيتاً يضيء
بقايا العتمة».
صورةٌ فردوسية رغم آثار الرصاص:
عبر مائة وأربعٍ وثلاثين قصيدة نثرٍ تتوالى بغالبية طول صفحة واحدة للقصيدة وتصل إلى ثلاث صفحات في أطولها، وبدءاً من القصيدة الأولى، يوضح العطاري أبعاد مجموعته في رسم الصورة الذاتية والجمعية المتشابكة له كابن لأرضه، تحت عنوان: «أنا»، وبتداخل لا يتكرّر كثيراً مع التراث القرآني، في آية سورة التكوير حول الشمس والصبح، حيث: «أنا الصبح الذي تنفّسَ؛ تنفّس تراب المقاثي من ثوب أمّه، واغتسلتُ بالعشب المغمّس بالندى، ويمّمت وجهي شطر الشمس؛ الشمس التي تكوّرت في العلا، وأنشدتُ أغاني الخلاص من حناجر السارحين المعفّرين بالوعود».
وعبر القصائد التي يتوالى ثلثها الأول تقريباً برسم ثلاثية العائلة، الأم والأب والطفل، يقوم العطاري بنسج ثوب المكان الفلسطيني، بروح الأمّ التي تتبدّى أمّاً كبرى دون إفصاح عن ذلك سوى بنبض الموجودات من إشراقة ابتسامتها، موسيقى ضحكتها، خُبزِ وزيتِ وزعترِ عنايتها بأبنائها، ونشرها عطر الحياة بورد رائحتها. وإكمال نسج الثوب بأيقونية الأب كحامٍ للعائلة وموقِظ لموجودات حياتها بقيمه المتوارثة من أجداد ينبض بذكر أفعالهم في بناء المكانِ المكانُ، حرثاً وشجراً ونماءً للكائنات، مع تركيز مفردات أدوات الصنع، مثل الفأس والمنجل، وأدوات القيم، مثل العكاز الذي يهشّ به الزمن.
وإتمام النسج بنفسه/ الطفل المتشابك مع الموجودات التي صنعتها الطبيعة من حيوانات يأتي في مقدمتها الغزلان والحمام، ومن نباتات تضمُّ عموم أشجار وازهار فلسطين من زيتون وليمون ورمانٍ ووردٍ ونرجس، بما في ذلك الشوكران السام. ومع المصنوعات التي يوجِدها الأبوان لنماء وتطور الابن والأجيال،/ الطفل الذي يتنفس كلّ تلك الحياة ويجسّدها في وجه الغياب المتولّد من أفعال سرقة الأرض ومحاولات محو تفاصيل حياتها لتدمير الذاكرة، في ما ظلّ منه بعد التهجير والاحتلال والزمن، ويحاول القبض عليه وتجسيده.
فيما يتوالى من قصائد، يوسّع العطاري أبعاد تشابكات مكانه، إلى الشهداء، مثل الأخ في الصورة التي تكلمها الأم بمسح شفتيها لها، في قصيدة «صورة»، حيث: «أمي كانت تمسح الصورة بشفتيها/ وبشيء من الكلام/ صورة على الجدار كان أخي/ أخي الذي نسيه الوقت/ ولم يذكر في كتاب الحرب». والشهداء: في قصيدة «صوت النرجس»، الذين «يزهرون في المواسم يعودون…/ كلما تعالى صوت النرجس/ في الشتاء الباكر.» وقصيدة «ظل النارنج الحزين»، الذين: «يرحلون كأنهم سرب قطا،/ في مواسم القبور،/ في خميس الكعك المخمَّر بالدموع وبالنواح.». وفي قصيدة «وطن»، المخاطب بـ: «يا وطن السيرة والمسيرة/ خذ بالشهيق عطرهم/ واكتمه كي نحفظ العتمة/ نحفظ في العين ضوء الطريق».
ثم المقاومون والمعتقلون، كما في قصيدة «الفتى الأملح»: «المعصوب العينين، الأملح في مشيته،/ رافع الرأس، يعاين الريح،/ الريح التي شربت بحرنا المأسور،/ وحملت الغيم في عتم الطريق الطويل». ثم الحبيبة المعجونة بعطر ورد فلسطين وقمحها في تجليات حبّ الطفولة على مقاعد المدرسة والصبا والشباب.
وفي كل هذا الامتداد، تختفي المباشرة في الحديث عن المقاومة والاستشهاد، والحب، إلى عالم تبرز فيه فردوسية فلسطين، من غير دم مباشر ومن غير وحشٍ مباشر يمحق البشر والحجر، لكن ظلَّه موجود في جرائم التغييب الذي يحاول الشاعر إيقافه بذكريات تعاني هي الأخرى من التشوش، مثل ما ظلَّ بعد النجاة، في زوغان ماهيته، إذ: «ويحدث أنْ نجوتُ؛/ وحملتُ ذاتي المنتصرة/ بين قوسين كما ادّعيتُ/ وارتفع بي المقامُ/ وارتفع المقام بي/ ورميتُ/ من بين السّخامِ/ بصري وابتسمتُ/ وابتسمتُ على ما ظلّ من لا شيء لي/ وما ظلَّ منّي ضلّ/ وقلت انتصرتُ!».
صورةٌ فنيةٌ لأبعاد المكان والرعوية:
لم يخطئ الناقد فخري صالح على الغلاف الأخير لمجموعة «ما ظلَّ منّي»، في توصيف وكشف أبعاد موضوعها بعميق الرؤية، وبالأخص توصيفه للأمّ التي تبدو صورتها: «كروحٍ حارسةٍ للذاكرة والمكان، ومشبعةٍ برائحة الأرض، والوجه الآخر للطبيعة الحانية، المقاومة لمحاولات المحو والطرد خارج الجغرافيا والتاريخ». كما لم يخطئ في توصيف صوت الشاعر الرعوي الذي: «تحضر في كتابته عناصر الطبيعة والبيئة، والأرض ونباتاتها وفصولها ومواسمها، وما يتصل بدورة الحياة في الريف الفلسطيني». ولا يخطئ القارئ في تكملة قراءة هذه الصورة وفق أبعادها الفنية التي تتناول مزايا قصيدة نثر العطّاري، وخصائص وضعها في مكتشفات ما وصلت إليه قصيدة النثر باستخدام الحكاية والسخرية وقفلات الدهشة التي تقلب المفاهيم في تراكب الجمل الشعرية، واستخدام طريقة الكتابة الآلية في تعميق الرؤية لما يفصح عنه الداخل كما يحدث في الأحلام، والصياغةِ اللغوية التي نجح العطاري في خلق تناغمها مع موضوعه، إضافة إلى المواصفات الإيقاعية الموسيقية التي يخلقها التراكب اللغوي في القصيدة، ويعبّر بها عن خصوصية الشاعر.
وفي هذا يمكن للقارئ أن يلمس اعتماد العطاري في معظم قصائد المجموعة على الجملة القصيرة الواضحة، مع غلبة التركيب الأحادي للجملة الشعرية في توخّي الشاعر اعتماد البساطة في التعبير عن البيئة، وابتعاد الشاعر عن خلق الدهشة في قفلات القصائد، للتناغم مع هذه البساطة ربّما.
كما يمكن للقارئ لمس مداخلات الشاعر في عددٍ من القصائد، مع التراث الديني كما قدمنا في تداخله مع سورة التكوير، ومع النبي نوح في التساؤل الذكي عن غياب المنطق في نوعية ركّاب سفينته، بقصيدة «الغرباء»، حيث: «لماذا فعلتها يا نوح/ ومَنْ هؤلاء؟/ كنتَ قد حمَلْت معك/ من كل زوجين اثنين/ فيهما النقاء والصفاء/ والقلبُ الحسن/ والإيمانُ ثالثُهما/ والطائرُ الغرّيد/ والشجرُ الظليل/ لماذا فعلتها يا نوح/ ومن هؤلاء الغرباء؟».
وكذلك التداخل مع التراث الثقافي الإنساني الذي يتفاعل فيه مع الثوري الشهير أرنستو تشي غيفارا، الذي هو: «بطل ليس من بلادي،/ لكنّه كان ابن أمي حين سألتُها عن إخوتي».
ومع بيت شعر أمير الشعراء أحمد شوقي: «وللحرّية الحمراء بابٌ/ بكلِّ يدٍ مضرّجة يدقُّ» في تعبيره عن دعم الشعب المصري للثورة السورية الكبرى عام 1926، في تعبير العطاري عن اليأس بقصيدة «اسم»، حيث: «يبحث عن قفل للباب العنيد،/ والبابُ يُدَقّ بمضرَّجةٍ/ اسمها الشهيد تلو الشهيد».
وعلى صعيد تكوين القصيدة يمكن للقارئ أن يلمس إكثار العطاري من واو العطف التي تثير السرد، ومن إكثار تكرار الكلمة بأل تعريفها بعد كلمة تنتهي بها الجملة، كما يرى القارئ في الأمثلة السابقة، ربّما لتأكيدها في الذاكرة، واعتماد ذلك أسلوباً، لكنه من جهةٍ أخرى، يثير تساؤلات القارئ إن كانت ذاكرتُه بحاجة إليه.
عبد السلام العطاري: «ما ظلَّ منّي»
الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان 2023
205 صفحة.







