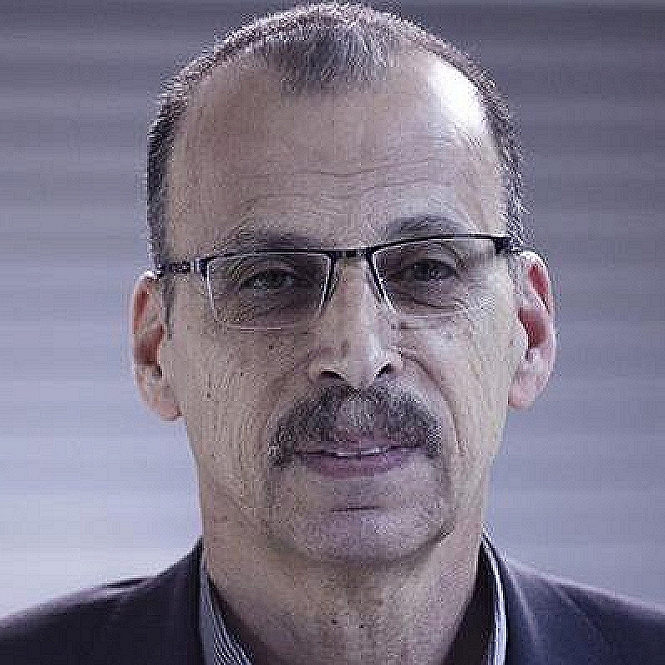مملكة أوجلان ومآل الفكرة القومية

مملكة أوجلان ومآل الفكرة القومية
وسام سعادة
أمضى عبد الله أوجلان ستة وعشرين عاما في سجنه في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ أن تمكنت المخابرات التركية من القبض عليه في كينيا وإعادته مكبّلاً بالأغلال إلى بلادها لمحاكمته.
لا يمكن الاسترسال في التكهن من الآن كم ستدوم مدة سجن الزعيم الكردي، وكيف ستستقبل تركيا وحكومتها مبادرته الداعية إلى حل «حزب العمال الكردستاني» الذي أسسه وقاده والذي يتعامل أعضاؤه وأنصاره مع «آبو» على أنه يتمتع ليس فقط بمهارات فكرية وقيادية وتنظيمية وسياسية، وعلى أنه رمز كفاحيّ ملحميّ، بل على أنه أيضاً بمنزلة «الملك – الفيلسوف» للأكراد، بحيث تتمازج في أحوال هالته عندهم معالم الحكمة مع شطحات الإلهام.
يطلب أوجلان من أعضاء حزبه الانعقاد في مؤتمر وبعثرة هيكلهم، وإلقاء السلاح، والانخراط في السعي السلميّ، لبناء مجتمع ديموقراطيّ مناطه التآخي بين أتراك تركيا وأكرادها. لم يعد يتحدّث عن دولة ثنائية القومية، ولا عن فدرالية. إنما عن التآخي. بعد خمسة عقود من الكفاح المسلّح المرير يقول إن الوقت حان لميثاق من التآخي.
المفارقة أنّ أوجلان يطلب من الحزب حل نفسه انطلاقاً من علمه علم اليقين بما له كشخص من سحر لامحدود على كوادر وقواعد هذا الحزب، بل على شريحة واسعة من أكراد تركيا وخارجها. كما لو أن مرجعيته الملهمة متعالية على هذا الحل، لها مقام آخر، تتبع ترتيبا مغايراً. أو ليس لها من ترتيب محدد. مطلقة ويفترض أن تستمر كذلك.
ما كان لأوجلان كل هذا قبل اعتقاله. بقاؤه في حماية نظام حافظ الأسد كان كفيلاً باستهلاكه، وإبعاده شيئاً بعد شيء عن مشاغل أكراد تركيا. باعتقاله في بحر مرمرة، غير بعيد من اسطنبول، لعبت تركيا دوراً في إكسابه هالة «الغورو» أو «المهاتما» الذي يقود الكفاح ضدها وهو في سجنها.
وهو لم يكذب خبراً منذ دأب على الابتعاد عن الترسيمة «الماركسية اللينينية» والاقتباس من الأدبيات اليسارية الأيكولوجية ذات النفس الأناركي، بحيث أخذ يبتعد سواء بسواء عن نظرية «الحزب الطليعي» أو عن ربط تقرير مصير شعب ببناء دولة لهذا الشعب لا شيء غير ذلك. برهن أوجلان مطلع هذه الألفية أنه راغب بالفعل في مغادرة قرن والانخراط في الجديد، هذا إن كان من الممكن استثناء ارتباط كل ذلك باستمرار نسج الهالة الأسطورية حوله.
ربما كان مغزى تجذير التحول لدى أوجلان الإدراك بأن الفكرة الكردية ينبغي، في اللحظة نفسها التي تحل الحزب وتلقي السلاح، أن تزداد مغايرة للنموذج التركي من القومية، بكل مندرجاته.
هذا التحول الفكري الذي عمد إليه أوجلان قبل ربع قرن فتح الطريق لتجارب مختلفة. في سوريا، الموضوع يحتاج لتفصيل لاحق. أما في تركيا، فقد استمرت المواجهة المسلحة، إنما نشأت بالتوازي معها تجربة تشكيل الحزب العلني الانتخابي، الذي يخوض رغم التضييق عليه، بل حظره، مرة تجربة الترشح للانتخابات الرئاسية، ومرة تجربة التعاون مع مرشح اليسار الأتاتوركي بوجه تحالف رجب طيب أردوغان مع اليمين الأتاتوركي. لا يمكن التكهن إذا كان وضع أوجلان الشخصي سيتبدل بسرعة بعد مبادرته الصادمة للكثيرين، إنما التي تستكمل منطقياً المسار الذي دشنه بعد قليل من دخوله السجن، حين بدأ يبتعد عن مركزية وديمومة مقولة «الحزب الطليعي» وعن حصرية مفهوم الدولة لتحقيق حق تقرير المصير لشعب.
اللحظة الأوجلانية الحالية تشير إلى دينامية في الأفكار والحيويات القومية، وليس إلى ضمور هذه الأفكار والحيويات.
التوتر بين الفكرة القومية والدولة-الأمة سمة تكاد تلازم الحداثة السياسية. القومية، من حيث تفترض في القالب الأيديولوجي الأكثر انتشاراً لها، نشدان مجتمع متجانس، منصهر. بينما الدولة-الأمة، كتركيب سياسي، لا تشترط هذا الإجماع الثقافي المسبق، وإن كانت عملياً تبحث عن مقدار من المجانسة الثقافية واللسانية، بحدود ما يقتضيه هم التماسك الاجتماعي السياسية، أي أن المجانسة الثقافية هي بحكم الوسيلة من منظار «الدولة الأمة» وهي الغاية من قيام الدولة من منظار الفكرة والحركة القوميتين. القومية تميل إذاً إلى «التجاوز» اطار على الدولة الأمة، بقلب العلاقة بين الغاية والوسيلة، لمصلحة التماثل الثقافي، بالشكل الذي يجعل من الممكن تصور الأمة على أنها جسد جماعي تنبض فيه روح واحدة، روح لا ترتاح الا بأن يكون لهذا الجسد منزله الخاص، دولته، لكنها روح لا تنفخها في هذا الجسد هذه الدولة.
التفريق الرائج بين التصورين الفرنسي والألماني عن الأمة لا يغطي كل المعنى هنا. التصوران الفرنسي (الدولة والتاريخ والإرادة المشتركة تصنع الأمة وليس العكس) والألماني (الأمة تشتاق إلى دولة تجمع شملها وتحقق مرادها) يضاف اليهما التصور الذي ساد في الحركات القومية في أوروبا الشرقية (أقلية مثقفة تخترع أمة من خلال وصل ثقافة النخبة مع الثقافة الفلاحية في مزيج خاص) وفي البلقان العثماني (تحويل الملة الدينية إلى الأمة من خلال ربطها بمحددين ترابي ولساني، وعلمنتها الجزئية). مفارقة النموذج التركي من القومية أنه أخذ شيئاً من كل هذا. من التصورات الفرنسية والألمانية والشرق أوروبية والبلقانية العثمانية «المسيحية» عن كيفية إيجاد الأمة. الدولة تصنع للأمة لغتها في النموذج التركي (فحوى خطاب «النطق» لمصطفى كمال) لكنها أمة يقال في الوقت نفسه أنها موجودة قبل آلاف السنين من وجود الدولة، منذ أيام الحثيين، عضوية، كجسد حاضر لا ينتظر سوى دولة تحقق مراده، وهي تقتبس من الحركات القومية البلقانية، بدءا من اليونانية فالبلغارية، عملية تحويل «الملة الدينية» إلى ملة قومية.
لأجل هذا، ربما كان مغزى تجذير التحول لدى أوجلان الإدراك بأن الفكرة الكردية ينبغي، في اللحظة نفسها التي تحل الحزب وتلقي السلاح، أن تزداد مغايرة للنموذج التركي من القومية، بكل مندرجاته. لكن هل هذا يعني التخلي عن الأصل القومي للفكرة الكردية؟ هناك من يقول ذلك. ليس الأمر -على ما نراه – كذلك. بل هو طفرة جديدة من التوتر الذي لا ينتهي بين مفهوم القومية ومفهوم الدولة الأمة. انما، في حالة أوجلان، القومية الكردية تقلع تماما عن أي مطالبة بتشكيل دولة أمة خاصة بها، وعن أي مطالبة بتشكيل دولة ثنائية قومياً، لصالح البحث عن صيغة مختلفة. ما هي هذه الصيغة المختلفة؟ لامركزية؟ حقوق ثقافية ولغوية؟ منحى مساواتي تشاركيّ تصاعدي؟ تليين للسرديات الغليظة؟ شيء من كل هذا، لكن أيضاً الرهان على أن ثمة بالفعل «جمهورية كردية» غير مرئية على جانبي الحدود التركية، وأن هذه الجمهورية في خطر عندما يغريها الاغواء بأن تصير مرئية، «رسمية» وتصبح في مأمن أكثر ان تحصنت في مقام… الهيولى، تلك المادة التي لا شكل لها والتي يتشكل منها كل شيء في فلسفة أرسطو طاليس.
كاتب وصحافي لبناني