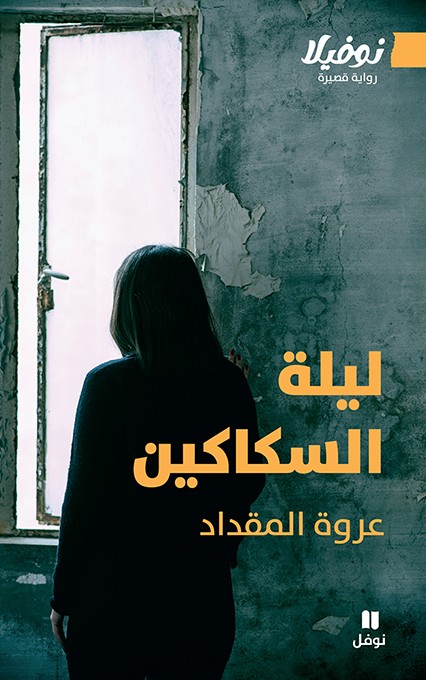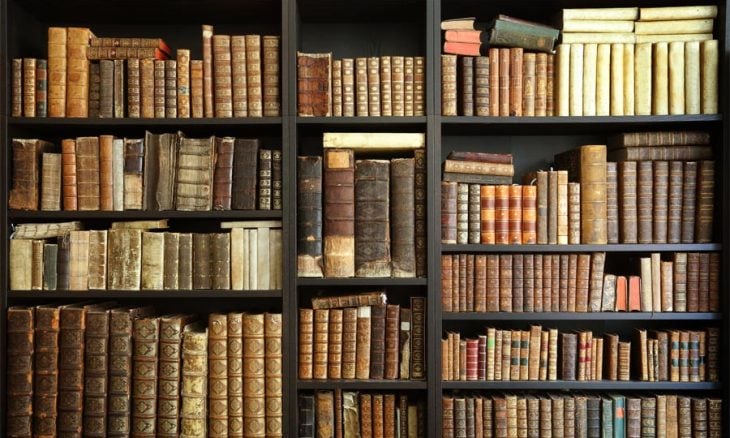
في الاشتقاق اللغوي من الدخيل والعامي

منصف الوهايبي
إن ظاهرة الاشتقاق من الدخيل والعامي، التي تتسع على نحو غير مألوف، في اللغة العربية المعاصرة، لأسباب من أظهرها اللغات الأجنبية التي تزاحم لغتنا، وتجاذبها مكانتها، قديمة جدا في تاريخها. ويكفي أن أسوق هذه الأمثلة الدالة، وكيف تصدى القدماء للظاهرة، وعالجوها بأريحية الباحث المتمكن المتضلع بلغته وبمواد بحثه. على أن هذه الاشتقاقات التي شاعت في شعر القرنين الثاني والثالث الهجري، وما بعدهما، لم تجئ كلها مخالفة للقياس؛ بل إن أكثرها يجري على أصول العربية وقوانينها في اشتقاق الصيغ وتصريفها. وهو مظهر مما نسميه «شعرية اللغة»، حيث ترد الكلمة في سياق من مشتقاتها. والمقصود بهذه الشعرية إنما هو التنويع الشعري على «الجذر» في نظام اللغة أو الأصل، أو «الثابت»؛ حيث التحول الشعري هو في جانب منه، من تحول اللغة الداخلي: فـ»الأصل» في العربية صامت يتكون من صوامت فحسب هي «الدال» وما يقدحه في الذهن من فكرة عامة، أو صورة ذهنية هي مدلوله.
على أن «الأًصل» لا يوجد لذاته أو بذاته، بل هو ليس سابق الوجود؛ فهو جزء من كلمات «مختلفة» تتأدى في حيزه بوساطة المصوتات، التي تضفي على الكلمة معناها أو مدلولها، على أساس من طابع المصوت وكميته أو مدته، من حيث الطول والقصر. وعليه فإن المصوتات هي التي تنهض ببناء الكلمة المصوغة، على نحو يتيح لنا الرجوع إلى صورتها، أو وزنها، أو صيغتها، أو بنائها.
ما يعنيني في هذا السياق، أن هذا النظام» نظام تعاقب المصوتات» أو بعبارة أدق «نظام التحول الداخلي»، القائم على إدخال المصوتات في الأصل الاشتقاقي، وهو من خصائص العربية؛ هو الذي أدار عليه شعراء «البديع» اشتقاقاتهم الخاصة، مثلما أداروا عليه أسلوب الجناس، من حيث هو حركة لغوية داخلية محكومة بقوانين صوتية. وهذا الاشتقاق، مهما تكن الهيئة التي يتخذها، أعمق من كونه توارد ألفاظ أو تداعي معان. ومن أمثلة ذلك قول أبي تمام من قصيدة يمدح بها المعتصم ويذكر قتل بابك وصلبه في سامراء:
وأباحَ نصلَ السيف كل مُمَهدٍ /// لم يَحْمَرِرْ دمُهُ من الأطفالِ
و»ممهد» أي صبي في المهد لم يتغير دمه من الصفرة إلى الحمرة.
ورواية المرزوقي هذه تبدو كأنها تصحيح لرواية الصولي «كل مرشح» أي قد ابتدأ شبابه. وجاء في شرح الصولي: «مرشح»: مربى ودم الطفل لا يحمر حتى يكبر».
وكذلك قوله:
يا سليمانُ تَرفَ اللهُ أرضا///أنتَ فيها بمستهلِ الغمامِ
ففي هذين البيتين تستوقفنا صيغتا» ممهد» (من المهد) «وترف» (من الترف) وهما توضحان الكيفية التي يستثمر بها الشاعر» نظام التحول الداخلي» في العربية، حيث إدخال المصوتات داخل الأصل طريقة أساسية من خصائص الفصحى. وإضافة هذه المصوتات مقيدة بطابع المصوت وكميته، وتضعيف الصامت الثاني من الأصل في «مهد» و»ترف» يعتبر إضافة عنصر آخر أساسي إلى إمكانات هذه التغيرات الداخلية؛ ومن معانيه المبالغة، وكونه محولا عن اسم (المهد، الترف).
والتضعيف يمثل في الذوق العربي عملية النطق بالصوت الصامت مرتين متتاليتين، دون انفصال، فضلا عن دوره البنائي في العربية، خاصة أن هناك كلمات لا يفرق بينها سوى التضعيف. ولا يوقفنا هذا النظام نظام «التحول الداخلي» على الهيئة التي تتخذها العلامة وعلى قواعد تنسيقها فحسب، وإنما يَبين أيضا عن وظيفة التركيب في نظم المعنى وتنظيمه. فإنتاج معنى مختلف من الفعل المزيد «مهد» إنما ينجم عن النظام المتعلق بوحدتين لغويتين، أو أكثر بحيث ننتقل من الثلاثي «مَهَدَ» بشتى معانيه مثل بسط ووطأ إلى المزيد «مهد» بسائر معانيه المستعملة مثل سوى وسهل وهيأ وقدم، فإلى المعنى الشعري المستحدث أي الصبي في المهد الذي لم يتغير دمه إلى الحمرة. وهو معنى مزيد، أو فضل معنى أو توسع في معنى الملفوظ وإفاضة، بل هو عبور من الكلام إلى اللغة نفسها، إذ يطعم الكلمة بما ليس منها مطابقة، أو تضمنا والتزاما، أو مجازا. وليس أصعب من هذا العبور الذي هو بمثابة وضع لغوي، فهو لا يكون إلا إذا ترضى ذائقة الجماعة وحظي بموافقتها. ذلك أن اللغة نتاج اجتماعي وملك الجماعة التي تتكلمها. ومن ثمة فإن سلطة الفرد على الدليل اللغوي جد محدودة. وكلمة «ممهد» موجودة في اللغة، ولكن ليس بهذا المعنى الذي استحدثه الشاعر أو «ولده»، بعبارة أدق؛ من ذلك مثلا قولهم» ماء ممهد» أي فاتر ليس ببارد ولا سخن. والحق أن هذه الظاهرة قديمة في الشعر العربي. وقد ذكر حمزة بن الحسن الأصفهاني، أن المولد لها قرائح الشعراء؛ وعللها بالضرورات التي يدفع إليها الشاعر في المضايق، أو عند حَصْره المعاني في بيوت ضيقة المساحة؛ أو بسبب العنت الذي يلحقه عند إقامة القوافي التي لا محيد له عن تنسيق الحروف المتشابهة في أواخرها. ذلك أن استيفاء حقوق الصنعة الشعرية يدفع الشاعر إلى «عسف اللغة بفنون الحيلة» إما بالحذف أو الزيادة، في أمثلة الأسماء والأفعال أو بتوليد الألفاظ… مثل توليد لغة أخرى في «الشكر» عند طرفة بإحلال حرف محل حرف: شكم وشكد، أو «الجرد» « مكان الجرذ في قصيدة العلاف البغدادي الشهيرة في رثاء هر له؛ أو ما قيل عن ابن أحمر الباهلي (ت.35هـ) من أنه جاء بأربعة ألفاظ لا تعرف في كلام العرب ولا في شعرهم وهي: «مأموسة» للنار، و»بابوس» للناقة، و»تنس» بمعنى تأخر، و» الأربة» لما يلف على الرأس؛ أو ما كتبه الجاحظ عن اللكنة كأن يدخل المتكلم حرفا أعجميا في حرف عربي وتجذب لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول.
ولنقس على ذلك كلمات مثل «ترف» التي تقدم ذكرها، و»قارٍ» في قوله:
هذا النبي وكان صفوةَ ربه/// من بين بادٍ في الأنام وقارِ
و»قارٍ» أي من أهل القرى، كأنه من قرى فهو قار إذا سكن القرى.
أو قوله يهجو:
إمْراتُهُ نفذتْ عليه أمورها/// حتى ظننا أنه امْراتُها
قال المعري: « لا يوجد في الشعر القديم إمراته، «إلا أن القياس يطلق ذلك…» وجوز أن تخفف الهمزة كما في قولهم « هذا خطا» أو «كلاك الله» بغير همز. وعليه فإن «إمراته» تحمل على أنها أنثى «إمرا»، ثم خفف المذكر والمؤنث الجاري عليه، وقطع ألف الوصل في « امرأة».
واللافت أن الاشتقاق لا يقتصر على اللفظ العربي، وإنما يتعداه إلى اللفظ الأعجمي واللفظ العامي مثل «فرزن» في قوله:
أفعشت حتى عبتهم؟ قل لي متى/// فَرْزنْت سرعةَ ما أرى يا بيدقُ
والشطرنج اسم أعجمي، وكذلك الشاه والفرزان والرخ والبيدق. ومن روى فُرزنت» بالضم، فالمعنى: جعلت فرزنا. ومن روى بفتح الفاء، أراد: متى صرت من الفرازين» وخلص أبو العلاء إلى أن ضم الفاء أحسن وأقيس».
وهذه الصيغة «فرزن» من الرباعي المأخوذ من أصل إسمي أعجمي (وفرزن) يتم تعديله على صيغتين إلى الحد الذي يتلاشى معه أصل الكلمة أو يكاد. أما الأولى فيحكمها التحول الداخلي والإلصاق بـ»سابقة التاء»، والثانية يحكمها التحول الداخلي المحض. وقد أثيرت قضية الدخيل أو الأعجمي في مباحث الإعجاز، من ذلك الفصل الذي عقده القاضي عبد الجبار في بيان فساد طعنهم في القرآن وذكر أمور غير معقولة في اللغة. ومما جاء فيه إشارته إلى أن» اللفظة لا يمتنع أن تكون فارسية، ثم تعرب وتغير فتصير عربية، لأن اليسير من التغيير يخرجها من بابها. ولا يمتنع أن تصير عربية لتعارف يحصل في اللغة العربية أو ابتداء وضع…»
وأما الاشتقاق من العامي فمثاله» تكشخن»:
لَمَ يُسودْ وجه الوصال بوشـــم الحب حتى تكشخنَ العشاق
وتكشخن كلمة عامية لا تعرفها العرب. وإنما حملت على القياس، ولعل الصواب فيها «تكشخ» كما يقول المعري؛ وهي مستعملة في عاميتنا التونسية. وقد سوغ ذلك بأمثلة مثل «تفعل» من سكران، فالوجه «تسكر». وأما مثل تسكرن وتعطشن من العطشان فمعدوم قليل بعبارته.
وما نخلص إليه أن بعض هذه الاشتقاقات كان مأنوسا قريب المأخذ يقدر لذة الأذن ومتعة السمع، فتقبلته الذائقة. وربما تفاوت بعضها، وكان ميزانها غير مستقر وباده المتقبل بما لا عهد له به، فاعترض عليه أو صرفه إلى أصل غير مرجوح. وهذا مما يفسر تعدد مناحي القول في هذه الاشتقاقات واضطراب الرواية في شواهد كثيرة من الشعر العربي. والأمر لا يتعلق بـ»واقعية» ينشدها الشاعر القديم، وإنما بـ»قصور لغوي» يجعل الشاعر يطرح الكلام بعضه على بعض، ويتأتى «التهجين»، أو «الاشتقاق»، أو «الدخيل» حتى يظفر بضالته من الإيقاع أو من التجنيس والتطبيق وما إليهما.
كاتب تونسي