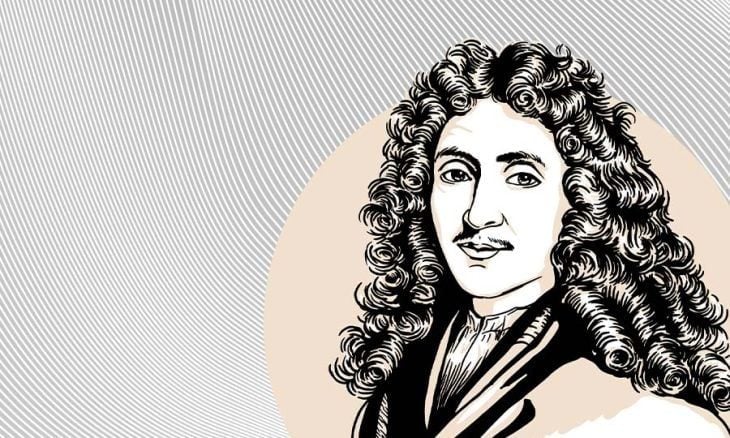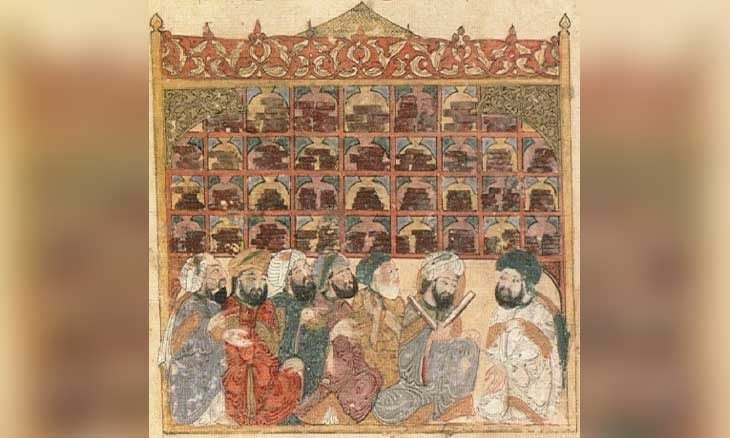عن فاطمة المرنيسي: الكتابة النسائية من معرفة السلطة إلى سلطة المعرفة

سلوى السعداوي
ضمن مؤلف جماعي مداره على النساء المعرفة والسلطة، قدمت فيه الباحثات التونسيات دراسات متنوعة وفق اختصاصات مختلفة (آمال قرامي وسلوى بلحاج وسلوى السعداوي وهاجر المنصوري وسماح اليحياوي وهاجر خنفير وهاجر حراثي وريحان بوزقندة)، جاء مقالنا عن فاطمة المرنيسي وكتابيها «نساء على أجنحة الحلم» و»شهرزاد ترحل إلى الغرب»، وبحثنا فيه موضوع الكتابة النسائية، وفي جنسين أدبيين ذاتيين بضمير المتكلم، وحاولنا تجاوز البحث في خصوصية الأدب النسائي وأسلوب الكتابة وموضوعاتها المتكررة في أغلب السير الذاتية بأقلام النساء على أهمية هذه الآراء، التي ما زالت سائدة تتساءل عن جمالية الكتابة عند النساء بمختلف مواضيعها من جهة، وتميز الكتابة الرجالية، أدبا وفلسفة وتاريخا، وفي مختلف البحوث العلمية من جهة ثانية.
قصدنا أن يتضمن عنوان المقال كلمة «النسائية» لا «النسوية» بما تحمله من دلالة أيديولوجية، ولأن كلمة النسائية تشمل الكتابة بأقلام النساء والأبعاد الإنسانية والوجودية والأيديولوجية، حتى لا نوجه مفهومي المعرفة والسلطة وجهة مخصوصة وضيقة الرؤية. فأردنا فهم كيف اكتسبت فاطمة المرنيسي المختصة في علم الاجتماع والمفكرة والروائية المعرفة الواسعة، منذ أن كانت طفلة، تدريجيا في الفضاء المنغلق (البيت المغربي الكبير) والمنفتح (الضيعة)، وكيف كان ذهنها وحواسها يسجلان تجارب النساء اليـومية في الحياة العادية، وكيف تمثلت القصص المروية مشافهة، وبنت ذاتها المعرفية، وقد تطور وعيها كهلة عندما رحلت إلى الغرب واتصلت بثقافة الآخر؟ ونقدته بجرأة في رسم الجسد الأنثوي العاري، وإفراغ صورة شهرزاد الحكاءة من الأبعاد الرمزية الكبرى، ومن أهمية فعل السرد مقابل الحياة؟

لقد بدأنا بتعريف المعرفة لاتساع مدلولها ومجالاتها المتعددة وأنواعها وغاياتها ووظائفها، وهي أوسع مدى من العلم والثقافة، ومن يمتلكها بوعي واكتسبها باقتدار، كان متفردا في فهم كل ما تعلق بالمعارف بكل أنواعها المادية والنظرية، الحسية والروحية، والسردية، ونقصد بذلك كل ما يتعلق بالنظرية والأجناس السردية والثقافية، وتتأكد الحاجة البشرية إليها. ولما أحطنا بهذا المفهوم المتشعب وصلناه بالسلطة ضديدها الظاهر، ولكن لولا المعرفة الكلية وخبرة العارف بكل ما يتعلق بالشأن البشري والتدبير: السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لما تمكن من السيطرة عليها، بل لما استطاع امتلاك هذه السلطة العارفة، فنفهم السلطة في اتجاهين: السلطة الجائرة بكل أجهزتها العقابيـة المادية والرمزية من جهة، والسلطة المعرفية الإيجابية الفاعلة والمؤثرة في متلقـيها وحيواتهم وسلوكهم وردود أفعالهم وتواصلهم الاجتماعي من جهة ثانية، ولذلك جاء تساؤلنا مشروعا عن تعدد المعارف، وتعدد السلطات، ولا يمكن لأي كان أن يفهم هذا التعدد ويتصدى لها بحثا عميقا وتأويلا وربطا، بوجود الإنسان وحريته، إلا النبيه والنبيهة من الأشخاص، الذين خبروا هذه المجالات وحفروا فيها عميقا، ونوعوا المرجعيات العلمية، ورصدوا مظاهر التمايز الاجتماعي والثقافي في الحياة الكبرى، وفي كل المؤسسات بداية من الأسرة إلى أجهزة الدولة.
فكان اختيارنا لعملين أدبيين للمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي المختصة في علم الاجتماع، والجامعية والناقدة النسوية والروائية القصاصة، والعمل الأول سيرذاتي روائي، والثاني يمكن تنزيله في أدب الرحلة، وهو من كتابات الأنا، ولا يخلو من السردية الأدبية وبناء القصة، على النحو الذي اختارته المؤلفة، مختلفا عن بناء الكتاب الأول «نساء على أجنحة الحلم». ورغم تأكيدنا وجوب التحرر من القيد الأجناسي الأدبي، والاشتغال بالكتابة الجامعة لأجناس الخطاب عامة، وهذا شكل من أشكال سلطة المعرفة بمفهوم الكتابة العالمة عامة، فإن جدل العلاقة بين الوقائعية والمرجعية بارز في أعمال المرنيسي القصصية: فلئن حاولت المرنيسي أن تحرر كتابها من الحد الأجناسي، فإنها تراجعت عن ذلك، وأكدت أن النص سيرة ذاتية أو متخيلة، وأن التاريخ روته نساء أميات.
وعمدنا في العملين إلى رسم ملامح المفكـرة فاطمة، وملامح مجموعة النساء في الحريم، وقد أسهمن في ترسيخ العادات اليومية من جهة، والتمرد عليها من جهة ثانية أمام الطفلة، التي كانت تحاول بفضل فطنتها ودقة ملاحظتها، فهم ما يحدث في هذا المجتمع العائلي عند غياب الرجال، أو في حضورهم (التجميل والتطبيب والسرد الشفوي والإخباري). فبعد أن كانت الطـفلة تحصل على المعرفة الطبيعية البدائية من أفواه النساء ومن ألعاب الأطفال المسرحية، ومن الثقافة القصصيـة الشفوية، تطورت مجالات أخذ المعرفة الاجتماعيـة والفلسفية والتاريخية «التي مكنتها من قراءة تاريخ النساء المنسي (السلطانات المنسيات في الإسلام) ومقارنتها بالتاريخ الرسمي الذي يدونه الرجال. فنوعت بذلك من أدواتها المعرفية لسبر المسكوت عنه في مواضيع الحريم والجنس والسياسة والتراث الديني، وأولت النصوص بعد الوقوف على معانيها جيدا ونفذت إلى خلفياتها الأيديولوجية وبحثت في بنى الثقافة التقليدية، وحللت أصناف الخطابات: نساء الحريم والصحافي الفرنسي الناشر، الرسام والفلاسفة والأدباء».
ولا نوافق بعض القراءات التي بالغت في وصف الجسد المقموع في «نساء على أجنحة الحلم»، فبدءا من العنوان لمسنا هذه الرغبة في التحرر من مختلف أشكال السلطة: سلطة الحكي التي أثبتت ذكاء السرد النسائي، وخبرة التمثيل والصناعة اليدوية، بل لمسنا سلطة حمل السلاح في الفضاء المنفتح، وإن سكن الحريم اللامرئي وجدان النساء. وما يهمنا في هذا المقال هو تمكن المرنيسي من اكتساب المعرفة حتى أصبحت من وسائل التفكير النقدي للخطاب الذكوري شرقا وغربا، وأكسبتها شجاعة لمواجهة الآخر بالحجج العلمية على قصر نظره لسلطة النساء المعرفيـة. وقد أوصلنا عملنا إلى أن الكتابة الأدبية وفعل السرد يعدان سلطة معرفية لم تعد حكرا على الرجال، وإنما أثبتت الكاتبات العربيات قدرتهن الفائقة على امتلاك الميكانزمات السردية (لا نتحدث هنا عن السرد الروائي التخييلي، أو السرد السير الذاتي فحسب، بل عن السرد مطلقا في جميع الخطابات، فنعتبر الكتاب الفكري أو التاريخي سردا، لسيرورة تفكير في موضوعات مختلفة، والتاريخ بطبعه سرد للوقائع الكبرى الماضية..).
ولاحظنا أن المرنيسي فضلا عن هذا التفنن في بناء الكون القصصي، خاصة في كتابها الأول «نساء على أجنحة الحلم»، بدت متفننة في بناء الخطاب الإقناعي الحجاجي في «شهرزاد ترحل إلى الغرب». لقد عادت المرنيسي إلى زمن شهرزاد الشرقية، وقارنتها بشهرزاد الغربية وناقشت موقف كانط السلبي من المرأة، وهذا يعني أنها أثارت قضايا الراهن من خلال مساءلة الموروث القصصي وفتنة السرد.
وما خلصنا إليه في مقالنا، بعد تدبر قضايا المعرفة والسلطة في الكتابين، والوقوف على مرجعيـات المرنيسي الفلسفية والتاريخية والأدبية، ومقارباتها التفكيكية والنفسية والاجتماعية، هو موضوعية الكتابة، وبعدها عن الإيغال في الذاتية رغم اختيارها السرد بضمير المتكلـم، فهيمن العقلي على الانفعالي الذاتي، ولم تبد منبهرة بالآخر مطلقا، رغم حذقها للسان الفرنسي واطلاعها الكبير على الثقافة الغربية.
ما الذي نخرج به بعد إنجازنا لهذه الدراسة ونشرها، وبعد متابعة الراهن في السرديات ما بعد الكلاسكية عامة، والسرديات النسوية خاصة؟
لقد أنجزنا هذا المقال قبل أن نقرأ كتابا مهما يضم دراسات مختلفة في الاتجاهات الجديدة للسرديات ما بعد الكلاسكية، أشرفت عليه أستاذة الأدب الفرنسي سيلفيا باترون Sylvie Patron، وهي مهتمة بالقضايا السردية: «الراوي وموته وإشكالية النظرية السردية»، واهتم أصحاب هذا الكتاب بمدخل إلى السرديات ما بعد الكلاسيكية، الاتجاهات الجديدة للبحث في القصة، بالسرديات النسوية، والبلاغية، والطبيعية، والعرفانية، والبلاغية – العرفانية في السرد غير الموثوق به، والأسس النظرية للسرديات عبر الوسائطية، والسرديات اللاطبيعية.
ففكرنا في إعادة تنزيل المقال في حقل معرفي كبير وهو السرديات النسوية، لأن العلاقة التقاطعية بين الأدب/ ونظرية السرد من جهة، والمقاربة الجندرية من جهة ثانية، مهمة تؤدي إلى نتائج جديدة بفضل اتساع مجال السرديات المعاصرة المنفتحة على السياق والمتحررة من كوسموس البنيوية التي شيأت دور المؤلف بعد أن أعلن البنيوي الشاب في بداياته رولان بارط، موته.
إن التمكن من منجزات النظرية السردية وتحليل الخطاب القصصي (جيرار جينيت) أفاد النقد النسوي في دراسة النوع الاجتماعي، فكانت هذه الحوارية التقاطعية مثمرة، أعطت أهمية لتحليل الأشكال السردية وأنواع التـبئيرات والموضوعات النصية واكتشاف بناء المتخيلات والتمثيلات الاجتماعية في الكون القصصي، وإدراك العلاقات بين الجنسين والتمايز الثقافي، وكيفيات تلقي هذا العالم السردي المبني على الاختلافات الاجتماعية وإدراكه ، وهذا ما لاحظناه في نص «شهرزاد ترحل إلى الغرب»، وقد نزلناه في أدب الرحلة، ويمكن تنزيله أيضا في الأدب المقارن( وهذا درسنا لطلبة الماجستير أدب) لا سيما وأن شهرزاد الشرقية تختلف عن شهرزاد الغربية التي أصبحت صورة جسدية مغرية، بلا فكر، فانزاحت عن صورتها الأسطورية الأولى إلى صورة غربيـة مشوهة.
لم ينته عصر السرديات إذن، وقد جددت المفكرات النسويات أدواتها (نقصد السرديات)، وأحيت كتاباتهن ما اصطـُلح عليه بالسرديات السياقية، لكن في جدل العلاقة بين مكتسبات النظرية السردية ودراسات النـوع الاجتماعي والسرديات الثقافية. لقد ساهم النقد النسوي المطبق على الأدب في تجديد «علبة السرد»، والميكانزمات السردية التي تُجرى على كل النصوص مهما كان نوعها. فاستفادت السرديات النسوية من السرديات العامة ومن أفكار سنايدر لانسر وروبين وارهول.
كاتبة تونسية