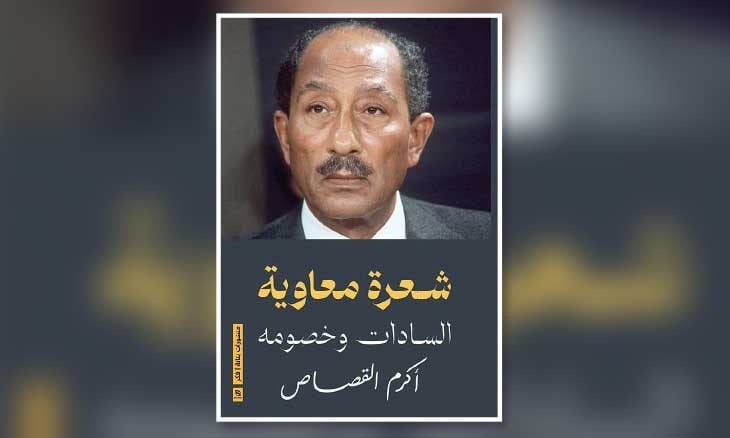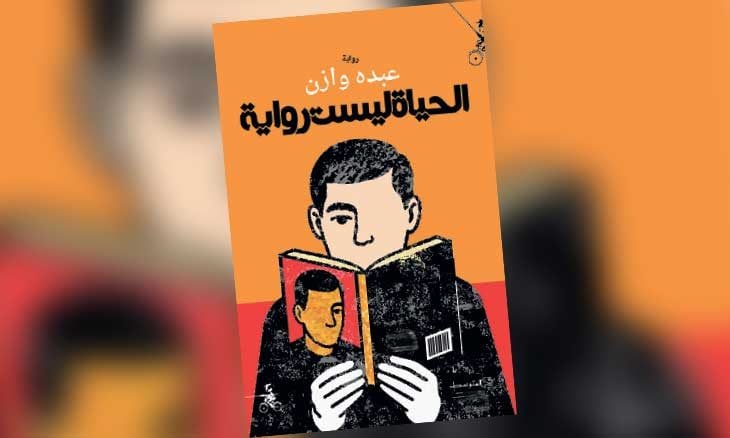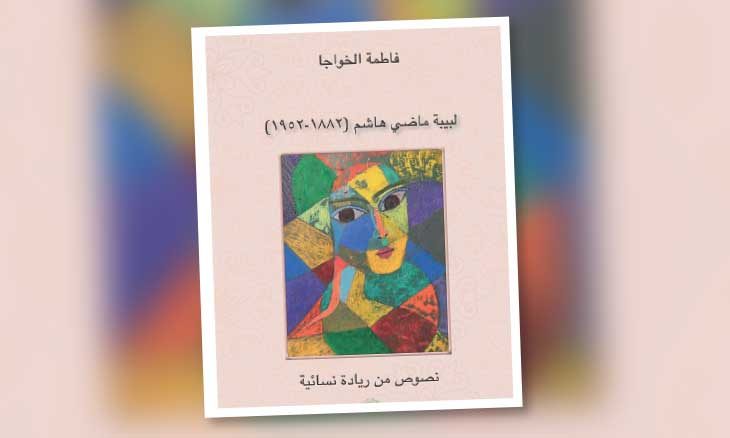استدعاء الشخصيات في الشعر العربي: هل ما زال توظيفها حاجةً فنّيةً؟

عبداللطيف الوراري
شكّل استدعاء الشخصيات التراثية، وحتى الأسطورية نفسها، إحدى الظواهر البارزة التي شاعت في شعرنا العربي الحديث، ولاسيما مع رعيل الحداثة الأول، من أمثال بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وخليل حاوي وأدونيس وصلاح عبد الصبور ومحمود درويش وأمل دنقل وغيرهم؛ فقد لجأوا إلى التراث العربي والإسلامي، وإلى أساطير حضارات وأمم عريقة، واستمدّوا من هذا وتلك شخصيات ذوات اعتبار ثقافي ورمزي حافل، وراحوا يوظفونها في أشعارهم توظيفا رمزيّا، ويعبرون من خلالها عن ذواتهم وهموم مجتمعاتهم وأمتهم وعصرهم، وكانوا بهذا الصنيع يتواصلون مع تراثهم وأسلافهم ومرجعياتهم المتأصلة في القدم. وقد صارت مثل هذه الشخصيات، أو الرموز والأقنعة الموظفة (سيف بن ذي يزن، المهلهل، زرقاء اليمامة، أبو ذر الغفاري، الحسين، الحلاج، ابن عربي، المعري، صقر قريش، طارق بن زياد، مهيار الديلمي، المتنبي، ديك الجن، إلخ)، تغتني بدلالات جديدة غير التي لها في المخيال الجمعي أو المرجع التاريخي، تبعا لأسلوب الشاعر واختياره الكتابي وموقفه الأيديولوجي ورؤيته للعالم؛ أي تصير هذه الشخصية غيرَها في رؤيا النص الجديد، وليس انعكاسا لها، بقدر ما يكون توظيفها نابعا من فهم التراث، واستيعاب حركة الواقع، والوعي بالعلاقة الجدلية بين الفن والحياة وصراع الهوية. ومن هنا، بات توظيف الشخصية/ القناع «وسيلة تعبير وإيحاء في يد الشاعر يعبر من خلالها، أو «يعبر بها» عن رؤياه المعاصرة»، يقول علي عشري زايد. ولعل الميزة الأكبر بالنسبة إلى قيم القصيدة العربية الحديثة من وراء ذلك الاستدعاء، هو التخفف من طابعها الغنائي وإدماج عناصر درامية وملحمية في بنيتها الشعرية، على نحو سمح بتوسيع أفقها الجمالي والثقافي.
وقد بحث بعض النقاد العرب هذه الظاهرة، حين وقفوا على آليات الاستدعاء وطرق تدبيره في النص الشعري الحديث، مثل علي عشري زايد في «استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر»، وخالد الكركي في «الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث»، وأحمد مجاهد في «أشكال التناص الشعري: دراسة في توظيف الشخصيات التراثية» وغيرهم. هل ما زال توظيف هذه الشخصيات حاجة فنية بالنسبة إلى الشاعر العربي المعاصر، وذلك في ضوء تحول مفهوم الشعر وأدوات كتابته، أو في سياق التبدلات الخطيرة التي جرفت فهمنا السائد للذات والعالم والأشياء؟
سمير سحيمي (تونس): رهانات الكتابة
تبقى الشخصيات التراثية مجال توظيف ممكن في الشعر العربي على اختلاف أنساق الكتابة فيه، يضمر استدعاؤها ويتوسع وفق الرؤى والتصورات والرهانات الإبداعية الجمالية والفكرية السياسية. والثابت أنّ هذا التوظيف لا ينطفئ كلّيا، بل تشوبه تحوّلات في كثافة الحضور وطرائق التوظيف، اقترانا بحضوره حضورا رمزيا ملغزا حينا، وحضورا مباشرا مكشوفا حينا آخر. وتعود أسباب هذا التفاوت إلى خصائص الكتابة الشعرية ورؤية الشاعر لها، إضافة إلى انخراط المبدع في سياقات إبداعية تختلف من زاوية وجهة النظر الموصولة بأشكال الكتابة الشعرية ومنطلقاتها ورهاناتها. وقد يبدو في تصورات تجانب الصواب، تقابل استدعاء الشخصيات التراثية مع الحداثة الشعرية، بسبب الوقوع في وهم الزمنية، أي فهم الحداثة فهما زمنيا، في حين أنّ الحداثة لازمنية. والحجة على ذلك ما تحقّق من حضور لرموز تراثية في تجارب قصيدة نثر عربيّة، رسخت قدمها وأصبحت مرجعا يستدلّ به في الاحتجاج برهاناتها الشعرية، وهذا ما يجعل القول بانكفاء حضور الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر مجانبا للصواب.
ولعلّ تمثّل استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي غير معزول عن صلته بالذاكرة، فالشعر ذاكرة متجددة تراهن على كتابة مختلفة بأسئلة راهنة وتقوم على تمثل مختلف تجلوه دينامية التوتر في قصيدة النثر، وتؤسس له شعرية التناغم والتجانس في شعر التفعيلة. على أنّ حضور الذاكرة في المنجز الشعري لا تعني هيمنة الماضي واستدعاءه كما هو، بل تقتضي كسر هذه النسقية الماضوية وتحويل أنساق الماضي المهيمنة إلى معانٍ شعرية راهنة تقول المستقبل أكثر مما تقول الماضي، وتبني شحنة دلالية شعرية جديدة تكون مرجعيتها الأساسية سؤال الكتابة الفردي، وحركة الذات الشاعرة في خطابها وفي فضائها الإبداعي المختلف الكاسر للأنساق، وهذا ما وجب تحقيقه في رهانات إنشاء كل تجربة شعرية تسعى إلى التفرد. ومن عوائق حضور الشخصيات التراثية في القصيدة العربية، الأسباب الدينية المذهبية والأسباب السياسية، لكنّ هذا العائق يرتبط بتجربة شاعر ما، لا الشعر العربي عموما، لأنّ الجمالي والشعري، وسمات القصيدة الحرّة المقاومة بالمعنى الجمالي، تمتلك ما لا يحدّ من الوسائط والطرائق التي تحافظ على هوية القصيدة وأبعادها الفنية، بكيفيات الكتابة ووسائط التوظيف والإخفاء والرمز والتخييل الممكنة، فالشعر عالم لا حدود لطاقات القول فيه، يسعى دوما إلى التجديد وتحقيق الاختلاف في أسراره وأسئلته الفريدة. وإذا أردنا التمثيل على عدم تعارض استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، يمكننا أن نشير ـ تمثيلا لا حصرا – إلى تجربتين شعريتين مكرّستين، على اختلاف رؤية الشاعر فيهما، حضر فيهما استدعاء التراث واستقدام الشخصيات التراثية هما تجربتا خليل حاوي وسركون بولص. وهذا ما يجعلنا ننتهي إلى أنّ حضور تلك الشخصيات يعزّز شعرية القصيدة العربية، إذا ما تمكّن الشاعر من تحديث آليات التوظيف والاستدعاء.
صلاح بوسريف (المغرب): صيرورة العمل الشعري

إن العمل الشعري الذي أتبنّاه ، بما فيه من تَرْكِيبٍ، وتَشَعُّبٍ، وتَشَابُك، وتَصادٍ، يفرض الابتعاد عن الشفاهة، أو الحَدّ من هيمنتها على النَّصّ، لأنَّه نصٌّ كِتابِيّ، له علاقة بالصفحة والعين، وليس تدويناً للصوت والشفاهة والإنشاد، كما أنَّه بناءٌ مُركَّبٌ فيه تتداخل الضمائر والأصوات، ويكون الاسترجاع، والسرد والحوار، وغيرها مما هي دَوَالّ لها علاقة بالبناء الملحمي، لا بالغنائيَّة التي هي من صفات القصيدة، ويبقى فيها الصوت الواحد هو المتكلم، وهو من يلبس أقنعة الآخرين، ويكون ناطقاً باسمهم، إذا ما حضروا عنده في القصيدة. وهذا يعود بي إلى بورخيس الذي عبَّر أكثر من مرة عن إحساسه بالشعر الملحمي، أكثر بكثير، وهذا كلامه، من الشعر الغنائي، وشعر المراثي. ويُضيف، في السِّياق نفسه، أن «كُتَّاب الأدب.. أهملوا واجباتهم الملحمية»، ما يعني أنَّ الشخصيات، من أي تاريخ، أو زمان، أو مكان، أو حضارة، أو لغة، أو ثقافة، لا يبقون بما كانوا عليه في العمل الشِّعْرِي، بل تتغيَّر سُحْناتهم، وأدوارهم، وهوياتهم، وما يكونون به في النص أو العمل، بل يكونون في سياق كونِيّ، لا علاقة له ببلد، أو ثقافة، أو إقليم، أو هوية، علاقتهم تكون بالخيال والمجاز، وما يترتَّبُ عن الخيال والمجاز من تعبيرات فنِّيَّة جمالية، هي إضافة لما هو موجود، وابتكار جديد، في غير الأفق الذي كانت عليه هذه الشخصيات. هذا كان عند جميع الشعراء الكونيين الكبار، أو من كبروا بعد موتهم، وصرنا نعتبرهم قيمة كبيرةً، وبورخيس بينهم، في شعره، لأنَّه كان شاعراً قبل كُلّ شيء، وبقي الشعر، بِكُل تداعياته، حاضراً في أعماله القصصية التي لا نقرؤها، إلا في أفق شعريّ جمالِيّ، أساسهُ الشكل كما كان يقول.
وإذا أنت عُدْتَ إلى رامبو، أو إلى إدغار آلان بو، أو إلى مالارميه، وحتَّى إلى السرياليين، ستجد هؤلاء، وستجد التراث والأسطورة، لكن بغير ما عرفنا به هذا التراث، وهذه الأسطورة. وإذن، فالشعر، والأدب عموماً، هو سليل زمن، هو صيرورة واستمرار، وهو أفق وطريق، وحين نستدعي مفهوم الصيرورة، فنحن نقصد الخلق والإحداث، والخُروج من القصيدة التي هي في بنائها، حتَّى في الشعر المُعاصر، وشعر الحداثة نفسه بالشكل الذي قرأناه، وعرفناه، بناء مسكون بالتاريخ، وبالماضي، في دوالِّه التي لم تُتِح البناء الملحميّ بِكُلّ تراكُباته، وما فيه من كثافة وغموض. الشعر هو الأرض التي تكون الإقامة فيها بالتَّجاوب مع هذا الزمان المتواصل السائل الذي لا يُسْتَنْفَد، ولا يُسْتَكْمَل، بل هو جُرْحٌ مفتوحٌ على مزيد من الجراح، أي بما يسمح بتأجيج الخيال والمجاز الذي هو تجاوزٌ وعبور واجتياز، بعكس الاستعارة التي هي اقتراض، وليست افتراضاً، كما في المجاز. فالاستعارة كما يقول عنها بورخيس، عُرِّيَتْ من اللحم، ليس مثل المجاز الذي عُمْقُه في دمه وهو يتجدَّد. والعربيَّة، في هذا التمييز دقيقة وعظيمة، والبلاغيون، مع الأسف، لم ينتبهوا إلى هذا الفرق الدقيق، لأنهم لا يقرؤون المجاز في الشعر، بل في النظريات البلاغية، بما فيها الحديثة، عندنا.
أرى أنَّ قراءةَ وجود شخصيات من التراث أو من الأسطورة، ينبغي أن لا نأخذه بهذا السُّؤال، بل بما تحضر به، ولماذا، وما السّياقات الفنية الجماليَّة، وأشكال البناء التي تكون فيها، آنذاك، يمكن أن نعرف هل حضوره قويّ أم ضعيف؟ هل هو شكل أم عمق، وهذا هو جوهر الحضور والغياب، وليس الحضور أو الغياب في ذاتهما.
سميح محجوب (مصر): حُجّة جمالية
لم يعد الشاعر في حاجة لارتداء أقنعة يرفع بها من سقف خطابه الشعري، أو يمرّر من خلالها مقولاته، تماما مثلما لم يعد في حاجة لمواضعات البلاغة القديمة التي تَحمّلها الشعر منذ عقود طويلة لصالح المشافهة والإنشادية، التي فرضها على نفسه، أو فرضت عليه من خارجه! لصالح إنشائية لغوية انتصرت طيلة الوقت لسطوة الألفاظ على المعاني، وربما لسطوة الأنا العليا في الأغلب الأعم على ما وصلنا من تراث شعري. لقد تخلّص الشعر من ذلك كله ليؤسس لنفسه خطابا جماليا جديدا لا يحتفي كثيرا بالموضوع، كما لا يحتفي بالسياقات المنتجة للتجربة، وبالضرورة لا يحتفي باللفظية التي تآكل محتواها الدلالي أمام «مكارثية» البصرية التي دفعت الخيال دفعا نحو نقطة اللاعودة. وحتى يواجه النص كل هذا، لم يجد أمامه سوى خيال اللغة ليحتمي به من السقوط في فخ الموضوع مرة أخرى، ومن ثمّ لن يستطيع ملاحقة أو منافسة آلة الواقع الذي امتلك الزمن ووظّفه لصالحه، قاطعا الطريق على التراث والأساطير كمضخات ميتافيزيقية يغذي بها الشاعر نصه. نحن إذن في عصر شعرية المعنى وأسطرة الذات، ومن السذاجة أن يستدعى شاعرٌ – قطع كل هذه المسافة نحو ذاته – تراث الآخرين وقصصهم ليمنح خطابه الشعري حجة جمالية من خارج نصه، في زمن ما بعد سقوط السرديات الكبرى.
أذكر أنني كنت مولعا باستدعاء الشخصيات التراثية والأسطورية في البدايات، ولديّ نصوص في دواويني الأولى مثل نص (محاكمة دين الجن)، ونص عن أبي ذر الغفاري وغيرهما من النصوص التي لا أتذكرها الآن، لكن هذا ظل يخفت شيئا فشيئا لصالح تقنيات أخرى عبر اللغة تحديدا، بعد تفكير طويل بين وبين نفسي حول أي مرتكزات الكتابة أعلى صوتا في التشكيل الجمالي للنص.
حكمة شافي الأسعد (سوريا): الحاجة إلى توظيف جديد
استدعاء الشخصيات التراثية سمةٌ من سمات الشعر العربي، منذ بدايته في عصر الجاهلية، إذ تجد شخصيات داوود وسليمان ولقمان وزرقاء اليمامة، واستمر هذا الحضور في عصور الشعر اللاحقة، فتجد مثلاً شخصية «الخضر» بصفاته الصوفية، فلا يقتصر حضوره في الشعر على شخصيته القرآنية، في حكايته مع النبي موسى. لكن هذا الحضور الثقافي للشخصيات التراثية أخذ منحى رمزياً وجمالياً أوسع في الشعر الحديث منذ بداياته، لأسباب سياسية وفنية. وهي أسباب لا تزال قائمة ومُحرِّضة، لكنها غير منتجة الآن فنّياً مثلما كانت في بدايات النقلة الحداثية؛ فاستدعاء الرموز التراثية والأسطورية أخذ يقلّ مع مرور الزمن، خصوصاً في قصيدة النثر، التي لا تحتمل عبئاً ثقافياً كبيراً، وحين تحضر هذه الشخصيات في شعر اليوم يغلب عليها الضعف التوظيفي، إضافة إلى الصورة الباهتة والنمطية والاستهلاكية، التي وصلت إليها معظم الشخصيات القديمة في الشعر. فالشخصية الموروثة ثقافياً تحتاج إلى إنتاج صفات شعرية وفنية لتعبّر عن واقع جديد وشعرية جديدة.
شخصياً، قلّما استدعيتُ شخصيات تراثية في شعري، من ذلك شخصية الحسين وشخصية السُّهْروردي، وكانت الغايات رمزية في ظل الديكتاتورية السياسية، لكنني غالباً أميل إلى نماذج رمزية خاصة، مثل تحويل «الرحى»، أو «الوعل» إلى رموز. في «رسائل السهروردي إلى حلب» تتحول هذه الشخصية إلى قناع لأنه بصوتي، لكن تحت القناع حديث سياسي سوري:
«سأعود إلى حلبٍ: وأرى جسدي المصلوبَ على أعمدةِ الصّيفِ تفسّخَ/ والطّيرُ تُغافلُ حرّاسَ الموت، وتخطفُ رزقَ اللهِ/ تَوَزَّعَ لحميَ في أفواهِ الطّيرِ، وصارتْ تنطقُ بالحكمة». وكذلك في نصّ عن الحسين: «أحمل رأسا وأركضُ/ أركضُ منبوذًا وطريدا/ أربعةَ عشَرَ قرنا ولم أجدْ زمنًا أدفنُ فيه هذا الرأس».
كاتب مغربي