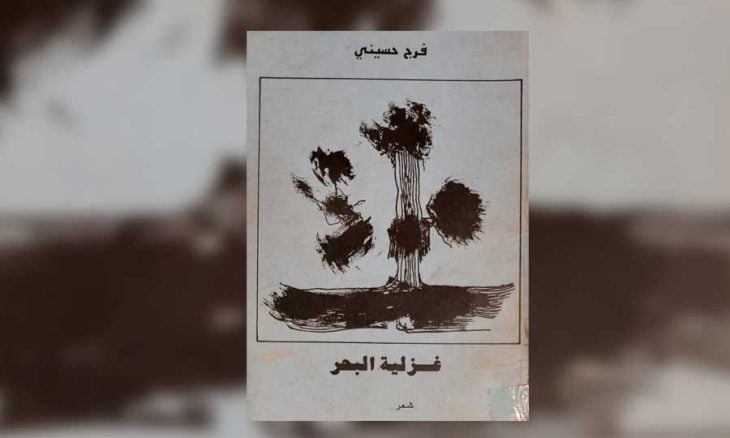
تفكيك الصورة الذهنية واستعادة الجماليات الموروثة في «غزلية البحر»

كريم ناصر
يتطلّب تأويل الشعر توضيحاً متأمّلاً ودقيقاً، وهذا ما يدفعنا إلى قراءةٍ دلالية تغطّي مساحةً واسعةً من مجموعة الشاعر فرج حسيني، لتفكيك الرموز اللغوية والاستعارية والسريالية المشفّرة لفهم البناء الفنيّ والصور المركّبة ومستويات التأويل في فضاء اللغة، وبذلك لا يمكن استيعاب هذا الشاعر الفذّ من غير استبطان لغته وتشوّفاته وتنبؤاته بالكشف والرؤى، وبالتوغّل في غابة أسفاره في الوطن ومن ثمّ في المنفى، وحتى بعد رحيله، وبناء على ذلك فلا يمكن أن تؤوّل الشعرية بمعالجة ذهنية لرصد توسّعاتها اللغوية من دون وعي باللغة لمسايرة إبداعه الشعري، والمرور بأفيائه ما لم يلامس الناقدُ الحصيفُ وعيه الجمالي لإنارة دراسته وتحقيق هذه الرؤية لاستكناه عالمه بغية اكتشاف ما في هذه المسيرة الشعرية من تحوّلات بنيوية وثورات في مستوياتها الدلالية والرؤيوية والفكرية.
التجديد رؤية وتمثّلا:
ربما أتاحت لنا هذه الدراسة مساحة لاستبطان الجسد الشعري وسبر أغواره، لخلق كينونة جمالية توازي البنية الذهنية في المجموعة الشعرية «غزلية البحر»، وإذا ما اكتشفنا تفكيكاً يعتور بنية اللغة التعبيرية، أو إشكالاً في ثغرة فنيّة تخلّلت تراكيبها اللغوية، فلا جَرمَ حقّاً أنَّ ورودها السلس إنّما يأتي لا ريب عابراً ووجودها من المنظور الشعري لا يُفسد هذا التفضيل اللغوي، الذي يكوّنُ عالم الشاعر الجمالي، وفي قراءةٍ تأويليةٍ لمنجز الشاعر نستطيع أن نلمس بالدلائل ومضات التجديد والاختلاف في الوحدات والدلالات، ونستنتج عموماً أنَّ الحداثة تكاد تسم معظم شعره وابتكاراته، وتخصّب رحابه وتتجاذب وجوده وطرائقه وكينوناته، ولأنَّ الشعر قضيّةٌ كبيرةٌ وهذا أكيد، إذن لا بدَّ من أنسنة الوقائع لنقل السمات الداخلية إلى الخارج لتفجير أنساقها الثورية، ما يسوّغ التسليم بتطويع تلك البنية الذهنية في سياق جماليات اللغة التي تتكوّن وحداتها من صورٍ متكافئةٍ من عيّنات تعطي انطباعاً عامراً بالكلمات الهادفة والحبك الجيد.
ولكيلا نطيل الحديث عن الطرائق الشعرية وسماتها الأسلوبية، لنسلب من جوهر المادة قيمتها الجمالية، فلا بدَّ من البحث في العمق عن الدلالة لنمسك بألبابها، انطلاقاً من هذه الرؤية، فكثيراً ما يعتمد الشاعرُ على آلياتٍ لغويةٍ تقوم على تنوّع أسلوبي (+ دلالي) يمثّل في الأغلب صورة الانزياح لاستنطاقه، سواء أكان في حالته السياقية، أو في نفيه في حالة الاستعارة، على ألّا يترك وراءه من ثغراتٍ تؤدّي إلى انحسار الدلالة وانتفاء المعيار لحساب البلاغة التقليدية، أو الصورة الذهنيّة الكامنة في اللغة.
الاستقلالية اللغوية:
عموماً فإنَّ الاستقلالية اللغوية كظاهرةٍ للتنوّع الأُسلوبي في الوعي الشعري، تمثّل نمطاً فنيّاً مبتكراً يحاكي جمالية الأسلوب، ويتطوّر منظوره باطّراد في رحاب الشعر وحركة التجديد والتخلّق والجدل، ما يخلق كينونة محايثة مستقلّة ومنفصلة عن القوانين الشائعة والأقنعة التقليدية وأغلال اللغة، وذلك يعني تكثيف الدلالات لتخطّي سيرورات إشكالية، وخلافات مشحونة بخيبات الشعراء ومصطلح الأجيال والتجنيس وتحجّر الفكر، وهذا سرعان ما ينصهر في بوتقة الشعر وتحوّلاته الفكرية لتكثيف دلالته، وبهذه الرؤى نصل إلى نتيجة نستخلص من مبادئها الأولية أنَّ مجموعة «غزلية البحر» تحظى بجوهر جمالي، وبمحمولات ثقافية ناشئة من مظاهر الانبعاث والتخلّق في نسيجها البنيوي، ما يعني أنَّ الظواهر الأدبية تبقى حوافز مولّدة للاستقلالية الشعرية، ومن ثمّ للتراكيب والوحدات في كيفية تجعل المبادئ من العمق والجوهر، خاصيّات يتفرّد بها الشاعرُ وحده، انتصاراً للتنوّع المثمر، وتوسيعاً للتعدّد الدلالي، وتطويراً للتراكيب اللغوية والسمات والظواهر حين تكون اللغة القاعدة لنقطة انطلاقها وجمالياتها الوحيدة، والحقّ أيضاً أنَّ هذا التمايز الدلالي من شأنه أن يوسّع مجال الاستكشاف، الذي يوفّر الأفضلية المثالية للاستقلالية اللغوية، بوصفها خرقاً لقواعد جاهزة تقيّد الحداثة بهذه الكيفية، ليس إلّا لتثبيطها أو لتقويضها لتبقى من غير جوهر دلالي.
التحرّر والمورفولوجيا:
إنَّ مفهوم التمرّد على الشكل والبنية والهيئة والتحرّر من النسق الخطابي، أو من الأنماط اللغوية السائدة، يعزّزُ البنية الشعرية الجديدة ويمكّنها من تشكّل مبادئها اللسانية خلال عمليات صوغ الوحدات الكليّة، التي تعتمد على بناها السابقة بواسطة أجزائها (البنى الداخلية للكلمات) ما يجعلنا نطمئن فعلاً إلى ذلك التحوّل الدلالي، وتلك الصيرورة المنبثقة من اللغة وجمالياتها، التي يعود إليها الفضل في تمتين البنية الشعرية لجعلها قادرة على تحقيق هدفها بمرونةٍ مقايسة بالنسق الخطابي السائد، وهذا ما يسمح للبدائل المورفولوجية بالنمو والتشكّل اللغوي تدريجياً، في إطار يفسح المجال لبنيةٍ جماليةٍ لا لبس فيها، ولا تهويمات وليست صعبة التأويل في تكوينها الاستطيقي، ما دامت هذه البنية بما تحملُ من خصائص جوهرية وأهداف سامية لا تخضع لمعايير غير جديرة بها.
ربما لا نستطيع الجزم في الحكم النهائي لنؤكّد بالقطع ضعف التمثيل الشعري من منظور النقد، نتيجة تحلّل فكرة تبدأ بالانحسار من جرّاء معالجة مبتسرة إلّا في حالتي خروج التركيب السليم عن مداره الطبيعي، أو في خروج الفكرة عن المعيار والصيرورة الشعرية، والشعر لم يقبل في تاريخه بتسويغ ما كان دون مستوى مضمونه التركيبي وسياقه الدلالي، فنحن نحلّل الديوان بوعي الناقد الجمالي، انطلاقاً من معالجةٍ صريحةٍ للموضوعات الجمالية التي تكاد تدمغُ جوهر الشعر وتتماهى به، وما استقراؤنا النقدي هذا إلّا تأويلٌ لتقويم المحتوى الجمالي لضمان سلامة اللغة، في إطار توضيب تراكيبها البنيوية من باب أولى، وليس التأويل لغرض التفنيد والإسقاط لغاية مبتذلة، لأنّنا والحق لسنا في معرض البحث المثالي عن المثالب اللغوية لتأليب وعي القارئ على الشاعر.
فإنَّ من الشطط النظر إلى أدب فرج حسيني من منظور لا يستبطن تجربته الشعرية بكلِّ تمظهراتها وتحوّلاتها البنيوية، وهذا يرتبط بقواعد استيعاب دلالية ومهارات إدراكية يقتضي فيها امتلاك خصائص النقد، لإغناء التأويل بمضمون دلالي، وبذلك تنتفي قواعد تصنيف الأشعار العميقة، بمقاييس النظم ولا يمكن توصيف ذلك تحت أيّ مسمّى من مستوى يستدعي الدرس اللغوي، الذي لا يمثّل في هوس النقد إلّا نفسه، نظراً إلى خصائصه المعيارية وسماته، وإذا ما استطعنا انطلاقاً من ذلك التأويل وضع اليد كإشارة أوليّة على بعض الهنات، ولاسيما قواعد النحو والصرف والتكرار والحشو وغياب التسلسل الكرونولوجي (Chronology) ومن ثمّ استبطان الصورة الذهنية على حساب جماليات اللغة فهذا عائد لا محالة إلى انحطاط الوحدات اللسانية في العلاقة اللغوية الناجمة عن نقل علّة موصولة بالدال (Signifier) )الفونيمات والحرف المكتوب) بتعبير دي سوسير وهذه العلّة باجتهادنا ليست من المسلّمات بالنسبة إلى المدلول (ٍSignified) (الصورة الفنية والمضمون).
وعلى كلِّ فإنَّ ثنائية الصورة الذهنية والصورة الجمالية كليهما، لا يعطيان بذلك الانطباع الكامل عن الخصائص الجوهرية، في ضوء رؤية تفرض هذه المعطيات وتصوّر الشعر منتجاً يعتمد في جوهره على موضوعيهما وتتغذّى خلاياه بنسغيهما الأثيرين، نستطيع أن نقدّم بالدلائل والتصوّرات أنَّ الشعر الحداثي في حقيقته ليس كلّه نعوتاً وصفاتٍ وتهويمات واستعارات ذهنية، ففي إطار هذا المساق يبقى من حقّنا أن نشير إلى بعضها بشيء من المسؤولية النقدية، وهذا بالضبط ما ندعو إليه في هذه المقاربة ليكون في مقدورنا زحزحة كلّ ما هو طارئ عليها لا يسير وفق المبادئ الجمالية في ذلك المنظور، كي ندخل في جوهر موضوعها للحدِّ ما أمكن من الرؤى العقلية المجرّدة والأحكام القاطعة لتخطّي حدودها بغية انتزاعها من ذاكرة الشاعر.
والملاحظ أنَّ شرحاً مختصراً لمعرفة مكمن الفرق بين الصورة الذهنية والصورة المتوارثة من جماليات اللغة، يمكننا عموماً أن نوجز صوغه كالآتي: إنَّ الصورة الذهنية تُفسد اللغة والمضمون والرؤية، بل ربما لا تصل التجربة الشعرية ككلّ إلى غاية إبداعية يرنو إليها الشاعر، بسبب احتدام القوالب اللغوية الجاهزة التي تهدم البناء العماري للقصيدة، بناء على ذلك لن ينال استئصال الصورة الذهنية الطارئة في هذا السياق من جماليات اللغة وعماريتها التشكيلية..
فالفرق هنا واسعُ النطاق، يرجع إلى الرؤى والتصوّرات الاستعارية، إذ إنَّ طريقة الاستئصال تتطلّب إزالة العلّة لابتكار بنية دلالية حتى يقوى المعنى ويعمّق وظيفته التي تمثّل كثافةً جوهرية تقتضيها تلك الغاية، وهكذا تُصبح الصورة الجمالية الموروثة من كنوز اللغة ضرورة حتمية لملازمة المعاني الدلالية لإحياء الشعر الحداثي وأفضيته وتراكيبه اللغوية ضمن هذه المبادئ.







