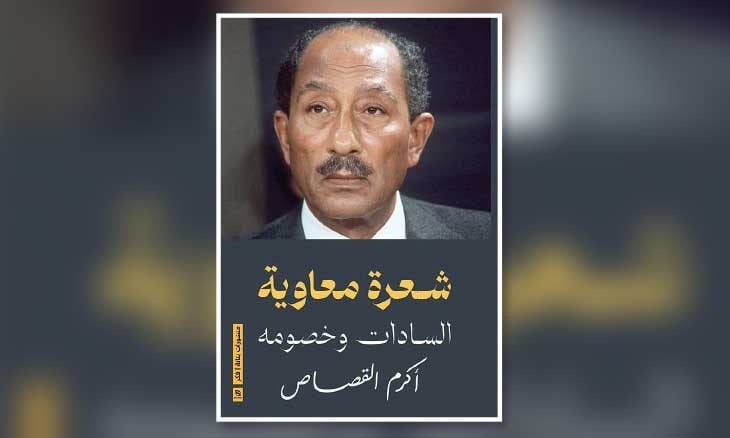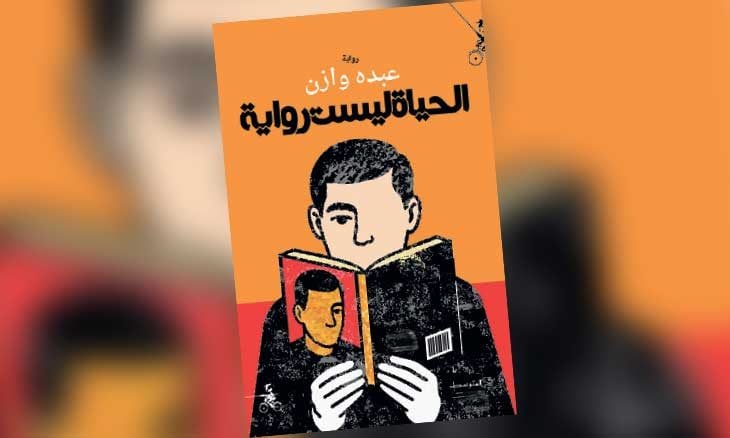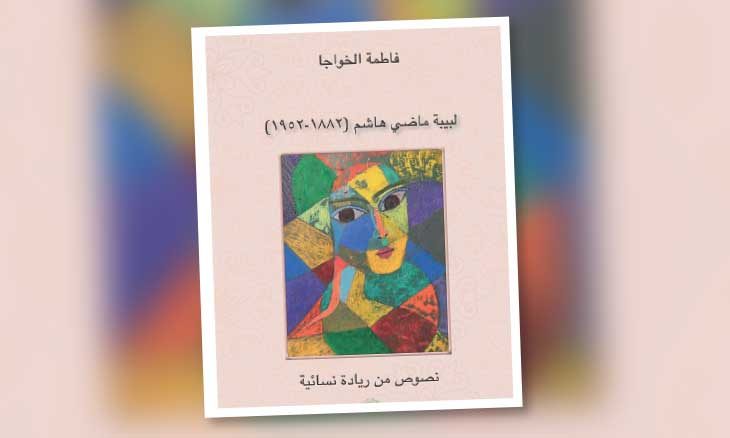علي شحرور: (جسد) العاملة الأجنبية في طوافِها المُهشَّمِ

علي شحرور: (جسد) العاملة الأجنبية في طوافِها المُهشَّمِ
رغمَ التَّراجُعِ الفنِّيِ المُؤْسِفِ الذي يُخيِّمُ أخيراً على مسارحِ بيروت، المدينة التي منحت العالم في أحد الأيام المدارسَ الفنِّيَّةَ الرائدةَ، ينهضُ فنّانونَ بقامةِ علي شحرور لإعادةِ بوصلتِها الفنِيةِ الضالةِ.
في هذا السّياق، يبرز شحرور كظاهرةٍ فنِّيَّةٍ مُتكاملةٍ، يتخطَّى في إبداعِهِ حدودَ القوالبِ والتّعبيرِ الحركيِّ الصرفِ. فهو مُلِمٌّ بمختلفِ اللُّغاتِ الفنِّيَّةِ الإبداعيةِ، يتعاملُ معها بطلاقةِ اللغةِ الأمِّ، فينجح ببراعةٍ في مُزاوجةِ العوالمِ والتعابيرِ الفنِّيَّةِ، مُدركاً جوهرها ومُعيداً تشكيلَها بأسلوبٍ فريدٍ، ليصبحَ فضاءُ العرضِ حلقةَ وصلٍ بين شتَّى الفنونِ، مُستعصياً على التصنيفِ ضمنَ قالبِ الرقصِ وحدَهُ، أو حصرِهِ في المسرحِ أو الموسيقى بمعزلٍ عن غيرِهما.
إنَّهُ مزيجٌ فريدٌ يحافظُ فيهِ كلُّ فنٍّ على استقلاليَّتِهِ، مُحوِّلاً خشبةَ المسرحِ إلى دائرةٍ فنِّيَّةٍ مُتكاملةٍ. في فضاءِ «مسرح المدينة» شِبهِ العاري، حيثُ تتجلَّى الأجسادُ النسائيَّةُ الثلاثةُ بأصالتِها الخام، قدَّمَ علي شحرور في عرضِهِ «عندما رأيتُ البحر» تجربةً بصريةً وحشيةً وصوفيةً تتجاوزُ حدودَ الرقصِ لتلامسَ عوالمَ إنسانيةً مُعذَّبةً، مُحوِّلةً الأجسادَ إلى أيقوناتٍ تستدعي في الذهنِ لوحاتِ غوغانَ البدائيةِ.
لكنَّها هنا مُجرَّدةٌ من الألوانِ لإبرازِ الوحشيةِ الكامنةِ في الملامحِ والحركاتِ. هذا التجاور بين إيقاعاتِ الجسدِ وعويلِ الغناءِ يُثيرُ دهشةً عميقةً أمامَ وحشيةِ الوجودِ الإنسانيِّ، فردياً وجماعياً (القبيلةَ).
يتَّسعُ مفهومُ المسرحِ في هذا العرضِ مُتجاوزاً الفضاءَ التقليديَّ الأحاديَّ البُعدِ، ليتحول إلى بُرجِ بابل شاهقٍ تتعالى فيهِ أصواتٌ ولغاتٌ وحضاراتٌ مُتشابكةٌ.
يتمازجُ الأنينُ مع المزمارِ، والشَّجنُ مع الغناءِ الطوطميِّ وعُواءِ الأمِّ الثَّعلبةِ، وحتى اللَّطمياتِ، خالقةً سيمفونيةً وجوديةً مُفعمةً بلعنةٍ تُفضي إلى بَلْبَلةِ الألسنِ، فتتحولُ خشبةُ المسرحِ بعدَها إلى سفينةِ نوحٍ عائمةٍ في الفراغِ، حيثُ يطوفُ الجميعُ بين الصُّوفيِّ والقبليِّ، صراعاً للنَّجاةِ من طوفانِ الحربِ الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والأحداثِ المأساويةِ التي أوقعتْ أعداداً كبيرةً من العاملات الأجنبيات ضحايا.
في بُؤرةِ العرضِ، تتمركزُ ثلاثيةٌ نسائيةٌ قوامُها زينة موسى وتيناي أحمد ورانيا جمال. لا يقتصرُ حضورُهُنَّ على استعراضِ سِيَرِهنَّ الفرديةِ، بل يتجاوزُ ذلك ليحملنَّ أمانةَ ذاكرةٍ جمعيةٍ لنساءٍ أُخرياتٍ.
تبرزُ أجسادُهُنَّ على الخشبةِ كأيقوناتٍ مُروِّعةٍ في الفراغِ، حيثُ يذوبُ لونُ البشرةِ في سوادِ الخشبةِ، بينما يخلقُ الضوءُ (تصميمُ غيوم تيسون) المُسلَّطُ عليهنَّ وعلى الجمهورِ في بدايةِ العرضِ تأثيرَ «السِّيليويت»، مُحوِّلاً إياهنَّ إلى ظلالٍ مُوحَّدةٍ، مُسقطاً عنَّا أحكامَنا المُسبقةَ. فالظلالُ واحدةٌ، بلا لونٍ للعينينِ أو للبشرةِ، لتتجلى بدايةُ الحكايةِ هنا كقصةِ إنسانٍ مُجرَّدٍ من أيِّ تصنيفٍ ضيِّقٍ، قبلَ أن تكونَ قصةَ عاملةٍ أثيوبيةٍ وقعتْ ضحيةَ نظامِ الكفالةِ والعبوديةِ الجديدةِ. يبدأُ السَّردُ من العامِّ ليلامسَ الخاصَّ ثم يتسامى فوقَ فضاءِ الأحكامِ الضَّيقةِ.
ثمةَ صوفيةٌ مُدهشةٌ تلفُّ الأجسادَ في طوافِها المُهشَّمِ على الخشبةِ، تصدحُ بأصواتٍ مُتناغمةٍ مع المُغنيةِ السوريةِ لين أديب والعازفِ اللبنانيِّ عبد قبيسي.
في فضاءٍ مأتميٍّ يضجُّ بالنَّدبِ والحزنِ بلغتينِ هما الأَمْهَرِيَّةُ والعربيةُ، يبلغُ الإحساسُ بالجنائزيةِ ذروتهُ في الأداءِ الصَّوتيِّ والحركيِّ. جسدٌ يتمايلُ كعبَّادِ الشمسِ مُتتبعاً النُّورَ، وآخرُ يسيرُ كشراعٍ مُنسابٍ في الريحِ يتوهُ اتجاهُهُ في الأفقِ الشاسعِ، فلا ندري أهو قادمٌ أم راحلٌ، وعظامٌ ناتئةٌ لجسدٍ جائعٍ يتلوَّى تحتَ وطأةِ المجاعةِ، وآخرُ يتحركُ برشاقةِ خُفَّاشِ الليلِ. ثمَّ يصدحُ عُواءُ الثَّعلبةِ الأمِّ مُتفجعاً على فقد ما.
في لغةِ الرقصِ التعبيريَّةِ هذهِ، ارتدادٌ مُحتملٌ إلى عوالمِ بينا باوش وروادٍ آخرينَ شكَّلوا مصدرَ إلهامٍ مُبكراً لشحرور. لكنَّ شأنَهُ شأنُ كلِّ مُبدعٍ أصيلٍ، يستلهمُ شحرور ليضيفَ لمستَهُ الخاصةَ، بصمةً فنيةً ترسَّختْ في أعمالِهِ السَّابقةِ وتتجلى بوضوحٍ في إيقاعاتِ النساءِ الثلاثِ، مُكوِّنةً عموداً فقريّاً لحركتِهنَّ. يبدو تحرُّكُهُنَّ كأنَّنا نشاهدُ شحرور نفسَهُ يرقصُ في عروضِهِ السَّابقةِ.
تأتينا السَّردياتُ من أفواهِ النساءِ مُصفَّاةً نقيَّةً، تبوحُ بالحقيقةِ عاريةً كما هي، ربما لأنَّهُنَّ لا يعرفنَ دهاليزَ اللغةِ المُعقدةِ ولا يستعرنَ بالجمالياتِ اللغويةِ، فتصبحُ اللغةُ وسيلةَ تعبيرٍ بدائيةٍ تنقلُ الجرحَ والقسوةَ كما هما وتعرِّي القصةَ من أيِّ تزيينٍ.
وقد أبدعتْ حلا عمران في توليفِ هذهِ الرواياتِ المُستمدةِ من شهاداتِ نحوِ ثلاثينَ عاملةً مُهاجرةً، وثَّقَ الفريقُ قصصَهُنَّ في أتونِ الحربِ الأخيرةِ على لبنانَ. في تلكَ الأجواءِ القاسيةِ، تُرِكَتْ عاملاتُ المنازلِ المُهاجراتِ لمصيرِهنَّ المجهولِ بعدَ تخلّي أصحابِ عملِهنَّ اللبنانيينَ عنهنَّ خوفاً من القصفِ، ليواجهنَ الوحدةَ والضياعَ بلا مأوى أو أوراقٍ ثبوتيةٍ.
صحيحٌ أنَّ الفنَّ قد لا يمحو الظُّلمَ الاجتماعيَّ، لكنَّهُ يظلُّ شاهداً أميناً في سجلِّ التاريخِ على وصمةِ العارِ التي تُلاحقُ الإنسانيةَ. فالجسدُ في هذا السياقِ نظامٌ مُتكاملٌ من الإشاراتِ والرُّموزِ والطُّقوسِ والتحولاتِ، يصبحُ فعلَ مُقاومةٍ ومُحاولةً لاستعادةِ الحقِّ في التعبيرِ والوجودِ بالرقصِ والغناءِ.
وفي حينِ عالجَ عدد من الفنانينَ قضايا مُماثلةً مُرتبطةً بالعاملاتِ ونظامِ الكفالةِ أو غيرِها من القضايا الاجتماعيةِ، يبقى التميُّزُ في الـ «كيف» لا في الـ «ماذا».
من هنا، يُطلُّ علينا علي شحرور في كلِّ مرَّةٍ بإبداعٍ يتخطَّى حدودَ توقعاتِنا مُتجاوزاً ذاتَهُ، مُرتقياً نحو آفاقٍ فنيةٍ أرحبَ، ليؤكد على فرادةَ صوتِهِ وقدرتَهُ الاستثنائيةَ على التعبيرِ، ما يجعلُهُ علامةً فارقةً تستحقُّ منَّا التوقفَ والتأملَ في تجربتِهِ الثريةِ التي تتجاوزُ القوالبَ الجاهزة.