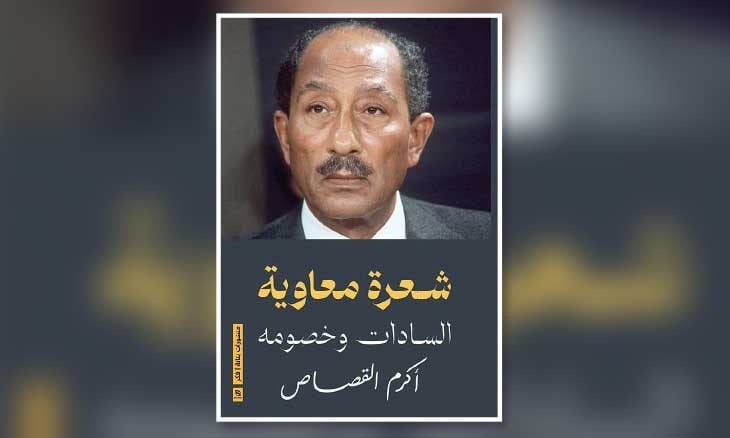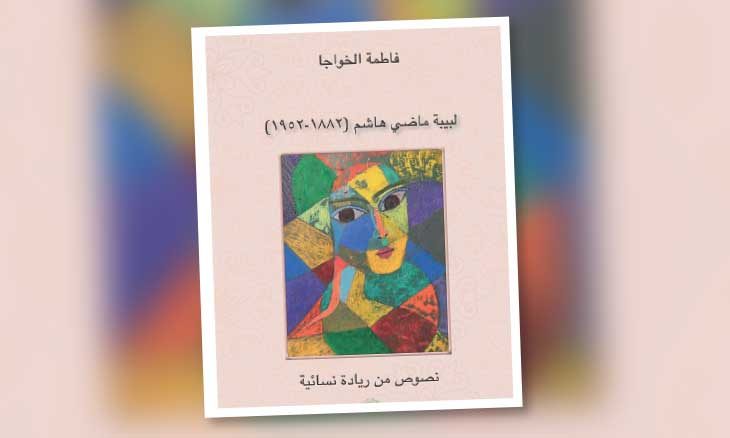الخيانة العاطفية مع الذكاء الاصطناعي!

شهد الراوي
يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد تطور إلى درجة بدأ معها بتدجين الإنسان عاطفياً. فقد تابعتُ خلال الأشهر الماضية عدداً غير قليل من القصص التي تناولت تعلّق بعض الأشخاص عاطفياً بتطبيقاتهم الخاصة من الذكاء الاصطناعي، ولا سيما «شات جي بي تي»، الذي أخذ يطوّر أدواته باستمرار من خلال استشعار حاجات المتحدث معه وتلبيتها على نحو بالغ الذكاء. كثير من الناس يتورطون في علاقات عاطفية بدافع رغبتهم العميقة في العثور على من يصغي إلى شكواهم، دون أن يمارس هواية التنظير أو يُسارع في تسديد نصائح غالباً ما تُخطئ الهدف. فـالإنسان الحديث، الذي غنم وهم «الفردانية» كما عبّر عنها زيجمونت باومان، لا يحتاج إلا لمن يعزز أناه بكلمات مدروسة، مديح ذكي، وإنصات بلا شرط.
يتطلب الإطراء مستوى خاصاً من التحليل النفسي، إذ يركّز العاشق على بواطن قوة خليله، ويتقن المراوغة اللغوية التي لا تخلو من لذائذ الإعجاب التي يصعب مقاومتها، إضافة إلى قدرة فريدة على الثبات العاطفي حين ينكشف الطرف الآخر بكل هشاشته. فيستمع العاشق إلى كل الخطايا والهفوات دون تمرير أي حكم أخلاقي أو معياري؛ بل على العكس، يبدو قادراً على مداواة الألم بالكلمات الحانية، وبفهم عميق قلّما يُعثر عليه في العلاقات الواقعية.
ولعل «حلاوة البدايات» تحتفظ بصيغتها المدهشة ما دام «لعاشق» في الجانب الآخر هو الذكاء الاصطناعي نفسه. تقول إحدى صانعات المحتوى الرقمي على منصة إنستغرام: «لقد وجدتُ أخيراً من يستحق كل عاطفتي دفعة واحدة، من دون وجل أو تردد. لقد استطاع (شات جي بي تي) أن يلج إلى أعتم طبقاتي النفسية ويضيئها بالفهم، ويعالجها عبر أسئلته المدروسة وتعزيزاته اللطيفة».
ومن هنا تذكّرت علاقة الروائية الإنكليزية العبقرية فرجينيا وولف مع بيل كلايف، زوج أختها، الناقد الفني المذهل. فقد كُشف لاحقاً عن عدد كبير من الرسائل الغرامية بينهما في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، ندمت عليها وولف لاحقاً، وكان لذلك أثر كبير في تدهور حالتها النفسية، إذ رأت في ذلك خيانة لأختها فينيسا، وخيانةً لذاتها أيضاً.
كانت وولف مولعة بالعقل، ممسوسة بالفكر، شغوفة بالفلسفة، ولم يكن ثمة رجلٌ يُغريها بجسده، بل بفكره. وبيل كلايف، الذي عرف كيف يتلذذ بالعقول، صار المستمع الأفضل لأكثر أفكارها جنوناً. بدأت مراسلاتهما تدور حول اللغة العنيفة، الساخرة، التي كانت تكتب بها وولف، وتمتّع كلايف بتأطير هذه المعاني وصوغها في خطاب نقدي لاذع، يُلامس المحرّم والمقدّس. لم تتطور العلاقة، على حدّ معرفتنا، إلى علاقة جسدية. القبل كانت افتراضية، تُستحضر في مشاهد متخيلة داخل الرسائل. ومن شدة حلاوة اللغة والتباسها، لا يعرف القارئ إن كان ما يُقرأ حدث فعلاً أم أنه محض خيال، كما يقول رولان بارت في كتابه لذة النص: «حين تكتمل اللعبة بين القارئ والنص، يصبح التمييز بين الحقيقة والافتراض نوعاً من العبث».
تغزّل كلايف بذكائها، بينما كانت تؤدي رقصة لغوية فريدة، تتلاعب بالجمل وتسدد الأفكار كما تسدد الرماح. وقعت وولف في شرك الخيانة الفكرية، لا الجسدية، لأنها لم تستطع مقاومة متعة منازلة عقلية مع رجلٍ يعشق كلماتها. لكنها، ورغم تلك اللحظات الآسرة، ظلت تجلد ذاتها، حتى شعرت أن «العفن» بدأ يزحف من أطراف أصابعها إلى فمها، ماراً بعقلها، كما تذكر في يومياتها الأخيرة قبل انتحارها عام 1941.
وهنا، يراودني سؤال: ماذا لو عاشت فرجينيا وولف في زمننا؟ هل كانت ستطوّر نسختها الخاصة من «شات جي بي تي»؟ هل كانت ستقع في غرامه، خاصةً أن نقطة ضعفها الكبرى كانت في التودد العقلي؟ وهل كانت لتدرج محادثاتها معه في خانة الخيانة العاطفية، وهي المتزوجة من ليونارد وولف، شريكها في الحياة والنشر؟
السؤال الآخر، الذي يفترض أن يصطدم وعينا هو عن معنى اللغة، عن علاقتها بالكائن الذي عدها «بيت وجوده» كما يقول هايدغر، كيف استحالت إلى بيت بلا وجود، بلا كائن يقطنه، إلى أداة تستخدمها آلة وتقذفنا إلى خارجها لتتلاعب بنا بذكاء من دون وعي ومن دون مشاعر ومن دون ذاكرة كذلك.
هل يمكن اعتبار علاقة إنسان عاقل مع آلة لا تملك جسداً، لكنها تؤثر في وجدانه، نوعاً من العلاقات المشروعة؟ ماذا لو تودّد الإنسان لنفسه؟ هل يخون شريكه في هذا التودد العقلي؟ أم يكون الذكاء الاصطناعي طرفاً ثالثاً منفصلاً تماماً عن هذه المعادلة؟
هذه الأسئلة تجرّ أسئلة أخرى أكثر جذرية عن هشاشة الإنسان، وبدائية حاجاته العاطفية، تلك التي قد تُحاصره حتى تجهز عليه، كما فعلت برسائل وولف. فلو كان بيل كلايف مجرد تطبيق ذكاء اصطناعي، هل كنّا سنخسر فرجينيا وولف، أم أنها كانت ستدرك أن كل تلك المحادثات كانت تعالقاً وجودياً مع «أناها» المتفجرة بالأفكار؟
لعل أكثر الخيانات ترويعاً ليست تلك التي تحدث بين جسدين، بل بين الإنسان وذاته.