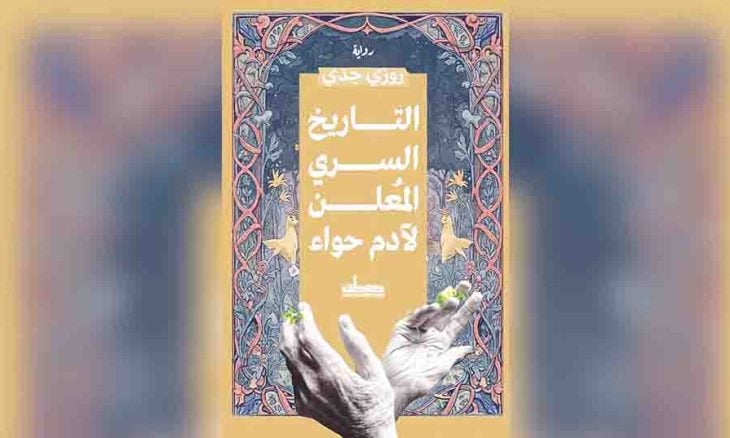«أيام الفاطمي المقتول» رواية التونسي نزار شقرون: سردية الروح وتوازيات الذاكرة والهوية

«أيام الفاطمي المقتول» رواية التونسي نزار شقرون: سردية الروح وتوازيات الذاكرة والهوية
عادل ضرغام
في روايته “أيام الفاطمي المقتول” يشتغل الروائي التونسي نزار شقرون على الذاكرة التي تنطلق من الآني والمستقبلي لتعود إلى ماضيها متأملة إياه، وكاشفة عن جدلها وارتباطها المستمر بالماضي، ومن خلال هذا الارتباط تعيد الرواية الاشتغال عليه برفده بزوايا رؤية لم تكن متاحة لحظتها، فنجد حضورا لأزمة الهوية وأمراضها وعللها الثابتة، وفقدان تصالحها الطبيعي مع تاريخها حتى في لحظات صحوتها وثورتها، وذلك من خلال التركيز على لحظتين فارقتين بمصر وتونس، تتعلقان بالثورة، وما يرتبط بها من ثبات، بتوليد بدائل مشابهة للسابق الذي قامت الثورة ضدها، وفي ذلك إقصاء للمتوقع أو المتخيل المرتقب.
في سياق هذا التداخل المستمر بين الماضي والآني والمستقبل يشتغل النص الروائي من خلال إشارات خافتة تتوزّع برهافة على امتداد النص الروائي، للكشف عن أزمة الهوية وعللها الممتدة، تتمثل في إقصاء المخالف أو المغاير في الدين أو المذهب، ومعاداة الاختلاف. تقوم الرواية على لعبة سردية، تعطي السارد حرية للحركة، وحرية للمعرفة، وكأن الحرية في البلدان العربية لا تتحقق إلا بالموت. السارد في الرواية (روح) تغادر جسدها، بكل ما يرتبط بها من حرية ومعرفة، حرية في الحركة، فلا توقفها الحواجز، حرية المعرفة، فلا يخفى عليها شيء.
الروح مهمومة بسرد الحياة بعد الموت وقبله، ففي رحلة البحث عن أصوله الفاطمية في مصر، ينفتح البحث على محاولة الوصول إلى هوية ذاتية، بها نوع من الصلابة، بدلا من الهوية أو الهويات السائلة التي ازداد رنينها بعد الثورة. وقد أتاح له هذا التوزّع بين مصر وتونس قبل الموت وبعده، ربط الرواية بهوية عربية في المشرق والمغرب على حد سواء، وأتاح ـ أيضا- انفتاح الرواية على التاريخ الموغل في القدم من خلال الإشارة إلى القاضي النعمان، وتحوّله من المالكية إلى الإمامية، التنبّه إلى الهوية الثابتة للمشرق والمغرب. هناك مساحة من التشابه تؤسسه الرواية بين مختار جسدا وروحا والقاضي النعمان، فتأتي رحلة بطل الرواية من القيروان إلى مصر مشابهة لرحلة القاضي النعمان، لكن الأخيرة زمنيا تنفتح على المستقبل.
تشريح الجثة يتموضع في الزمن المستقبلي، حيث هناك فاصل زمني بين لحظة الموت أو القتل 2012، ولحظة الصحو المستقبلي، وانفصال الروح عن جسدها في عام 2030، وهي لحظة تكتشف فيها الروح واقعا مغايرا أقرب إلى عالم الديستوبيا. في ظلّ هذا الفارق الزمني تتجذّر الرواية بناء على ارتحالات الذاكرة في القريب والبعيد في مساحة النبوءة والتوقع المستقبلي انطلاقا من العلل الثابتة، فالرواية تؤسس ماضيين، زمن القاضي النعمان، والأخير لحظة الثورة في مصر وتونس، وتؤسس مستقبلا تتوقعه، مكوّنة رموزا ورؤية بها الكثير من الخصوصية.
سرد الروح والرمز المحوري
في لحظة زمنية مستقبلية تؤسس الرواية وجودها على سردية الروح الخاصة بالفاطمي المقتول، الروح التي تنفصل عن الجسد لحظة نبش القبر لمعرفة سبب الوفاة في زمن تال لزمن الثورة. وقد كفلت سردية الروح مزيدا من الحرية، وأسست سبيلا للمعرفة، فلها- أي الروح- قدرة على المرور من الحواجز والأبواب المغلقة والجدران، ولها قدرة على الحركة في الفضاء، والرؤية والمقاربة من أعلى للواقع المتفسّخ الذاهب للتلاشي. ففي اللحظة الأولى يواجه القارئ سردية مغايرة لروح تتخلّص من صندوقها، ومن جسدها لتبصر، وتظلّ موزعة بين الآني المستقبلي وماضيها القريب والبعيد.
يتحوّل النص الروائي في ظلّ هذه اللعبة السردية إلى حفر في التاريخ الثقافي للسياق العربي مشرقه ومغربه، يقول النص الروائي على لسان روح (مختار) لحظة الصحو وبداية المراقبة والإنصات: “هل أنا حي، لو كنت حيّا مثلهم، فلماذا أحلّق ولا أحد يراني؟ وهل يمكن أن أنشطر نصفين، نصفا في الصندوق، ونصفا خارجه؟ هل أنا ميّت؟ وهل هذا قبري؟ لو كنت ميّتا حقّا، فكيف أعقل أني موجود في عالم الموت؟ أشعر بالارتفاع أكثر فوق المكان”. في النص السابق تلازم الروح الجسد، في حركته، بداية من نبش القبر واستخراج الجثة، حتى الوصول إلى المستشفى العسكري.
تبدأ الرواية من عودة إلى الزيارة القاهرية تنفيذا لمنحة دراسية للبحث عن أصوله الفاطمية، في التوزّع إلى نمطين سرديين متواليين، الأول يتعلّق بمدّة إقامته في القاهرة، والأخير برصد الروح للزمن المستقبلي، لكنهما ينفتحان على بعضهما في جزئيات ليست قليلة، إلى أن يتحدا في الفصل الأخير للإشارة إلى تشابه السياقات في البلدين، والكشف عن اتحاد الروح بالجسد المحنّط، بعد كشف حقيقة موته مقتولا، بدلا من الخطاب الرسمي الذي يشير إلى موته بصاعقة جوية. التداخل بين النمطين يأتي مشدودا لتشابهات حياتية بين (بيرسا) مرافقته في مركز الدراسات التاريخية و(كانوبي) رفيقه في المركز من جانب، وشقيقته (نعيمة) و(خديجة) حبيبته من جانب آخر، فأي حضور لجانب منهما يستدعي الآخر، وانفتاح النمطين كاشف عن تشابه العلل الثابتة التي تعرقل الوصول إلى المعرفة، وإلى المصالحة مع التاريخ، وانقطاعات الذاكرة.
في متابعة رصده للمتغيرات هناك عدو له رائحة، وهناك بالمقابل دكتاتور يسميه البشر (الزعيم)، وكلاهما – العدو والزعيم الدكتاتور- يحتاج إلى الآخر، بالإضافة إلى القيادة العامة التي تتحكم في كل شيء، حتى في الموسيقى والألحان، ويأتي التغيير في طريقة تعامل السلطة مع قضية مقتل (مختار) مرتبطا بهدف لحظي، سوف يسوّقه الزعيم لصالحه في عيد ميلاد الثورة. منطق الرواية الأساسي ينصبّ على معاينة نتائج الفشل الثوري، وبقاء جانبي الصراع في حالة تأهب دائم، فكل جانب يخلق نظيره أو مقابله أو عدوّه، ويتأهب لنزاله من خلال شحن تابعيه بعدالة موقفه، وإسدال القداسة على حربه.
يجد القارئ بتتابع الورود والحضور للفظة مرشدات دالة توجهه إلى معان جديدة لها، تتمثل في إشارات الروح الساردة إلى وجود الخنازير المستمر في كل الأزمنة، تزيد درجته في زمن دونن آخر، فالخنازير- بالرغم من أن المدينة التي ينتمي إليها ملعونة منذ قرون- تظهر من حين لآخر، فقد تتسبب في حادث أو جريمة قتل، لكنها لم تكن تستدعي حربا.
ولكن الوصول إلى هذه الدلالة الرامزة لا يمرّ بشكل نهائي دون مراوغة، في بعض الأحيان نرى الدلالة الواقعية حاضرة، للإيحاء بالواقع الديستوبي المتخلّف بعد فشل الثورة، وما يتجاوب معه من صناعة الدكتاتور، وهو واقع قائم على النبوءة في العقود القادمة، من خلال أكياس الملح وثيقة الصلة بالخنازير. فسرد الروح يجعلنا موزّعين في تلقينا لهذا الوصف، حين يقول: “ترامت أكداس الملح على جنبات الشوارع، بعضها تعفّر بلون أحمر قان يميل إلى الزرقة. أكان ذلك من بقايا معركة دامية مع الخنازير التي تخشى الملح”.
إن المقاربة الفنية أو الروائية للمستقبل تؤسس مقابلة لها دورها في توجيه الانحياز إلى الدلالة الرمزية بعيدا عن الدلالة اللغوية، فالمقابلة الزاعقة بين (الخنازير) و(الوطنيين) من خلال الإشارة إلى شاطئ يخص القسيم الأخير، تكشف عن استمرار التقاطب الحاد، فالطهارة من رائحة الخنازير- على حد تعبير النص الروائي- هي جواز السفر إلى شاطئ الوطنيين. وتأتي اللقطة الأكثر حسما في حسم هذه الدلالة إلى رمز دال، قد يكون كاشفا عن توجّه فكري يملك الحقيقة، ويرفض المغاير، ويقنع بالثبات، وقد يكون مرتبطا بفصيل أو فصائل أيديولوجية.
الذاكرة البعيدة والقريبة والعلل الثابتة
في الرواية اشتغال على الذاكرة التاريخية والثقافية القريبة والبعيدة، وكأن النص الروائي يحاول أن يفككها من خلال وضعها في حيّز للمساءلة في تماسها مع الآني، فالبطل مختار في صورته الأولى قبل الرحيل إلى مصر للبحث عن أصله الفاطمي، شكّل أو وجه توجيها خاصا بداية من التأمل لكل الأشياء التي تستدعي التأمل، ومرورا بالرؤية المغايرة للإجماع والتسليم، وانتهاء بالمعرفة والارتباط بالكتب والمخطوطات والانفتاح على الثورة من خلال أغاني الشيخ إمام. ففي ظل هذه التوجيهات تأخذ حركته منحى يرتبط بالمثقف الذي يعرض كل شيء على عقله، قبل الارتباط به رفضا أو قبولا.
البحث في تاريخ الفاطميين ليس نزوعا مذهبيا، بل يمثل نزوعا إلى البحث عن الحقيقة والمخبوء والمهمش والمهمل والفردي، خاصة في سياق بيئة تحتفي بالإجماع، وترفض المغايرة، وتذم الاختلاف وإعمال العقل، يتجلى ذلك من خلال بعض الإشارات الدالة التي تسهم في التوجيه والتشكيل الخاص للبطل، يقول النص: “كنت أخفي شكّي في الأحاديث، اتقاء اتهامي بالزندقة. فالقول بإعمال العقل، وتدبّر ما وصلنا في الكتب التي صارت مقدسة، هو تحريض للناس على بيتنا، وهو شبيه بإعلان حرب”.
اختيار الطريق على هذا النحو المغاير جزء من التكوين، والسير فيه مشدود إلى ذاكرة قريبة أو بعيدة، تتوقف عند النظير أو الشبيه. وتبدو الرواية في ظل انفتاح الذاكرة على مشابهين سابقين في جانب من جوانبها، وكأنها تنضيد سيرة على سير سابقة، سيرة للهامش في اللحظة الآنية، وفي اللحظة الموغلة في القدم، يتجلى ذلك في قول الرواية على لسان والد بطل الرواية علي الفاطمي “قبل ولادتك رأيت في منامي القاضي النعمان يقف على باب البيت ويصيح: احرثا حتى يأتيكم صاحب الزرع”. فالوقوف عند القاضي النعمان- مؤسس النظام القضائي والفقه الإسماعيلي- وقوف عند خطاب الهامش، وإنعاش لذاكرة مطموسة بالإجماع.
يتحرّك البطل في الرواية وفق سرديات توجّه حركته، مثل سردية ونبوءة القاضي النعمان لأبيه، ومثل حكاية (الأشقر) التي ترتبط بدلالات عديدة، منها- وهذا جزء من إشكالية الهوية الزائفة في نصاعتها- جزئية المذهبية، وما تجرّه على البلدان من ويلات عدم الانسجام أو الاندماج مع تاريخها الممتد، ومنها- أيضا- المعرفة وثمن الوصول إليها والبحث عن الهامش وخطابه، فكلاهما- الأشقر بطل الحكاية ومختار بطل الرواية- دفع ثمن محاولته للوصول إلى المعرفة، ورفع الستر ومناوشة السائد، فالأول عاد أعمى وفقد حبيبته، والآخر عاد مقتولا بسبب محاولته الوصول إلى حقيقة الأجداد، ومنها- أخيرا- هامشية الأقليات، وقدرة المهيمن على التنكيل بها، وإخفاء صوتها وخطابها.
النص الروائي يكوّن وجهة نظره ضد هذا الإقصاء، ومع التعدد من خلال إشارته إلى اختلاف الأشكال العمرانية للمدينة، وكأنها طبقات متجاورة تزداد قيمة بالتعدد والاختلاف. فالهوية في منطق الرواية لا تحفل بالنصاعة المذهبية والإقصاء، وتركز على قيمة التعدد في صناعة ذاكرة تعقد مصالحة مع التاريخ بالاحتفاء بأثر كل من مرّوا على المكان في أزمنته المختلفة، تقول الرواية: “كثيرا ما أتساءل كيف لمدينة أن تحفل بكل هذا الخليط، في حين رفض إخوة الدين فيها قبول من يختلف معهم في المذهب؟”.
الجماعة أو الإجماع يرتبطان بقتل الروح الفردية، فالكل في لحظة الحرب المستقبلية المملوءة بالتمزّق والإقصاء- ومنهم حسين الضابط شقيق السارد، والطبيب، وكل مسؤول في مكانه- ينتظر دائما التوجيه من القيادة العامة، فالفاعلية الفردية أصبحت غير موجودة، تقول الروح الساردة عن الطبيب ووقوفه منتظرا الأوامر (أيواصل التشريح أم لا؟، أيتجاسر على الجثة المحنّطة أم يعيدها إلى صندوقها؟). فقد تحوّلت المدينة- وفق منطق الرواية ورؤيتها المستقبلية- إلى شكل جديد من أشكال العبودية، وهي العبودية التي لا تأتي قسرا كما في السابق، بل تأتي طواعية دون شكوى أو تبرم، يتحرّك البشر في إطارها وفق تنميط متعال جاهز.
نزار شقرون: “أيام الفاطمي المقتول”
مسكلياني، تونس 2025
351 صفحة.