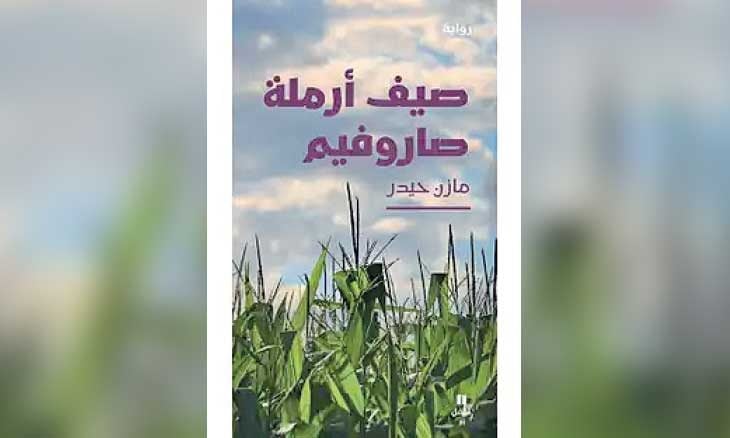
عين سرار تروي المسكوت عنه: قراءة في صيف أرملة صاروفيم

منير الحايك
تقول الناقدة آن ريجني في مقالها «الحياة الثانية للقصص»، أو «حيوات القصص بعد الموت»، «الرواية التاريخية هي حوار بين الماضي والحاضر، حيث يعالج الكاتب الصمت والفجوات في السجلّ التاريخي ليبني سردا يمنح الصوت للمنسيين والمهمّشين»، ولأنّ ما يُسكَت عنه بعد انتهاء الحروب، خصوصا الأهلية منها، بمعاهدات هشّة لا يُعاقب فيها الفاسد والقاتل والسارق، سرد مازن حيدر في روايته «صيف أرملة صاروفيم» (دار نوفل 2025) ما سُكِت عنه في مناطق عدة من قرى لبنان، وأعطى الأبطال الفعليين أصواتا ليسردوا قصصهم.
تبدأ القصة مع أسامة، التي تقرأ مخطوطا لخالها ملحم، نسيه فوق مكتبه، في قرية متخيّلة «عين سْرار»، تشبه قرى لبنان جميعها، أو فلنقل في معظمها، خصوصا المختلطة منها، مذهبيّا وطائفيّا، في أعالي جبيل أو البترون، عين سْرار التي بالفعل حمل اسمها رمزا للأسرار، التي ستسعى أسامة وخالها ومن معهم لكشفها.
أسامة التي أرسلها والداها، الصحافي والطبيبة اللذان استمرّا، على الرغم من الخطر، في العمل في بيروت، إلى بيت خالها في ذلك الصيف، الذي حصلت فيه حرب التحرير عام 1989، قُبيل انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وهناك تعرف بأمر اللغز الذي تركه الشيخ عبّاس، وأسرّت إليها به جوهرة أرملة صاروفيم، أسامة التي كانت قد أوكِلت إليها مهمة تدريس توأمين، جهاد وميلاد، هُجّرا مع والدتهما إلى القرية نفسها، فيساعدانها في حل اللغز قبل مغادرتهما ليلتم شمل العائلة مع الوالد في إحدى مدن الخليج العربي.
يظهر نزار، والأستاذ صادق مسؤول المتحف، ومساعده خريستو، ووالد نزار الذي يعمل في الموبيليا، ومعهم تظهر «العناصر»، أي عناصر الميليشيا التي سيطرت على القرية في تلك المرحلة، ولكن الرواية تقصّدت ألّا تذكر الطرف الذي انتمت إليه، عن قصد وتصميم. حيدر بدأ التخييل وحاك قصة اللغز لغاية واحدة، لم يحد عنها طيلة صفحات الرواية، غاية أراد منها تسليط الضوء على قضية سرقة الآثار والمتاجرة بها في ظلّ الفوضى وضياع الحقائق، والتبرير الذي يرافق ذلك من الفاسدين بأنه «شو وقفت عليِّ»، والأهم من القضية نفسها، أن يعطى الصوت لأبطال يظلون مهمشين ومظلومين أحيانا، بعد انتهاء تلك الحروب، واجتماع المتقاتلين الفاسدين على تقاسم «جبنة» البلاد، كما حصل في لبنان بعد «اتفاق الطائف» الشهير، ولعل أهمهم صاروفيم وصادق، وملحم والسرّ الأهم الذي تخبرنا به الرواية في نهايتها، والذي نكتشف فيه الخدعة التي أوهمنا بها حيدر، عندما جعلنا نصبّ تركيزنا على ملاحقة الأحجية وفكّ رموزها، واكتشاف حجر الشيخ عباس، في حين يكون السر الأكبر هو ما يكشفه الخال ملحم.
الأحجية كانت بسيطة في ملاحقتها من قبل المتلقي، ولم يجعل منها الكاتب العقدة الأهم والغاية، بل كانت وسيلة أرادها، وكأنه اختارها من بين عدة احتمالات كانت لديه، عندما قرر البدء بكتابة روايته، لذا كانت في بعض المواضع أبسط من أن تكون مكوّنا أساسيّا لرواية حديثة، على الرغم من فهم القارئ لغاية الكاتب، فقد اتخذت الرواية معها أحيانا منحى يجعلها أقرب إلى روايات الفتيان، ولكنها لم تكن تفلت منه كثيرا، بل كان يعود ليسلّط الضوء على أحداث أخرى تعيد النصّ إلى طريقه السليم والواضح.
اللغة ميزة أساسية في هذه الرواية، لأنها عذبة ومتقنة وسلسة، وبعيدة عن التكلف بشكل مبهر، ومعها تأتي الأحداث التي كانت تتوالد بشكل منطقي وبسيط بعيد عن التعقيد، لأنه أرادها كذلك منذ بداية الرواية، ولأنّ الغاية كانت التركيز على الشخصيات، ليبدأ النص بالأخذ بيد المتلقي ليدله على البطل الحقيقي، على الرغم من كل الشكوك التي كانت تساوره تجاه كلّ شخصية، وخصوصا صاروفيم ومعه أرملته، وملحم، وصادق، ولكن هؤلاء سيكون صوتهم هو المقصود، وهو الذي أرادتنا الرواية أن نسمعه. قد يعتبر البعض التبسيط في العُقَد والتشويق، وفي اكتشاف الحقائق من دون الدخول في أعماق نفسيات الشخصيات وأفكارها خللا، ولكن في رواية حيدر يُعتَبر نقطة مقصودة وقوية، لأنّ الأبطال هؤلاء، هم من المهمشين أساسا، فأبقت الرواية على تهميشهم، وأبرزت أفعالهم.
المخطوط الأول في الصفحة الأولى ينتهي بـ»هنالك، فوق، على مشارف جبّانة المتاولة المنسيّة، ستُشعل أرملة صاروفيم موقدها في ردهة أعدّتها للشتاء، تترقب بصبر وإيمان حلول فصل الربيع، يؤانسها نعيق الغربان وخفخفة ضباع أودية عين سْرار»، ولكن النصّ نفسه يصبح، قبَيل انتهاء الرواية، بعد تدقيقه من ملحم قبل نشره في روايته، وبعد هدوء الأحوال وسير البلاد نحو توقّف حربها، يصبح «وهنالك، فوق، على مشارف جبّانة المتاولة المنسية ستُشعِل أرملة صاروفيم موقدها في ردهة الشتاء متحلية بالصبر والإيمان بغد مشرق، مرتقبة حلول ربيع عين سرار»، وبين تشاؤم الخال وتفاؤله بعد اكتشاف سرّ الشيخ عبّاس، وقبره الذي قد يكتمل بعد ظهور شاهدته، في الجبانة المنسية للشيعة في تلك القرية، التي بقي فيها مسيحيّوها، ككل قرى لبنان التي تركها أبناؤها، الأضعف، تنتهي الرواية التي أرادت التفاؤل، في الزمن الذي تعيش فيه البلاد نفسها، خطر بدء ما انتهى في ذلك «التاريخ» القريب.
مقطع من الرواية كان مثيرا ومدهشا من قربه للواقع اللبناني خصوصا، وبلادنا جميعها، «أهالينا متشابهون يا أسامة. متشابهون في مظهرهم، في عاداتهم الاجتماعية، في أساليب الحديث والإطراء أو الجِدال، متشابهون حتى في طرائفهم. غير أنّ قلّة قليلة منهم تتحلى ببصيرة تميّز فعلا بين الخطأ والصواب. قلّة منهم فقط قد ترتدع عن القيام بالأفعال السيئة كالكذب والسرقة والتحريض وتشويه البلاد في أجواء حربنا هذه»، هذه القلة ما زالت اليوم قلّة مع الأسف، ونحن مستمرون في التشابُه.






