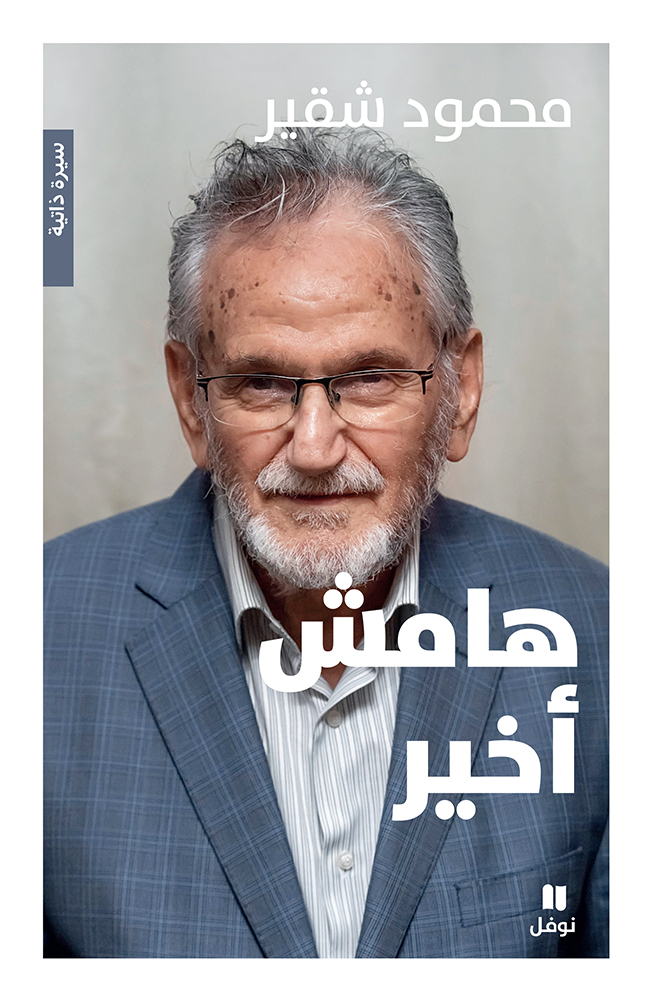القطاع ودرسدن صورتان للهمجيّة الغربية: الغزيّ… إذ يكتب «أدب النجاة» في زمن القتلة

القطاع ودرسدن صورتان للهمجيّة الغربية: الغزيّ… إذ يكتب «أدب النجاة» في زمن القتلة
لا يتورّع السفاح بنيامين نتنياهو عن الاستعانة بأدبيات الحرب العالمية الثانية واستدعاء أحداثها في حال شعر بأنه استنفد المعجم النازي الذي اعتاد أن ينهل منه مفرداته.

لا يتورّع السفاح بنيامين نتنياهو عن الاستعانة بأدبيات الحرب العالمية الثانية واستدعاء أحداثها في حال شعر بأنه استنفد المعجم النازي الذي اعتاد أن ينهل منه مفرداته.
في تصريح صحافيّ له، أعلن نتنياهو الأسبوع الفائت أنه «بوسعنا قصف غزة تماماً كما قصف الحلفاء مدينة درسدن أثناء الحرب العالمية الثانية».
بعد استحضاره الدائم لمصطلحات «هتلرية» من قبيل «حيوانات بشرية» و«الملاعين الأشرار» وغيرهما معتمداً إياها أوصافاً على الغزيين لتسويغ الإبادة الحاصلة، بل لإدامتها، لجأ نتنياهو هذه المرة إلى أحفاد النازيين: «الحلفاء» (إنّهم «الناتو» في النسخة المعاصرة) ليمسح عن جبينه عار ما يرتكبه.
يبدو أنّ كتب التاريخ باتت أشبه بكتب «الكوميكس». كأن قراءة التاريخ فعل تسلية مثل قراءة قصة من الخيال العلمي.
هكذا تستمر الفاجعة في الحدوث حاضراً ومستقبلاً، تتكرر بلا توقف، وما يفترض إدانته وعدم اقترافه مجدداً لأنه جريمة، تصبح إعادته عادةً يومية، ربما لأنّ قوات «الحلفاء» التي قصفت درسدن، باتت أصحاب «السيادة» و«الشرعية» في «العالم الجديد الشجاع» الذي نحيا فيه. يرأسون مجلس الأمن ويتشدقون بحقوق الإنسان، فيصبح بالتالي الامتثال بإثمهم وخطاياهم ضرباً مغفوراً.
وقائع قصف درسدن عام 1945
في منتصف شهر شباط (فبراير) من عام 1945، قصف «الحلفاء» مدينة درسدن على مدى يومين متتاليين حتى دمّرت المدينة بكاملها. أطلق على تلك العملية وصف «القصف الإرهابي».
قتل خلال موجة القصف على درسدن، ما يقرب من نصف مليون شخص، جميعهم تقريباً، مدنيون أبرياء؛ وماتت أيضاً درسدن، تلك المدينة الساحرة التي عرفت بعمارتها الآسرة، وإرثها الثقافيّ والمعرفيّ المديد. ليست درسدن وحدها المعلَم الحضاري الجليل الوحيد الذي دمّرته قوات «الحلفاء».
نذكر على سبيل المثال لا الحصر، تدمير دير مونتي كاسينو، وهو أشبه بقلعة أثرية في إيطاليا، إذ زعم «الحلفاء» آنذاك وجود قوات من دول «المحور»، فقاموا بشنّ غاراتٍ عنيفة أدت إلى دمارها. متأثراً بجرائم أسلافه، يعود نتنياهو إلى تلك الأحداث الهمجية، برغبة صاخبة منه في إعادة تكرارها.
قصف غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين
بلغ عدد القنابل الإسرائيلية الملقاة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى يومنا هذا ما يعادل قنبلتين نوويتين. من الجائر مقارنة حادثة تراجيدية بأخرى، أليست مقارنة المآسي وإخضاعها لمنطق القياس فضيحة تنمّ عن نرجسية المُقارِن، أو ضرباً من ضروب الخبل؟ لكن أليس من الجائر أيضاً مقارنة درسدن التي تعرضت للقصف على مدى يومين متتاليين بالقصف التي تتعرض له غزة؟ هذه المدينة الفلسطينية الصامدة أمام همجية «العالم الجديد الحرّ» تقصف بشكلٍ متواصل منذ عامين.
-

درسدن عام 1945 (والتر هان ـ أ ف ب)
غير أنّ القصص وسير الناجين في كل من درسدن وغزة تتشابه، لأن في كلا المدينتين يرسل الموت من السماء عبر القنابل. هكذا، لا نقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكن اعتباره «احتمالاً» حقيقياً، في أن تكون الكلمات المكتوبة هناك، هي الكلمات الأخيرة للغزيّ -الناجي- الذي استطاع أن يقول ما أراد قوله قبل أن يلقى حتفه فقط، إنّما بتنا نقرأ معنى العيش فيما الموت هو بمنزلة الظل.
على فايسبوك، نقرأ مثلاً ما كتبه مالك شنباري، مواطن غزيّ لا يزال على قيد الحياة: «خبرتكم سابقاً عن شعور ابني زين حينما رأى الحائط لأول مرة، ووضع يده على الجدار وخوفه من السقوط ظناً منه أنها مثل شرائط الخيمة البالية. اليوم تذكرت هذا كله عندما ذهبت به للمستشفى بسبب مرض جلدي منتشر بين الأطفال.
وأنا أنتظر دوراً آخر طويلاً من الأطفال المحروق جلدهم تحت شمس الخيام، لمحت مروحة هواء -تعمل- يحاول الجميع الاقتراب منها -على خجل- والشعور بالآدمية التي قتلتها الإبادة والطبيعة معاً. أردت أن يشعر زين بهذا الاختراع الذي لم يره هذا البطل منذ ولادته.
فور أن اقتربت منها، خرجتْ منه صرخة كالتي أسمعها منه كلما رمت الطائرة صاروخاً قريباً. يصرخ خائفاً وأظفاره تحاول تمزيق ملابسي من التشبث والرجفة. فوراً ابتعدت وحاولت تهدئته وأنا نادم ليس لأنني السبب، بل لأنني وضعته في هذا الموقف فجأة من دون مقدمات.
جلست أفكر كيف لي أن أشرح لابني مقدمة عن المروحة! كيف أجعله لا يخاف حتى من الهواء! كيف أبدأ! كيف سأشرح له أن هذا كله كان أقل من عاديٍّ قبل ولادتك يا صغيري، أفكارٌ كانت ستحملني إلى حقدٍ آخر على هذا العالم حين قاطع أفكاري الطبيب ونادى: «زين الشنباري دورك». لدينا إذاً قصة قصيرة تحكي عن طفل فلسطيني يخاف من الهواء.
«كتاب الوصايا»: وصف الموت الغزيّ
يعد «كتاب الوصايا» (دار مرفأ ــــ 2024) الذي حررته ريم غنايم، وهو كتاب يضم مجموعة من النصوص لشعراء وكتاب فلسطينيين، بعضهم استشهد مثل رفعت العرعير، وصفاً شعرياً باذخاً حول الفاجعة الغزية، وتخليداً لها. إنه وثيقة أدبية تحاكي لحظة تاريخية استثنائية. نقرأ مثلاً ما كتبه مصعب أبو توهة: «إن كنت سأموت، فليكن موتاً نظيفاً. لا ركام فوق رفاتي، لا جروح في رأسي أو صدري، لا دمار في مخدعي، لا آنية ولا كؤوس متكسرة».
بعد قراءة «كتاب الوصايا»، يتملك القارئ إحساس يشبه التلويح لراحل لن يعود، كأننا أمام وداعٍ أخير. ثمة كتابة على تماس مباشر مع الموت.
في «كتاب الوصايا»، الصوت يستسلم للزفرة الأخيرة، هناك من يقول: «لا أزال على قيد الحياة ولكنني تحت قصفٍ متواصلٍ، وعليه، قد يكون هذا آخر ما أقوله». تكتب الكلمة بوصفها «الكلمة الأخيرة»؛ الكاتب يشعر بأن موته وشيك، الزمن «الحيّ» عنده هو زمن الكتابة، والكاتب يزوّد القارئ بكل ما لديه، بكل نبضٍ حيّ فيه. إنه أدب الوصايا فإذاً الوصية باعتبارها بقايا وأثراً.
إذا كان «كتاب الوصايا» يحكي عن تجربة الاحتكاك مع الموت، واختبار «اللحظة الأخيرة»، وكتابة ما يراد أن تكون «ذكرى» في حال استشهد الكاتب، أي كتابة وصية، فما نجده الآن منثوراً على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي ليس كتابة وصايا بقدر ما هو كتابة يوميات النجاة من آلة القتل والهمجية الإسرائيلية.
يعدّ النص الذي كتبه مالك شنباري نموذجاً عن هذا الأدب الذي يمكننا تسميته بـ«أدب النجاة». النجاة من حرب عالمية تحدث في غزة، حيث «القصف الإرهابي» الذي طاول درسدن ليومين متتاليين، يحدث في غزة كل يوم لمدة تقرب من السنتين.
كل عناصر الأدب الغرائبي وأدب الرعب من توظيف للأسطورة، وتجاوز الزمان والمكان، وشخصياتٍ مجنونة موجودة هنا؛ هناك وحوش ضارية فالتة تريد حصد الأرواح والمناخ قاتم جداً. ومع ذلك، لا يزال الغزيّ على قيد الحياة، وهو إذ يكتب عن العيش ونقرأه، فهو يكتب عن نجاته، هذا أدب امتزج مع الحياة، مع اليومي المعاش.
كورت فونيغيت: شهادة من درسدن
في الحرب العالمية الثانية، وبينما كان جندياً تابعاً في صفوف المشاة، وقع الكاتب الأميركي كورت فونيغيت أسيراً لدى القوات الألمانية. اقتيد مع باقي الجنود الأميركيين إلى زنزانةٍ، كانت في الأصل مسلخ خنازير. بقي فونيغيت أسيراً إلى حين انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد أفصح في مقابلة صحافية أجرتها معه «باريس ريفيو» أن درسدن «أجمل مدينة شاهدها على الإطلاق».
أخذ فونيغيت وقته في كتابة روايته «المسلخ رقم خمسة: أو حملة الأطفال الصليبية، ورقصة الواجب مع الموت»، أي إنه لم يكتبها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على الفور، بل انتظر حوالى عشرين عاماً.
إذا كان السياق الغزيّ قد خلق أدباً تجرأنا على وصفه بـ «أدب النجاة»، فإن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد ولّدت تيارات أدبية عدة من بينها أدب «ما بعد الحداثة» الذي راج في الحالة الأميركية خصوصاً.
كورت فونيغيت واحدٌ من هؤلاء الكتاب الأميركيين الذين ينتمون إلى التيار «ما بعد الحداثي» في الأدب. وإذا كان «أدب النجاة» يشترط لغة واقعية تحاكي العنف الساخط والمهول الذي يحدث في العالم الخارجي، حيث الكاتب -الغزيّ- هو الناجيّ الذي يعيش حياة تنطوي على توحّش مفرط يفوق الخيال، فإننا نجد مع فونيغيت ومدرسة «ما بعد الحداثة» تواطؤاً مع الخيال، ولغة يغلب عليها العبث والتشظي عوضاً عن اعتماد الأسلوب الواقعي والمحاكاة.
«المسلخ رقم خمسة»: أبشع جريمة في التاريخ الحديث
في «المسلخ رقم خمسة» نجد إدانة مقذعة لواحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث، قصف درسدن، من ناج شهد على حال المدينة قبل تدميرها وبعده.
بطل الرواية بيلي بيلغرام ليس بطلاً تقليدياً، بل شخصية مضادة للبطل. جندي أميركي ضعيف، ينجو من القصف بالمصادفة، ويعود ليعيش حياة مفككة، يزعم أنه «انفلت من الزمن»، يتنقّل بين ماضيه ومستقبله، ويُختطف من قبل كائنات فضائية تضعه في حديقة حيوانات كونية. هذا التداخل بين الواقع والخيال العلمي ليس زخرفة سردية، بل هو قلب فلسفة الرواية: الحرب بحد ذاتها حدث لا عقلاني، ولا يمكن تفسيره إلا بلغة أقرب إلى الخيال. يذكّر فونيغيت القارئ بأن الموت في الحروب يصير خبراً عادياً يستهلك ببرود.
صحيح أنّ «المسلخ رقم خمسة» انبثقت من درسدن، وأخذت من درسدن موضوعها لكنها استطاعت تجاوز نفسها، فتصلح لكل «درسدن» لاحقة مثل هيروشيما، وفيتنام، وغزة عندما يتحوّل الفناء الجماعي إلى مشهد عابر أو حدث عادي.
أسلوب فونيغيت الساخر والساخط في آن واحد، جعل من الرواية نصاً عصياً على التصنيف، فهي ليست مذكرات شخصية، ولا رواية خيال علمي بالمعنى المألوف بل خليط هجائي مرير.
ومثلما غدت درسدن مقبرة مفتوحة، فتح فونيغيت خط الزمن على مصراعيه حيث الرواية لا تسير وفقاً لخط كرونولوجي مستقيم من «بداية إلى نهاية»، بل تتشظى مثل ذاكرة تعاني من آثار الصدمة. نجد أنّ عنوان الرواية الكامل هو: «المسلخ رقم خمسة: أو حملة الأطفال الصليبية، ورقصة الواجب مع الموت».
ما شأن حملة الأطفال الصليبية؟ نقرأ في الرواية: «يخبرنا التاريخ الرسمي للحملات الصليبية أنها كانت حملات همجية قام بها أناس متوحشون وأن دوافعها كانت التعصب الشديد لا غير. وكان طريقها هو طريق الدم والرغبة الحيوانية. وفي جانب آخر، كان الفكر الرومانسي قد طغى على فكر التقوى والمجد. وتصوّر هذه الحملات في أشد أشكالها بريقاً وإشعاعاً على أنها رمز للشهامة والفضيلة والشرف التليد العتيد والمجد الذي كسبه هؤلاء الجنود لأنفسهم بما قدموه من خدمات جليلة لمصلحة الديانة المسيحية».
هناك احتجاج صارخ على الهمجية الغربية إذاً، وهؤلاء «الأولاد» الصليبيون في «المسلخ رقم خمسة»، لو تبحرنا في الرواية وقرأنا بين السطور، لاكتشفنا أنهم «أبطال» رواية كورت فونيغيت.
الحرب تفتعلها مجموعة من الفتية الحمقى المجانين، أو كما يورد في روايته: «أنفقت أوروبا الملايين من القطع الذهبية وأهرقت دماء قرابة المليونين من أبنائها، بينما استولت حفنة من الفرسان الصعاليك على فلسطين لمدة تزيد على الألف سنة».
صدرت رواية فونيغيت عام 1969 حين كانت الحرب على فيتنام في بداياتها، كتب أحد الصحافيين معلقاً: «لو استبدلنا مدينة درسدن ووضعنا مكانها فيتنام، ستكون رواية فونيغيت عن فيتنام». هكذا استطاع هذا الناجي أن يخلق رواية تصبو إلى وثيقة أدبية شاهدة على أنّ التاريخ الذي يكتب بلغة السفاحين، يستطيع الأدب أن يعيد للضحايا أصواتهم.
رامبو وزمن القتلة: هنري ميللر في انتظار المخلّص
بدا الحديث عن القنبلة النووية عام 1956 ــــ وهو تاريخ نشر الكاتب الأميركي هنري ميللر كتابه «رامبو وزمن القتلة» ــــ مثيراً ورائجاً وعصرياً.
كانت ثمة مخاوفٍ بشرية حول مآل التكنولوجيا والتقنية، التي تقتلنا الآن والذي يباد عبرها الغزيون. وكان هناك من يضع الأدب والعلوم الإنسانية في وجه «الآلة» لأنه تيقّن أنها ستقضي على البشرية في المستقبل القريب.
وصف هنري ميللر عصره بـ«زمن القتلة» ولم يكن متصالحاً البتة مع العالم الحديث، وقد أحاطه التشاؤم حول «قدر» هذا العالم الحديث نفسه.
ولأن القنبلة الذرية في ذاك الحين كانت لا تزال طريّة خارجة للتوّ من المصنع، حيث القوّة والخراب المنظم والاستهلاك سادت في «زمنه»، ارتأى ميللر الغوص في أعماقه بما يشبه الرحلة الصوفية للبحث عن خلاصٍ وعن مخلّص.
في «رامبو وزمن القتلة»، يقدم ميللر تأويلاً باذخاً وعميقاً لشخصية الشاعر، وللأثر الجوهري الذي يتركه الشعر في تشكيل العالم.
يعود إلى الشاعر الفرنسي أرتور رامبو وإلى زمن رامبو؛ القرن التاسع عشر أي لحظة صعود الرأسمالية وانفجار العنف الاستعماري. لحظة نشوء الحضارة الغربية التي تتغذى على القتل والتدمير. يعود ميللر إلى أرتور رامبو، هذا الشاعر الملعون «صاحب الروح المتعطشة أبداً» كما يصفه، ويدعونا إلى الامتثال بهذه الروح لتجنب الدمار الشامل.
يكتب ميللر: «إننا أمام خيارين، إما أن نفعل مثل رامبو أي أن نطابق قدرنا بأخطر المراحل التي عرفها الإنسان، ونرفض كل ما وقفت الحضارة إلى جانبه منذ وقت طويل أو أن ندمر الحضارة بأيدينا نحن». يعلي ميللر نبرته في «رامبو وزمن القتلة» تجاه الشعراء الذين عجزوا عن الاتصال بالجمهور وأخفقوا في إيجاد لغةٍ شعرية.
«هل صدمت قصيدة العالم، مثلما فعلت القنبلة الذرية، أخيراً؟» يتساءل، ويضيف: «أي أسلحة يمتلكها الشاعر، مقارنة بهذه؟ وأي أحلام؟».
على أنّ ميللر لا يكتفي بالتعويل على اللغة الشعرية لأنها بحسبه وحدها تنقذ العالم إنّما يناديها ويصرخ عالياً. كأنه يستولد مقولته الخاصة: «خلاص العالم في الشعر» كبديل من مقولة دوستويفسكي: «خلاص العالم في الجمال».
ولأن اللغة الشعرية تحتاج إلى شاعر، يستحضر ميللر أرتور رامبو، فيمضي بمديحه والغوص في أغواره مستخرجاً سمات بطولية تعد، في الدرجة الأولى، إنسانيةً حيث التصاق التراجيديا بسيرة صاحبها زاد إنسانيته عمقاً وجمالاً.
لم ينته زمن القتلة إنما نعيش أوج مستوياته اليوم. رامبو بالنسبة إلى هنري ميللر ليس شاعراً عبقرياً لا تزال إشراقاته تلمع حتى اليوم، إنما صوت غاضب شاذ عن إيقاع عصره.
استعادة ميللر لشخصية الشاعر هذه ــــ رامبو الذي خلق لغة شعرية مضادة في عصره ــــ تعدّ عند ميللر ضرورة من ضرورات البقاء على قيد الحياة وشرطاً لعدم أفول الحضارة البشرية.
نحن أمام أسطورة إذاً، أرتور رامبو بوصفه مخلصاً من القتلة ومن لغتهم الرديئة. ألا يمكننا من منطلق مشابه لهذا الطرح، أن نتعاطى مع الغزيين بوصفهم «أدباء نجاة» وخلاص لما تبقّى من «أخلاق وحساسية» إنسانيين في وجه القتلة وزمنهم؟
وبالأحرى، ألا يجب التعاطي مع الغزيّ من هذا المنطلق، على أنه الكائن البشري الأوحد الذي يقف وجهاً لوجه أمام تاريخ مكتمل من التوحش البشري؟ إذا كان رامبو صاحب «الرؤية الكاشفة»، فإننا اليوم، مع الغزيين وتجربة نجاتهم، نرى حقيقة العالم مكشوفة.
يكشف الغزيّ حقيقة العالم وزيفه، هو الناجي الأخير من همجية إنسانية سحيقة يقدم لنا الرؤية: «أيها العالم، ما حدث في درسدن يجري كل يوم هنا»، هل على الغزيّ أيضاً أن يقدم عينيه؟