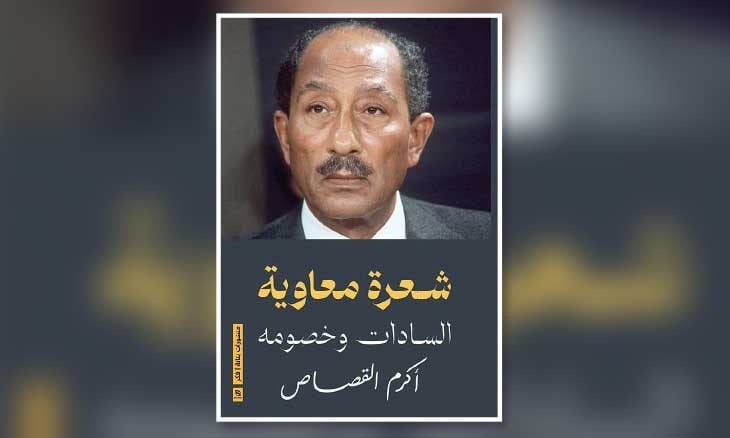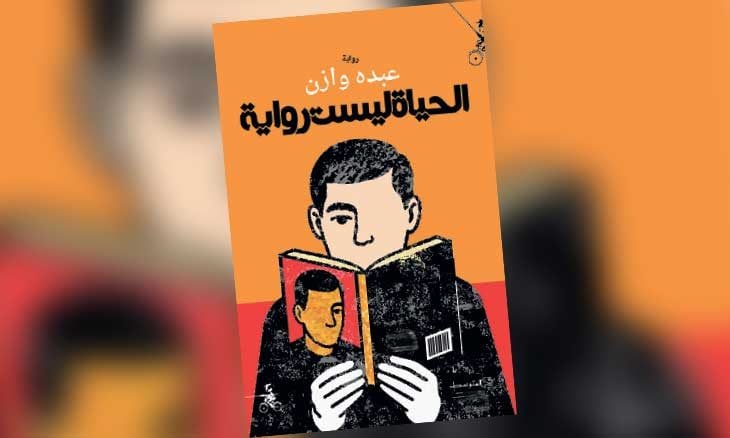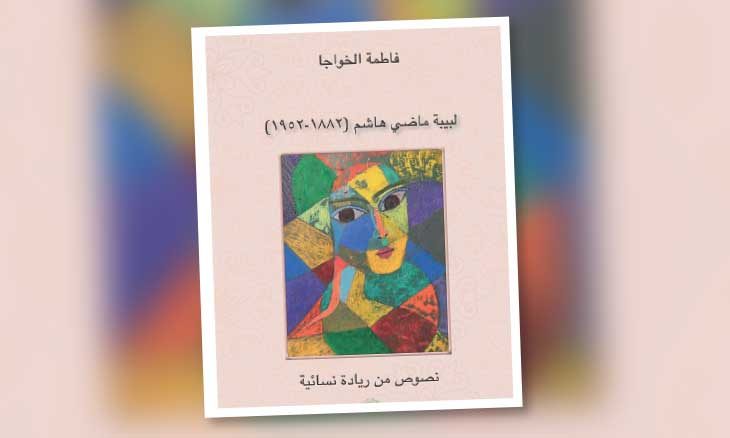النقد الثقافي… محاولة في قراءة المغايرة

علي حسن الفواز
يظل النقد الثقافي مجالا لممارسات ثقافية مفتوحة، لكنها ضاغطة، تعمد إلى إثارة أسئلة تخص المشكلات والتناقضات الثقافية، على مستوى توصيفها، أو على مستوى علاقتها بالمعرفة والمنهج والجدل، وبالنظرية الأدبية، أو على مستوى أدائها في تمثيل «النسق الثقافي» فكل شيء في هذا النقد، ينفتح على المجال الثقافي، في مقاربة المخفي، و»المسكوت عنه»، و»المقموع» والبحث عن الغائب، وهذا لن يتم إلا عبر فاعليات قرائية، تتجدد معها الأدوات والوسائط، وعلى النحو الذي تتحرر فيه فاعلية القراءة من المهيمنات والرمزيات والوصايا، حيث يتجاوز فيها الناقد نمطية «الخطاب الأدبي» قصدية ما يستدعيه من أطروحات تجعل «النقد الثقافي» وكأنه عملية طرد وإقصاء للنقد الأدبي، من فضاءات المعرفة النقدية، وبالتالي إدخال النصوص الأدبية في ورشة الفاعل الأيديولوجي والسياسي والنفسي والأركيولوجي، وغير ذلك من المناطق المعرفية والفلسفية، التي ارتبطت بتقويضات دريدا، وبحفريات فوكو، وبنقديات ليتش وغيره من صانعي خطاب النقد الأمريكي الجديد.
قد تبدو أطروحات عبد الله الغذامي، جريئة في مجالها، وفي تعالقها مع المغامرة الثقافية، لكن ذلك لا يعني التصديق الكامل بفكرته حول قطع الطريق مع النقد الأدبي، واختصار الحديث عن «المشكلة النسقية،» بوصفه المجال الخاضع للمقاربة النقدية، والمساءلة الدائمة، والمكشوفة على إجراءات نقدية مفتوحة، قد تتجاوز الحدود التي وصل إلى نتائجها الغذامي، لاسيما أن «الأدبية العربية» في موضوعها الشعري والسردي، وحتى النقدي، ما زالت تملك «أصولا فاعلة» في مجال تداولها الجمالي والنظري، وحتى في علاقة هذا النظري بالمعرفي والتاريخي والفلسفي..
من الصعب على أطروحات النقد الأدبي أن تتخلص من التاريخ، ولا من مركزيته، وأحسب أن توسّع مديات «النظريات الأدبية» قد أسهم في توسيع قراءات النصوص والظواهر الأدبية، على المستويات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والجمالية، وحتى على مستوى تداول مفهوم «الشعرية»، كما اقترحه ياكوبسن، وباتجاه جعله يدخل في اشتباك مع ما هو ثقافي، من حيث توصيفه للطريقة التي فرضت على الأدب أن يكون أدبا، ما يعني أن الخاصية الجمالية/ الشعرية/ الأدبية ستظل مغذية للنص، في فهمه، وفي تواصله، وفي ما يقدمه من جماليات، ومن معارف، لاسيما وأن اللغة العربية هي ذاكرة متوهجة تستغوي ذلك الجمالي، وتفتح للثقافي مجالا أن يكون مكملا وليس طاردا، أي أنها ستظل بيتا يتسع للمعرفة، مثلما يتسع للبلاغة ولجمالياتها التي تتوهج بالإشباع، وربما في أن تصنع وجودا موازيا، عبر ما سماه هيدغر بـ»الدزاين»، فهذا «الموجود هنا» هو شرط ظاهراتي تعتمده اللغة في أن تكون مجالا وخطابا وشهوة في التفكير..
ما طرحه محسن الموسوي حول «النقد الثقافي» جعله أكثر حذرا في التوصيف، وفي إطلاق الحكم النقدي، فهو لا يجد أي رابطة تربط هذا النقد بالهيمنة المعرفية، وبفرضية القطيعة مع الأدبي، وأنه سيظل في هذا السياق قريبا من التعاطي مع الممارسة الثقافية، أو مع «الفعالية التي تستعين بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج الأدبية من الخوض فيه» كما يصفها، في الوقت الذي كان الغذامي يرى أن «النقد الثقافي هو قطيعة مع النقد الأدبي»، من منطلق تقاطع الوظائف بينهما، فالشعري/ الأدبي/ الجمالي سيظل رهينا بوظائف النقد الأدبي، وأن وظيفة النقد الثقافي ستتحرر منه، وستبدو وكأنها تجاوز على ذلك من خلال تشغيل الأنساق، أي ما يتعلق بكشف المخفي والمضمر، وتمثيل ما هو معرفي/ ثقافي داخل بنية النص، وهو رأي يحتاج إلى مراجعة، لأن الحديث عن المخفي سيجعلنا إزاء تعالق هذا النص أو ذاك، بالأيديولوجيا والهيمنة والسياسة والتحليل النفسي والأنثروبولوجيا، وهي قضايا باتت الدراسات الثقافية التي خرجت من «المعطف الماركسي» أكثر انشغالا بها، وبأسئلتها ودروسها، وبإشكالاتها المعقدة، لاسيما تلك التي ارتبطت بدراسات ما بعد الكولونيالية، وما بعد البنيوية والنقد النسوي، ودراسات التابع والتاريخانية الجديدة وغيرها.. لم تكن هذه الدراسات فاعلة في وجودها إلا من خلال نصوص مكتوبة، ومن خلال بروتوكولات كتابتها التي دخلت في مسار صياغة السرديات، وفي تمثيلها الثقافي الأنثروبولوجي، فهل ثمة أحكام مسبقة تخصُّ قراءة هذه النصوص، والتعرف على أنساقها؟
أظن أن الإجابة ستكون غير قارة، وغير قياسية، فروايات أمين معلوف مثلا، وبعض روايات رضوى عاشور وسعدي المالح وإبراهيم الكوني ومحمد حسن علوان وغيرهم، ستثير جدلا حول هويتها الأجناسية أولا، وحول علاقتها بالتاريخ ثانيا، وحول علاقتها بالنسقي المضمر ثالثا، ففضلا عن كونها تكشف عن مشغل سردي مغاير، إلا أنها تتعاطى مع موضوعات التاريخ بنوع من الحساسية، وبما يجعل مقاربتها مكشوفة على تشابك أيديولوجي وإنثروبولوجي، مع ما هو أدبي، فالرواية تظل جزءا من «الحكي» وأن هذا الحكي الماكر يحمل في متونه» التاريخ مسرودا» ومخترقا، وهي مجاورة قلقة وغير آمنة، ومفتوحة على قراءات ضدية، من الصعب على النقد الثقافي التخلّص من قصديتها، ومن طبيعة سحر الجمالي الذي يجعلها أكثر جاذبية في إغواء فضول القارئ، رغم ما تُثيره من استفزازات، تخص المخفي الأيديولوجي والديني، وحتى الطائفي، فالثقافي هنا لن يكتفي بأنساقه المضمرة، بل سيظل قريبا من لعبة الجمالي الذي يصنعه «الحكي السردي»، بوصفه كتابة تقصد التجاوز على الوثائقي، والإنثروبولوجي، والنزوع إلى توظيف «المتخيل السردي» عبر بيان علاقته الشائكة بين التاريخ والسرد، وبين فاعلية تلقيه.
النقد الثقافي وما بعد الحداثة
يشكل تمثيل النقد الثقافي لأطروحات ما بعد الحداثة، مدخلا للحديث عن الطابع الإشكالي لها، وعن قدرتها على تقويض علاقتها بالمركزيات، وبالبحث في النص عن «الذات المفكرة» بوصف أن الثقافي هو تمثيل لفاعلية تلك الذات في الأنساق الثقافية عبر النصوص، وعبر جعل فاعلية هذا النقد مشروطة بالكشف عما تخفيه اللغة، من خلال الحفر والتفكيك، أو من خلال التأويل، وتخريب علاقتها بالقيم التي تكرست عبر التاريخ والسلطة والعصاب، فالمدح والذم والنسيب، وتوظيفات المجاز والاستعارة الكناية، هي جزء من مهيمنة نصوصية، ليست بعيدة عن المتعالي/ السلطة/ الأيديولوجيا/ الجماعة/ الطائفة، ولا عن مركزيتها التي فرضت خطابها عبر المقدس، وعبر الفحولة والبطولة والأنوثة، التي انتقى لها الغذامي رموزا شعرية عربية وجد في شعريتها سمات ذلك الخطاب، كما عند المتنبي أو أدونيس ونزار قباني، وعند نازك الملائكة.
لقد أثارت ما بعد الحداثة صدمة كبيرة، على مستوى المفاهيم وصلاحيتها، أو على مستوى الأفكار والفلسفات والمناهج، وحتى على مستوى الدرس الأكاديمي، فـ»الما بعد» هو خروج عن المركز، وتجاوز على النمط، وربما هو انسحاب من التاريخ إلى النص، لكن ذلك لن يأتي عفو الخاطر، بل هو خاضع إلى إجراءات وتحولات كبرى، كانت أولى ضحاياها، السرديات الكبرى، بما فيها السرديات الجمالية، ما جعل النقد الثقافي يواجه التباسا وغموضا في سياق علاقته بهذه التحولات، فتحول النقد الثقافي إلى مجال للدرس النقدي، جعله أكثر اقترابا من الأفكار التي طرحها الناقد الأمريكي فنسنت ليتش حول «النقد الثقافي ـ النظرية الأدبية وما بعد البنيوية»، حيث تبدت أفكاره النقدية من خلال ما « تحيله إلى كيان من النصوص قديمة وحديثة، معنية بالشعرية ونماذجه الثقافية، مضيفا إليها السيميائيات وسائل الاتصال والخطاب والشيفرات الخاصة بالعنصر والطبقة والجنوسة وبالثقافة المرئية والشعبية» بتوصيف حسام الدين فياض..
الاشتباك الأدبي مع الثقافي العام هو الرهان على توسيع مساحة الفاعلية النقدية، وعلى الكيفية التي تُزيد من فاعلية « القارئ العمدة» بتوصيف ريفاتير، ومن مساحة القراءة الفاعلة، وبالاتجاه الذي يجعل من ممارسة «النقد الثقافي» تبدو وكأنها ممارسة متعالية تنفتح على كل شيء مقروء، بدءا من نظريات المعرفة، وإلى خطابات المؤسسات الثقافية، وبهدف تحويل «المابعديات» إلى مجال نصوصي، يتجاوز المركزيات الكبرى وسردياتها، وعلى نحو يجعل منه اندفاعا نحو إنضاج «الممارسات النقدية الثقافية لفكرة التابوهات في المساءلة الثقافية، وفي الكشف عن تحول في طبيعة الاهتمام بالأخلاق، والسياسة والنشاط الاجتماعي» بتوصيف علي عطا. لقد ضم كتاب ليتش المؤسس ثمانية فصول شملت «التكوين الاجتماعي، والنقد الثقافي، التأليف والمقصد، الخطاب «الشعري»، والنص الاجتماعي، النوع الأدبي والميثاق الثقافي، آداب الأقليات، «الشعريات العامية»، التفسير النصوصي والتقييم، النظرية المؤسساتية والتحليل، دراسات برمنغهام الثقافية وما بعد البنيوية»، وهي فصول لم تغادر ما هو أدبي، أو ما تحوزه النظرية الأدبية، لكنه جعل من انحيازه إلى ما بعد البنيوية مدخلا لنقد التاريخ والنظام السياسي الأيديولوجي والمؤسساتي، عبر مساءلة الماضي الذي يعتقد أنه ما زال يملك سلطة رمزية، ويتطلب وجود الممارسة الثقافية بوصفها النقدي والتقويضي، وعبر مواجهة كثافة المعلومات التي تصنعها مؤسسات البورجوازية الغربية وأنظمتها السياسية والأيديولوجية، وعلى النحو الذي يسهم في «بناء مفهوم مختلف للنقد الثقافي لا يضعه في صراع مع النقد الأدبي، أو إلغاء الجماليّ من مجال اشتغاله، فضلًا عن محاولة تقديم تصور واضح عن مشكلة المنهج والمفاهيم الإجرائية التي يستعيرها النقاد الثقافيون من منظورات نقدية وفكرية متنوعة، أو التي يجترحونها ليقاربوا النصوص والخطابات المختلفة» بتوصيف عبد الرزاق المصباحي..