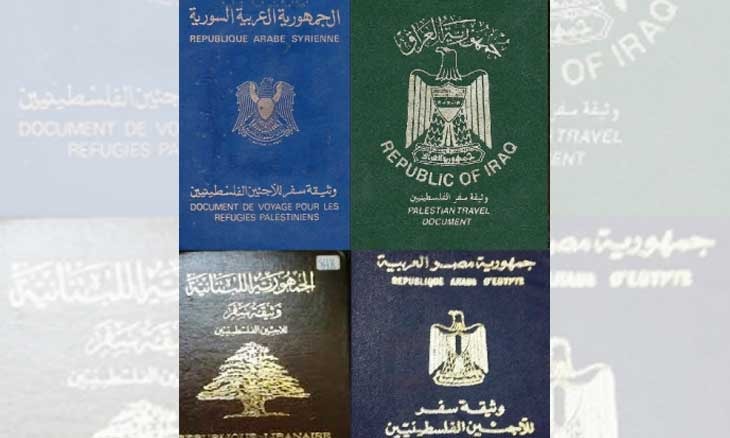الجريمة والعنف بوصفهما سياسة

الجريمة والعنف بوصفهما سياسة
مرزوق الحلبي
في كلّ مكان في العالم نشطت فيه الجريمة المنظّمة كانت تتمتّع بغطاء في مستويات السياسة والشرطة والقضاء والمجتمع. لا يُمكن للجريمة المنظّمة أن تنشط وتتوسّع وتعمل في وضح النهار إلّا بغطاء كهذا…
عندما استفحلت الجريمة والعنف قبل نحو عقدين، كانت القراءات لهما على أنّهما تلقائيّان ينفجران كلّما سنحت لهما الفُرصة، ولا نعرف تمامًا متى وكيف ولماذا. كان الحديث في تلك المرحلة علاجيًّا تربويًّا من لدن العلوم الاجتماعيّة ونظريّات التربية وعلم النفس العلاجيّ والأطر الناشطة في هذه الحقول. حديث يُناسب العنف الأسريّ أو التعامل مع مجموعات في ضائقة. في مرحلة لاحقة تعمّق البحث عن الأسباب وقُرِن العنف بالجريمة المنظّمة، لكنّنا أبقينا على القراءة إلى الداخل والبحث عن الأسباب في الداخل. فانتشرت نظريّات عن “الثقافة العنيفة” و”الديانة الحاثّة على العنف” وعن “تدهور أخلاق الناس” و”إلى أين سنصل”. وهي قراءات امتنعت، بقصد أو بغير قصد، عن رؤية الجريمة والعنف كجزء من السياسة وكسياسة تعتمدها المؤسّسة في التعامل مع مجتمعنا هنا وفي مواقع أخرى. بمعنى أنّه احتجنا إلى مدّة طويلة كي نستطيع الحديث صراحة عن الجريمة والعنف كسياسة ومحصّلات للسياسة. ومع هذا لا نزال نصادف أناسًا مسؤولين، رؤساء سلطات محليّة ونوّابًا وقيادات مجتمعيّة، يتحدّثون عن العنف كأنّ المجتمع العربيّ الفلسطينيّ هنا يعيش في فقاعة بمعزل تام عن الدولة ومؤسّساتها، لا سيّما الحكومة، التي تملك زمام أموره وسيادة على ما تعنيه من ميزانيّات وصلاحيّات.
لظاهرة كالجريمة والعنف جملة من الأسباب أساسيّة ومباشرة وثانويّة وغير مباشرة، ذاتيّة ـ للمجتمع ـ وموضوعيّة ـ للسياق وسياسيّة واقتصاديّة، إلى آخر القائمة. لكن المسؤوليّة الأولى والأخيرة عنه وعن مواجهته هي على الدولة ومؤسّساتها. فهي الوحيدة التي تملك حقّ تشريع القوانين وحقّ تطبيقها وحقّ استخدام العنف وممارسته. وهي الوحيدة الملزَمة بحكم العقد الاجتماعيّ بحفظ السلم والأمن العامّ وحيوات الناس وسلامتها وأملاكها وحقوقها. وهي التي تربّي من خلال المدارس والجامعات ومن خلال العقوبات في حال مخالفة القانون، وهي الضالعة بعمليّة “الجتمعة”. ليس صعبًا أن نستدلّ من الوقائع أنّ الدولة أخفقت في كلّ هذه المسؤوليّات فيما يتّصل بالمجتمع العربيّ. فلا هو عندها طرف في العقد الاجتماعيّ، ولا هو شريك، ولا هي ملزَمة ناحيته ـ هكذا في الممارسة الفعليّة. بل هو عندها “عدوّ” أو “ثقافة عنيفة” أو “مجتمع فاشل” إلى آخر النعوت والتراكيب.
إنّ عمليّة التحديث التي مرّ فيها مجتمعنا كانت قسريّة، ولم تأتِ لتحقيق مصالحه بقدر ما هو تحديث مبتور مقموع يحصل بمعظمه لأغراض المؤسّسة. فحصار البلدات العربيّة هو أوّل السياسات التي أفضت إلى ما نحن عليه. وهذا كجزء من سياسات التخطيط التي حرمت هذه البلدات من حقوقها التخطيطيّة. فقد تحوّلت كلّ البلدات العربيّة، خاصّة الكبيرة منها، إلى تجمّعات متفجّرة سكّانيًا بالفعل أو بالاحتمال. والتفجّر السكّانيّ يبدأ حين يتزايد عدد السكّان وتنحسر المساحة التي يعيشون عليها، وتقلّ الفُرص والموارد. فلنتخيّل أنّ بلداتنا لا تزال تنعم بمورد الأرض كما كان في العام 1948 قبل النكبة. لنتخيّل أم الفحم اليوم مع 130 ألف دونم؟ والأرض مكان ومورد وحيّز للعيش وأفق للتطوّر. في كلّ مكان في العالم شهد “التفجّر السكّاني” ـ ولو في الدول “العُظمى” والمدن “المشهورة” و”العواصم” ـ رأينا استفحالًا للجريمة والعنف بكلّ أشكالها كما هو حاصل عندنا!
إنّ عمليّة التحديث المشار إليها أفضت إلى اضمحلال مؤسّسات الضبط الاجتماعيّ وتفكّكها. هذا يعني تفكّك واضمحلال ما كانت تعنيه من قدرة على فرض سلطة اجتماعيّة عبر سلسلة من الأعراف والعلاقات بين الأفراد والجماعات تشكّل طبقة أخرى من الممنوعات والمسموحات والضوابط إضافة إلى القانون والتربية. ظلّت الدولة بمنأى، لا تُطبّق القانون إلّا انتقائيًّا عندما يخدم مصالحها أو سياساتها: جباية دين لسلطات الضريبة، أو هدم بيت، أو تجريد حملة جرّارة لاعتقال ناشط سياسيّ! الدولة قالت في سياستها وتصريحات مسؤوليها وسلوكها ـ “أنتم رعايا فقط، وحقّ حفظ الحياة والسلامة لا يسري عليكم!” وإلّا كيف نفسّر غيابها التامّ عن التدخّل، علمًا بأنّ عناوين الجريمة معروفة لها وكذلك أفعالها وناشطوها! لسنا بهذه السذاجة كي نقبل بحجّة “شحّ القوى البشريّة تحت تصرّف الشرطة”، خاصّة وأنّ الدولة أقامت عشرات مراكز الشرطة في البلدات العربيّة وسط مهرجانات وعروض ووعود بأنّ الأمور ستنعطف نحو الأمن والأمان. بل تبدو الدولة ثكنة عسكريّة ذات طبيعة أمنيّة ومظاهر عسكرانيّة واضحة.
الجريمة المُنتِجة الأساسيّة للعنف المتعدّد الأشكال هي في نهاية الأمر فرع من فروع “النشاط الاقتصاديّ”. هي التي تمسك بالسوق السوداء. وهي سوق مُربحة حسب كلّ المعايير، سوى أنّها تُسقط الضحايا بالجملة كلّ يوم. والجريمة تستهدف فئتين في مجتمعنا: فئة الناجحين من أصحاب المهن والمصالح والشركات والمشاريع الاقتصاديّة الناجحة باعتبارها “بقرة حلوب” أو “دجاجة تبيض ذهبًا” لأنّها القادرة على دفع “خاوة” بمبالغ كبيرة. وفئة الفقراء المعوزين الذين يحتاجون إلى قرض في السوق السوداء يتضاعف بسرعة مع تخلّف تسديد الأقساط الشهريّة. الواقفون على المحور بين هذه الفئة وتلك غير مُحصّنين لأنّهم قد يجدون أنفسهم مطلوبين لعائلات الجريمة المنظّمة بسبب قريب لهم لم يُسدّد الخاوة أو لم يُسدّد أقساط القرض.
في كلّ مكان في العالم نشطت فيه الجريمة المنظّمة كانت تتمتّع بغطاء في مستويات السياسة والشرطة والقضاء والمجتمع. لا يُمكن للجريمة المنظّمة أن تنشط وتتوسّع وتعمل في وضح النهار إلّا بغطاء كهذا. بل سنجد حالات تختلط فيها الأمور وتتقاطع إلى حدّ التداخل. فلا تعرف “ممثّلي” هذه من تلك، ولا “مندوبي” المؤسّسة من “جُباة” السوق السوداء. من هنا علينا أن نرى الجريمة والعنف عندنا ضمن هذا السياق الذي أنتجته السياسة وتُديره السياسة لأغراض السياسة. وأستذكر ما كان في جنوب أفريقيا قبل انتهاء نظام التمييز العنصريّ (وغيرها من مواقع إدارة الفقر والتحكّم بالمصائر) من سياسات قصدت أن يأكل المواطنون الأصليّون بعضهم في المعازل والجيتوات التي حُوصروا فيها كنوع من الإلهاء وتفريغ الغضب. إنّها السياسة هناك وهنا.