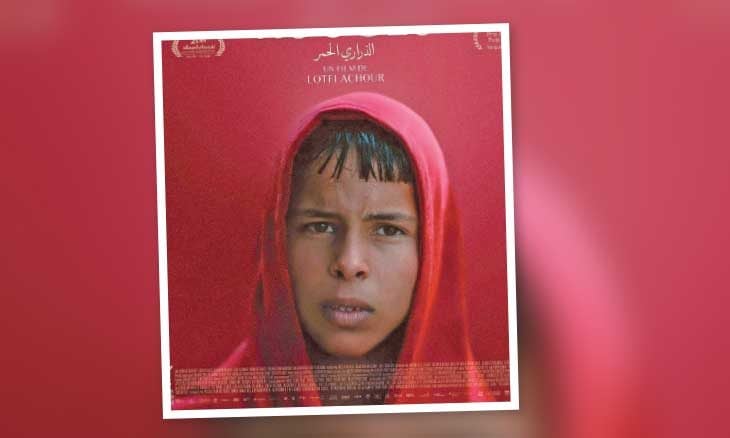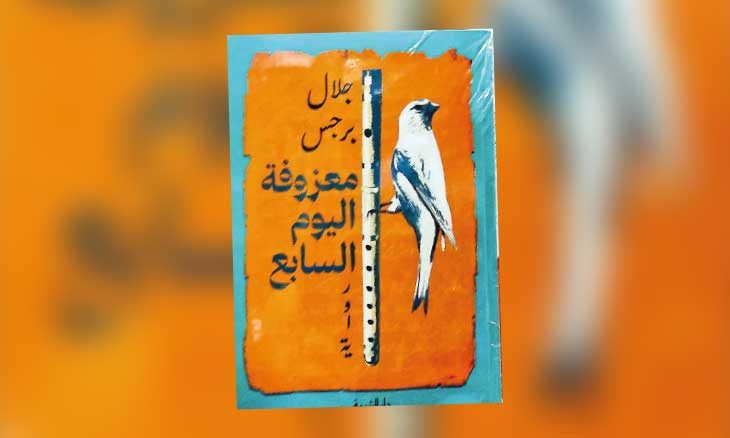عبد الجليل الأزدي – قُمْبَاز المنفلوطي وتسليح اللغة ببلاغة الدموع

عبد الجليل الأزدي – قُمْبَاز المنفلوطي وتسليح اللغة ببلاغة الدموع
إهداء: إلى أستاذتي الفاضلة زهراء ناجية الزهراوي
شرذمة من الفتيات والفتيان تغادر جحورها بالأحياء الشعبية المحاذية لسور المدينة متجهة صوب إعدادية شاعر الحمراء التي كانت في بداية سبعينيات القرن الماضي عبارة عن بناية من عشرة أقسام تقف وحيدة ومنعزلة في القفر الممتد بين باب دكالة وجنانات سقر…
كنا فتيانا نعبر أولى خطواتنا فوق الجسر الممتد من الطفولة إلى الصبا. لن أقول كنا فتيات وفتيانا في عمر الزهور كما تريد البلاغة أن توهم بذلك؛ فنحن لم نكن نعرف الزهور إلا فوق صفحات خماسية السيد أحمد بوكماخ وكتب اللغة الفرنسية Bien lire et comprendre؛ ونحن أنفسنا لم نكن ظهورها برغم صغر سننا. كنا شرذمة قادمة من جحور البؤس الواطئ. معظم آبائنا مياوم أو حرفي وأمهاتنا، في أحسن حالاتهن، تغزلن الصوف داخل بيوت معتمة وكئيبة ترفرف في باحاتها خفافيش الاشتباك اليومي مع ضرورات سد الحاجة فقط… كان سور المدينة حاجزا بيننا والآخرين ورثة المعمرين… نحن هنا وهم هناك في الحي الشتوي والفيلات الفارهة والعمارات ذات الطوابق الأربع أو الخمس، التي يطل عليها جبل جيليز… الذي كان ذات زمن مضى ملاذ الولي الصالح أبي العباس السبتي…
كنا على مشارف الصبا بداية السبعينيات في مغرب لم يصمد بعد جراح انتفاضة 1965 بالدار البيضاء. كانت الحركة التلاميذية في بدايات تشكلها الجنيني؛ وكان الجيش يتأهب للانخراط في مغامرة دونكيشوطية تحت تأثير ما جرى في سوريا والعراق وليبيا ومصر. وهذه المغامرة ستسميها الأزمنة القادمة: انقلاب الصخيرات. وكانت حركة اليسار الجديد، أسوة بأشباهها ونظائرها على الصعيد العالمي، تشتغل في سرية تامة. ظلت شعاراتها تثير النقع اللفظي، إلى أن تناثرت طلائعها كالغبار تحت ضربات قمع شرس، امتد من اليمن السعيد إلى المغرب “الجديد”!
كنا فتيانا بالفعل. في كل فصل دراسي أربعون نفرا وأكثر. وكان على أساتذتنا تدبير شؤون جميع الرؤوس التي تجلس أمامهم وأمامهن. وكانت رؤوسنا مليئة بالدهشة والخوف والشوق والتوق، لكنها مزدحمة فوق ذلك بجحافل القمل… وفوق أعناقنا بقع حمراء خلفتها لسعات البق الذي كان يمتلك حق الإقامة الدائمة معنا في الجحور والمضاجع التي نأوي إليها كي نقتات وننام فقط؛ إذ معظم وقتنا، يمضي وينقضي فوق طاولات الفصول الدراسية، أو تسكعا في الحواري والأزقة وأحياء النصارى في جيليز…
وبانتقالنا من الطفولة إلى الصبا، ومن التعليم الابتدائي إلى الإعدادي، انتقلنا كذلك من خماسية السيد أحمد بوكماخ إلى كتب المطالعة والقراءة المسترسلة. وأينما اتجهنا في تلك الكتب التي كانت تسمى المطالعة، تطالعنا صورة مصطفى لطفي المنفلوطي مصحوبة بنص من كتاباته ومترجماته؛ وفي كتب القراءة المسترسلة، كما في تلاوات المطالعة، كانت نظرات المنفلوطي وعبراته تجثم على عواطفنا وتستولد منا الدمع مدرارا وترسخ وعينا الشقي بفقرنا الدائم وبؤسنا المقيم. نحن “المعذبون في الأرض”، نطالع المنفلوطي ونسترسل في قراءة نظراته وعبراته، بل ونذهب رفقته إلى “ظلال الزيزفون”، ويترسخ عندنا الوهم بما زعم المنفلوطي أنه: الفضيلة التي لا فضيلة فيها؛ بل إن واحدة من المدارس الخصوصية الأولى بالأحياء الشعبية حملت اسم: الفضيلة؛ ربما إمعانا في تكريس المنفلوطي وإعلاء ألوية بكائياته وبيارق فجائعه المفجعة التي تبكي الناس بسبب أو دون سبب، على حساب نبي جبران خليل جبران ودمعته وابتسامته، وكذا على حساب “أديب” طه حسين ومعاوله التشكيكية التي هدمت الكثير من اليقينيات في الأدب الجاهلي وأحاديث الأربعاء ومستقبل الثقافة في مصر…
كنا فتيانا بالفعل تأخذنا الدهشة والإعجاب أمام الصور المبثوثة فوق أغلفة كتب المطالعة العربية والفرنسية. ولازلت أذكر أن أختي Rachida Elazadi “تناولت” على يدي أبي الفقيه وجبة عقوبة محترمة بحزام جلدي عريض، لأنه ضبطها متلبسة بالفرجة على الصور الملونة في كتاب الفرنسية Bien lire et comprendre…
أما أنا، فأشد ما كان يدهشني، فهو صورة المنفلوطي بشاربه ووجهه الذي يظهر وافر الصحة وعليه جميع علامات الراحة. وفوق تلك الوجه، رأس بغطاء مألوف فقط ضمن ثقافة اللباس عند أعيان الريف المصري…
تحت تلك الرأس وذاك الوجه الصبوح ذي الشارب الأفقي المستقيم الشبيه بشارب المرحوم محمد بسطاوي، جسد متلفع في لباس تقليدي عالي الأناقة لو تعرف عليه المشرفون على حدائق جاك ماجوريل، لوظبوه ضمن تحف الخياطة الراقية في متحف السيد سان إيف لوران بمراكش.
لباس المنفلوطي هو ما يدعوه أهلنا في بلاد الشام: القمباز؛ ثوب تقليدي يرتديه الرجال في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وفي بلاد الكنانة كذلك. وقد جرت العادة أن يرتدي الناس هذا الزي في المناسبات؛ وأكثر من كان يرتديه الأغنياء والمثقفون والموسرون والأعيان وكبار والوجهاء وكل من كان له موقع شعبي واجتماعي متميز. وإجمالا، ينتمي القمباز إلى ثقافة اللباس ويشكل عنوان تَمَيُّز distinction بلغة السيد بيير بورديو.
قطعة القماش هذه تشبه الجلباب في ثقافة اللباس بالمغرب؛ غير أنه مفتوح من الأمام، من الأعلى إلى الأسفل؛ وينتهي بـ«ردة» أو «شريط» من الأعلى يلف الرقبة من الأمام ممتدا من اليمين نحو اليسار؛ منتهيا إلى العروة والزِّرُّ.
كان القمباز لباس المنفلوطي اليومي؛ وكانت عبراته المتواترة قسطا طريفا من وجباتنا اليومية في المطالعة والقراءة والتعبير والإنشاء. كان المنفلوطي قديما في لباسه، قديما في لغته وأسلوبه. يستعذب حرارة البكاء، بل ويتلذذ في إبكاء جماهير غفيرة من الفتيات والفتيان تتوافر لذيهم جميع دواعي البكاء ومؤهلاته.
وسيعرف هؤلاء الفتيان والفتيات فيما بعدة أن هذا الأزهري المتلفع دوما بقمبازه تركيبة عجيبة من ابن المقفع والجاحظ والمتنبي وأبي تمام وحكيم المعرة وابن خلدون وابن الأثير الجزري ومحمد عبده؛ إذ كان يأوي إلى هؤلاء القدماء لتصنيع إنشاء عربي قديم، أو لنقل إنه قديم ومختلف عن القدماء الذين شكلوا دوما منهل استمداد واستيحاء.
صيغت عبرات المنفلوطي ونظراته بأجزاءها الثلاثة بلغة عجيبة ومدهشة تطفح الصناعة فاقعة فوق سطورها وترغم القارئ على العودة المتواترة إلى القاموس نتيجة التكلف الشديد في انتقاء الكلمات والمفردات. وكنا نحن التلاميذ نستنجد بمنجد الطلاب الذي لا منجد لنا سواه؛ بل إنه إنجيلنا المقدس الذي يهدينا سواء السبيل في مجاهل وأدغال لغة “أبي المساكين والبؤساء” وفق العبارة السديدة التي أطلقها عباس محمود العقاد صوب أول ضحايا معاركه السياسية والأدبية التي دامت أكثر من خمسين عاما. كان اسم الضحية: المنفلوطي؛ وكانت شرارة الطلقة تحمل بيرق: ضرورة هزيمة أدب المهزومين.
والواقع أن نظرات أبي المساكين وعبراته لا تدخر جهدا في صناعة الدموع، وتمعن بقسوة مفرطة وغامضة الأسباب في استحضار اليتامى والفقراء والمرضى والحزانى والممرورين والمهمومين والسجناء والمكابدين والذين إن لم يلحقهم العقاب التحقوا به، والذين ولدوا في الهاوية وظلوا عالقين في سديمها.
يكتب أبو المساكين والبؤساء برومانسية فاقعة؛ ترى الفقر ولا تدرك جذره؛ وتكتب عن الفقير كفرد معزول، ولا تحاول أن تذهب بعيدا للنظر فيه كعلاقة ضمن جملة العلاقات الاجتماعية؛ أي أنه يكتب بؤس الواقع بوعي بئيس. وعلى هذا النحو، نتضامن بالرأي مع الفلسطيني فيصل دراج حين توكيده أن المنفلوطي يقوم ب(تصنيع الحكاية لجمهور غفير يستعذب المآسي والبلاغة المؤسية). وهذا ما أومأ إليه عنوان هذا المنشور بعبارة: تسليح اللغة ببلاغة الدموع.
ومن الغريب الذي لا غرابة فيه أن هذا الرجل ذا الوجه الصبوح، والذي كان يكتب المآسي بأسلوب مؤسي ولغة تكاد الدموع تنهمر منها، كان يعيش في رغد ويسر فوق أفرشة وثيرة الملموس داخل قصر فسيح بطلاء أبيض ونوافذ زجاجية لا يقربها ذباب الفقراء؛ قصر لا نظير له سوى فيلا السيد رؤوف علوان في رائعة نجيب محفوظ: اللص والكلاب.
ذلك قسط من الماضي، ماضينا، نستعيده انطلاقا من وعي الحاضر، ليس رغبة في محض استعادته، وإنما رهبة من تلف الذاكرة، وخوفا من أفول الذكريات… ذكريات جيل برمته.
المتشرد الحكيم عبد الجليل بن محمد
مراكش يناير 2023.