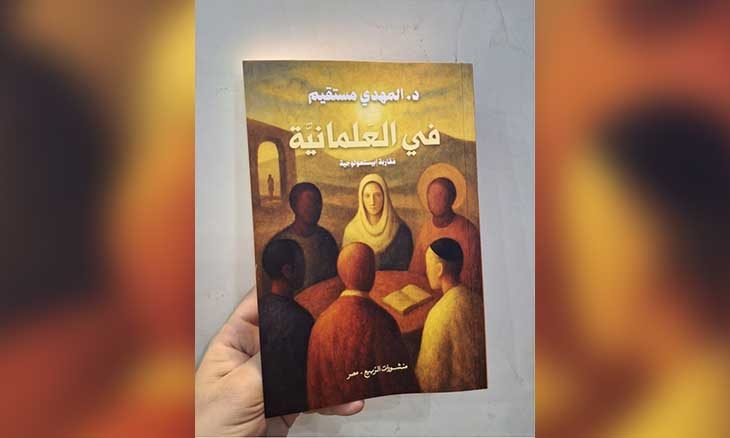ذاكرة

ذاكرة
سيد درويش (1892 – 1923)
مئوية رحيل المغني والموسيقار المصري الذي استحق لقب «فنان الشعب» بالنظر إلى ما أنتجه من محتوى في الغناء والموسيقى استُمدّ من روح الهموم الإنسانية والمعيشية والعاطفية للحياة الشعبية المصرية، وكذلك اعتماداً على ما أحدثه من ثورات جذرية متتابعة في تقاليد الموسيقى المصرية والعربية، والقصيدة الغنائية، وأساليب العزف، وفنون «الدور» و«الطقطوقة» والأوبريت والمسرحية الغنائية.
ولم يكن عجيباً أن تنطلق مواهب درويش من بوّابة الكدح وشظف العيش، إذْ اشتغل عامل بناء وكان يشدو لزملائه العمال حين لفت أسماع الأخوين أمين وسليم عطا الله الجالسين في مقهى قريب، وكانا من كبار المتعاقدين على الفنون، فاتفقا معه على رحلة فنية إلى الشام أواخر 1908. وهناك تابع دراسة العزف على العود والنوتة الموسيقية، وبدأ أولى خطواته في التأليف والغناء، وحين عاد إلى القاهرة كان صيته قد سبقه فسارعت إلى الاتفاق معه الفرق المسرحية الأبرز في تلك الحقبة، من نجيب الريحاني إلى جورج أبيض وعلي الكسار.
ثم ترسخ مقامه في الوجدان الشعبي العام حين انطلقت ثورة 1919 فغنى لها «قوم يا مصري»، وتتالت أعماله الخالدة مثل «زوروني كل سنة مرة» و«الحلوة دي» و«أنا هويت» و«أهو ده اللي صار»، وموشحات ذائعة الصيت مثل «يا شادي الألحان» و«يا غصن البان حرت في أمري»؛ فضلاً، بالطبع، عن لحن النشيد الوطني المصري «بلادي لك حبّي وفؤادي».
ويؤثر عن درويش قوله إنّ الموسيقى لغة عالمية ونحن نخطئ عندما نحاول أن نصبغها بصبغة محلية. يجب أن يستمع الرجل اليوناني والرجل الفرنسي والرجل الذي يعيش في غابات أواسط أفريقيا إلى أي موسيقى عالمية فيفهم الموضوع الموسيقي ويتصور معانيه ويدرك ألغازه. لذلك «فقد قررت أن ألحّن البروكة على هذا الأساس، وسأعطيها الجو الذي يناسب وضعها والذي رسمه لها المؤلف سأضع لها موسيقى يفهمها العالم كله».
ويرى د. أسامة عفيفي أنّ خصائص فن سيد درويش يمكن تلخيصها في التالي: 1) اختيار الموضوع والكلمات؛ و2) التعبير عن الموضوع والكلمة باللحن؛ و3) اختيار النغمات ذات الجذور الشعبية؛ و4) صياغة الجمل اللحنية في أبسط صورة؛ و5) صياغة الألحان في تراكيب حديثة متطورة. وفي جانب الغناء، يضيف عفيفي، كان درويش قد فاجأ الجمهور بأغانٍ كاملة مدّتها بين 60 و90 ثانية؛ وكانت «من الجاذبية بحيث تلتصق بذاكرة المستمع فيرددها تلقائياً بعد سماعها ولو لمرّة واحدة! بل ويتذكرها الجمهور لعشرات السنين».
نزار قباني (1923-1998)
مئوية ولادة الشاعر السوري الكبير نزار قباني، الذي اقتحم المشهد الشعري السوري، والعربي، في سنة 1944، بمجموعته الشعرية «قالت لي السمراء»، التي كانت فارقة حقاً، وانتهاكية تماماً. ففي زمن القصائد الوطنية العصماء، الصادحة والمجلجلة والملتزمة، كانت تلك المجموعة حافلة بقصائد حبّ غنائية، وغزليات حسّية، ورشاقة مباغتة في تطويع المعجم، وأناقة رهيفة في اختيار المفردات، وشجاعة عالية في المجاورة بين الفصحى والعامية. وإلى هذا كلّه، وسواه من الخصائص الفنية والجمالية، تضمنت المجموعة تمثيلات جسورة تماماً عن امرأة جديدة، طارئة على الذائقة العربية يومذاك، تحلّق في «أبدٍ يبدا ولا ينتهي/ في ألف دنيا بعدُ لم تخلقِ/ في جزر تبحث عن نفسها/ ومطلق يولد من مطلق»!.
ولن يطول الوقت حتى رسخ صيت قباني تحت لقب «شاعر المرأة»، في المقام الأوّل والأبرز والأشدّ شيوعاً لدى الملايين من قرّائه؛ في أوساط الشباب، ذكوراً وإناثاً على حدّ سواء؛ وفي وجدان العاشق العربيّ الفتيّ، حيث تصالحَ غزل عقود القرن العشرين، مع نماذج عريقة خلّفتها تقاليد الغزل في التراث الشعري العربي القديم. ولا عجب أنه بلغ درجة من الإخضاع لاشتراطات هذا اللقب دفعته إلى أن يهتف، بأسى وتضرّع معاً: «هل من الممكن، إكراماً لكلّ الأنبياء، أن تخرجوني من هذه القارورة الضيقة التي وضعتني فيها الصحافة العربية: أي قارورة الحبّ والمرأة؟».
وفي كتابه «قصتي مع الشعر»، 1982، شاء قباني أن يدوّن ما يشبه السيرة الذاتية والشعرية في آن معاً؛ حتى إذا كانت الفصول المكرسة للسنوات الأولى في حياته (الولادة والأسرة والطفولة والدار الدمشقية والمدرسة الأولى…)، أقلّ في الحجم والتفاصيل من الفصول اللاحقة المكرّسة لمسارات التجربة الشعرية. هنا يعثر قارئ الشاعر على آراء بالغة العمق والأهمية حول الشعر بصفة عامة، ومشهد الشعر السوري خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي خصوصاً؛ إلى جانب دور قباني الشخصي في مواكبة التجارب الكبرى لتلك العقود، أو الانشقاق عنها في ميادين كثيرة.
على سبيل المثال، يذهب قباني إلى درجة الجزم بأنّ كلّ قصيدة، وأيّاً كان الشاعر والعصر، هي «محاولة لإعادة هندسة النفس الإنسانية»، و«إعادة صياغة العالم». وهذه السمة تعكس تشخيصاً متقدّماً للموقف الحداثي من ملفّات النفس الإنسانية، وملفّات العالم أيضاً؛ الأمر الذي لم ينسحب بالضرورة على التوجيه الداخلي، الشعوري والحدسي والحلمي، للقصيدة القبّانية ذاتها. وباستثناء الانزياحات الرعوية هنا وهناك في قصائده، حين يبدو أقرب ما يكون إلي سعيد عقل (الذي أقرّ بفضله، مراراً)؛ لا تنفتح ملفّات النفس الإنسانية في قصيدة قباني إلا عبر استبصارات حواسّية محضة، مرهفة تارة وعجلى طوراً، «تشمّ» و«تسمع» و«تتذوّق» النفس، أكثر مما تتأمّل فيها وعَبْرها.
بابلو بيكاسو (1881-1973)
الذكرى الخمسون لرحيل الفنان الإسباني الكبير بابلو بيكاسو، أحد أعمدة الفنون التشكيلية على امتداد القرن العشرين، وصاحب عشرات الأعمال المنفردة التي باتت بمثابة علامات فارقة ومحطات فاصلة في تعريف مسارات التحوّل الجذري في المحتوى والشكل، اللون والكتلة، العناصر الطبيعية والبشرية، التمثيل الرمزي والتجسيد المادّي، وامتزاج المدارس والتيارات والرؤى في ذلك كلّه واعتماداً عليه أو أحياناً من خلال تعديله أو تثويره أو حتى تجاوزه تماماً.
تلك كانت حاله مع المدرسة التكعيبية مثلاً، التي انخرط فيها عبر الممارسة والتطوير في آن معاً، وتفاعل مع كبار ممثليها على اختلاف أساليبهم وتآلف معهم وتكامل أحياناً أو تصارع وتنافس، من دون أن يحجب حقّ الجميع في الاختلاف إلى حدود قصوى. كما كان تأثره بالفنون الأفريقية والبدائية، خاصة أشكال الأقنعة ومرونة الأجساد البشرية وتوظيف الطقوس والأساطير، قد اتخذ المنوال ذاته من حيث العلاقة الجدلية والتفاعل المشترك. وليست بعيدة عن هذا المنحى صلاته مع السورياليين في باريس مطالع القرن العشرين أمثال أندريه بروتون، أو صداقاته لاحقاً مع فنانين وكتّاب يساريين والتي أسفرت عن انضمامه إلى الحزب الشيوعي الفرنسي. ورغم أنّ بيكاسو لم يشارك عسكرياً في الحرب الأهلية الإسبانية، إلا أنّ عداءه للملكيين والجنرال فرانكو كان صريحاً، ولم تكن لوحته الشهيرة «غرنيكا» هي وحدها الشهادة البليغة على مواقفه. وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا أو ذاك من تصنيف أساليبه، ثمة إجماع واسع النطاق على تقسيمها إلى خمس مراحل: الزرقاء، الوردية، الأفريقية، التكعيبية التحليلية، والتكعيبية التركيبية؛ على امتداد السنوات 1907 وحتى 1919. ومن جانب آخر، شهدت السنوات الأخيرة محاولات حثيثة لتدقيق ما يُقال عن مواقف بيكاسو من المرأة، اعتماداً على علاقاته المتعددة وتصريحات نُسبت إليه تنطوي على تحقير النساء عموماً، أو اعتماداً على لوحته الشهيرة «نساء أفينيون»، 1907. وكتاب روز – ماريا غروب «آلهة ومماسح أحذية: نساء في حياة بيكاسو»، الذي صدر سنة 2023، مثال بارز على تلك الأبحاث.
جوائز
البوكر الدولية – الإرلندي بول لينش عن رواية «أغنية نبي»:
فاز الكاتب الإرلندي بول لينش بجائزة البوكر الدولية لعام 2023، عن روايته «أغنية نبي» Prophet Song ، التي تمزج بين حكاية عائلة ومصائر بلد يواجه خيارات كارثية، من خلال حكومة إرلندية متخيلة تنزلق نحو الطغيان. وهذه هي الرواية الخامسة من لينش، وليست بعيدة عن مناخات أعماله السابقة التي اتسمت بنقد عميق لمواقف الديمقراطيات الغربية إزاء الكوارث العامة والمعضلات الإنسانية والسياسية الكونية.
وكانت إيسي إدوجيان، رئيسة لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام، قد صرّحت بأنه «منذ أول طرقة على الباب، أجبرتنا (أغنية نبي) على الخروج من شعورنا بالرضا عن النفس، بينما نتابع المحنة المرعبة لامرأة تسعى إلى حماية أسرتها في إرلندا التي تنحدر إلى الشمولية»؛ معتبرة أنّ الرواية «انتصار للقصص العاطفية… وللشجاعة».
من جانبه قال لينش إنه أراد أن يَفهم القراءُ الشموليةَ من خلال تسليط الضوء على الواقع المرير، عبر الواقعية الشديدة في كتاباته؛ مضيفاً: «أردت تعميق انغماس القارئ إلى درجة أنه بحلول نهاية الكتاب، لن يتعرف على هذه المشكلة فحسب، بل سوف يشعر بها هو نفسه».
وتُعد الجائزة بين أبرز المكافآت الأدبية في العالم، ويحصل الفائز بها على 50 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب مساندة معنوية لمسيرة الكاتب الأدبية ونشر أعماله على نطاق واسع. وكانت الرواية الفائزة، «أغنية نبي»، قد نُشرت في بريطانيا عن دار Oneworld التي سبق لها أن نشرت أيضا العملين الفائزين بالجائزة في 2015 و2016.
رحيل
سلمى الخضراء الجيوسي (1926-2023)
الناقدة والشاعرة والمترجمة الفلسطينية التي لا مبالغة في اعتبارها مؤسسة ثقافية ومعرفية ونقدية متكاملة، ليس بسبب أنها كانت محرّرة سلسلة من الأعمال المرجعية عن الأدب العربي، بالغة الأهمية، وذات فاعلية ثقافية وعلمية وتربوية وموسوعية فريدة حقاً، فحسب؛ بل كذلك لأنّ هذه الإنجازات تكاملت مع أعمالها النقدية المعمقة (خصوصاً كتابها الموسوعي «الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث»، الذي صدر بالإنكليزية أوّلاً، ثم ترجمه الدكتور عبد الواحد لؤلؤة إلى العربية)؛ حيث يرتدي التباري طابع التكامل الأقصى بين النصوص الإبداعية، والحقول البحثية، والأنظمة الدراسية.
وبفضل الجيوسي، الإنسانة والمؤسسة والفريق العامل معها، بات الدارس الأجنبي لآداب اللغة العربية يمتلك مجموعة فريدة من المراجع المحكمة والاشتمالية والمتنوعة، باللغة الإنكليزية؛ مثل «أدب الجزيرة العربية الحديثة: أنطولوجيا»، المجلد الضخم (560 صفحة) الذي حرّرته الجيوسي وصدرت طبعته الأولى سنة 1988، ويضمّ ترجمات مختارة، شعراً ومسرحاً وقصة قصيرة، لـ95 كاتبة وكاتباً من بلدان الخليج العربي، بالإضافة إلى اليمن. أحدث الطبعات تقترح بعض أبرز الخدمات التي باتت قرينة الإصدارات الإلكترونية، مثل التحويل من النصّ إلى الجهر الصوتي، والطباعة الميسّرة التي تريح البصر، وشرح الكلمات الصعبة أو النادرة.
متوفرة أيضاً طبعة إلكترونية من مجلد الجيوسي المكمّل «قصص عربية كلاسيكية»، الذي صدر عن منشورات جامعة كولومبيا سنة 2010، وضمّ نصوصاً سردية كُتبت في أطوار مختلفة من تاريخ الأدب العربي، ابتداء من أحقاب ما قبل الإسلام؛ مصنّفة حسب موضوعات مشتركة، مثل حكايا السلاطين والحكام، والمخاطر والحروب، والقصص الدينية، ونوادر جحا، وطرائف أخرى ساخرة، والغرائب والخوارق، وقصص الحبّ. والمرء ينتظر صدور طبعات إلكترونية مماثلة لأعمال أخرى ليست البتة أقلّ أهمية، أشرفت الجيوسي على تحريرها: «حقوق الإنسان في الفكر العربي»، «المدينة في العالم الإسلامي»، «القصة العربية الحديثة»، «مسرحيات عربية قصيرة»، «تراث إسبانيا المسلمة»، «الدراما العربية الحديثة»، «أنطولوجيا الأدب الفلسطيني الحديث»، «الشعر العربي الحديث: أنطولوجيا»….
ولعلّ نقاش الشعر والنثر يظلّ أحد ألمع إنجازات الجيوسي النقدية، وأرفعها بصيرة وبُعد نظر. ذلك أنها كرّست قسطاً واسعاً من كتاباتها لمناقشة قصيدة النثر، وتأطير علاقة هذا الشكل الشعري الوليد بحركات الحداثة والتحديث في الشعر العربي المعاصر، فضلاً عن تدقيق المصطلح ذاته. وكانت في طليعة قلّة قليلة تجاوزت التنظير النقدي الغائم، والتهويم اللفظي، والتأتأة الإنشائية، والهروب من مواجهة المشكلات الفنية الفعلية الخاصة بهذه المغامرة الشكلية.
خالد خليفة (1964 – 2023)
لم يكن الروائي السوري خالد خليفة متحمساً لتوصيف أعماله السردية تحت خانة الرواية التاريخية، وفي التعليق على روايته الأخيرة «لم يصلّ عليهم أحد»، 2019، قال خلال لقاء صحفي: «لم أرغب في كتابة رواية تاريخية، لم أرغب في الوقوع تحت ثقل الحقائق التاريخية»، مفضلاً اعتبار العمل «رواية عن الحب المفقود والموت والتأمل والطبيعة في حياتنا، وعن الأوبئة والكوارث، وعن محاولة الناس ونضالهم ليكونوا جزءًا من الثقافة العالمية، وعن الصراع بين الليبراليين والمحافظين، وعن التعايش الأبدي لهذه المدينة، عن المدينة في وقت كان العالم كله يسعى للانتقال إلى مرحلة جديدة».
المدينة المشار إليها هنا هي حلب، التي كانت ميداناً فسيحاً للغالبية الساحقة من روايات خليفة، وهيمنت أيضاً على معظم المسلسلات التي كتبها للتلفزيون ولقيت نجاحاً جماهيرياً كبيراً أضاف إلى الدراما السورية عمقاً تاريخياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً؛ خاصة حين تعاون مع هيثم حقي، أحد كبار المخرجين السوريين الملتزمين. وبهذا المعنى فإنّ التاريخ كان هاجساً مركزياً طبع خيارات خليفة، ربما على امتداد كامل الحقبة الأسلوبية التي أعقبت روايته الأولى «حارس الخديعة»، 1993، والثانية «دفاتر القرباط»، 2000؛ اللتين تميزتا بحسّ تجريبي مبكر في الشكل، ونزوع في المضمون إلى ترميز الشروط المادية والميتافيزيقية لمشكلات الوجود واليفاعة والاجتماع.
وكما صرّح هو نفسه، كان الربع الأخير من القرن التاسع عشر مصدراً مركزياً لترسيم المشاهد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشخصيات السورية التي اقترحها في رواياته، وكذلك في مسلسلاته؛ إذْ رأى أنّ معركة الليبرالية السورية مع التيارات المحافظة والأصولية كانت أيضاً ميداناً لمشروع نهضة متعثر فشل في فصل الدين عن الدولة وعجز عن تطوير التعليم والصحافة والمجتمع المدني. وإلى جانب وقائع فاصلة في حياة سوريا، ومدينة حلب خصوصاً، على غرار مجاعة 1914 مثلاً؛ فإنّ خليفة استوحى الكثير من تفاصيل المدينة المعمارية والموسيقية والصحفية، ولم يغفل استكشاف الطباعة والنسيج وتقاليد الطبخ وصناعة الحرير ومظاهر اشتباك قوى وعلاقات إنتاج متعددة ومتقاطعة.
ولم يكن غريباً، والحال هذه، أن تضيفه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى لائحة أبرز راحلي العام 2023، تحت هذا التوصيف: «مسجِّلّ، في رواياته، للحرب والانتفاض في سوريا».
روايات خليفة الأخرى هي «مديح الكراهية»، «لا سكاكين في مطابخ المدينة» الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، و«الموت عمل شاق»؛ وقد وصل بعضها، مراراً، إلى اللائحة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. وبين أبرز أعماله للتلفزيون، يُشار إلى «قوس قزح»، «سيرة آل الجلالي»، و«هدوء نسبي».
لويز غلوك (1943 – 2023)
انتمت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك إلى جيل من شاعرات وشعراء الولايات المتحدة تسيّد المشهد الشعري الداخلي، وبعض الأنغلو – سكسوني والأوروبي والعالمي أيضاً، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم؛ من دون أن تتلاقى شعرياتهم، بالضرورة، تحت هذا أو ذاك من الخيارات الجمالية والأسلوبية؛ أو حتى تتعارض أو تتصارع، على غرار عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن ذاته. وعلى سبيل المثال فقط، هنالك مايكل س. هاربر، أحد أفضل الشعراء تحريضاً على مناقشة السؤال الشائك بصدد إيقاع الجاز في النصّ الأدبي؛ وهنالك غالواي كينيل الذي اقترح قصيدة تحتفي بالعلاقة الروحية بين الكائنات والأشياء والعناصر، وترقى إلى مستوى المزمور والترتيلة؛ وهنالك، ثالثاً، روبرت بلاي، أحد أصفى أصوات قصيدة نثر أمريكية خرجت عن إسار الصيغة الفرنسية. وحين فازت غلوك بجائزة نوبل للآداب سنة 2020، أوضحت الأكاديمية السويدية للعلوم في حيثيات قرارها أنّ الشاعرة مُنِحت الجائزة «على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعاً عالمياً على الوجود الفردي». وأضافت: «في قصائدها، تستمع النفس لما تبقى من أحلامها وأوهامها، ولا يمكن أن يكون هناك من هو أشد منها في مواجهة أوهام الذات». وكانت غلوك أوّل أمريكية تفوز بالجائزة بعد 27 سنة أعقبت فوز الروائية توني موريسون، وكانت المرأة الـ16 الحائزة على الجائزة منذ إطلاقها في سنة 1901. المجموعة الشعرية «فيرستبورن» (البِكر)، 1968، هي الإصدار الأول للشاعرة، وقد نشرت بعدها 12 مجموعة شعرية، بالإضافة إلى سلسلة مقالات حول الشعر والنظرية الأدبية. والمحاضرة التقليدية، التي ألقتها غلوك أمام الأكاديمية السويدية، قد تكون الأقصر والأشدّ تكثيفاً (1264 كلمة في الأصل الإنكليزي) بين عشرات المحاضرات المماثلة. لعلها، أيضاً، في عداد الأكثر أهمية، لجهة الدلالة حول مفهوم الشعر وأغراضه، وكذلك التنظير له في هذا المقام وهذه المناسبة على وجه التحديد. ولقد أوضحت، من خلال التركيز على قصيدة من وليم بليك وأخرى من إميلي دكنسون، أنها انجذبت على الدوام إلى «قصائد الاختيار أو التواطؤ، القصائد التي يكون للمستمع أو للقارئ إسهامه الجوهري فيها، كمتلقٍّ لمكاشفة أو لصرخة، أو كمشارك في المؤامرة أحياناً».
مهارة غلوك في ابتكار الصورة الصادمة والجاذبة في آن، وتحقيق نقلات وجدانية ذكيّة ومباغتة بدورها، وقَطْع السطر الشعري على نحو تشكيلي مدروس إيقاعياً (في مستوى المفردة، والصوت، والمقطع النَبْري)؛ كلّ ذلك أتاح لها على الدوام أن «تموّه» الثقل الفلسفي والميتافيزيقي الذي يكتنف موضوعاتها الأثيرة: الموت، الحرية، الصمت، الحبّ، الموسيقى، الطبيعة…