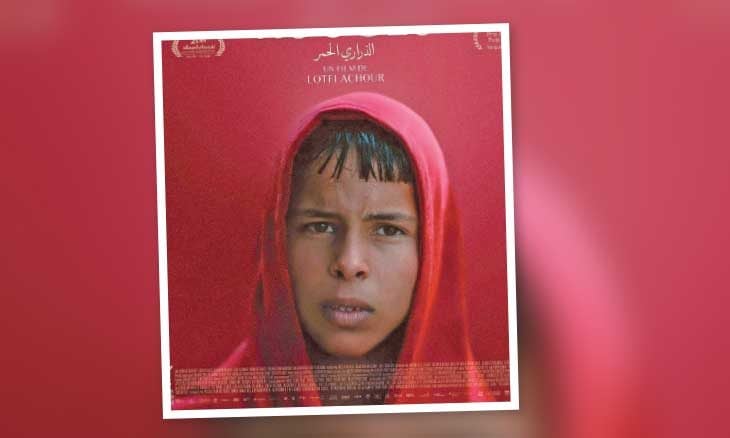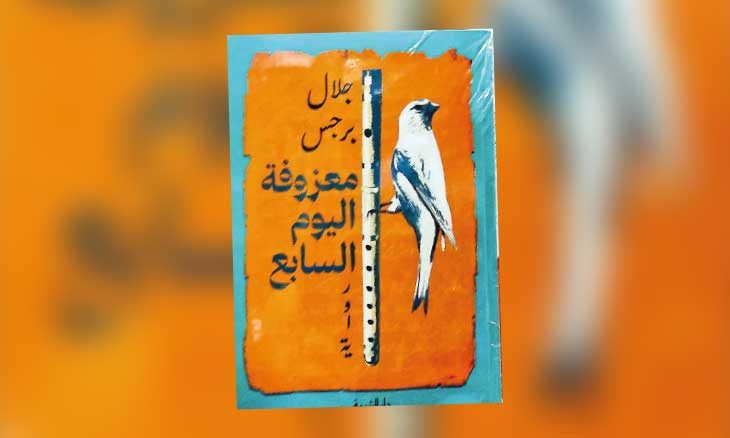كيف تقرأ إدوارد سعيد في غزة

محمود بركة
كَتبَ إدوارد سعيد «الإذن بالرواية» وترجمها عبد الرحيم الشيخ، عن الفاشية الاستعمارية، التي تحفر للحرب، لاجتياح إسرائيل للبنان عام 1982، السؤال يعود لغزة وهي تعيش أكبر حرب عرفها التاريخ الحاضر على مرأى الكون، من يكتب الزمن الفلسطيني وروايته في غزة؟ الزمن الصاعد بالمأساة وعصر الإبادة الصهيونية، في غياب الأنظمة، وقانون لم يسأل عن الصهيونية وضحاياها، ما الرواية، ومن كاتبها؟ وأين يقع السؤال، الكتابة عن الشهداء؛ والأطفال أزهار الأمل والحياة، منهم المستيقظون في ثلاجات العدو دون موت طبيعي، والبيوت المحطمة، وبلاد صارت بوابات المراقبة والعقاب، ومشرحة الحركة والحياة، تُعيد صوت الكارثة الأول، وتعيد الصورة، وتعيد الحقيقة إلى مكانتها، حين يضيع في المتاهة الوهمية إذ لا يرى شفير الأوجاع، وقيامة مستعجلة تدق الجسد لحظة الاستعجال، فتطارد المكان وأزمنته، ولأمّنا الشجرة خطاب واحد وسؤال «شو نعمل»، ليعود السؤال الأكبر في التاريخ «ما العمل؟» حين يصبح التاريخ «أسلوبا متأخرا» عند من يقوده متوهماً فهم الماضي ومستقبله، والسياسة المتأخرة، والمتقدم هو من يجدد صياغة الفعل الواحد وطريقه في الفداء والتضحية.
في غزة المحاصرة المحتلة تتجدد الرواية تكتب سطورها بالدم الفلسطيني من الأطفال والنساء، حتى الأطباء والصحافيين وفدائيي المكان والزمان «لا يعتذر عما فعلت» يقول إعجاز أحمد: على الفلسطينيين أن يكتبوا روايتهم، لأن لحظة الفاشية تكبر بحفريات الكارثة، وقد كتبها إدوارد سعيد المتمسك بفلسطين والمواجه للأنظمة ضد الخوف والتردد، وقد كتب نقده ووضع كراسات العمل السياسي الوطني، معلقاً الجريمة في أعناق مرتكبيها من النهر حتى البحر، في غزة يعود بيت محمود درويش «لا تكتب التاريخ شعراً» والتاريخ هناك يحاكم الجلاد ومناصريه، في ذاكرة الحقيقة، التي لا يؤجلها الزمان..
الذاكرة خارج الماء.. وحجر الخطاب
من «أنسنة» الوقت، قبل أن تأكله صناعات الذكاء المُصنع، إدوارد سعيد «إلى ما بعد الموت، بداية الرحلة من بطن اللغة الأول حتى ما بعد السماء الأخيرة»، صار جداره، في الحديد الآخر، شعور الطوبائية يمشي باحثاً عن الوصول وإن تعثرت الدروب، يُصبح أكثر خروجا، إذ توقفت «الذات الجوّانية» في حجر الخطاب الفلسطيني المقاوم في قلب جغرافيا أخرى، تشبه الشرق لحظة الثبات، إذ لم يكن مهددا، كتبْ إدوارد، تاركا الصوت «وداعا إذا شعرت بالاكتئاب» إلى محاولاته الصعبة، ومفادها، لا يمكن المصادقة على جغرافيات للاستعمار، اختار سعيد مكانه الأخير «وليس مكانه تماما ليطلّ قبره على فلسطين من ناحية الجنوب اللبناني من جبال ترسو فوق بيروت» وعاش لاختياره الفعلي، ووصل زمنياً بمسافة الكتابة، وطريد الأشباح من مكان إلى آخر، واختار سعيد للرواية والحوار إقبال أحمد، صديقه الأبدي، وبلاكميور، الذي شكّل بلغته الصعبة حالة استثنائية، تستدعي الفهم والدراسة، بعد حياة «في قلب الظلام» مع جوزيف كونراد، وإيمانه بكتابات تيودور أدورنو، ورسائله إلى إسرائيل شاحاك حول «معارضة التمييز العنصري»، روايات الأساطير، والاستشراق صار حقيقة ووثيقة لفهم أسباب المأساة، والأسلوب المتكرر، وحجرا في يديه يقذف سياج الكارثة؛ رحلة الحل والحقيقة النهائية. هذا المقطع يجسد جزئياً لا غنى عنه في كتابة التاريخ والحقيقة حين ذاك»، سلطة المؤلف المهيب، الذي يبدو أن صفته الباطنيّة تكمن في عدم خضوعه لأيّ نظام من أنظمة التصنيف، يترك إدوارد سعيد هذه العِبَارة بسياقات متعددة، تشيد في الدلالة للتأكيد على اشتراطات متغير الثقافة، كلمة تعلقت على مسمار كاتب الأنظمة «السائلة» المنتمية لسياسات وصلت لمستوى للانفكاك بالسير في مسار يضعها في قبضة الهيمنة، كنوع من تأمين البقاء، وقارئ يقرأ بحواس الأسماك، في حالة الموج ينام بين الصخور، ليقرأ ويتحدث عن كل شيء إلا عن المواجهة لأسباب الطوفان والغرق (الإفلاس والمسخرة)، ذلك ما بعد حداثية تعود على وجدانية الفرد ذاته، صاحب القلم والمسرح والسياسي وحتى المهرجان الثقافي، وكل تلك الفواعل التي تأخذ معنى الاغتراب الغريب في سياق المسافات الجديدة، إذ يُصبح المرء ذاتية غير واضحة رغم مرايا الوضوح، وغير مفهومة في عالم مفتوح، شديد الضيق.. وسؤال يحاول إزاحة الكم إلى كيف العمل؟ سقطت الأقلام من الأدمغة المصبوغة بالركض في انفعالات كثيرة، وهو يشاهد الأيدي تتعلم الرقص مع السموم المهاجرة إلى الصحراء المتحولة لذاكرة التراب.. والحجر وحدهُ ابن الطبيعة يقاوم، بعد تخدير جسد البشرية، لكنه يصحو بالنقد المقاوم، من قدم الطفل يسأل سؤال الوجود الأبدي. «عمو رجليا بتطلع ثاني» هذه الكلمات وحدها كافية لكتابة الرواية في غزة، دون إذن وانتظار البرهان والأدلة لما يفعله الاحتلال الكارثة في فلسطين وجغرافيات أحلامه..
نحن نعود بالسؤال مما علينا اختياره الآن والحرب في غزة تقتلع الجذور وتواصل التدمير، في زمن الاستقطاب الذي يريد ذاكرة تتغير حتى تصل مرحلة الصم وتذويب الحق في متحف التاريخ، إلى تغير الكتابة، هذا طريق مسدود بالمستحيل وأن وضع قدميه في البداية، حيث الفكر متعلق بالوجود والفعل، وفعل الفلسطيني النابت في الأرض لا يتوقف ولا يهدأ، إن معالجة الكتابة هي فعل مقاوم للذاكرة والنهج الذي يتبعه الفلسطينيون في بلادهم المحتلة، منذ الوريث الاستعماري البريطاني، مروراً بمجازر المنفى في المخيمات حتى الضفة الغربية والقدس، إلى غزة التي امتلأت بالوداع وأوراق المنفى داخل المكان، يلدغ اللون خياله حين يحاول كتابة التاريخ شعراً ويتوقف يترك النّص لمحاورة راشد حسين، فيقول «لن تصير الخيمة السوداء في المهجر قصرا، وصديد الجرح والإعياء لن يصبح عطرا، وجيوش القمل لن تصبح أغناما، ودموع اليتم لن تصبح للأيتام خمرا، وثمة فتاة بين الخيام ماتت ولم يسعفوها، دفنوها في ظلام الليل سرا دفنوها، لينالوا مؤن الطفلة من قوت جهنم، مضوا عنه وقالوا عش سعيدا في جهنم»، وغزة نشيد الأمل والجسد المجروح في لوحات الصمت على جدران العالم..
ثلاثية الحرب
للجذور في مجابهة عناقيد البقايا، ما يعود قديماً، كأول الحُلم، وأول الصوت، وأول الوردة، وأول ليلة تحت حجر الأرض، وللوقت شظايا من الحديد، اللحم يتعرى أمامك، كعناق العاشق، وفي الرأس تدور المغفرة إلى المستحيل؛ من يخرج «الضوء الأزرق» حين صارت ملحمة الموت، ولن يُنسى، وإن صرخ الغفران للصلاة على جبل الركام، من يعيد لشهداء غزة الأمنيات، والأسئلة الحرجة، لمن بدأت رحلتهم مع الغرق الأبعد من حدود الماء، قلتُ للشجرة، وطائرات الفاشية تحاصرني، لا أريد الموت الآن، لا أريد رؤية الدم بلا جسد، قالت شجرة المقبرة الوحيدة، والأطفال الثلاثة يكبرهم الراوي، والعصا الذاكرة، السعداء لا يطرقون الأسئلة، قلتُ، لدينا بيت من زجاج، يشبه جسد أمي، حين كان تحلم بالأمومة، وتذكرتُ مع الجنازة السريعة، أن أمي رحلت، وعيناها مفتوحة في لحظات الوداع، تكتب سطرا أخيرا، لمن غاب عن المعركة، وغاب طويلا عن الحصار، وغاب بعيدا في أبراج الذاهبين نحو الهراء، والبيت صار مقبرة جماعيّة لا للنسيان والغفران، سلام لغزة، حتى يصرخ الشهداء، وكل الكلام رماد، حين يختصر الطفل الكتابة بكلمة، وقد رحل إلى سياج ما بعد السماء، من يُجيب على سؤال الطفل، يُجيب على سؤال الرواية في يوميات الفداء والعائد من المنفى، إلى الثابت في منفى لم يكن خارج المكان، وكتبوا أطفال غزة الرواية…
صحافي فلسطيني