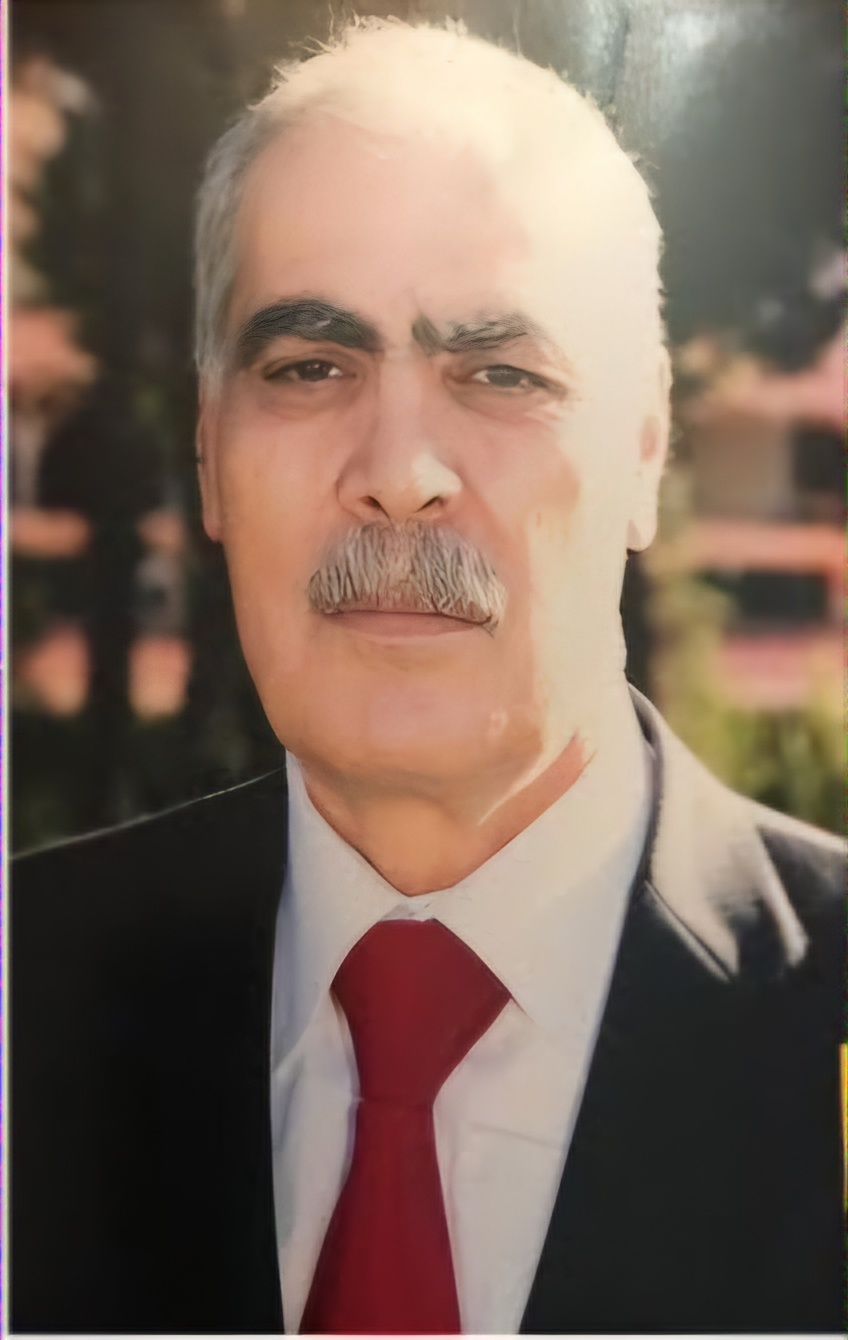وذكّرهم بأيّام فلسطين

وذكّرهم بأيّام فلسطين
منصف الوهايبي
قد يكون الفلسطينيّون في التاريخ المعاصر هم الشعب الوحيد الذي حاولت دولة الاحتلال الصهيونيّة منذ النكبة إنكار وجوده. غير أنّ تقلبات الأيّام، وتحديدا منذ القرن العشرين، وما تعرّض إليه الفلسطينيّون من المحن والمآسي، وما خاضوه من كافّة أشكال النضال، سواء في فلسطين التاريخيّة أو في الشتات، عزّز هويّتهم الفلسطينيّة وتضامنهم على نحو مثير؛ بالرغم من الفروق الاجتماعيّة والثقافيّة والفجوات الاقتصاديّة بين لاجئ في غزة أو أريحا أو رام الله أو الأردن، ولاجئ في مجتمعات الوفرة في أمريكا أو الخليج أو أوروبا.
يقول ادوارد سعيد، وأنا أنقل كلامه بتصرّف بسيط، عن الفرنسيّة، في تعليقه على كتاب رشيد الخالدي «الهويّة الفلسطينيّة: صياغة وعي قومي حديث» (ت.جويل مارلي عن الانكليزيّة) إنّ هناك وجهة نظر ذائعة مفادها أن الفلسطينيين اكتسبوا هويتهم من حيث هم شعب، من صراعهم مع الحركة الصهيونيّة. وقد عزّز هذا الرأي أو الانطباع، وهو في الحقيقة ينطوي على إنكار لحقوقهم الوطنيّة، ما تكبّدوه، لأسباب قد تكون موضوعيّة أكثر منها ذاتيّة، من «خسارات» في الأرواح والممتلكات.
والخالدي يستأنس في هذا الكتاب بمصادر صهيونيّة وإسرائيليّة وعربيّة، ليبين أنّه إذا ما كانت هذه الهويّة قد «صيغت» أو وُضعت نظريّا أو «ابتكرت»، فهي ليست بأقلّ واقعيّة. على انّه يكشف في هذا العمل الرائد أنّ الوعي الوطني الفلسطيني، إنّما ظهر في نهاية العصر العثماني في الأوساط المثقّفة. ويحفر عميقا في أرشيفات المكتبات الخاصّة بالعائلات والمثقّفين الفلسطينيين البارزين، وفي أوراق الصحافة، و«ينبش» عن كلّ ميّت ودفين، في حياة السياسيين الفلسطينيين في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. ولقد توصّل بمهارة لافتة وهو يحشد معرفته ومناهجه، في قراءة كلّ هذه الوثائق؛ ليقودنا بتؤدة إلى تتبّع شتى الطرق والمسارب والثنايا التي يسّرت انتقال الفلسطيني من واقع الهوية الطبقيّة المتعدّدة إلى شعور وطني أكثر اتحاداً وعزما. وهذه الهويّة الفلسطينيّة، التي تشكلت منذ نهاية القرن التاسع عشر، ليست بمعطى طبيعي ولا هي تتوافق معه أو مع تجريد فكري: فالوعي الوطني الفلسطيني هو بلا شك بناء قائم، وطريقة استوفت شروطها تاريخيّا، من أجل أن يأخذ الفلسطيني مكانه في العالم. لكن دون أن تحرمها هذه التاريخيّة من الواقع البتّة: فهي بدورها تحدّد العلاقات والتاريخ والسياسة. وقوة هذا العمل العلمي الذي أنجزه رشيد الخالدي تكمن في إبراز الهويّة الفلسطينيّة من حيث هي واقع صيغ تاريخيًا، ممّا يسمح ويمهّد لنا فهما أفضل ليس لتاريخ هذه المنطقة وقضايا الشعب الفلسطيني وحسب، وإنّما أيضًا لإذكاء نقاش أوسع حول القوميّات وأعمق.
وليس بالمستغرب أن يشيد ادوارد سعيد بهذه الدراسة المتعمّقة في تاريخ صياغة الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة، وأن يعدّها عملا رائدا ذو أهميّة قصوى. وهو في تقديره «الكتاب الأوّل الذي كان منطلقه أنّ هذه الهويّة موجودة بالفعل، إذ يكشف عن فروعها أو طبقاتها المتقاطعة ومراحلها التاريخيّة وهزائمها المأساوية، مع معرفة تامّة بالببليوغرافيا والمصادر العربيّة والعبريّة والغربيّة». ومع ذلك لا بدّ من دراسة لتاريخ الأماكن التي تشكّلت فيها الهويّة الفلسطينيّة، ومعرفة كيف يعرّف الفلسطينيون أنفسهم؟ وكيف يُنظر إليهم، منذ القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر؟ وثمّة مفاتيح للهويّة هي «قيد الإنشاء دائمًا» من أجل فهم هذا الشعب العظيم الذي يناضل من أجل الاعتراف به؛ ذلك أنّ الهويّات ليست أبديّة ولا هي بالثبات الذي نتوهّم. وما يقترحه الياس صنبر من ضرورة أن نسأل «أين نحن؟» بدل السؤال» من أين نحن؟» فيه مقدار كبير من الصواب؛ من أجل أن نتحرّر من أسطورة «اللحظة الصفر للهويات» ومن فكرة أنّ للهويات تواريخ ميلاد، منها يبدأ استمرارها.
ولذلك يصحّ ما يقوله البعض من أنّ الأمر يختلف مقارنة بالشعوب الأخرى في الشتات حيث الأساس في وحدة المجموعة: وضع الضحيّة والتعويض لها، بالمعنى الحديث أي كلّ من يُقتل أو يُجرح في كارثة أو حادث، أو كان عرضة لأذى جسدي خطير؛ حتى كاد المفهوم يخلو من أيّ تمييز بين ضحيّة وضحيّة؛ إذ صرنا نعتبر كلّ شخص كان عرضة لأيّ مظلمة أو أيّ ضرر «ضحيّة»؛ سواء أكان مردّ هذا الضرر إلى عنف أو ظلم، أو حتى إلى مرض أو حادث أو اغتصاب أو تعذيب أو قتل، أو إلى أذى أو إهانة أو مخالفة أو خرق للقانون؛ وسواء أكان هو مدّعيا أم شاكيا؛ فالكلّ ضحايا والكلّ مظلومون. والتعميم كان ولا يزال مدخلا إلى المغالطات. ولا نظفر بالحدّ الجامع المانع إلاّ في قرار الأمم المتّحدة الصادر عام 1985 الذي ينصّ على أنّ الضحيّة/ الضحايا «هم أشخاص أفراد أو جماعة، كانوا عرضة لظلم، ونيل من حرمتهم الجسديّة خاصّة أو العقليّة، ومعاناة نفسيّة وخسارة مادّيّة؛ وتعدّ خطير على حقوقهم الأساسيّة؛ بسبب من أفعال أو إغفالات تنتهك القانون الجزائي المعمول به في دولة عضو، بما فيها الدول التي تحظر تجاوزات السلطة». وهو ما لا تقرّه دولة الاحتلال التي لم يتورّع وزير خارجيّتها عن تمزيق ميثاق الأمم المتّحدة، غير واع أنّه بصنيعه الفظ، إنّما يمزّق دون وعي منه، «شهادة ميلاد « دولته على أرض فلسطين: قرار التقسيم.
ما يفعله الاحتلال هو تحويل الفلسطيني إلى كائن غُفل يُشلّ ويفقد منزلته الإنسانيّة، يصرّفه الجلاّد ويتصرّف فيه كما يشاء؛ ولا تفكير له ولا تدبير، بل لا إرادة له ولا رغبة، بل يُقطع لسانه، ولا «يقيم» في جسده الخاصّ كما نقيم. بل هو يفقد إحساسه بالزمان وبالمكان على نحو ما نحسّ ونكابد. كل شيء في معتقلات الاحتلال عبث أو عدم، حيث الفلسطينيّون قطيع يُعامل بكل احتقار، يضربون دون غضب، ويمحون دون سبب. وعليك أن لا تسأل «لماذا؟» بل عليك أن لا تفكّر في السؤال أصلا، بل عليك أن لا تحاول أن تفهم؛ بل أن تكون «إمّعة» لا شخصيّة ولا رأي له: دمية يُتلاعب بها، وهي تُحرّك بالخيطان. ومن ثمّة لا يحقّ للضحيّة أن يتصرّف بإرادته أو من تلقاء نفسه. وكلّ ما كان ذا معنى عنده يُمحى، وكل ما كان رابطا بالعالم، يُقطع. وليس أدلّ على ذلك من شهادات الفلسطينيّين، وقد تقطّعت بهم السبل، وكأنّ لكلّ شأنًا يغنيه؛ وهو يُقطع عن أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه. بل يكاد لا يتفرّغ لما هو فيه من هول المحنة وشدّتها، لأحد، ولا يشتغل حتى بنفسه. تحدث هذه الإبادة في عالم يستطيع فيه أفراد أوتوا سلطان المال والنفوذ والسلاح، أن يجعلوا من الغير ضحايا.
تخذلنا اللغة، ولا نجد العبارة التي تفي المحنة حقّها من الوصف والتصوير. وقد لا نجد أبلغ من قول جيل دولوز «الغير ينعدم» فهو الآخر الذي لا نعترف به «آخرا»؛ وهو من ثمّة مجعول للغياب والنسيان والمحو والهجران. أمّا في ذاكرة لسان العرب، فترجع كلّ معاني الضحيّة والجريمة إلى جذر القطع والبتر كيفما قلّبتها، وإلى القتل والذبح والنحر. وهي ثنائيّة لا فكاك منها: القاطع/ القاتل والمقطوع/ المقتول. ومن لطائف العربيّة أيضا أنّ أصوات الحروف تجري على سمت الأحداث ومسموعها. وعلى هذا تجري كلّ هذه الأفعال التي تتصدّرها القاف أو تقفلها (قتل وقطع وقسم وقصم وقلم وقلع وقبر وقعر ونفق وفتق ورتق وسلق وفلق…) وهذا ما تقوله غزّة اليوم حيث للمحتلّ القاتل وجهان: وجهه ووجه ضحيّته.
ومع ذلك يظلّ مفهوم الضحيّة محفوفا بالغموض، وقد لا يوضّحه سوى الضحيّة؛ والضحايا لا يتكلّمون دائما لسبب أو لآخر. وهذا إنّما تنهض به الفنون في فلسطين، وتحديدا الشعر.
في الثلاثينات من القرن الماضي، كان بن غوريون يردّد أنّ قوّة الصهيونية تتمثّل في تحويل «المسألة اليهوديّة» إلى «قضيّة عربية». بيد أنّ المقاومة الفلسطينية استطاعت منذ الستينيات إعادة طرح «المسألة الفلسطينية» من حيث هي قضية دولية كبرى. والحلّ السياسي العادل هو وحده الذي يمكن أن يسمح لنا بالإفلات من هذه الدوّامة الجهنّمية التي يدور فيها الاحتلال الذي يرفض اليوم حتى حلّ الدولتين، زاعما أنّ شرط وجود أحدهما هو نفي الآخر. وها هنا يجب على التاريخ أن يفسح المجال لـ«الاستقباليّة» حيث تشعّ فلسطين اليوم على العالم. وهذا مهاد لشتّى هذه الأسباب والملابسات التي تتيح لنا أن نرجم بالمستقبل الذي تتولّد منه أيّام فلسطين الحرّة.
أمّا العنوان الذي وسمت به هذا المقال، فهو تنويع على الآية الكريمة «وذكِّرْهم بأَيامِ الله» ابراهيم، الآية5، وهو تعبير كنائي، من لطائف القرآن إذ المقصود بـ«الأيّام» نِعَمُ الله التي أَنْعَمَ فيها ونِقَمُه التي انْتَقَم فيها. ولفلسطين اليوم نعمها ونقمها.
*كاتب من تونس